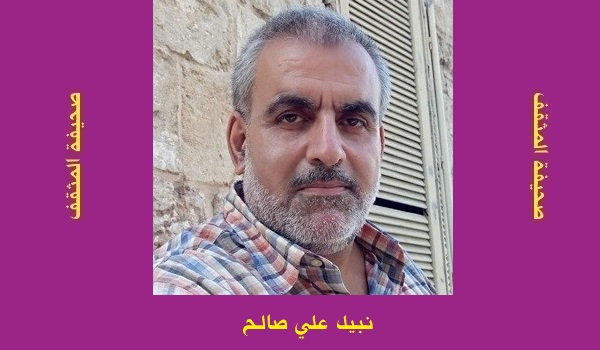قضايا
مجدي إبراهيم: محمد عبده.. من عقلانيّة الإمامة إلى حكمة العارفين (5)

توقفنا مع الإمام محمد عبده عند قوله: "كل ما أنا فيه من نعمة في ديني، فسببها التصوف".
وقلنا إن هذه المقولة الخالدة وحدها استبصار ذوقي، كاشفة عن أذواقه وإشراقه الروحي ومراقي بصيرته؛ فهو يعد التصوف نعمة أنعم الله بها عليه في دينه، بل عنده أن "التصوف هو الدين"، "وأن ارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية الإلهية هو بحث دقيق ممّا أختص به علم التصوف"؛ ولنلحظ أنه يذكر التصوف ولم يذكر الصوفيّة؛ لأن نقد الصوفية وارد ليس منه مانع، إذ كان نقداً للرجال وللأفكار. إنّما الفرق واضحُ وضوح الشمس في ضحاها بين إنكار أشخاص ومسالك، وإنكار قضايا وعقائد؛ فالأشخاص ممّا يجوز لك الاختلاف معهم ومع مسالكهم فيما شاءت لك حجة الخلاف أن تمضيها نقداً على الأعمال والأفكار، وعلى ما يكون وراؤها ممّا يكشف عنها فيما هو مخبوء تحتها من طوايا ونوايا وتخريجات.
وليست العقائد الكبرى هكذا؛ لأنها ليست سوى النصوص، صامتة في ذاتها لا ينطقها إلاّ من أراد النطق بها بمقدار ما يفهم، وبمقدار ما يلهم منها، ومن ذلك الفهم الذي يتوخّاه. أمّا التصوف فمعناه كبير جداً فهو القيمة العليا، هو الإحسان من الدين ومقام الإحسان من الدين إذا أوتيه إنسان فليس من نعمة فوقه.
وتتجلى لديه حكمة العارفين منهجاً لطريقة العمل والتفكير في أرفع صورها وأخلص عطاياها، حين يكون مع المتصوفة في رياضاتهم النفسية والفكرية؛ وله من الرأي السديد:" أن إلهام المتصوف "ذوق وجداني" لا يجوز له أن يدين به غيره، ولا ينكر أن لهم أذواقاً خاصاً وعلماً وجدانياً، ولكنه خاصٌ بمن يحصل له لا يصلح أن ينقله لغيره بالعبارة، فإنِّ هذا الذوق يحصل للإنسان في حالة غير طبيعية، وكونه خروجاً عن الحالة الطبيعية، لا يجوز أن يخاطب به المتقيد بالنواميس الطبيعية.
فكل ما يتصل بالمعارف الوجدانية والإيمان ممّا ليس في استطاعة البشر بذله أو البذل منه، وهو ما فضل الله به بعض الناس على بعض في المواهب الظاهرة والباطنة هو ما يسميه الصوفية بالأسرار التي قالوا فيها: إنها أمور ذوقيّة لا يعرفها إلا من ذاقها، فلا يصح أن تطلب ولا أن توهب".
ومع ذلك كله؛ فقد نجد بيننا الكثير ممّن فقدوا ذوق البصيرة والشعور الديني الصادق؛ من يرى أن التصوف ما كان، ولن يكون أبداً، حسب اعتقادهم، هو طريق الخلاص من وضعنا المتردي، لأنه في نظرهم طريق استسلامي يشجع على استكانة المشاعر وانهيار القوى في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للروح الوثابة، والمشاعر الثائرة، والفكر النير، والحلول التي تخلصنا من مشاكل التخلف التي نرزح تحت وطأتها صباح مساء.
ومن الغريب الداعي للدهشة أن هذه الصفات الأخيرة التي ومضت من عقولهم على غفلة في زمن القيم الساقطة، والتي يرصّونها لفظاً ميتاً لا حياة فيه يجيء بغير معنى ولا مدلول هى صفات في الأصل من العمل الحي لمعطيات التصوف ومن فاعليته الكبرى، فالروح الوثابة الحرة الطليقة والمشاعر الثائرة والفكر الصافي المستنير هى في الواقع صفات الصوفي الحقيقي الذي لا يعرف للخمول ولا للاستكانة طريقاً بل هَجِّيرَهُ العمل، وديدنه الجهاد في سبيل مطلوبه، وغايته الإخلاص في القول والفعل؛ فلا يهدأ الصوفي أبداً إلا أن ينال ما يريد؛ لكن الفرق بينه وبين غيره من أصحاب الإرادات أن مراده غير مرادات الذين غرقوا في وحل الواقع المتردي؛ فانهارت قواهم على التصدي له بروح وثابة طليقة فلم يتقدّموا في إصلاحه خطوة واحدة، ولا حتى ترقيعه قيد أنملة، بل كلما رقعوه تمزق منهم ولا يزال مع التّمزّق حتى مزق بشراهته نفوسهم وقلوبهم حسرةً على الضعف والتردي والشّرَه المادي الساقط اللعين.
ولا يخفى أن للإمام محمد عبده موقفاً من نقد سلوك المتصوفة الطرقي التجهيلي الذي لا يقوم لديهم على العلم ولا المعرفة؛ بل على الاعتقاد السلبي في شيوخ التصوف مما بثت في نفوسهم أوهام الوساوس التي "تملك الجاهل وتربك العاقل إذا لم يغلبها بعوامل الدين الصحيح"، وعلى "اتخاذ الدين متجراً يكسب منه الحطام ويجعل من ذكر الله آله لسلب أموال الطغام"؛ ممّا يسبب لوثة الاعتقاد بل الشرك، وهو أمر لا ينفرد به محمد عبده وحده؛ بل وجد عند أعلام التصوف أنفسهم: نقد أنفسهم بأنفسهم نقداً ذاتياً منذ أيام المحاسبي في الرعاية لحقوق الله، والغزالي في الإحياء، والقشيري في "الرسالة"، ووصولاً إلى الشعراني في "آداب العبودية".
فلئن كانت حكمة العارفين قد تجلت عند الأستاذ الإمام والفيلسوف الحكيم في أعلى مراقيها، فهو من جانب آخر كان، طيّب الله ثراه، "... مع الحكماء المتصوفين ولا سيما الأخلاقيين؛ لأن التصوف عنده رياضة عقلية. غير أنه يرى لهذه الرياضة جانباً غير الجانب الحسي من الحياة الدنيوية يسميه "ذوقاً"، ويحمد من صاحبه أن يروض عليه ضميره ووجدانه ولا يدين به أحداً من المقيدين بالحياة الطبيعية أو الحياة الحسية؛ لأن الأمر في هذه الحياة لما يستقيم عليه صلاح الجماعة، ولا محلّ فيه للذوق الخاص الذي تراض عليه طبيعة العموم".
ذكر الإمام محمد عبده للسيد رشيد رضا يوماً قوله:" إذا أنا يئست من إصلاح الأزهر، فإنني أنتقي عشرة من طلبة العلم، وأجعل لهم مكاناً عندي في "عين شمس" أربيهم فيه "تربية صوفية" مع إكمال تعليمهم"؛ ويعقب رشيد رضا على ذلك، أن الإمام محمد عبده كان أقترح على السيد جمال الدين الأفغاني هذه الاقتراح أيام كانا ينشئان مجلة "العروة الوثقى" في باريس، ثم يقول رشيد رضا معقباً على هذا:" ولو تمَّ للأستاذ الإمام هذا على الوجه الذي يريده، لكان أعظم أعماله فائدة" .
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: ولماذا التربية الصوفيّة؟
لأنها هى سبيله الذي قاده إلى الكمال، وقرر من يوم أن فتح الله بها عليه أن يكون كامل المعرفة، من طريق ذلك الشيخ الصوفي الشاذلي (درويش خضر) خال أبيه، الذي أخذ بزمام الجانب الروحي من تلميذه الفتي (محمد عبده) في عنفوان ثورة نفسية، قد وجه عواطف الشباب وخيالاته إلى معان من اللذائذ القدسية. مرة أخرى .. ولماذا التربية الصوفية؟ لأنها داعية إلى تلطيف السر بأنواع الرياضات؛ كالعبادة المشفوعة بالفكرة والألحان المستخدمة لقوى النفس، الموقعة لما لحن من الكلام موقع القبول من الإفهام ويعين على تلطيف السر- كما يقول ابن سينا في الإشارات - الفكر اللطيف، والعشق العفيف الذي تأمر فيه شمائل المعشوق لا سلطان الشهوة. إنه كانت التربية الحديثة تدعو إلى تهذيب الذوق بفنون الجمال، كما يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق في ترجمة الإمام على صفحات جريدة المنار لمنشئها رشيد رضا؛ فإن التربية الصوفية تدعو إلى تلطيف الأسرار وتهذيب قوى النفوس.
ولا جَرَمَ كانت تلك التعاليم الصوفية من شأنها أن تربي الوجدان وتكمّل النفس وتزينها بمفعول الآثار. ولا جَرَمَ كذلك كان الشيخ محمد عبده صوفي الأخلاق.
وليس في المستطاع تصور تربية مستقيمة في رحاب الدين القويم بغير اعتماد التربية الصوفية؛ لتكون أساساً لها ومرتكزاً على دعائمها، وذلك لأن غرض صوفية المسلمين كان تربية المريدين بالعلم والعمل الذي غايته أن يكون الدين وجداناً في أنفسهم تصدر عنه الأعمال الصالحة ولا تؤثر فيه الشبهات العارضة.
ــ موقفه من الصوفية:
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف أراد الأستاذ الإمام ـ في حالة يأسه من إصلاح الأزهر ـ أن يربي تلاميذه من طلبة العلم "تربية صوفية"، وهو في الوقت نفسه يكيل الهجوم على المتصوفة وبخاصّة في موقفهم من الحرية؟ أو كيف صار التصوف لديه بديلاً تربوياً وهو في ذات الوقت يحاربه، ويحارب معطياته العملية؟ وللإجابة على هذا السؤال نتوقف وقفة تحليلية نزيل بها هذه الإشكالية؛ لنرى موقف الأستاذ الإمام من مشكلة حرية الإرادة الإنسانية وتكييفها تكييفاً عقلياً وشرعياً أيضاً.
وبداية نقول: إذا كان الشيخ محمد عبده قَدَحَ في موقف الصوفية من الحرية، وبخاصَّة حرية الإرادة الإنسانية التي لا يعترف بها ولا ينشط لموجباتها إلا الجهلة والغافلون، فهو في موقفه هذا لا يعدُّ قدحاً على الصُّوفيَّة، ولكنه قدح بالجملة على الجهل والتخلف والركود الروحي وادعاء الولاية على وجه العموم.
وقد يفهم من أقواله إنه يقدح في موقف الصوفية من الحرية قدحاً شديداً، وينعي باللائمة على تركهم العامة يعيثون في تيه من الفوضى والعبث اسمه "الجبر"، ويعتبره موقفاً يكاد يكون خارجاً عن الإسلام، ولا يَكاد يعتبره موقف مَنْ يؤمن بقدراته وملكاته التي غرسها الله فيه. فواجب كل مسلم ـ كما قال ـ:
"هو أن يعتقد بأن الله خالق كل شيء على النحو الذي يعلمه، وبأنه يجب عليه مع ذلك أن يُقرَّ بأن أعماله منسوبة إليه، وأن يعمل بما أمره به وَيَتَجَنَّب ما نهاه عنه، وذلك باستعمال تلك الحرية التي يجدها من نفسه. وليس على المسلم بعد هذا أن يبحث فيما وراء ذلك".
أقول؛ قد يفهم منه أنه يهاجم التصوف والمتصوفة، ولكن فهم من يَفْهَم عن الأستاذ الإمام أقواله شيء، وحقيقة هذه الأقوال شيء آخر؛ لكأنما الصوفية لا يعيرون اهتماماً بالغاً لما كان قرَّره الشيخ، وهو الاعتقاد بأن الله خالق كل شيء، وأن العبد عليه أن يعمل بما أمره به ويتجَنَّب ما نَهاه، ويقر مع العمل بأن أعماله منسوبة إليه، فمن يفهم من قول الشيخ محمد عبده معنى أن الحريّة عند الصوفية تخالف هذا يفتري عليهم كل الافتراء.
نعم! قد يركن العجزة والمفلسون إلى البطالة والخنوع والتردي وكل ما يؤدي في عصب الحياة إلى الكسل والخمول، ثم نسبة ذلك كله إلى القضاء والقدر في الإسلام. ولكن هذا كله شيء، والتبتل العميق في باطن الوعي الصوفي شيء آخر، وهو ما أشار إليه محمد عبده نفسه، وهو بصدد بحث مشكلة القدر التي نهى القرآن ونهر الحديث عن الخوض فيها وكثرة الجدال لما يتضمنها جسيم الخطر، وركز على الإيمان بالقدر الذي لا يتطلب بحث هذه المشكلة الغامضة، غير أنه يجزم بأن التطلع إلى حلها هو "شَرَه العقول في طلب رفع الأستار عن الأسرار".
وليس في مقدور العامة ـ كما قال ـ أن تنفذ بصائرها إلى أسرار الحرية والقدر؛ فذلك شأن من شئون القليلين من أهل الولاية والصفاء.
وعليه يمكن القول، بأن الشيخ محمد عبده لا يُهَاجم الأولياء من كبار الصوفية، كيف وهو القائل: "إنه لم يوجد في أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس، وأنه بضعف هذه الطبقة وزوالها فقدنا الدين".
ولقد تصوف مصلحنا العظيم - كما قال أستاذنا العقاد - زمناً في صباه، ولا نخاله أبتعد من طريق المتصوفة إلى ختام حياته. وهو ينسب نفسه إلى الطريقة الشاذلية، ويحترم أبا الحسن الشاذلي، وهو من أهل طريقته، ولم يكن سالكاً طريقة غيرها.
ولكن الأستاذ الإمام والفيلسوف الحكيم يهاجم خزعبلات العامة من المسلمين ممّن ساروا في غير علم ولا دلالة وراء كبار الصوفية، بيد أنهم لا يعملون عملهم ولا يطيقون مجاهداتهم، ولكنهم ركنوا إلى القضاء ركون المفلس العاجز الضعيف، فبثوا في نفوس الضعفاء أوهاماً لا نسبة بينها وبين أصول دينهم؛ الأمر الذي دفع الوهن بالمسلمين فكانوا يرزحون تحت ثقل الجبر بمعناه الكلامي لا بمعناه الصوفي؛ فالجبر بمعناه الكلامي مراء باطل وجدل عقيم حول أفعال الرّب وأفعال العبد، بما فيه "نظرية الكسب الأشعرية التي يعتبرها الإمام محمد عبده نظرية غير مفهومة.
أمّا الجبر بمعناه الصوفي فهو غير هذا كله: هو شعور دائم بالمعية الإلهية ليس إلا، شعور لا ينقض العمل والعبادة؛ بل يدفع إلى التَّحَرُّر من سطوات الأغيار؛ فهو ليس جبراً كلامياً سلبياً اتكالياً لا ينهض بعمل ولا يتقي شريعة ولا يتوقى العلم، كلا بل معيَّة دائمة لا ينفذ إليها إلا أهل الولاية والصفاء.
وليس أدل على هذا من قوله طيب الله ثراه:" إنه قد اشتبه على بعض الباحثين في تاريخ الإسلام، وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوَّهت جماله، السبب في سقوط المسلمين في الجهل؛ فظنوا أن التصوف من أقوى الأسباب، وليس الأمر كما ظنوا ...".
ولكن هذا كله شيء، والتكاسل والخمول شيء آخر:" فما أشَدَّ جمود هؤلاء العامة وتواكلهم وإشفاقهم على أنفسهم من السَّعي والكفاح. وكأن لسان حالهم يقول: مَادَاَمَتْ قدرة الله قد حُدّدت من قبلُ كل شيء، فليس من الحوادث ما يقع خلافاً لما أراد الله. وإذا كان الله يعلم المستقبل منذ الأزل فلا بدّ أن المستقبل يكون على نحو ما يعلمه الله. وإذن ما الفائدة من العمل؟ وفيمَ نتكلف العناء والنَّصَبَ؟ إننا لا نغير قط شيئاً مما كُتبَ علينا في لوح العالم الآخر. أفليس خيراً لنا أن نسلّم أمورنا إلى المقادير دون أن نفرض على أنفسنا جهوداً مقضياً عليها بالضَياع.
إنّ مثل هذا القول إنْ هو إلا تحريف فاسد للعقيدة والدين؛ لأنه مذهب جبري بحت، لا يقوم على شعور ديني ولا على ذوق إيماني؛ فهذا الموقف الفاسد المهين للكرامة الآدمية هو الموقف المرفوض من قبل الشيخ محمد عبده؛ ولأن عقائد الإسلام تخالف عقيدة الجبر، فلم يكن هذا الموقف بالذي يؤيده القرآن الكريم، وهو الذي أيد الحرية بصراحة تامة، ومن غير مواربة في نحو ست وأربعين آية. وإذا كان هناك آيات أخرى قد يكون فيها ما يفيد فكرة القهر والجبر؛ فلم ترد تلك الآيات إلا لتقيم القوانين الإلهية العامة التي نُسَمّيها "نواميس الكون".
وفي إطار الدفاع عن الحريّة في الإسلام ونقد كل ما يقابلها من اتجاهات جبرية؛ يذهب الشيخ "محمد عبده" إلى أن الذين ينكرون الحرية يحتجون بالآية القرآنيّة القائلة: "والله خلقكم وما تعملون". وهم يفسرون هذه الآية على معنى أن الله هو خالق أعمال الإنسان. غير أنه يُلاحظ أن هذه الآية نفسها تقول "وما تعملون": فهي بذلك تفيد نسبة العمل إلى الإنسان، ولكنهم قد يزعمون بعدٌ أننا إذا صرحنا بحرية الإنسان، فقد رفعنا إرادته إلى مرتبة الإرادة الإلهية، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله وهو كبيرة الكبائر. ولكن الأستاذ الإمام والفيلسوف الحكيم يدفع هذا الاعتراض على وجه لا يخلو من طرافة، فيبيّن أن الإنسان الذي يقترف إثم الشرك ليس هو الإنسان الذي يعول على قواه الخاصة وقدرته الذاتية، ويعد نفسه مسيطراً على أفعاله؛ بل المشرك هو الذي يفعل ذلك.
ــ وخلاصة القول:
إنما التربية الصوفية في الأساس أدبٌ وحضورٌ بالعلم والعمل بين يدي الله، تتوجه إلى غرس قيم دينية عاملة ونافعة ليس بالمستطاع لغيرها من أساليب التربية أن تغرسها.
هذا ما تبيَّنه الأستاذ الإمام محمد عبده نفسه من خلال تجربة عاشها وتذوق معالمها. ومن هنا فعندما نقول: إنّ اللفظة القرآنية لتشع في قلب المتصوف الذي يقرأ القرآن على شرعة الأدب وفريضة الحضور نوراً متصلاً وحياة جديدة، لكأنما يتلقاه بالمباشرة من ربِّ العالمين؛ فهو يحفظ تلك الألفاظ القرآنية؛ لأنه يعلم نورانيتها بمقدار ما يعلم ما عَسَاه تُضْفِيِهِ عليه هذه النورانيّة من حياة خصبة راقية متجدّدة، يكون قولنا واقعاً مقرراً من حياة كبار أئمة الصوفية أنفسهم ومن حياة الإمام محمد عبده نفسه.
وفي المحافظة على ألفاظ الشارع أسرار: أسرارٌ لا يعلمها إلا أهلها الذين يحفظون في أنفسهم هذه الأسرار ممّا يتبع حفظهم لتلك الألفاظ حين يتوجّهون بها ذلك التوجُّه العلوي نحو شرف الغاية وقصد التحقيق. في الحفاظ على الألفاظ القرآنية أسرار. وفي الحفاظ على ألفاظ الحديث النبوي كذلك أسرار: ألفاظ الشارع فيها أسرار يلمسها لمس اليقين كل مَن تذوَّقها فيمضى من فوره باللفظة إلى غاية ما تصيبه من مكامن الشعور وفجاج الفكر وأغوار الضمير.
إنّ هذا الكتاب قيمة عُلوية كبرى ومباركة: قيمة تلخص الحكمة وتفرِّع مدلولاتها في الواقع وفي شتى مناحي الوجود، بمقدار ما تعطي الحكمة في الوقت نفسه خالصة لمن يخلص لها ويبذل قصارى ما في سعته من تقدير لهاته القيمة تقديراً يلمس آثارها في أعصابه وخلاياه، في جوفه وباطنه، في رُوحه وآفاقه. في كيانه كله، في حركته كلها، وفي سكونه وثباته، وفي مثواه الأخير.
إنه حقاً وصدقاً لمعجزة لا يدركها حق دَرْكها إلا من تحقق بها وعرف بعد التحقيق موارد الإعجاز فيه. طوبى للذين وفّقهم الله إليه؛ فاغتربوا عن هذا العالم وتبتَّلوا في رحاب الغربة من أجله "وَطوُبَى للغُرَبَاء".
وقد دل دليل الصدق في واقع تلك الشخصية الكبيرة: حياتها وأفعالها ومناقبها كما تبينت معالمها في أوصاف الأقربين ممّن عرفوه ولازموه: أنه كان سليم الفطرة، قدسيّ الروح، كبير النفس، صادف تربية صوفية نقيّة زهدته في الشهوات والجاه الدنيوي، وأعدته لوراثة هداية النبوة، فكان زيته في زجاجة نفسه صافياً يكاد يضئ ولو لم تمسسه نار. هكذا وصفه السيد رشيد رضا وافتتح ترجمته بعد وفاته بنحو عشرين سنة بقوله عنه:"إنّ هذا الرجل أكمل من عرفت من البشر ديناً وأدباً ونفساً وعقلاً وخلقاً وعملاً، وإنّ من مناقبه ما ليس فيه ندٌ ولا ضريب، وإنه لهو السريّ العبقريّ". وزاد الأستاذ العظيم عباس محمود العقاد فقال:" رأيت الشيخ محمد عبده مرات معدودة، ورأيته مرات لا تحصى في صوره الشمسية التي لا تلتبس إحداها ملامح صورة أخرى، فكانت النظرة الأولى كالنظرة الأخيرة إلى تلك الملامح فيما تنم عليه وتشير إليه: قوة وطيبة متفقتان لا يبين لك أنهما تنازعتا يوماً أو تتنازعان، فهو قوى لا ينازع طيبته نية من نياتها، وهو طيّب لا ينازع قوته دافعاً من دوافعها، وهو أقرب الناس سمة بما يرتسم في أخلادنا من سمات النبوة وهى في طلعتها الإنسانية بشر مثلنا، وإن لم نكن نحن بشراً مثلها فيما تتلقاه عن وحي الله".
وعندي أنه ليس هناك أدني مبالغة فيما ذكره الأستاذ العقاد ممّا عساه يرتسم من شخصية الأستاذ والإمام، وتبيّن له مما وصف من ملامحها، فهو بحق الفيلسوف العقلاني والحكيم المتأله، تجلت فيه حكمة العارفين كما تجلت فيه عقلانية الإمامة، ولم تنفصل صفة الفيلسوف وجهاد العقل والمعرفة، عن صفة العرفاء ممّن جهدوا أنفسهم في سبيل ارتقاء أممهم وعقائدهم التي يدينون لها بكل الولاء. وما من عجب فقد كان القرآن الكريم قبلته وهداه.
ليس من شك عندي أن دعوة الدين كما بيَّنها لنا الأستاذ الإمام والفيلسوف الحكيم، وكما نفهمها منه؛ لتهدف إلى الشعور بالاستقلالية والتميز، وبالطلاقة الرُّوحيَّة وبالتّفرُّد على شِرعة القرآن؛ ليُنتج الدين على هداها دوماً أُناسَاً خَلاَّقين.
***
د. مجدي إبراهيم