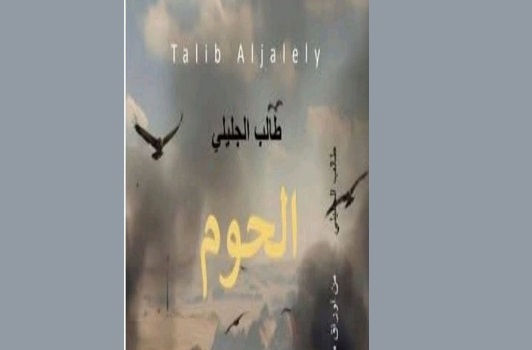قضايا
بدر الفيومي: أشققت عن صدره؟.. قراءة مقاصدية في سماحة الإسلام

وحدود الحكم بالظاهر والعذر بالجهل
لا ريب في أن الحديث عن النية والظاهر والباطن في الفكر الإسلامي يفتح أبوابًا من الجدل الفلسفي والشرعي على مصاريعها، ويثير في الذهن تساؤلات شتى عن حدود العقل في التقدير، وسلطان الشرع في الحكم، ومدى صلاحية الإنسان لأن يكون قاضيًا على ما وقر في القلوب، أو شاهدًا على خفايا الضمائر. وهل يُعقل أن يُترك للعقول المحدودة أن تقتحم ما اختص الله بعلمه؟، أم أن الرحمة الإلهية قد أحاطت الإنسان بحدودٍ تحفظ عليه دينه ودنياه، فلا يضلّ في مسالك التقدير، ولا يتعدّى في ساحات القضاء على القلوب؟.
تتجلّى هذه التساؤلات في الحديث النبوي الشريف الذي خلدته الذاكرة الإسلامية كواحدٍ من مفاتيح الفهم المقاصدي للشريعة: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!»... «أَشَقَقْتَ عَنْ صَدْرِهِ؟!»، ذاك السؤال الذي لم يكن إنكارًا على فعلٍ بعينه بقدر ما كان تأسيسًا لقاعدة كونية تقطع بأن الحكم في الدنيا إنما هو على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى العليم الخبير. فبهذا التساؤل أرسى النبي صلى الله عليه وسلم معلمًا من معالم الرحمة الإلهية، وسدًّا منيعًا أمام التجرؤ على الغيب، وإعلانًا صريحًا بأنّ العقل لا سلطان له على ما وراء الحس، وأنّ الظنون لا تبني عدلًا ولا تبرّر قتلًا.
ولئن كان الموقف الذي قيل فيه الحديث حادثة عابرة في ميدان قتال، فإنه في جوهره دستورٌ أخلاقيٌّ وفكريٌّ يضبط علاقة الإنسان بغيره، ويقنّن سلطان الحكم بين الناس. ففي لحظةٍ من الغليان الميداني، حين قتل أسامة بن زيد رجلًا نطق بالشهادة، متأولًا أنّها كلمة نجاة لا كلمة إيمان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقلب المعادلة، فيُعلِّم البشرية أنّ العبرة بما يظهر لا بما يُضمر، وأنّ الشريعة لا تُبنى على الشكوك، بل على البينات.
وما كان ذلك إلا امتدادًا لقول الحق سبحانه: (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) حيث قطع القرآن الطريق على كل متأولٍ يزن الإيمان بموازين الهوى أو الشك، وأكد أنّ الأحكام الدنيوية مبناها على الإقرار الظاهر لا على النية الخفية، وأنّ الله وحده يتولى حساب السرائر، إذ هو العليم بذات الصدور.
ذلك هو الفارق الجوهري بين العدل الإلهي المطلق والاجتهاد البشري النسبي؛ فالإنسان مأمور بالحكم وفق ما يشهده من ظاهر القول والفعل، ومنهيٌّ عن اقتحام الغيب الذي لا يبلغه عقل ولا تدركه حواس.
ولئن تأملنا في الفلسفة الكامنة وراء هذا الحديث، لوجدناها تؤسس لثلاث قواعد كبرى:
أولها/أن الحكم في الدنيا على الظاهر هو مقتضى العدل ورحمة الخلق، إذ لو وُكِل الناس إلى الظنون والخواطر لاستُبيحت الدماء وهُتكت الأعراض.
وثانيها/أن الجهل عذر معتبر في ميزان الشريعة، فلا مؤاخذة إلا بعد البيان، ولا تكليف إلا بعد العلم، امتثالًا لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا).
وثالثها/ أنّ العدل لا ينفصل عن الرحمة، وأنّ مقاصد الشريعة لا تتحقق إلا إذا زان الفقيه أحكامه بميزان الظاهر، وخلّى بين الخالق وعباده في حساب الباطن.
وهنا يتجلى سرّ سماحة الإسلام: دينٌ يُربي العقول على التورع عن الحكم على النيات، ويُهذّب النفوس لتزن الأمور بظاهرها، ويؤجل الحساب إلى اليوم الذي تُبلى فيه السرائر.
وقد تجلت تطبيقات هذه القاعدة في مواقف شتى غير حديث أسامة الذي نحن بصدده، منها قصة قتل خالد بن الوليد بعض بني جذيمة، متأولًا عبارتهم «صبأنا»، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، وأمر بدفع دياتهم من بيت مال المسلمين، ولم يقم عليه حدا أو يعاقبه إذ علم أن خطأه ناشئ عن الجهل لا عن العمد.
وحين بال الأعرابي في المسجد، لم يزجره صلى الله عليه وسلم، بل قال: «دعوه ولا تُزرموه» ثم علّمه برفق، فأدّب الأمة على أن التعليم مقدم على التعنيف.
بل إن الله تعالى قد غفر لرجلٍ لم يعمل خيرا قط –بعد أن أمر أبنائه بحرق جسده بعد موته جهلًا بقدرة الله-، لما علم من صدق خوفه وخشيته، فكان جهله مقرونًا بالإخلاص سببًا للمغفرة.
هذه المواقف النبوية التي أوردناها ليست شواهد فقهية فحسب، بل غرابيل فكرية تهذب أحكامنا وتُنقّي عقولنا من أوهام الإطلاق، لتذكرنا أن الحكم على الظاهر رحمة، وأن اقتحام الباطن جرأة على مقام الألوهية.
ولمّا أدرك العلماء والفلاسفة هذا المبدأ، جعلوه ركيزة في بناء الفكر الإسلامي؛ حيث أثبتت المعتزلة وكذا الأشاعرة أنّ السرائر موكولة إلى الله، وأنّ الإيمان لا يُعرف إلا بظاهر القول. وأكد الفلاسفة المسلمون –كابن رشد والفارابي– أن العدالة لا تُبنى على الظنون، وأن العقل مقيد بمدركات الحس. بل تلاقت المدارس الصوفية والفقهية والفلسفية على أنّ العلم بالنيات إلهيّ لا بشري، وأنّ الجهل عذر معتبر، وأن الرحمة أصل في كل حكم.
وما أعظم الخطر حين تُهمل هذه القاعدة الراشدة، فتنبثق من رحم الغفلة عقولٌ مغلقةٌ توهّمت أن لها سلطانًا على القلوب، فجعـلت من الظنّ يقينًا، ومن الغيرة جفاءً، فراح أصحابها يُوزّعون صكوك الإيمان والكفر، ويستبيحون الحرمات باسم الدين الذي ما نزل إلا رحمة للعالمين.
هؤلاء هم خوارج الأمس الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» فحكموا على الناس بما لم يأذن به الله، وخوارج اليوم الذين يُعيدون إنتاج الفكر نفسه بلبوسٍ جديد، يوزّعون التهم كما توزّع الغنائم، ويقيمون محاكم التفتيش باسم الشريعة، ناسين أن الرحمة أصل، والعذر فريضة، والنية سرّ لا يملك مفتاحه إلا الله.
ومن هنا تتأكد مسؤولية النخبة الفكرية والعلمية في إعادة الاعتبار لهذا الحديث النبوي؛ لا باعتباره واقعة فقهية، بل كـ ميثاق فلسفي مقاصدي يُعيد التوازن بين العقل والوحي، وبين الحكم الظاهري والسر الإلهي، ويُرسي أسس العدالة في زمن التسرع والاتهام. فـ «أشققت عن صدره؟» ليس سؤالًا لأسامة وحده، بل نداء لكل عقل متعجل وقلب متسرع ولسان متهم: قف عند حدودك، واحكم بما ترى، ودع لله ما يعلم. فما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلًا، وما كُلف إلا بما يدركه.
ولعل في استحضار هذا الحديث اليوم طوق نجاةٍ في عصرٍ امتلأ بالفتن، وتصدّر فيه الجاهلون منابر الحكم على الناس، فأصبح الكذب لباسًا للحق، والجهل سيفًا باسم الدين.
فما أحوجنا إلى أن نُعيد صناعة غرابيلنا الفكرية على هدي هذا المبدأ النبوي، الرحمة قبل الحكم، والظاهر ميزان، والباطن لله، والجهل عذر، واليقين شرط، والعدل فريضة. لأن هذا الحديث النبوي الشريف لم يكن مجرّد عتابٍ لصحابيٍّ متأوِّل، بل كان بيانًا إلهيًا على لسان نبيٍّ رحيمٍ، يرسم للعقول حدودها، ويهدي القلوب إلى سواء السبيل، ويضع بين أيدي الأمة غرابيل فكرية نقية تميّز بها بين الحق والهوى، والرحمة والقسوة، واليقين والظن. فمن شاء النجاة فليزن أحكامه بميزان الظاهر، وليدع لله ما استتر في الصدور، فإنّ الرحمة أصل الدين، والجهل عذر، والنية سرٌّ بين العبد وربّه، ومن تجاوز حدّه فقد اعتدى على مقام ربه.
فوجب على من يرفع راية الدين، ألا ينسَ أنَّ العدل لا يقوم على الظنون، وأنّ الرحمة هي مفتاح الهداية، وأنّ الله لم يكلّفه بمحاسبة القلوب، بل أمره أن يصلح الظاهر ويدعو إلى الخير بالتي هي أحسن.
ذلك هو الدرس الخالد الذي خلّده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أشققت عن صدره؟» سؤالٌ خالدٌ، يُحاكم به الزمان نفسه، ويذكّر الإنسان بأنَّ من لم يرحم، لا يُرحم، ومن لم يعدل، ضلّ، ومن تجرأ على الغيب، فقد خسر خيري الدنيا والآخرة.
***
بقلم: د. بدر الفيومي