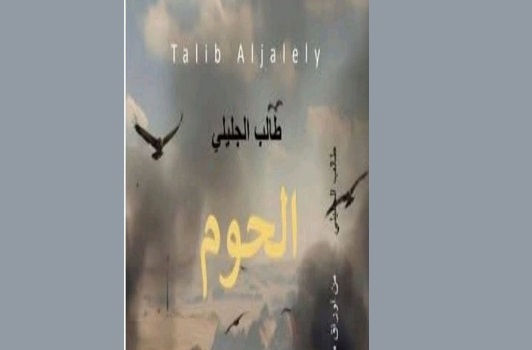قراءات نقدية
عدنان عويّد: الاغتراب في النقد الأدبي

الاغتراب لغة: جاء في معجم الغني:
[غ ر ب]. (مصدره. اِغْتَرَبَ) ويُمْكِنُ أنْ يُفَسِّرَ اغْتِرَابُ الشخص: هِجْرَتَهُ البَعِيدَةَ. "قَضَى جُلَّ حَيَاتِهِ فِي اغْتِرَابٍ" وهناك اِغْتِرَابُ النَّفْسِ: أي شُعُورُهَا بِالضَّيَاعِ وَالاسْتِلابِ.
إن الاغتراب في صوره وأشكاله المختلفة ليس إلا نتاجا لعجز الإنسان أمام قوى الطبيعة وقوى المجتمع في تحقيق ذاته، كما يأتي نتيجة طبيعيّة جهل الإنسان بالقوانين التي تُسَيْرُ هذه القوى. ويعد الاغتراب ظاهرة إنسانيّة متعددة الأبعاد؛ ومن الصعوبة بمكان تحديد معناه في الاصطلاح تحديداً دقيقاً، نظرا لاختلاف استعماله في البحوث الاجتماعيّة والدينيّة والدراسات الفلسفيّة ومجالات النشاطات الثقافيّة والأدبيّة وغيرها، وبالتالي يمكننا تحديد أهم أشكال الاغتراب هنا وهي:
الغربة الجغرافيّة: أي هِجْرَة الإنسان البَعِيدَةَ عن بلده أو وطنه.
الغربة النفسِّة: شُعُورُ الإنسان بِالضَّيَاعِ وَالاسْتِلابِ والتشيء.
الغربة الذهنيّة: مرض نفسيّ يحول دون سلوك المريض اتباع سلوكً سويًّ وكأنّه غريب عن مجتمعه، ولذا يلجأ إلى العزلة عن المجتمع.
الغربة الاجتماعيّة: أو الاغتراب الاجتماعي: كثيراً ما يصاب الإنسان بالإحباط من مجتمعه الذي يعيش فيه، وربما كان السبب وراء هذا الإحباط طبيعة مخزون اللاوعي الذي استقر في نفس هذا الإنسان، ومن ثم وجد أن هذا المخزون لا يتوافق مع طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.
الاغتراب الديني: الاغتراب الديني: وهذا النوع واحد من أبرز أنواع الاغتراب التي يعيشها الإنسان على وجه العموم، وذلك حين يحس أن المحيط الذي يعيش فيه لا يلبي رغباته الدينيّة ومثل وقيم هذا الدين، ولا يقف إلى جانبه من أجل صياغة حياته الدينيّة التي يريدها، ومن هنا فإنه يشعر بعناصر الاغتراب الديني، والتصوف أنموذجاً.
ومن التعسف توصيف كل غربة على حدة، أما تسمية الغربة بالاجتماعيّة، أو بالسياسيّة، أو بالعاطفيّة أو الدينيّة أو غيرها، فذلك راجع إلى دواعي الغربة نفسها التي أمدتها بعناصر النمو.
إذاً يمكن استخلاص مفهوم عام للاغتراب يدور حول عناصر متقاربة كشعور الفرد بالعزلة والانفصال عن الذات، والانطواء على النفس، وعدم القدرة على مسايرة الآخرين، والإخفاق في التكيّف مع الأوضاع السائدة في المجتمع، وعدم الشعور بالانتماء لأي مرجعيّة من مرجعيات الانتماء من الأسرة إلى الوطن. هذا وأن أزمة الإنسان المعاصر ومعاناته من حروب وجوع وفقر وألم وتشرد، التي رافقت تلك التحولات العميقة في البنى الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة، يرافقها التقدم التکنولوجي المادي بكل صور تقدمه ومنها الثورة المعلوماتيّة واستخداماتها السلبيّة، فكل ذلك ساهم في تراجع القيم الإنسانيّة النبيلة من جهة، وإفقاد إنسان العصر الشعور بالأمن والأمان من جهة ثانيّة، وبالتالي راحت تجرفه الغربة وضعف الانتماء في عالم مليء بالصراعات والمشاحنات والمشكلات النفسيّة والاجتماعيّة معلنة عن تفشي المفاهيم السلبيّة والتي من أبرزها مفهوم الاغتراب موضوع بحثنا.
مع تأكيدنا بأن ظاهرة الاغتراب قديمة قدم الإنسان، فهي ليست ظاهرة عصريّة أو معاصرة، إذ يمكن للباحث أن يتتبعها في كل العصور، وفي مختلف المجتمعات؛ فكلما توافرت العوامل والأسباب المهيئة للشعور الإنساني وإحساسه بالاغتراب نفسيّاً واجتماعيّاً ووجوديّاً، ازدادت حدّته ومجال انتشاره.
لقد وجد الاغتراب تعبيره الأول في الفكر الغربي، وذلك في تصور العهد القديم للوثنيّة، كما يمكن أن نجد جذور فكرة الاغتراب في كتابات الفيلسوف اليوناني "أفلوطين"، وفي المذهب المسيحي حول فكرة الخطيئة الأصليّة وفكرة الخلاص، كذلك عند القديس "أوغسطين" و"مارتن لوثر". والاغتراب في هذه المواقف يعني الجهاد لفصل الذات الإنسانيّة عن نواقصها بجعلها في حالة تواصل مع كائن متعال هو (الإله). هذا وقد تناول مفهوم الاغتراب فلسفيّاً كل من (هيجل وماركس وأميل دوركهايم وهربرت ماركوز) وغيرهم من فلاسفة، بعد قيام الثورة الصناعيّة وظهور الطبقة البرجوازيّة وسيطرتها على الدولة والمجتمع.(1).
وإذا انعطفنا نحو الأدب العربي بشكل عام والشعر منه بشكل خاص، سنجد أن انعكاس الاغتراب على الشعراء بات طرديّاً مع تعقيدات الحياة، فقد ظهر في نتاج العديد من شعراء المخضرمين فترة الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام، بسبب جملة من الأسباب الحيويّة والمنطقيّة التي ساهمت في انتشار حالة الاغتراب.
إن تلك الفترة الأولى للاغتراب تشكل فترة انتقاليّة كما بينا من الجاهليّة إلى الإسلام، ولا شك أن لهذه النقلة الدينيّة العقائديّة دوراً بالغ الأهميّة في التأثير على نفسيّة هؤلاء الشعراء، واتخاذ الدين الجديد سبيلاً للفرار من حالات الاغتراب التي يعيشونها، خاصة أن المعاني الجاهليّة لم يعد لها أي أثر في عقليات الكثير من الشعراء الذين اعتنقوا الإسلام.
أما الفترة الثانية فتمثل تلك النقلة الحضاريّة التي تلت ظهور الإسلام بعقدين أو ثلاثة من العصر الإسلامي، حيث انتقل العرب من كونهم تابعين إلى أقطاب الحضارة العالميّة آنذاك، إلى كونهم مؤسسين لحضارة عربيّة إسلاميّة تلت فتح فارس وبلاد الشام، حيث توسعت رقعة الدولة الإسلاميّة، واتسع معها دور المسلمين الحضاري في خارطة العالم القديم.
أما الفترة الثالثة فتتعلق بجوانب الجغرافيا الجديدة التي وصل إليها العرب، إذ انتقل كثير من الشعراء للعيش في المدن المفتوحة، وبهذا تغربوا عن ديارهم، وابتعدوا عن أوطانهم، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في شعرهم ونفسياتهم.(2).
لابد لنا أن نشير هنا إلى أن قضية الاغتراب في الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص عبر تاريخ الأدب، قد مثلها الأدباء في نصوصهم الأدبيّة بكل أنواعها، بل هم الأكثر قدرة على تصوير حالات الاغتراب هذه.
أمثلة على حالات الاغتراب عند الشعراء العرب:
فهذا "عنترة بن شداد" يبين لنا عمق الغربة الاجتماعيّة لديه بسبب ما ولدته الحالات العنصريّة في مجتمعه اتجاه المختلف في اللون. (3). حيث يقول:
حَسَناتي عِندَ الزَمانِ ذُنوبُ --- وَفَعالــــــــي مَذَمَّةٌ وَعُيوبُ
وَنَصيبي مِنَ الحَبيبِ بِعادٌ --- وَلِغَيـــري الدُنُوُّ مِنهُ نَصيب
كُلُّ يَومٍ يُبري السُقامَ مُحِبٌّ --- مِن حَبيبٍ وَما لِسُقمي طَبيبُ
وهذا قيس بن الملوح يشكو المرارة والألم، وهو يمرّ بالديار بعد هجرانها والتغرب عنها، وإن كانت غربته مقرونة بإحساس عميق من الشوق إلى الحبيبة، وهي أقسى درجات الغربة النفسيّة التي يعبّر عنها الشاعر من خلال الانتماء إلى كلّ ما يمثّل اللقاء بالحبيبة، حتّى وإن كانت جدران، أو بقايا أوتاد.(4).
أَمُرُّ عَلى الدِيارِ دِيارِ لَيلى --- أُقَبِّلَ ذا الجِدارَ وَذا الجِدار
وَما حُبُّ الدِيارِ شَغَفنَ قَلبي --- وَلَكِن حُبُّ مَن سَكَنَ الدِيار
غربة الشعراء العرب في العصر الحديث:
لقد استمرّ موضوع الغربة حاضرًا لدى الشعراء العرب في العصر الحديث، بسبب الظروف المأساويّة التي حصلت مع تراجع الأمّة العربيّة، حيث نشأت في مجتمعاتنا العربيّة المعاصر صراعات جديدة، كصراعات القيم بين الماضي والحاضر، وببن الريف والمدينة، وبين الاستبداد والحريّة، وبين الدكتاتوريّة والديمقراطيّة، وبين قيم الحدثة وما بعدها، هذا إضافة إلى الصراع مع قيم المجتمع الاستهلاكي والتخلف والجهل والأميّة والطائفيّة الدينيّة.. الخ. فكل هذه الصراعات والتناقضات بدأت تسود وجه الحياة اليوميّة من غرف المنازل ودواخل النفس، وصولاً إلى المدرسة والجامعة والمؤسسة الوظيفيّة والاعلام ودور الثقافة. وهذا ما أسقط الفرد في لجة الحيرة والتردد والغربة بكل أشكالها ومعانيها.
لقد كانت غُرْبة "الباروديِّ" ونَفْيُه، وكذلك "شوقي" ونفيه إلى الأندلس على سبيل المثال سببًا للكثيرٍ من قصائدهما حول الغُرْبة والاغتراب؛ ومِا يعدُّ امتداداً للحديث عن الغربة، والاغتراب في الشعر العربيِّ الحديث.
فهذا "الباروديّ" بقي في المنفى بمدينة (كولومبو) أكثر من سبعة عشر عامًا يعاني الوحشة، والسقم والبعد عن وطنه، وطيلة هذه الفترة أنشد قصائده التي يسكب فيها آلامه وشوقه إلى الوطن، ويرثي من مات من ذويه وأصحابه، ويتذكّر أيّام صباه، وشبابه وما آل إليه حاله، حيث مرّت أيّامه في المنفى ثقيلة، وأثقلها عليه كثرة العلل والأمراض التي أصابته، وفقدان الأهل والأحباب.(5). يقول:
كَفَى بِمَقَامِي فِي سَرَنْدِيبَ غُرْبَةً -- نَزَعْتُ بِهَا عَنِّي ثِيَابَ العَـلاَئِقِ
وَمَنْ رَامَ نَيْلَ العِزِّ فَلْيَصْطَبِرْ عَلَى -- لِقَاءِ الْمَنَايَا وَاقْتِحَامِ الْمَضَـايِقِ
كذلك كان نَفْي "شوقي" وإبعاده إلى إسبانيا ومعاناته الغربة المكانيّة والزمانيَّة، سببًا لِما سُمِّي بأندلسيَّات شوقي، تلك القصائد التي يَعْزف فيها على وتر الغربة والاغتراب، ويبكي حال الأندلس الذَّاهب مَجْدُها، ويتأسَّى على حاله في غربتِه؛ يقول شوقي في سينِيَّته الشهيرة.(6).
اخْتِلاَفُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ يُنْســي -- اذْكُرَا لِي الصِّبَا وَأَيَّامَ أُنْسِــــي
وَصِفَا لِي مُلاَوَةً مِنْ شَبــابٍ -- صُوِّرَتْ مِــــــنْ تَصَوُّرَاتٍ وَمَسِّ
وَسَلاَ مِصْرَ: هَلْ سَلاَ القَلْبُ عَنْهَا أَوْ أَسَا جُرْحَهُ الزَّمَانُ الْمُؤَسِّي
وحين نتناول :السيّاب" شعرًا فأنّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن غربته، وهو يحلم بحضن الأم التي لن تعود لتُقبّل دمع صغيرها. لقد بدأت حياة السيّاب بحرمان لا يردّ ألمه أيّ فرح، ويكبر السؤال معه عن تلك التي لن تعود. كأنِّ طفلاً بات يهذي قبل أن ينام:
بأنَّ أمّه – التي أفاق منذ عامْ
فلم يجدها، ثمَّ حين لجّ في السؤال
قالوا له: “بعد غدٍ تعودْ …”
وهذا الشاعر "الشابي" يشرح لنا في مذكراته عن إحساسه الشديد بالغربة والضياع قائلا:
(أشعر الآن أني غريب في هذا الوجود..غربة من يطوف مجاهل الأرض ويجوب أقاصي المجهول.. ثم يأتي يتحدث إلى قومه عن رحلاته البعيدة، فلا يجد واحدا منهم يفهم من لغة نفسه شيئا، غربة الشاعر الذي استيقظ قلبه في أسحار الحياة حينما تضطجع قلوب البشر على أسرة النوم الناعمة، فإذا جاء الصباح وحدثهم عن مخاوف الليل وأهوال الظلام، وحدثهم في أناشيده عن خلجات النجوم ورفرفة الأحلام الراقصة بين التلال، لم يجد من يفهم لغة قلبه ولا يفقه أغاني روحه. الآن أدركت أني غريب بين أبناء بلادي). (7).
أما أهم المفردات المعبرة عن الاغتراب لدى الأدباء بشكل عام والشعراء بشكل خاص: هي المفردات المشبعة بالحزن، مثل: (الوحيد الطريد الشريد الغريب الحزين القبر الأشباح الشقاء الملال الضجيج النشيج)..
***
د. عدنان عويّد
كاتب وباحث وناقد أدبي من سوريا.
..........................
الهوامش:
1- (الاغتراب – موقع الموسوعة العربية -). بتصرف.
2- (ظاهرة الاغتراب في شعر مخضرمي الجاهلية والإسلام - آمال عبد المنعم الحراسيس - جامعة مؤتة، 2016 م). بتصرف.
3- (الغربة في الشعر العربيّ - مجلة أوراق ثقافية - عبّاس حسن حاوي. ). بتصرف.
4- (الغربة في الشعر العربيّ - مجلة أوراق ثقافية - عبّاس حسن حاوي.). بتصرف.
5- (الغربة في الشعر العربيّ - مجلة أوراق ثقافية - عبّاس حسن حاوي. ). بتصرف.
6- (الغربة في الشعر العربيّ - مجلة أوراق ثقافية - عبّاس حسن حاوي. ). بتصرف.
7- (موقع نداء الهند - النزعة الإنسانية ومظاهر الاغتراب في الأدب الحديث - السيد محمد بوتانغودان -).