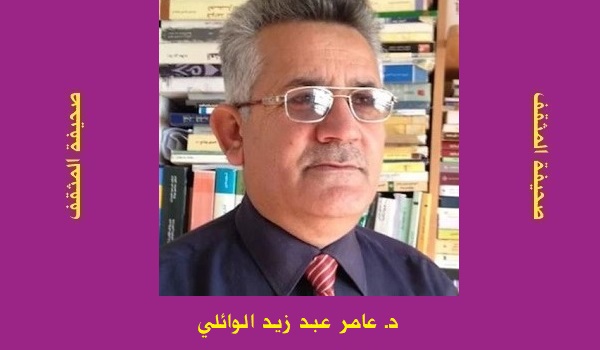قراءات نقدية
عبد الله الفيفي: مفهوم النَّظم.. بين التوحيدي والجرجاني

روَى (ابن عبد البَر)(1)، من طرائف «الورِعين» الحمقَى، أنَّ أحدهم سمع الآية: «يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ»، فقال: «اللَّهمَّ اجعلنا ممَّن يتجرَّعُه ويُسيغُه!»> وهذه الطُّرفة تنطوي على ما هو أبعد ممَّا ساقها (ابن عبد البَر) من أجله.
ذلك أنها إذا كانت ردَّة فعل هذا المتلقِّي قد حدثت بسبب اختلالٍ في ذهنه، كما سيقت الطُّرفة تعبيرًا عنه، فقد يحدث مثل ذلك بسبب اختلال النصِّ نفسه، من حيث انقطاع السياق أو غيره، وبالجملة اختلال النَّظم. فاجتزاء النصِّ من سياقه قد يجعل المتلقِّي يفهم هاهنا أنَّ الإشكال الذي تحدَّثت عنه الآية إنَّما هو كامن في أنَّ المذكور (يتجرَّع ولا يكاد يُسيغ)! دون أن يعي مَن المقصود بذلك؟ وماذا يتجرَّع؟ وما «السالفة»، كما يقال بالعامِّيَّة؟ من خلال النَّصِّ، من قَبل ومن بَعد، في الآيات من (سُورة إبراهيم): «وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ المَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.»
وكثيرًا ما يحدث مثل هذا في تلقِّي نصٍّ خارج بِنيته الكُلِّيَّة؛ فإذا المتلقِّي يضرب في فهمه أخماسًا بأسداس، بقطع النظر عن حالته الذهنيَّة. وهذا نموذج لما يمكن أن يُحدِثه غيابُ النَّظم من اختلالٍ في العلاقة بين النصِّ والقارئ، حتى ليبدو القارئ أحمق لدَى من أَلَـمَّ ببِنية النصِّ الكُليَّة. تلك البِنية التي كان (الجرجاني) يُطلِق عليها مصطلح (النَّظم).
على أنَّ من الاجتزاء كذلك الاجتزاء في فهم مفهوم النَّظم نفسه. فلو كان مفهوم النَّظم لا يعدو نَظم الأوزان والقوافي الشِّعريَّة، كما يفهمه بعضٌ، لاستطاع (عبد القاهر الجرجاني) أن يكون من أشعر الشُّعراء، وقبله (الخليل بن أحمد)، أو (الأصمعي). وإنَّما يَصِحُّ قول الجرجاني (2): إنِّ النَّظْم ليس «إلَّا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه (عِلم النحو)» إذا عنَى بـ(عِلم النحو)، الذي عزا إليه قيام (النَّظم)، ما سمَّاه (دريدا): (عِلم النحويَّة Grammatology). فذلك هو ما يُحدِث (الأَثَر) الجَماليَّ الانفعاليَّ الذي يثيره النَّصُّ في نفس المتلقِّي ومخيِّلته؛ حين يقتفي الناظم، كما قال الجرجاني(3): «رَسْمًا من العقل اقتضَى أن يتحرَّى في نَظْمه ما تحرَّاه.» لأنَّ ذلك «الرَّسْم من العقل» هو منبع الإبداع؛ ورَسْم عقل الشاعر غير رَسْم عقل المفكِّر، أو رَسْم عقل الفيلسوف، أو رَسْم عقل النَّحوي، أو غيرهم من العقلاء والرُّسوم.(4) وذلك الرَّسْم هو ما يُسمَّى في الفَنِّ، ومنه الشِّعر: الموهبة، التي تميِّز شاعرًا عن شاعر، وتميِّز الشاعر عن غير الشاعر؛ كما يمتاز المطرِب الموهوب عن المؤدِّي الموهوب، فضلًا عن امتيازه عن سائر الناس، مع أنَّ الجميع يشتركون في أنَّ لهم أصواتًا؛ من حيث إنَّ (رَسْم عقل المطرِب الموهوب)، كـ(رَسْم عقل الشاعر المطبوع)، هو ما يميِّزه عن غيره.
وبالحديث عن مفهوم النَّظم و(عِلم النَّحويَّة)، و(الأَثَر) الجَماليَّ الانفعاليَّ- المتوخَّى ممَّا يثيره النَّصُّ في نفس المتلقِّي ومخيِّلته- يمكن أن نتوقَّف، مثلًا، عند الهوسُ بالانزياحات المكدَّسة، في بعض التجارب النصيَّة المعاصرة، التي تَعُد نفسها حداثيَّة، واهمةً أنَّ ذلك هو التجديد والتحديث في الشِّعر. وهذه الظاهرة اليوم- التي يمكن أن أسمِّيها (التضخُّم المَرَضي في بِنية المجاز في القصيدة المعاصرة)- هي كهوس البديع في العصر العباسي وما تلاه؛ أيَّام كان البديعيُّون يتوهَّمون كذلك أنَّ الإغراق في البديع هو التجديد والتحديث في الشِّعر. من حيث إنَّه ما لم يوظَّف ذلك كلُّه لتشكيل معنى بنائيٍّ كُليٍّ للقصيدة، فإنَّه يستحيل إلى محض استعراض مهارات لُغويَّة وتركيبيَّة، لا يفضيان إلى تشييد شِعريَّة حقيقيَّة، ولا يُبقيان للشِّعر ولا للشاعر قيمةً تُذكَر. وإنَّما الانزياح وسيلةٌ شِعريَّة، وأداة فنيَّة، وكذا البديع، والموسيقى الشِّعريَّة. وحين تستحيل الوسيلة إلى غاية والأداة إلى هدف، فقل على الشِّعر: السلام ورحمة الله!
وبذا، فإنَّه إذا كان مفهوم النَّظم الشِّعري لا يتعلَّق بالأوزان والقوافي وحدها، فكذلك لا يتعلَّق بكثرة الانزياحات، أو البديع. بل حقيقته أنْ ينصهر كلُّ ذلك في بوتقة تشكيل النصِّ، المعبِّر بمجمله عن المعنَى، أو- بمصطلح (الجرجاني) وكلماته- المعبِّر عن «الرَّسْم من العقل، الذي اقتضَى أنْ يتحرَّى الشاعر في نَظْمه ما تحرَّاه».
على أنَّه ما زال من أرباب النَّثر والانتثار مَن ينتقصون من النَّظْم والانتظام، منذ عصر بني العبَّاس، ولا جديد تحت الشمس. ألم يقل (أبو حيَّان التوحيدي)(5): «والشِّعر كلام، وإنْ كان من قبيل النَّظم، كما أنَّ الخُطبة كلام، وإنْ كان من قبيل النَّثر، والانتثار والانتظام صورتان للكلام في السَّمع، كما أنَّ الحقَّ والباطل صورتان للمعنَى، ...وليس الصَّواب مقصورًا على النَّثر دون النَّظم، ولا الحقُّ مقبولًا بالنَّظم دون النَّثر؛ وما رأينا أحدًا أغضَى على باطل النَّظم واعترض على حقِّ النَّثر؛ لأنَّ النَّثر لا ينتقص من الحقِّ شيئًا. وما أحسنَ ما قال القائل:
وإنَّما الشِّعـرُ لُـبُّ الـمَرْءِ يَعرِضُهُ
عَلَى المجالسِ إنْ كَيْسًا وإنْ حَمَـقَا
وإنَّ أَشْعَـرَ بَـيـتٍ أنـتَ قـائـلُـهُ
بيتٌ يُقال، إذا أَنشدتَـهُ: صَدَقا.»
فانظر هنا كيف جعل النَّظم- وهو يعني به الشِّعر- قرين الباطل: «باطل النَّظم»، وجعل النَّثر قرين الحق: «حق النَّثر»! و«قد» يوجَد الصواب في النَّظم، كما قال: «وليس الصَّواب مقصورًا على النَّثر دون النَّظم»، وإنْ كان الصَّواب في النثر أصيلًا غالبًا، وليس محلَّ شكٍّ أو خلاف! غير أنَّ النَّظم- كما يستدرك- قد يجتلب للحقِّ القبول، بما فيه من سِحرٍ وتطريب. هذا هو خطاب (التوحيدي) الناثر البائس. ولذا لا غرابة أن يختم كلامه باستحسان ما كان خليقًا- لو كان يعي ضُروبَ الكلام كما ادَّعَى، وافتراقَ طبائعها ووظائفها- أن يكتب: «وما أبردَ ما قال القائل:...»! كما كان حقُّ البيت الذي رفع رايته أن يكون:
وإنَّ أَسخفَ بَـيتٍ أنتَ قـائلُـهُ
بيتٌ يُقال، إذا أَنشدتَـهُ: صَدَقا!
لماذا نقول هذا لـ(أبي حيَّان)؟
لأنه قد عرضَ لُبَّه علينا، بوصفه ناقدًا، فكشف عن تهافته؛ فليتقبَّل ما جاءه من بيان سقوطه في فهم تمايز النُّصوص وتقييم ما بينها من فوارق.
وهنا يتجلَّى البَون الشاسع بين (أبي حيَّان التوحيدي، -414هـ) و(عبدالقاهر الجرجاني، -471/ 474هـ) في الوعي النُّصوصي، وفهم معنى النَّظم، وعدم اقتصاره على منظوم الأوزان والقوافي.
ثمَّ إنَّه لا يُنتظَر من النَّصِّ الأدبي، شِعرًا أو نثرًا، الإعرابُ عن الصَّواب وعن الحقِّ إعرابًا مباشرًا، كما يُنتظَر من الكلام الإخباري والتقريري. ولا تنهض الفروق بين الانتثار والانتظام، أو بين النَّثر والشِّعر، على أساس تلك المعايير الذهنيَّة، التي أسَّس عليها (التوحيدي) خطابه المتوحِّد. وإنَّما آليَّة النصِّ الأدبيِّ عمومًا، شِعرًا أو نثرًا، تخيُّلٌ، يكسِبه قبولًا أو نُفورًا. وما البيتان اللَّذان استشهد بهما، إلَّا نتاج ذلك العَشَى في تمييزه ألوان الكلام، يظنُّه الظمآنُ ماءَ بصيرةٍ ثاقبةٍ دقيقة. من حيث إنَّ البيت الشِّعري الذي يصدِّقه السامعُ ويُؤَمِّن عليه القارئُ هو موجودٌ لديهما سَلَفًا، وإنْ لم يعبِّرا عنه. وهو ما عناه (المتنبِّي) بالذَّمِّ، في قوله:
أَنا السَّابِقُ الهادِي إِلى ما أَقولُهُ
إِذِ القَولُ قَبْلَ القائِلينَ مَقُـوْلُ
فالقول الذي يكون «قبل القائلين مَقُوْلًا» هو نفسُه البيت الذي «يُقال، إذا أَنشدتَهُ: صَدَقَا». وإنَّما الشِّعر أن يأتي سَبْقًا، وهِدايةً، وتجديدًا لبناء العالَم، وترتيبًا لطرائق التفكير والتخيُّل. ومن ثَمَّ فإنَّ الشِّعر نقض ما كان يصدِّقه القارئ والسامع من المقولات والأفكار. وإلَّا صحَّ أن يقال: إذا كان الشِّعر من فِضَّة، فالسكوت من ذهب! ولهذا قال العَرَب: إنَّ أعذب الشِّعر أكذبه، لا بمعنى الكذب الأخلاقي، بل بمعنى الكذب الفنِّي، أي الخيال والتخييل، اللَّذين إنْ لم يستبدَّا بالنصِّ، فلا شِعر فيه، ولا حتى أدبيَّة. غير أنَّه ينبغي على القارئ كذلك أن لا يعشَى، بدَوره، عمَّا أنتج هذا القول التوحيدي الكسيح لدَى (أبي حيان). لا لتعلُّقه بسطحيَّة وعيه النقدي فحسب، ولكن أيضًا لموقفه النفسي من الوزيرَين، (الصاحب بن عبَّاد)، و(ابن العَميد)، اللَّذين تصدَّى لثلبهما بكتابه «مثالب الوزيرَين»، حيث جاءت مقولته تلك. وكلاهما كان ناثرًا شاعرًا، على حين انحصرت مواهب صاحبنا في «الهوامل والشوامل»، وأضرابها من فنون الترسُّل. بل لقد حاول أن يُحرِق في نهاية حياته ما استطاع من تراثه النثري هذا!
وهكذا انتهى الأمر بـ(أبي حيان التوحيدي) إلى أن يثلب في كتابه «مثالب الوزيرَين» نفسه هو وفهمه، بل إلى أن يثلب أدبه، حينما استدعته المناكفات إلى الخروج من الكتابة الأدبيَّة إلى التنظير النقدي.
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
............................
(1) يُنظَر: (د.ت)، بهجة المَجالس وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس، تحقيق: محمَّد مرسي الخولي، (بيروت: دار الكتب العِلميَّة)، 2: 551.
(2) يُنظَر: (1984)، دلائل الإعجاز، قرأه وعلَّق عليه: أبو فهر محمود محمَّد شاكر، (القاهرة: مكتبة الخانجي)، 55، 81.
(3) يُنظَر: م.ن، 49.
(4) بل إن المفكِّرين بدَورهم مفكِّران: مفكِّر ذو عقل شمولي مَرِن حُر، ومفكِّر أُحادي النظرة، منغلق، اتِّباعي، مستعبَدٌ لتيَّارٍ أو توجُّه، (الفرنسي ميشال أونفري- «نفي اللَّاهوت» نموذجًا، في ترجمته العَرَبيَّة الركيكة الحافلة بالعِيِّ اللُّغوي). وهذا الضَّرْب هو الغالب على مفكِّري العالَم عبر العصور، ولا سيما في الثقافات المنغلقة أو المؤدلجة. ومن ثَمَّ فإنَّ رَسْم العقل هنا أيضًا يختلف.
(5) (1992)، أخلاق الوزيرَين «مثالب الوزيرَين: الصاحب بن عبَّاد وابن العميد»، تحقيق: محمَّد بن تاويت الطَّنجي، (بيروت: دار صادر)، 8- 9.