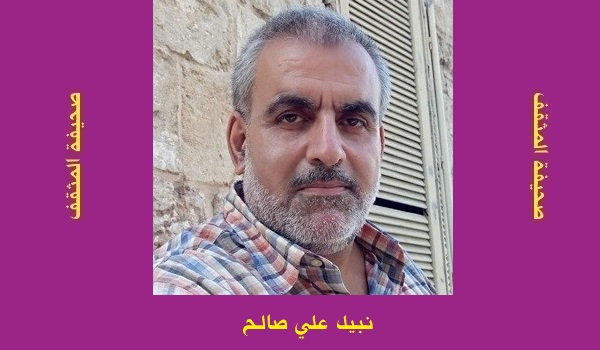دراسات وبحوث
محمد آيت بود: العنف والقوة بدل الحوار والتواصل

كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية والطائفية
ملخص: يتطلب تحليل وفهم منطق اللجوء إلى القوة والعنف لتسوية الخلافات السياسية والأيديولوجية في المجتمعات العربية والإسلامية إعتماد منهج (هابرماس) الذي يعتمد على نظرية الفعل التواصلي وتستند على العملية النقدية والتحليل النفسي، وذلك من أجل تحقيق غاية تحرر الإنسان من الأوهام وتحقيق الإستقلالية والحياة الصالحة، وتروم النظرية التواصلية إلى فهم مغزى الفعل البشري من أجل الوصول إلى مجتمع تنتفي فيه الفروقات المبنية على النزوعات الطائفية والتي تشكل الدافع الأساسي للعنف كبديل للتسويات السياسية السلمية بواسطة الحوار والتواصل البناء في مجتمع متعدد و / أو تعددي، وتجاوز اللاعقلانية ومشكلة هيمنة الأيديولوجيات التي تبني عليها الفئات المتناحرة أوهامها وهي معتقدات خاطئة عن ماهية مصالحها، وهذا يؤدي إلى بناء نماذج مجتمعات استبدادية تعدم فرص أيجاد نظام اجتماعي مستقر، وتحول البشر إلى أفراد مجتمع متناحرين فيما بينهم بما يؤدي إلى حرب الكل ضد الكل حسب (طوماس هوبس).
كلمات مفتاحية: القوة والعنف – الخلافات السياسية – النظرية التواصلية – الطائفية – الحوار والتواصل .
مقدمة:
بينت الأحداث الجارية في مدينة السويداء في سوريا على أن السلم الإجتماعي في الدول العربية والإسلامية هش جدا، باعتبار أنه غير مؤسس على نظرية للدولة صلبة وصامدة تستطيع أن تحتوي كل الطوائف والإثنيات المشكلة للنسيج المجتمعي بشكل يؤدي إلى ضمان حقوق الجميع ووضع سقف للتعايش السلمي وقبول الإختلاف، (مع ضرورة التأكيد على نسبية هذا الحكم فيما يخص الحالة السورية، باعتبار أن الظروف السياسية الداخلية والتدخلات الأجنبية لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار) وعلى هذا الأساس فالسلم الإجتماعي كوسيلة لتحقيق الإستقرار والتنمية يضلان في وضعية غير مريحة كفيلة بتحقيق مجتمع يسود فيه منطق القانون ويغلب عليه طابع الحوار العقلاني المبني على ركيزة المواطنة، لهذا فالدولة في المجتمعات العربية والإسلامية ماهي إلا تلك القشرة التي تغطي تقرحات المجتمعات وأمراضها الإجتماعية ونزوعاتها الأيديولوجية المدمرة، فحالما تزول تلك القشرة تنزع نحو العنف والإحتراب.
محاولة لفهم أسباب النزاعات المسلحة في الدول العربية
لابد لفهم أسباب النزاع بين الدروز وعشائر البدو في السويداء من الانطلاق من مساءلة دور الدولة في ذلك النزاع، (وهذه الحالة قابلة للتعميم بطبيعة الحال، نظرا لتشابه التركيبة الإثنية والطائفية في جميع الدول العربية) وعلى ما يبدو فغياب هذا الدور هو الذي فاقم الوضع وأدى إلى انتشار الفوضى والعنف، وهذا الوضع غير المستقر لمكونات مجتمع متعدد ومختلف عقائديا وطائفيا وإثنيا سوف يقودنا في التحليل إلى نتيجة مفادها أن الدولة في العالم العربي ليست سوى ذلك الكائن الهلامي القابل للانهيار في أية لحظة، لأنها لم تكن مبنية سوى على توافقات قبلية أو طائفية أو مصلحية ظرفية هشة، وليس على مبادئ وأسس عقلانية قادرة على استيعاب جميع الاختلافات والتوترات والتناقضات، وبالنسبة لهابرماس فالأسباب الحقيقية تعود إلى غياب الحوار والتواصل[1]، ووفقا لمفهوم العقلانية التواصلية فالمجتمعات التقليدية تشيد فهما أسطوريا للعالم يٌشكل داخل التقاليد الثقافية وجه التباين الحقيقي مع الفهم الحديث للعالم؛ حيث يؤدي الفهم الأسطوري للعالم إلى تشييد تمثلات للفعل غير عقلانية، وينتمي هذا الفعل الأسطوري إلى طور ما قبل الطور المنطقي للمعرفة والفعل، وهذا ما يؤدي إلى التفكير الوحشي، حيث الإيمان بالسحر مثلا في القبائل البداية حسب أبحاث (ليفي شترواس) أثبتت أن الفوارق بين التفكير الأسطوري والتفكير العقلاني الحديث تظهر بشكل أساسي على مستوى الوسيط اللغوي الذي تنعكس ضمنه علاقات الفاعل بالعالم، حيث تغدو الأفعال آلية للتنسيق بين أفعال الفاعلين المشاركين وتبريرها، و تدار بحسب المصلحة الجماعية عبر الوسائط اللغوية[2]، ويفترض الفعل التواصلي وجود اللغة باعتبارها وسيطا للتفاهم تصاغ ضمنه المقولات التي تعزز موقف الجماعة ضد الجماعة الأخرى المناوئة، وفي إطار هذه السردية المبتورة ينعدم الوطن وتفتقد الدولة ويصيران شيئان غير ضروريان بل وغير مرغوب فيهما، لأن العالم تعاد صياغته في قوالب تفاعلية رمزية وبلاغية تقوم بتشكيل المعنى وفق خارطة طائفية أو إثنية وهندسة عقلية جديدة تتمركز الطائفة أو الإثنية في صلبها عوض الوطن والدولة[3]، وحسب (ماكس فيبر) فنزع السحر عن العالم (فهم العالم بوضوح) يتطلب وعيا اجتماعيا متطورا؛ بحيث يؤدي إلى فهم أعمق له على ضوء دينامية الفعل الفردي وفهم الظواهر الإجتماعية يكون من خلال تحليل بنية الفعل الإجتماعي الفردي في المجتمع.
نظرية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي
يحدد اِبن خلدون أنماط الحكم ثلاثة أنماط للحكم هي[4]: حاكم أو ملك مستبد، 2- الحكم المدني؛ 3- الحكم الديني أي الحكم بشرع الله أي الإمامة والخلافة. وبالتالي فابن خلدون يؤسس نظريته للحكم والسلطة على ثلاثة أنماط من المشروعية السياسية، وأورد أن مشروعية الخلافة مرغوب فيها باعتبار كونها الحكم بشرع الله أي الإمامة والخلافة، وربطها بالعصبية والغلبة، وهذه النظرية الخلدونية أثرت على الفكر السياسي الإسلامي، وجعلت منطق السلطة والدولة مرتبطا بعنصرين رئيسيين هما: الخلافة والعصبية، في حين وعلى خلاف ابن خلدون يرى الفارابي أن الدولة كيان يجب أن يرتكز على الأخلاق والحق والعدل، وأن الهدف من إنشاء الدولة هو الإنسان ذاته، فهي دولة تتمتع بالصلاح والعدل[5].
ويرى حسن البنا أن الدولة يجب أن تندرج ضمن إطار شمولية الإسلام باعتباره يتضمن مبادئ لبناء دولة تجمع الجانبين الدنيوي والأخروي في كفة واحدة[6]، ويجب على هذه الدولة أن تطبق الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، ويرى علي عبد الرازق في نقده للخلافة أن القرآن والسنة لم يحددا نمطا معينا من الحكم في الإسلام وبالتالي ترك الأمر للإجتهاد البشري، وأن الآية التي تحدثت عن الشورى { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (سورة آل عمران38)} لا يمكن الإستناد إليها بالقول إن القرآن حدد نمطا للحكم في الإسلام، لأنها تعتبر قاعدة عامة ولم تقدم أي تصور للحكم بناء على هذه القاعدة، كما أن السنة لم تقدم تفسيرا لهذه الآية، والتفسيرات المتوفرة إلى الآن ماهي إلا اجتهادات الفقهاء، وبالتالي فنظرية السلطة والدولة في الفكر الإسلامي لم تستطع الخروج من دائرة الفقه التراثي إلى مجال الفكر السياسي والإجتماعي، ويرى الجابري أن العقل العربي يرتكز على ثلاثية[7]: العقيدة – القبيلة – الغنيمة، وتشكل هذه القاعدة الركيزة الأساسية للفعل الإجتماعي والسياسي في الثقافة العربية، وتؤثر بالتالي على تمثل العرب والمسلمين لجميع العلاقات الإجتماعية بما فيها علاقة الفرد والمجتمع بالدولة والذي يرتكز على هذه الثلاثية.
آفاق بناء الدولة الحديثة في واقع المجتمعات العربية والإسلامية
يواجه بناء الدولة الحديثة في واقع المجتمعات العربية والإسلامية رهانات وتحديات كبيرة بعضها مرتبط بتمثل العرب و المسلمين للدولة والتي لا يجب أن تنفصل عن العقيدة الإسلامية والولاء للطائفة أو العشيرة، وهذا الأمر يطرح إشكالية العلمنة؛ بحيث لا يزال يعتقد العرب والمسلمون أو على الأقل قطاع كبير منهم (حتى من المثقفين) أنه يستحيل فصل الدولة عن الدين في التجربة الإسلامية على غرار ما هو معمول به في الغرب، باعتبار أن السياقين السياسي والإجتماعي مختلفان، وهذا الإعتقاد يتعزز بموقف سياسي مرتبط بإمكانية عودة الخلافة الإسلامية والتي سوف تعيد للعرب والمسلمين أمجادهم السياسية والإجتماعية، ويسود هذا الإعتقاد عند قطاع عريض من المسلمين باستثناء بعض المثقفين المحسوبين على التيار العلماني والحداثي؛ والذين يدعون إلى إتباع نفس خطوات الغرب في فصل الدين عن الدولة وتبني الأيديولوجية الليبرالية باعتبارها تجسد أرقى ما وصلت إليه البشرية في العصور الأخيرة من التنظيم السياسي والإجتماعي؛ وذلك بحكم كونها تتضمن مصفوفة من المبادئ السياسية والإجتماعية التي أثبتت نجاحها في تدبير المجتمعات الغربية؛ وبالأخص النظام الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان[8].
غير أن الإشكال الذي يترتب عن هذه النظرية المتعلقة بالدولة سواء في الفكر السياسي الإسلامي أو في واقع العرب والمسلمين، هو عدم قدرتهم على بلورة تصور أو نظرية للدولة الحديثة بعيدة عن طوباوية الخلافة، وعدم قدرتهم على استبطان وقبول فكرة الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس العقد الإجتماعي كما صاغه (جون لوك) وما يستدعيه من الخروج من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية[9]، بالرغم من كونهم يعيشون في كنفها (الدولة المدنية) منذ بناء الدولة الوطنية القطرية؛ وهذا الواقع أدى بهم إلى بقائهم عالقين بين التجربة السياسية الإسلامية التي هي الخلافة المأمولة بما هي دولة تستند إلى الفقه الثراتي الذي يرتكز على تفسير النصوص الدينية وفق آليات وقواعد العصور القديمة، والغربية والتي هي الدولة المدنية الحديثة المعاشة التي ترتكز على الديمقراطية و مبدأي سمو القانون و المواطنة[10].
وهذا التناقض بين مرجعية ثراثية وأخرى حداثية، و بين حلم مفقود وواقع معاش الذي يعيشه المسلمون، أسقطهم في الإنتظارية وعدم الحسم في هوية الدولة، الشئ الذي أدى إلى تأجيل حل كل الإشكاليات السياسية والإجتماعية والإقتصادية المرتبطة به، ما نتج عنه في المحصلة عدم قدرتهم على حل الخلافات السياسية الناشئة فيما بينهم بناء على قاعدة المواطنة التي هي فكرة تقوم على مبادئ الحرية و قبول الإختلاف وتحقيق المساواة وصون حقوق الأقليات وتقاسم الخيرات المادية والرمزية داخل الوطن الجامع ونبذ الكراهية والعنصرية المؤديتان إلى الفرقة والإحتراب[11]، وهذا الوضع يجعل من المستحيل بناء مجتمعات قائمة على التضامن والتسامح بعيدا عن منطق الولاء للقبيلة والعشيرة والطائفة، بحيث تصبح فكرة الدولة والوطن كيانا مؤقتا فقط سرعان ما يتم التخلي عنهما لصالح التعصب للطائفة أو الإثنية أو القبيلة أو العشيرة[12].
4 – الحوار العقلاني والتواصل البناء كحل لمواجهة معضلة الدولة والطائفية
لقد أدى سقوط الأنظمة السياسية وانهيار الدول بسبب ثورات ما سمي بـــ " الربيع العربي" إلى بروز الانقسامات القبلية والطائفية، الشئ أثار نقاشا واسعا وقلقا من طرف الشعوب التي كانت تراهن على هذه الثورات لتحقيق الحرية و الديمقراطية والمساواة والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفساد والاستبداد، غير أن سقوط تلك الأنظمة الإستبداية كشف عن واقع اجتماعي مزري ومشحون بالتوترات الطائفية والقبلية، الشئ الذي نتج عنه سقوط الشعوب التي أزاحت تلك الأنظمة الإستبدادية في مستنقع الطائفية وعدم قدرتها على التعافي من هذه الآفة المدمرة، وأدى هيمنة البديل الأيديولوجي المرتبط بـــواجهة "الإسلام السياسي" في واقع الدول التي عاشت هذه التجارب إلى عدم القدرة على بلورة آليات سياسية واجتماعية تفضي إلى بناء مجتمعات تسودها ثقافة المواطنة والتسامح، بل إن النخب الجديدة التي تولت زمام الأمور بعد الثورات سرعان ما سقطت بدورها في نفس الولاءات الطائفية والقبلية وقامت بإعادة إنتاج أسباب الإستبداد والفساد، كما أن غياب الحوار العقلاني المبني على قاعدة التوافق والمواطنة والمفضي إلى الرغبة في تحقيق السلم الإجتماعي على ركيزة التعايش السلمي أدى إلى تشبث كل طرف من الأطراف برأيه واعتقاده بصوابية قناعاته الطائفية وامتلاكه للحقيقة المطلقة ضدا على مصلحة الوطن الجامع، وبالتالي جنحت تلك الطوائف إلى تعميق الجراح وتكريس الإنقسام والإمعان في التدمير والإفساد ونشر الرعب والتوحش[13].
أبانت العديد من النزاعات المسلحة والاختلافات الأيديولوجية في الدول العربية والإسلامية عن فشل ذريع وعجز جلي في تدبير الاختلافات السياسية والأيديولوجية والطائفية بواسطة الحوار العقلاني والهادئ بعيدا عن التشنج والتعصب الطائفي والقبلي، ويأتي هذا الموقف كنتيجة للاستبداد السياسي الذي مورس على الشعوب الإسلامية لعقود طويلة، الشئ الذي نتج عنه غياب ثقافة قبول الاختلاف والحوار والتفاوض، ورغم تنصيص القرآن والسنة على ضرورة اِنتهاج أسلوب الحوار مع المخالفين حتى من غير ملة الإسلام، إلا أن العرب والمسلمين ونظرا لعدم قدرة الفقه الإسلامي على بلورة اجتهاد فقهي ينص على الإشادة بثقافة الحوار وقبول الاختلاف، لم يستطيعوا قط الخروج من هيمنة الفكر الأحادي الرافض للنقد والحوار البناء والنسبية في الرأي والحقيقة، وذلك بحكم تأثره بالاستبداد السياسي الذي هيمن على المجتمعات العربية والإسلامية؛ بحيث لم يكن بمقدور الفقهاء مخالفة السلاطين والحاكمين في آرائهم، فكان نتيجة ذلك سقوط الفقه الإسلامي في الأرثوذوكسية الدينية الرافضة للحق في الاختلاف[14].
يتطلب الخروج من هيمنة الفكر الأحادي الأرثوذوكسي على الذهنية العربية – الإسلامية، وكذلك عدم قدرة الميتافيزيقيا الأخلاقية المحرفة و الموسومة بتلبس العالم بالسحر الذي يحجب الحقيقة عن الإدراك، القيام بمجهود جبار من طرف الدولة والقوى الفاعلة في المجتمع سواء الفكرية منها والسياسية والثقافية والدينية والاقتصادية، وكذلك ومؤسسات التنشئة الاجتماعية ووسائل الإعلام، وذلك من أجل العمل على بناء نموذج للتعايش السلمي المرتكز على الحوار العقلاني البناء، وهذا المجهود يندرج ضمن ما سماه (يورغن هابرماس) العقلنة القانونية من حيث اعتبار القانون تجسيد للعقلانية ووسيلة تنظيمية، حيث يتحول القانون من وسيلة للضبط الأمني والإداري إلى وسيلة لإنتاج الفعل العقلاني للمجتمع ويساهم في إنتاج المعنى المفقود في مستنفع الطائفية الآسن، ويفسر ذلك بكون العقلانية التواصلية هي حالة تٌناقض الميتافيزيقية العرفانية والإشراقية التي يرتكز عليها العقل العربي في تفسير وفهم العالم وفي بناء العلاقات الاجتماعية.
***
محمد أيت بود
باحث في العلوم السياسية
....................
الهوامش:
[1] - يورغن هابرماس – نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس – (المجلد الأول) عقلانية الفعل والعقلية الإجتماعية – مكتبة سر من قرأ – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – ص 139
2 - نفس المرجع السابق ص 212
3 - قراءة في دور نظرية التفاعلية الرمزية – دين تامي رضا – قادة بن عبد الله نوال – مجلة منيرفا – مجلد 4 – العدد1 – ديسمبر 2017 – ص 2.
4 - ابن خلدون، المقدّمة، تحقق محمّد تامر، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة، 2005)، 152-156
5 -إبراهيم، ز. (2008). الفكر السياسي الإسلامي بين النص والتاريخ. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية
6 - مفهوم الدولة عند حسن البنا – أبرار حامد ثامر – مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث – المجلد 4 العدد 06 – 15-11-2024 .
7 - محمد عابد الجابري - العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط3 1995، ص 372
8 - جدلية العلاقة بين الدولة المدنية والدولة الدينية وأثرها في الاستقرار السياسي – أ.م.د ديمة عبد الله أحمد –مجلة اتجاهات سياسية – المجلد الثامن – العدد 29 – ديسمبر 2024 – ص 330
9 - حالة الطبيعة كما صاغها طوماس هوبس مرتبطة بتلك الحالة التي كان يعيشها الإنسان البدائي قبل اهتدائه إلى أشكال التنظيم الإجتماعي، والذي أكد على أن في هذه الحالة يصبح الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان، ومثل للدولة بالليفياتان أو ذلك الوحش الكبير الذي يجب أن يحد من غلواء حالة الطبيعة عند الإنسان.
10 - جدلية العلاقة بين الدولة المدنية والدولة الدينية وأثرها في الاستقرار السياسي – أ.م.د ديمة عبد الله أحمد –مجلة اتجاهات سياسية – المجلد الثامن – العدد 29 – ديسمبر 2024 – ص 331
11- - الطائفية في المجتمعات العربية وانشطار الدولة – عبد القوي حسان – مركز دراسات الوحدة العربية – الرابط: https://urls.fr/1LLA-U
12 - روان هانيبر، العقل الإسلامي أمام ثراث عصر الأنوار في الغرب، الجهود الفلسفية عند محمد أركون، منشورات الأهالي، ط 1، دمشق، سورية 2001، ص 23، 24
13- يمعن الفرقاء الطائفيون في دول الربيع العربي (مصر – ليبيا- تونس – اليمن – سوريا) في الانتقام من الأفراد المنتمين للطائفية المعادية أو الفرقاء السياسيين بشكل وحشي؛ حيث يتم التمثيل بالجثث وتصويرها في أبشع الصور والانتشاء بذلك أمام عدسات الكاميرات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، ويقومون بقتل الضحية بأبشع الطرق كالدهس أو الرمي من الطوابق الشاهقة أو الرمي بالرصاص معصوب العينين وأمرهم بالركض رغبة في بإطلاق السراح، أو القتل حرقا أو تلفيق التهم الباطلة وإيداعهم المسالخ البشرية والمعتقلات السرية.
14 - إشكالية الشريعة والقانون في الدولة الإسلامية – محمد أيت بود – مجلة الحوار المتمدن – الرابط: https://urls.fr/_aeILg
[1] - يورغن هابرماس – نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس – (المجلد الأول) عقلانية الفعل والعقلية الإجتماعية – مكتبة سر من قرأ – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – ص 139
[2] - نفس المرجع السابق ص 212
[3] - قراءة في دور نظرية التفاعلية الرمزية – دين تامي رضا – قادة بن عبد الله نوال – مجلة منيرفا – مجلد 4 – العدد1 – ديسمبر 2017 – ص 2.
[4] - ابن خلدون، المقدّمة، تحقق محمّد تامر، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة، 2005)، 152-156
[5] -إبراهيم، ز. (2008). الفكر السياسي الإسلامي بين النص والتاريخ. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية
[6] - مفهوم الدولة عند حسن البنا – أبرار حامد ثامر – مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث – المجلد 4 العدد 06 – 15-11-2024 .
[7] - محمد عابد الجابري - العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط3 1995، ص 372
[8] - جدلية العلاقة بين الدولة المدنية والدولة الدينية وأثرها في الاستقرار السياسي – أ.م.د ديمة عبد الله أحمد –مجلة اتجاهات سياسية – المجلد الثامن – العدد 29 – ديسمبر 2024 – ص 330
[9] - حالة الطبيعة كما صاغها طوماس هوبس مرتبطة بتلك الحالة التي كان يعيشها الإنسان البدائي قبل اهتدائه إلى أشكال التنظيم الإجتماعي، والذي أكد على أن في هذه الحالة يصبح الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان، ومثل للدولة بالليفياتان أو ذلك الوحش الكبير الذي يجب أن يحد من غلواء حالة الطبيعة عند الإنسان.
[10] - جدلية العلاقة بين الدولة المدنية والدولة الدينية وأثرها في الاستقرار السياسي – أ.م.د ديمة عبد الله أحمد –مجلة اتجاهات سياسية – المجلد الثامن – العدد 29 – ديسمبر 2024 – ص 331
[11] - روان هانيبر، العقل الإسلامي أمام ثراث عصر الأنوار في الغرب، الجهود الفلسفية عند محمد أركون، منشورات الأهالي، ط 1، دمشق، سورية 2001، ص 23، 24
[12] - الطائفية في المجتمعات العربية وانشطار الدولة – عبد القوي حسان – مركز دراسات الوحدة العربية – الرابط: https://urls.fr/1LLA-U
[13] - يمعن الفرقاء الطائفيون في دول الربيع العربي (مصر – ليبيا- تونس – اليمن – سوريا) إلى الانتقام من الأفراد المنتمين للطائفية المعادية أو الفرقاء السياسيين بشكل وحشي؛ حيث يتم التمثيل بالجثث وتصويرها في أبشع الصور والانتشاء بذلك أمام عدسات الكاميرات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، ويقومون بقتل الضحية بأبشع الطرق كالدهس أو الرمي من الطوابق الشاهقة أو الرمي بالرصاص معصوب العينين وأمرهم بالركض رغبة في بإطلاق السراح، أو القتل حرقا أو تلفيق التهم الباطلة وإيداعهم المسالخ البشرية والمعتقلات السرية.
[14] - إشكالية الشريعة والقانون في الدولة الإسلامية – محمد أيت بود – مجلة الحوار المتمدن – الرابط: https://urls.fr/_aeILg