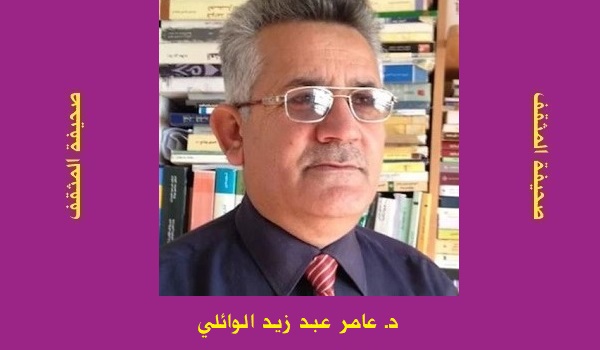أقلام فكرية
غزلان زينون: واقع التحول اللغوي عند الفئة الناشئة

تلاميذ المستوى الثانوي الإعدادي نموذجا
تمهيد: وُجدت اللغة مع وجود الإنسان، ثم بدأ هذا الأخير يتكون في شكل جماعات بشرية مختلفة تنتقل باستمرار بحثا عن مقومات العيش على سطح الأرض، فصار لكل جماعة بشرية لغة تميزها عن باقي الجماعات، وترتب عن عدم الاستقرار والتنقل الدائم ظهور تنوع لغوي استمر في النمو والتوسع بحكم التطور المستمر للمجتمعات نتيجة عدة عوامل اجتماعية سياسية واقتصادية وثقافية... وهو تطور نتج عنه أيضا احتكاك الأنظمة اللغوية مع بعضها البعض داخل حيز جغرافي واحد، الشيء الذي سيسفر عن تطور ظواهر لغوية متعددة من قبيل: التعدد اللغوي، والثنائية اللغوية، والازدواجية اللغوية، والتداخل اللغوي، والتحول اللغوي الذي سيكون موضوع عرضنا هذا، والذي حاولنا من خلاله الإجابة عن الإشكاليات التالية:
ما مفهوم التحول اللغوي وما هي أنواعه وما أسباب وقوعه في التواصل؟
كيف نشأ هذا المصطلح في الأدبيات اللسانية وكيف تم تناوله من منظور علم اللغة الاجتماعي؟
كيف يتمظهر هذا الوضع اللغوي عند الناشئة- تلاميذ المستوى الثانوي الإعدادي نموذجا- وكيف يتعاملون مع هذه الظاهرة؟
بناء على هذه الإشكاليات تناولنا العرض من جانبين: جانب سنجيب فيه عن السؤالين الأول والثاني، والجانب الثاني شق تطبيقي سنقف من خلاله على ظاهرة التحول اللغوي عند عينة من تلاميذ المستوى الثانوي الإعدادي.
وقبل الخوض في تعريف هذا المفهوم سنتعرض لبعض المفاهيم المرتبطة به، خاصة مفهومي الثنائية اللغوية والازدواجية اللغوية باعتبار التحول اللغوي النقطة التي تجمع بينهما.
الثنائية اللغوية
الثنائية اللغوية هي مقابل للمصطلح الإنجليزي Bilingualism[1] وتتكون من السابقة اللاتينية Bi وتعني المثنى أو المضاعف، وLingual أي لغوي، واللاحقة ism بمعنى الحالة أو الصفة، وحاصل الترجمة؛ سلوك لغوي ثنائي أو مضاعف/ الثنائية اللغوية[2].
وقد تعددت تعاريف مفهوم الثنائية اللغوية بتعدد أراء الدارسين ووجهات نظرهم، فنجد مثلا:
أن فرانسوا جروجون Francois Grosjean يرى أن "ثنائيي اللغة هم أناس يستخدمون لغتين، أو لهجتين أو أكثر في حياتهم اليومية، فالإيطاليون الذين يستخدمون واحدة من لهجات إيطاليا- مثل البوليزية- مع الإيطالية الرسمية، يمكن وصفهم بأنهم ثنائيو اللغة"[3]. أما جورج مونان Georges Mounin فيرى أن ثنائي اللغة هو الفرد الذي يتحدث لغتين دون تمييز. وينظر إليها بلومفيلد Bloomfild على أنها إجادة الفرد للغتين مختلفتين. ويعرفها ماكي Mackeyبأنها الاستخدام المتناوب للغتين أو أكثر من قبل نفس الفرد[4].
من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن الباحثين يتفقون على أن الثنائية اللغوية مرتبطة بالفرد الواحد ومدى قدرته على استخدام لغتين أو أكثر في محادثاته، لكن شرط الإجادة الذي وضعه بلومفيلد يضعنا أمام التساؤل عن وضع الفرد الذي يعرف لغتين أو أكثر بدرجات متفاوتة.
فالشخص قد يستعمل اللغتين الأولى والثانية بصورة متكافئة فتسمى هذه الثنائية بالثنائية اللغوية المتوازنة، وقد يتقن اللغة الأم أكثر من اللغة الأخرى فتسمى ثنائية اللغة السائدة، وهذا ما يطلق عليه الدارسون المظهر الفردي للثنائية اللغوية، أما المظهر الاجتماعي فهو استعمال الأفراد داخل المجتمع لغتين أو أكثر، فيختارون استعمال لغة في مواقف معينة، ولغة أخرى في مواقف أخرى، أو قد يزاوجون بينهما في موقف واحد[5].
ويمكننا وصف الشخص بأنه ثنائي اللغة إذا ما توفرت أربع خصائص؛ درجة المعرفة باللغتين اللتين يستخدمهما الشخص، والدور الذي تلعبه هذه اللغات في البنية العامة لسلوك الفرد والهدف الذي يسعى إليه من خلال استخدام هذه اللغات، وكيفية الانتقال من لغة إلى أخرى، ثم الحالة التي يتمكن فيها الفرد من الإبقاء على اللغتين منفصلتين[6].
لقد كانت مسألة التمييز بين الثنائية اللغوية والازدواجية اللغوية محط نقاش طويل بين الدارسين، ترتب عن الخلط الذي اعترى المصطلحين منذ ظهورهما عند الأوروبيين بسبب تقارب البنية المصطلحية للمفهومين في اللاتينية، لكن تم لاحقا الفصل بينهما عندما تم نقل المصطلحين إلى اللغة الإنجليزية ليدل كل منهما على شكلين مختلفين من الاستخدام اللغوي.
ويكون فرجسون بذلك أول من وضع الحدود العامة لمفهوم الازدواجية، ثم جاء فيشمن فأقر بأن الثنائية اللغوية هي صفة مميزة للتصرف اللغوي على المستوى الفردي، أما الازدواجية فهي خاصية من خصائص التنظيم اللغوي على مستوى مجتمع ما[7].
الازدواجية اللغوية
الازدواجية اللغوية هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي [8]Diglossia، ويتكون المصطلح من Di وتعني في اللاتينية مثنى أو مضاعف، و glossمعناه لغة، واللاحقة ia وتعني الحالة، وحاصل الترجمة هو حالة لغة مضاعفة أو مثناه/ الثنائية اللغوية[9]، وهنا يظهر جليا تطابق مصطلح الازدواجية مع مصطلح الثنائية أعلاه، وهو واقع أربك علماء السوسيولسانيات في أوروبا بداية القرن العشرين.
ويجمع الدارسون على أن كرومباشر (1856 – 1909) Karl Krumbacher أول من تعرض لمصطلح الازدواجية اللغوية بالدراسة، إلا أن بعضهم يؤكدون على أن الفرنسي وليام مارسي Willam Marssais أول من استخدم المصطلح، لكن أن أغلب الدراسات لم تشر إلى دراسة مارسي، بل تبنت عمل شارل فرجسونFerguson Albert Charles [10].
ميز فرجسون في رأيه حول الازدواجية اللغوية بين شكل لغوي أعلى/ فصيح يكون عادة لغة الأدب المكتوب، وهو نوع يتم تعلمه عن طريق التعليم الرسمي ويٌستخدم في الكتابة والتحدث الرسميين، وشكل لغوي أدنى/ العامية وهو لغة التداول اليومي. أما فيشمن فكانت له نظرة مغايرة، فهو يرى أن الازدواجية اللغوية لا تقتصر على وجود لهجتين فصيحة وعامية في المجتمع الواحد، كما لا يهم إن كانتا لهجتين أو أسلوبين أو لغتين... بل الازدواجية تتحدد بوجود اللغات المختلفة في هذا المجتمع، وهو هنا أدخل الثنائية مع الازدواجية، أي أن الازدواجية يدخل فيها تعدد اللهجات وحتى تعدد اللغات في مجتمع لغوي ما، عكس الثنائية التي يُستخدم فيها أكثر من لغتين على المستوى الفردي. أما فاسولد فالازدواجية عنده تضم اللغات واللهجات والأساليب، ما دام هناك توزيع وظيفي لها، حيث حدد أربع نقاط يمكن من خلالها الوصول إلى نظرية متكاملة للازدواجية، أولا؛ وجود "الشكل المعياري واللهجات"، ذلك أن الجمع بينهما لا يتعارض مع معنى الازدواجية، ثم "العلاقة الثنائية" بين اللغة العليا واللغة الدنيا (الفصحى والعامية)، وأيضا "الترابط"، حيث وصف الازدواجية من خلال الحالات التي يكون فيها الشكلان اللغويان الأعلى والأدنى لغتين مختلفتين، كما هو بين اللغة الإنجليزية واللغة السواحلية بتانزانيا، وأخيرا "الوظيفة"؛ فاللغة واللهجة والأسلوب الأعلى تستخدم في الوظائف الرسمية في المجتمع، أما اللغة واللهجة والأسلوب الأدنى فهي للاستعمالات غير الرسمية أو الحديث اليومي[11].
هذه التعاريف توضح لنا أن الازدواجية يندرج ضمن نطاقها أشكال لغوية مختلفة للغة واحدة، عكس الثنائية التي تتعامل من لغتين مختلفتين تماما، لا تنتميان إلى نفس النسق التركيبي والصرفي. فالازدواجية إذن مرتبطة بالمجتمع بينما الثنائية فترتبط بالفرد.
أما التعدد اللغوي Multilingualism[12] فيدخل ضمنه الثنائية اللغوية والازدواجية اللغوية، فهو يحيل على "استعمال الفرد أو على قدرة الفرد أو على الوضعية اللغوية في أمة كاملة/ مجتمع ما"[13].
التحول اللغوي
ظهرت العديد من الكتب والمقالات اهتمت بمفهوم التحول اللغوي، وكان الموضوع الأكثر جدلا خاصة في الدراسات المهتمة بالثنائية اللغوية والاتصال اللغوي، وحسب ميوسكن Muysken فإن السبب ربما يرجع إلى حقيقة أن الناس قادرون على استخدام أكثر من لغة في نفس الوقت ونفس المحادثة وحتى في نفس الجملة، وليس العكس[14].
1-3- تعريف التحول اللغوي
يعرف الباحثون التحول اللغوي [15]code-switching على أنه ظاهرة يتحول خلالها المتكلم بلغتين أو أكثر- فجأة- إلى استعمال لغة أو جملة أو عبارة بلغة أخرى في سياق محادثاته، ومن التعريفات التي وضعت له نجد:
كريستال (1987)، ويعرف التحول اللغوي بأنه "تحول الفرد أثناء حديثه مع شخص آخر من لغة إلى لغة ثانية أو من لغة فصيحة إلى لغة عامية أو العكس، ويرى أن هذا التناوب في استخدام اللغات يحدث عند شخص ثنائي اللغة القادر على التواصل بدرجات متفاوتة بلغة ثانية أو القادر على استخدام لغة ثانية لكنه لم يفعل (ثنائي اللغة الخاملة Dormant Bilingulism) أو لديه مهارة كبيرة في لغة ثانية"[16].
أما حسب ميوسكن Muysken (2000) "فيشير التحول اللغوي إلى التناوب السريع بين عدة لغات في حدث كلامي واحد، وهو بذلك يميزه عن التداخل اللغوي الذي يشر إلى الحالات التي تظهر فيها العناصر المعجمية والسمات النحوية من لغتين في جملة واحدة، عكس الرأي الذي يقول أن التحول اللغوي هو نتيجة التداخل بين لغتين مما ينتج عنه لغة ثالثة"[17] )وهو رأي كل من ديفز وبنتاهيلا Davies and Bentahila ، ينظر إلى: Gerald Stell and Kofi Yakpo(2014))
يعرفه بولوك وتورْبيو (2009) Bullok and Torbio بأنه "القدرة على التبديل بين اللغات في وضعية غير متغيرة، وعرفته بوبلاك Poplack(2001) بأنه المزج بين لغتين أو أكثر في الخطاب دون تغيير موضوعه"[18].
كل هذه التعاريف تتفق على أن التحول اللغوي هو انتقال من لغة إلى أخرى في سياق تواصلي ما، وهو ما يؤكد ارتباط التحول بالثنائية اللغوية من جهة وبالتداخل اللغوي من جهة أخرى بحيث تتطلب الظاهرة وجود أكثر من لغة عند الفرد الواحد وانشار أكثر من واحدة في مجتمع واحد، بحيث يتم استخدام مفردات أو عبارات خاصة بلغة ثانية في الخطاب التواصلي، غير أننا لا يمكن النظر إلى مفهوم التحول اللغوي ومفهوم التداخل اللغوي على أنهما مصطلح واحد.
فالتحول اللغوي حسب سكيبا يتم بطريقة شعورية أو لا شعورية ويبقي اللغتين منفصلتين ومتميزتين، وهو ما يخلق حاجزا يحول دون حدوث تداخل بينهما[19].
فالتحول اللغوي هو امتداد للغة بالنسبة لثنائيي اللغة، ويتم على مستوى المفردات والجمل وليس تداخلا، بينما التداخل هو تأثير اللغة الأولى على اللغة الثانية التي تعلمها الشخص في مستويات عدة: صوتية، نحوية، ومعجمية ودلالية، فالتحول اللغوي هو شكل من أشكال التداخل اللغوي[20].
مثال: (حوار دار بين تلميذتين من المستوى الثاني من التعليم الثانوي الإعدادي في مجموعة تربوية عبر تطبيق واتساب)
التلميذة1: واش نكتبو القاعدة لي عطات لينا الأستاذة ونأونكادريوها؟
التلميذة2: je pense لا، ماقالتهاش لينا.
في السؤال الذي طرحته التلميذة 1 نجد تداخلا لغويا على مستوى الفعل encadrer فقد تمت معاملته معاملة الفعل غير التام في العامية المغربية، تمت إضافة (السابقة) صرفة الزمن (ن) والتي حققت سمة الزمن+ الشخص، وأيضا اللاحقة( واو الجماعة) الدالة على العدد والجنس، فحاولت بناء الفعل في الفرنسية على غرار الفعل( نكتبوا) وجعلته يوافقه في الزمن والتطابق، كما تم إلحاقه بعائد يعود على "القاعدة"، ليصبح الحاصل في النهاية جملة "نأونكادريوها": فعل –فاعل- عائد، وبالتالي خرق في الرتبة المعروفة في الفرنسية ب فاعل- فعل- مفعول به، هذه التلميذة قامت بتداخل لغوي بين اللغتين العامية المغربية والفرنسية، حاولت من خلاله جمعهما في بنية واحدة رغم اختلاف قواعد النسقين وهذا التداخل يسمى بالتداخل السلبي[21]، حيث نقلت التلميذة 1 مقولات وظيفية من العامية المغربية وأسقطتها على مقولة معجمية من اللغة الفرنسية دون مراعاة خصائص البنيوية لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى خرق فونيمي باستبدال فونيمات اللغة الفرنسية بأخرى عربية، أما في جواب التلميذة 2 فهناك تحول لغوي حدث داخل الجملة لكن لم يتم خرق قاعدة أي من اللغتين الفرنسية والعامية المغربية، فالجملة الفرنسية pense je" هنا حافظت على رتبة فاعل – فعل، وبالتالي أبقت على اللغتين منفصلتين من حيث قواعدهما الخاصة.
2-3- نشأة المصطلح
إن مصطلح التحول اللغوي قديم قدم مفهوم الثنائية اللغوية نفسها، وهو مصطلح صاغه فوجيت(1954)voget في مراجعته لكتاب فاينرايشWrinreich’s "اللغة في تماس" (1953)[22]، وقد استحوذ المصطلح حينئذ على اهتمام الباحثين وتطورت المواقف تجاهه بشكل كبير وكان التصور المبكر للتحول اللغوي سلبيا، حيث كان يُعتقد أنه يحدث بسبب ضعف القدرة اللغوية لدى ثنائيي اللغة، ومع تطور الدراسات اللسانية الحديثة تغيرت النظرة للمصطلح، وأصبح التحول اللغوي منذ السبعينيات من القرن الماضي موضوعا مستقلا للدراسة له مفاهيمه الخاصة ومنهجيته الخاصة في الدراسة، لذلك لا عجب إن كثرت التعريفات حوله أو تناقضت، وجاء بعد ذلك كل من كويك (1987) و ماكسوان(2000) ليؤكدا أن التحول اللغوي يمكن النظر إليه على أنه مؤشر مرموق للقدرة اللغوية واعتبراه استراتيجية للتواصل ولزيادة إثراء الخطاب[23] ، عكس الادعاءات السابقة.
3-3- وجهات نظر
لقد تم إجراء عدة دراسات تناولت التحول اللغوي من ثلاث وجهات نظر مترابطة مع بعضها البعض.
المنظور اللغوي The linguistic perspective: اهتم بما يتعلق بالنظرية اللغوية و القيود اللغوية على التحول اللغوي، كما حددتها بوبلاك(1980) وسلسلة القيود التي جاءت بعدها، والتصنيف البنيوي الذي جاء به ميوكسن(2000) [24].
المنظور اللغوي الاجتماعيThe sociolinguistic perspective: اهتم بالدوافع الاجتماعية وراء عملية التحول اللغوي، وبالتفسيرات الاجتماعية المرتبطة به كالتعبير عن الهوية وعن القيم الأيدولوجية أو الثقافية...
فقد تناولت الدراسات الأولى للتحول اللغوي مع غامبرز(1971) الوظائف الاجتماعية للتحول اللغوي وكان سؤال البحث، لماذا ينخرط المتحدثون في التحول اللغوي؟ وتم التوصل إلى إجابة مفادها أن التحول اللغوي هو استراتيجية للتأثير على العلاقات الشخصية، واستمر البحث خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لتنقيح هذه الإجابة، واعتبر كل من غامبيرز(1982)و أوير(1984) أن التحول اللغوي إشارة سياقية وهي واحدة من مجموع الأدوات التي تستعمل في الإشارة إلى نوايا المتكلم في الخطاب، كما درس أغلب الباحثين الوظائف الاجتماعية للتحول اللغوي وأشكال استخدامه بين الأشخاص، التي تعكس قيم المجموعة والمعايير المرتبط بالتنوعات اللغوية داخل المجتمع[25].
المنظور اللغوي النفسيThe psycholinguistic perspective: وقد ركز على كيفية تخزين الأنظمة اللغوية عند الأشخاص ثنائيي اللغة والوصول إليها في النظام المعرفي؟ وحاول البحث عن إجابة لسؤال: كيف تكتسب اللغة الثانية؟ سؤال أثار جدلا واسعا بين الباحثين، نتج عنه وجهتا نظر مختلفتين هما: أن الأشخاص ثنائيي اللغة يتشكل لديهم "نظام لغوي واحد" منذ بداية الطفولة وينفصل فيما بعد، ودليل ذلك أن الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم يخلطون لغتيهم معا أو يستخدمون قاعدة واحدة قد يستمدونها من إحدى اللغتين، ومَثَّل لذلك فرانسوا جروجون بطفلة ثنائية اللغة في الفرنسية والإنجليزية، وُضعت تحت تجربة لدراسة اكتساب المفردات، فلوحظ أنها كانت تمزج بين chaud (الفرنسية) وhot ( الإنجليزية) في كلمة واحدةshot أو تمزج بين pickle و cornichonفي كلمة pinichon، وطفل آخر كان يقول: papa-daddy وchaud-hot. أما وجهة النظر الثانية فترى أن الأشخاص ثنائيي اللغة يتشكل لديهم "نظام لغوي مزدوج" مميز منذ البداية، حيث تستطيع كل لغة من اللغتين أثناء اكتسابهما أن تتطور على نحو مستقل وبنمط اكتساب مماثل للذي عند أحاديي اللغة، وحجة ذلك ما قدمته الباحثة بيرجمان كورال، كون أن ابنتها كانت تميز بين اللغتين قبل السن الثانية تقريبا وتستخدم كل لغة على انفراد وهو الطرح الذي تبناه الباحثون بعد ذلك حيث فسروا الطرح الأول على أنه مجرد تحول لغوي لا غير[26] .
4-3- التصنيف البنيوي للتحول اللغوي:
يقسم ميوسكنMuysken (2000) التحول اللغوي حسب المنهج البنيوي إلى ثلاثة أقسام[27]:
الإدماجInsertional[28] : حيث يتم دمج مكونات من A في إطار صَرفي نحوي يهيمن عليهB.
التناوب Alternational[29] : حيث يتناوب A وB دون التعدي على الحدود الصَّرف نحوية الخاصة بكل منهما.
التطابق المعجميCongruent Lexicalization[30]: حيث يتقارب A وB في الإطار الصَّرفي النحوي.
يتضمن الإدماج دمج عناصر معجمية لوحدات من اللغة الأولى في بنية اللغة الثانية أو العكس، ويتراوح هذا النوع من التحول بين تبديل كلمة أو عبارة كاملة، أما في التناوب فتحافظ عناصر اللغة على بنيتها النحوية مستقلة، أي يتم استخدام بنيات مختلفة وفقا لقواعد لغتها الخاصة، رغم استخدامها في بنية مختلفة، ويرى مويرMoyer أن التناوب يتوافق مع التحول بين الجمل ويشير إلى الحالة التي يقول فيها متحدث ثنائي اللغة جملة بلغة أولى ثم جملة أخرى بلغة ثانية لنفس الحوار، أما في النوع الثالث والأخير فيتم دمج المفردات من لغات مختلفة داخل بنية نحوية مشتركة (نفس الجملة) حيث لا يتم ملاحظة المفردات المتطابقة إلا إذا كانت اللغتان لهما بنيات نحوية ومعجمية متشابهة، مما يعطي انطباعا بأن التطابق بين المفردات يتطلب تطابقا أو تشابها بين اللغتين، كالإنجليزية والفرنسية مثلا، وهذا النوع يستعمله ثانئيو اللغة الذين لهم مهارة لغوية عالية بنفس الدرجة في كلتا اللغتين[31].
5-3- القيود
بنت بوبلاك(1980) poblack أول نموذج نظري للقيود البنيوية على التحول اللغوي من خلال وضع قيدين أساسين هما[32]:
قيد الصَّرف الحر [33] The free morpheme constraint؛ يشير هذا القيد إلى أنه لا يجوز التحول داخل نفس الكلمة، مثل إلحاق علامة الجمع باسم voiture فنقول فواتيرات أو singer(مغني) سينجرون.
قيد التكافؤ The equivalence constraint[34] : تبعا لهذا القيد، التحول اللغوي ينبغي أن يقع في نقطة ما في الجملة بحيث لا تُخترق قواعد كل من اللغتين كأن نقول مثلاmilk je bois، هذا المثال يخرق قاعدة الرتبة في اللغتين الفرنسية الإنجليزية فعل- فاعل- مفعول به.
وهذه القيود توفر الآلية المناسبة تحول دون حصول تداخل لغوي في المحادثات بين ثنائيي اللغة.
6-3- أنواع التحول اللغوي:
"أنواع التحول اللغوي بالنظر إلى المتكلم والمستمع.
التحول الإنتاجي: يقوم به المتكلم شفهيا أو كتابيا.
التحول الاستقبالي: يقوم به المستمع، فكلما تحول المتكلم من لغة إلى أخرى يتحول معه المستمع، فيصبح المتكلم هو الموجه والمتحكم في الخطاب والمقام والوقت، ويبقى المستمع هو المتفاجئ بهذا التحول، الشيء الذي يضعه أمام احتمال عدم قدرته على فهم الكلام"[35].
أنواع التحول بالنظر إلى المستوى اللغوي:
تحول داخلي/ثابت: يتم داخل نفس اللغة، كالتحول من العربية الفصحى إلى العربية المغربية/ العامية.
تحول خارجي/ متغير: يكون بين لغتين مختلفتين في مجتمع لغوي واحد، كالعربية والفرنسية في المغرب، أو من لهجة إلى أخرى[36].
ج- أنواع التحول بالنظر إلى السياق والمتكلم حسب بلوم وغامبيرز:
تحول سياقي/ ظرفي: يحدث هذا التحول حسب الموقف وذلك عندما تتغير اللغة المستعملة وفق الموقف الذي يجد المتكلم نفسه فيه، وباختلاف الموقف تتغير اللغة، فالموقف يملي- داخل جماعة ثنائية اللغة- اختيار التنوع، وهذا التنوع يتحدد من خلال العلاقة بين المتخاطبَين، ويرى كل من جانيت ودونالد (2015) أن الازدواجية اللغوية تعزز الاختلافات بين المتكلمين في حين أن التحول اللغوي يميل إلى تقليصها.
التحول اللغوي العاطفي/ الرمزي: حيث يحمل اختيار لغة بدل أخرى في خطاب ما بُعدا رمزيا، وذلك لتتناسب لغة التبليغ مع الخطاب، ويتضح ذلك من خلال المثال الذي ضرباه جانيت ورولاند بشارلز حاكم روما، حينما قال: أنا أتحدث الإسبانية مع الله، والإيطالية مع النساء، والفرنسية مع الرجال، والألمانية مع حصاني، فالانتقال من لغة إلى أخرى يحدث لإرادة داخلية لها بعد عاطفي بالدرجة الأولى[37].
يتم تحديد التحول اللغوي إذن، إما من خلال عوامل خارجية للمتحدث كإدخال موضوع جديد في المحادثة، أو أن المتحدث نفسه هو الذي يخلق تغييرا في المحادثة من خلال تغيير اللغات، فيصبح التحول بذلك أداة للكشف عن نوايا المتحدث وتفسيرها.
7-3- أسباب التحول اللغوي.
هناك عدة أسباب تدفع المتكلم إلى التحول من لغة إلى أخرى، من هذه الأسباب نجد[38]:
رغبة المتكلم في التأثير في السامع.
رغبته في التعبير عن التضامن مع جماعة لغوية.
رغبته في الحفاظ على سرية المعلومة، إقصاء شخص ما من دائرة الحديث، أو إخراجه من سياقه، فيتعرض المرء أحيانا إلى الإقصاء لأنه لا يجيد لغة الآخرين.
توضيح المعنى باللغة الثانية، أو تأكيد مفردة أو جملة.
الاقتباس، قد يحدث التحول بالاقتباس من لغة ثانية؛ شعرا، أو قولا مأثورا.
تحديد المخاطب وتوجيه الكلام له في جماعة لغوية، حيث يتم إنشاء علاقة ودية بين المتحدث والمستمع عندما يستجيب المستمع لهذا التحول. وهذا النوع من التحول يمكن استعماله لإقصائه من دائرة الحديث وإخراجه من سياقه لإظهار رفعة المكانة، باستخدام لغة أخرى قد يعطيها المجتمع منزلة أعلى من غيرها.
إعطاء إشارة بإدراك اللغة الثانية، أو نقل انفعال ما، يميل هذا النوع من الأشخاص إلى التحول اللغوي عندما يكون منزعجا أو متعبا أو...
واقع التحول اللغوي عند تلاميذ المستوى الإعدادي.
تعد المرحلة العمرية ما بين 12- 18 سنة تقريبا- مرحلة المراهقة- من المراحل التي يمكن أن نلمس فيها الكثير من التحول اللغوي، فهي المرحلة التي يستكشف فيها المتحدثون مدى قدرتهم على التلاعب باللغة أو اختراع ألفاظ جديدة وما إلى ذلك، وهي أيضا الفترة التي يحاولون فيها إثبات أنفسهم بين أقرانهم وأيضا تأثرهم بسلوكيات غيرهم ولعل التحول اللغوي من أبرزها.
سنحاول في هذا المحور من العرض الوقوف على ظاهرة التحول اللغوي عند هذه الفئة العمرية، وعينة الاشتغال هم تلاميذ من المستوى الثانوي الإعدادي بالتعليم الخصوصي (عددهم59 تلميذا) تم اكتشاف هذه الظاهرة في تواصلهم عبر الرسائل القصيرة داخل مجموعة تربوية لتبادل الدروس والمعلومات على تطبيق واتساب.
وقد استندنا في هذا العمل على بعض الأسئلة والاستبيانات، ونماذج من المحادثات لتقصي هذا الوضع اللغوي لدى هذه الفئة، فكانت الأسئلة المطروحة عليهم كالآتي:
- هل يحدث التحول اللغوي في تواصلك؟
- لماذا تلجأ إلى توظيف لغة ثانية في محادثتك، هل الأمر مقصود؟
- ما هي اللغة التي تتحول إليها عادة في حديثك؟
- هل يحدث التحول في البيت أم المدرسة أم في الشارع؟
- ما هو محيطك الذي تنتشر فيه ظاهرة التحول اللغوي بكثرة، هل البيت أم المدرسة أم الشارع أم الوسائل التكنولوجية الحديثة؟
بعد فحصنا لأجوبة هذه الأسئلة توصلنا إلى ما يلي:
يظهر المبيان أن جل التلاميذ موضوع الاشتغال يحصل عندهم تحول لغوي، لكنهم يتفاوتون في اللغات التي يتحولون إليها ماعدا العربية والفرنسية فهم متساوون فيهما، ويرجع ذلك إلى أن العربية والفرنسية هما اللغتان اللتان يتعلمانها منذ السنوات الأولى من عمرهم في المدرسة بعد اللغة الأم، بالإضافة إلى تشابه العربية الفصحى مع اللهجة المغربية في الكثير من الخصائص( النحوية، الصرفية، الدلالية...)، والعكس بالنسبة للذين يتحولون بين اللهجة المغربية والأمازيغية لأن هذه الأخيرة هي اللغة الأم التي تم اكتسابها وأصبحوا يتحولون منها إلى لغات أخرى لكن فقط مع من يتحدثون الأمازيغية، فرغم أن عددهم قليل كما يوضح المبيان، إلا أنهم الأكثر قدرة على التحول بين اللغات من غيرهم أو بالأحرى القدرة على التحول إلى أكثر من لغة في سياق واحد. أما اللغة الإنجليزية فقليلا ما يتحولون إليها ربما لأنها جاءت في المرتبة الثالثة بعد الفرنسية والعربية في التعلم والتلقين داخل المؤسسة التعليمية، لكنهم يقبلون عليها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وللإشارة فالتلاميذ الجدد الملتحقون بالمؤسسة لهذا الموسم الدراسي (2024/2025) منخرطون أيضا في هذه العينة وينتقلون بنفس الكثافة بين اللغات رغم أن بعضهم كان متمدرسا بالقطاع العمومي، لنعدم حقيقة أن المدرسة هي المسؤول الوحيد عن التحول اللغوي لدى هذه الفئة من التلاميذ.
يوضح لنا هذا المبيان أن التحول اللغوي يحدث في كل الأوساط التي يتواجد فيها التلاميذ- موضوع البحث- أغلب وقتهم، وقد تم وضع استبانة على مجموعات الواتساب، طرح فيها السؤال الآتي، ما هو محيطك الذي تنتشر فيه بكثرة ظاهر التحول من لغة إلى أخرى في المحادثات؟ بحيث ينتقل المتخاطبون من لغة إلى أخرى أو يخلطون بينها. وكانت المعلومات التي توصلنا إليها هي ما يقدمه المبيان أعلاه.
بحيث أقر حوالي 49 من التلاميذ من المجموعة أنهم يلاحظون هذه الظاهرة بشكل كبير على شبكة الأنترنيت وتم الاستفسار عن المواقع والتطبيقات التي يحدث فيها بكثرة، فكانت أغلب أجوبتهم: الواتساب والفضاء الأزرق واليوتيوب وموقع spotify. وأغلب ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر التطبيقين الأخيرين هو البودكاست، وهو من الوسائط الإعلامية الرقمية المشهورة في الآونة الأخيرة والتي يمكن أن نلاحظ فيها ظاهرة التحول بين اللغات بشكل كبير، وتأتي المدرسة في المرتبة الثانية بعد الأنترنيت ويقر التلاميذ أن المدرسة ثاني وسط يحصل فيه الانتقال بين اللغات لكن يقل ذلك أثناء الحصص الدراسية خاصة في المواد الأدبية، ويأتي الشارع في المرتبة الثالثة، بحكم أن الاحتكاك مع المتخاطبين في هذا المحيط يختلف من شخص إلى أخرى بحسب الفئة العمرية وبحسب إمكانية حصول التحول اللغوي أم لا؛ هناك أشخاص لا يحصل لديهم تحول لغوي وهناك أشخاص يحصل لديهم تحول لغوي لكن بدرجات. أما البيت فيحصل فيه التحول اللغوي بشكل قليل، ويتحكم فيه الوضع الثقافي والاجتماعي وحتى المادي لأسر التلاميذ، فبعد الاستفسارات التي قمنا بها وجدنا أن التلاميذ الأكثر تحولا بين اللغات منحدرون من أسر ميسورة وأفرادها إما مثقفون أو موظفون، وكلما كان أحد أفراد الأسرة غير مثقف خاصة الأم وثم الأخوة، تحول التلميذ إلى لغة واحدة فقط. وهذا إن دل فهو يدل على دور الأسرة في تثبيت وترسيخ قيم المعرفية التي يكتسبها التلميذ في باقي الأوساط.
إذا فكيف لتلميذ من هذه الفئة العمرية ألا تحصل معه هذه الظاهرة وكل من يحيطون به متعددوا اللغات و يحصل لديهم تحول لغوي في محادثاتهم؟ لذك فمحيط التلميذ له دور فعال في توجيه لغويا كيفما كان نوع هذا المحيط.
نماذج من التحول بين اللغات عند العينة:
عندما بحثنا في المجموعات التربوية- على التطبيق المذكور أعلاه- عن نماذج من التحول اللغوي، استوقفنا حوار قصير دار بين تلميذتين من المستوى الثاني إعدادي، موضوعه الاستفسار عن تتمة درس علوم الحياة والأرض على شبكة الأنترنيت.
التلميذة 1: واش ساليتي الفيديو دعاء؟
التلميذة 2: آه
التلميذة 1: أنا Non، عاودت leçonكاملة (2)
التلميذة 1: ولكن مشارحاش الأستاذة Last document (3)
التلميذة 2: واه مشرحاتوش ولكن دبا يشرح لنا الأستاذ
التلميذة 1: داكشي لي بالي ماشارحاش first one ، راها دايرة تكميلته فشي فيديو آخر Maybe (4)
التلميذة 2: I think (5)
التلميذة 2: ولكن تكون تكون دايرة cours كامل في another vidio (6)
التلميذة 1: Maybe
...
سنحلل هذه الأمثلة وفق التقسيم البنيوي الذي وضعه ميوسكين(2000) والقيود الصَّرف النحوية التي وضعتها بوبلاك(1980).
الملاحظ في الأمثلة أن التحول اللغوي عند التلميذتين كان من العربية المغربية( اللهجة المغربية) إلى الفرنسية تارة أو إلى الإنجليزية تارة أخرى أو إليهما معا (تحول خارجي) وهو تحول استقبالي كانت التلميذة 1 المثال (4) المتحكمة فيه والموجهة للغة التي انتقلت إليها التلميذة 2 المثال (5) ، والملاحظ أيضا غياب النوع الثاني الذي ذكره ميوسكن في تقسيمه( التناوب بين الجمل في سياق واحد).
في المثال (2) تحولت التلميذة من الدارجة المغربية إلى اللغة الفرنسية وتم إدراج العنصرين non و Leçon في بنية اللهجة المغربية دون أن تخرق القيد الأول كأن تلحق(ال) التعريف مثلا ب الاسم Leçon ، ولم تخرق القيد الثاني وأبقت المفعول به leçon بعد الفعل والفاعل في الرتبة المخصصة له فلم تكتب مثلا: *Leçon عاودت. وبالتالي فالمثال(1) هو نموذج عن التحول اللغوي.
في المثال (3) أدرجت التلميذة عناصر من اللغة الإنجليزية في بنية اللهجة المغربية فحافظت أيضا على رتبة: نفي+ فعل + فاعل+ مفعول به( document) كما هي في العربية، ورغم معرفتها برتبة موصوف+ صفة في العربية الفصحى وفي العربية المغربية( الدارجة) حافظت على رتبة الصفة + موصوف last documentفي الإنجليزية وبالتالي أبقت قواعد اللغتين منفصلتين وهذا في حد ذاته يتطلب وجود قدرة لغوية في كلتا اللغتين وكثرة الممارسة، كما لا نجد خرقا للقيد الصرفي فالاسم document بقي مستقلا بمكوناته دون أن تدخل عليه مكونات صَرفية عربية.
في المثال(6) تم الانتقال من الدارجة المغربية إلى الفرنسية ثم إلى الإنجليزية في نفس المحادثة، العنصر اللغويcours من اللغة الفرنسية، والعنصران another vidio من اللغة الإنجليزية وتم إدراج العنصرين داخل بنية الدارجة المغربية دون خرق القيدين الصرفي أو النحوي.
ما نستنتجه من هذه المحادثات-وحتى باقي المحادثات المكتوبة والشفهية لدى هذه الفئة من الأشخاص هو غياب المستوى الثاني من تقسيم ميوسكن(التناوب) وهذا يدل على أن هذه الفئة تميل إلى التحول اللغوي الذي يشمل المفردات وليس الجمل، فكمية المادة اللغوية المستعملة التي يقع التحول اللغوي فيها، تقل عند هذه الفئة، بينما عند الأشخاص الأكبر سنا سنجد أن التحول اللغوي يشمل الانتقال بين الجمل. وهو ما يفسر أن الانتقال من لغة إلى أخرى في التواصل لا يحدده فقط السياق ونوع المخاطَب ومقصدية المتكلم بل أيضا يتحكم فيه عامل السن.
وبعد استجواب قمنا به مع هذه العينة تبين أنهم ينتقلون أحيانا بين الجمل، لكن بشكل قليل جدا، وأنهم يقومون بذلك بشكل متعمد لأن عليهم التريث والتفكير جيدا في جملة اللغة المراد الانتقال إليها لتوظيفها في محادثتهم، أما الكلمات فينتجونها بشكل لا شعوري ويوظفونها تلقائيا فهم لا يستوعبون أنهم يوظفونها، وحتى وإن كان توظيفها مقصودا فإن ذلك من أجل الشرح والإبانة، إذا فهم يميلون بحكم سنهم إلى السهولة والسرعة في أداء المحادثة.
خاتمة:
إن التحول اللغوي ظاهرة منتشرة في كل مجتمع لغوي وكسلوك بشري هي مسألة حتمية في عصر أصبح الناس فيه يختلفون في العادات والثقافات واللغة، لذلك فالتحول اللغوي قد لا يعني صعود لغة على حساب أخرى وإنما هو وسيلة فعالة لتعلم اللغات الأجنبية في وقت أصبحت الحاجة إلى هذه الأخيرة ملحة، وقد ساعدنا هذا البحث على الوقوف على هذه الظاهرة واستنتجنا ما يلي:
اللغة كائن يستجيب للاختلاط اللغوي وهذا الاختلاط يسمح بوجود عدة لغات في مجتمع واحد.
التحول اللغوي مفهوم قديم قدم الثنائية اللغوية نفسها وحقل أسال حبر العديد من الباحثين.
التحول اللغوي مرتبط بالازدواجية والثنائية اللغوية والتداخل اللغوي.
التحول اللغوي هو وضع يعكس ديناميكية المنافسة بين عدة لغات في سياق تواصلي واحد.
التحول اللغوي هو استراتيجية يستخدمها ثنائيو اللغة لإثراء الخطاب.
التحول اللغوي ظاهرة تتحكم فيها عوامل عدة: كالموقف والعلاقة بين المتخاطبين ونوايا المتكلم والسن...
التحول اللغوي له أنماط وقيود تضبطه، حددها علماء علم اللغة الاجتماعي.
***
غزلان زينون - باحثة
..................
قائمة المراجع:
بلرهمي نسرين(2003) التداخل اللغوي بين العربية والأمازيغية وتأثيره على تلقي الطفل لقواعد اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة.
الفاسي الفهري عبد القادر، العمري نادية(2007) معجم المصطلحات اللسانية، دار الكتاب الجديدة المتحدة.
فرونسوا جروجون (2017) ثنائيو اللغة، ترجمة زينب عاطف، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة الأولى.
القطيطي بدر بن سالم، الثنائية اللغوية وظاهرة التحول اللغوي، قراءة فيما وراء اللغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي، المجلس الدولي للغة العربية، المؤتمر الدولي السابع للغة العربية.
كزار حسن(2018) اللسانيات الاجتماعية في الدراسات العربية الحديثة، التلقي و التمثلات، الطبعة الأولى، دار الرافدين، لبنان
كايد محمود إبراهيم(2002) العربية الفصحى بين الازدواية اللغوية والثنائية اللغوي،المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية( المجلد الثالث - العدد الأول-
المرزوقي منال(2015) التعدد اللساني في المجتمع الإماراتي، دراسة اجتماعية تربوية، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الطبعة الأولى.
محمد اسماعيلي علوي ، التداخل اللغوي الإيجابي وتأثيره في تعليم اللغة العربية وتعلمها، المدرسة المغربية أنموذجا، العدد الأول، مجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنسانيـة المجلد الثاني ـ madjalate-almayadine.com
Benazouz Nadjiba, sociolinguistique, Université M. Kheider. Biskra. Faculté des Lettres et des Langues, 2eme lmd
Florian Coulmas (1998) The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell reference online, ,
Gerald Stell , Kofi Yakpo (2015) Code-switching Between Structural and Sociolinguistic Perspectives, walter de Gruyter Gmbh. Berlin/Munich/ Boston .
Mehmet TUNAZ ( 2016) Development of Code-Switching, A Case Study on a Turkish/ English/Arabic Multilingual Child , Erciyes University
Rajend Mesthrie (2011)The Combridge Hanbook of Sociolinguistics, Cambridge University Press
Richard Skiba ( 1997) Code Switching as a Countenance of Language Interference http://iteslj.org/Articles/Skiba/CodeSwitching.html
Ronald Wardhaugh and Janet M. fuller (2015) An Introduction to Sociolinguistics, seventh edition, Wiley Blackwell,.
هوامش
[1] الفاسي الفهري عبد القادر، العمري نادية (2007) معجم المصطلحات اللسانية، ص 30.
[2] كايد محمد إبراهيم) 2002( العربية الفصحى بين الازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية، العدد الأول، المجلد الثالث، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية)، ص 55.
[3] فرانسوا جروجون(2017) ثنائيو اللغة، ترجمة زينب عاطف، مؤسسة هنداوي للنشر، ص .19
[4] Benazouz Nadjiba, sociolinguistique, Université M. Kheider. Biskra. Faculté des Lettres et des Langues, 2eme lmd p 12.
[5] Benazouz Nadjiba , p 12 – 13.
[6] , p 12. Benazouz Nadjiba
[7] كايد محمود إبراهيم، ص 55- 56 – 57.
[8] الفاسي الفهري عبد القادر(2007) معجم المصطلحات اللسانية ، ص 80
[9] كايد محمود إبراهيم، ص 55.
[10] المرزوقي منال (2015) التعدد اللساني في المجتمع الإماراتي، دراسة اجتماعية تربوية، الطبعة الأولى، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ص 19 – 20.
[11] المرزوقي منال(2015)، ص 20- 21- 22- 23.
[12] الفاسي الفهري عبد القادر(2007)، ص 207.
[13] كزار حسن(2018) اللسانيات الاجتماعية في الدراسات العربية الحديثة، التلقي و التمثلات، الطبعة الأولى، دار الرافدين، لبنان. ص 46.
[14] Rajend Mesthrie (2011)The Hanbook of Sociolinguistics, Combridge University Press p 301
[15] الفاسي الفهري عبد القادر(2007)، ص 325.
[16] p 1 ، Code Switching as a Countenance of Language Interference، Richard Skiba http://iteslj.org/Articles/Skiba-CodeSwitching.html
[17] Gerald Stell , Kofi Yakpo (2015) Code-switching Between Structural and Sociolinguistic Perspectives, walter de Gruyter Gmbh. Berlin/Munich/ Boston .p 2.
[18] Mehmet TUNAZ( 2016) Development of Code-Switching, A Case Study on a Turkish/ English/Arabic Multilingual Child , , Erciyes University , p 4
[19] P 5 ، Code Switching as a Countenance of Language Interference، Richard Skiba http://iteslj.org/Articles/Skiba-CodeSwitching.html
[20] بلرهمي نسرين(2003) التداخل اللغوي بين العربية والأمازيغية وتأثيره على تلقي الطفل لقواعد اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، ص 37.
[21] محمد اسماعيلي علوي ، التداخل اللغوي الإيجابي وتأثيره في تعليم اللغة العربية وتعلمها، المدرسة المغربية أنموذجا، ـ العدد الأول، مجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنسانيـة المجلد الثاني ، ص 122. (يحدث التداخل السلبي عندما ينقل الشخص بنيات من لغته ويسقطها على اللغة الثانية) www.madjalate-almayadine.com
[22] Gerald Stell , Kofi Yakpo (2015) Code-switching Between Strucrural and Sociolinguistic Perspectives, p 2
[23] Mehmet TUNAZ (2016), p 5.
[24] Gerald Stell , Kofi Yakpo (2015), p 3- 4- 5.
[25] Florian Coulmas(1998) The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell reference online p 149
[26] فرونسوا جروجون (2017) ثنائيو اللغة، ترجمة زينب عاطف، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 175 – 176.
[27] Gerald Stell , Kofi Yakpo(2015), p 4.
[28] الفاسي الفهري عبد القادر(2007)، ص 149
[29] الفاسي الفهري عبد القادر (2007)، ص 19
[30] الفاسي الفهري عبد القادر(2007)، ص 55.
[31] Mehmet TUNAZ (2016) , p3-4.
[32] . p 2، Code Switching as a Countenance of Language Interference، Richard Skiba http://iteslj.org/Articles/Skiba-CodeSwitching.htm l
[33] الفاسي الفهري عبد القادر(2007) ص 111.
[34] الفاسي الفهري عبد القادر(2007)، ص 95.
[35] القطيطي بدر بن سالم، الثنائية اللغوية وظاهرة التحول اللغوي، قراءة فيما وراء اللغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي، المجلس الدولي للغة العربية، المؤتمر الدولي السابع للغة العربية، ص 167.
[36] القطيطي بدر بن سالم ، ص 167 .
[37] Ronald Wardhaugh and Janet M. fuller, An Introduction to Sociolinguistics, seventh edition, Wiley Blackwell, p 98.
[38] القطيطي بدر بن سالم، ص 166- 167.