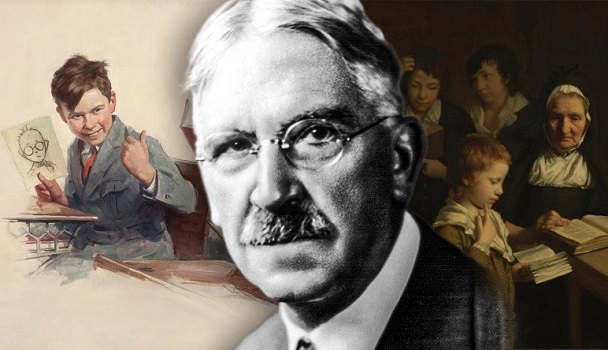أقلام فكرية
غالب المسعودي: جدلية السلطة النصية.. من القدسية إلى النسبية

يمثل التنازع على مرجعية النص محوراً مركزياً في العملية التأويلية والفلسفة المعاصرة. على الرغم من الحضور المكثف للنص في حياتنا اليومية وفي علوم شتى، يظل تحديد ماهيته وتعريفه عصياً على الإجماع، حتى عند المتخصصين في لسانيات النص. ويُعزى هذا الإشكال إلى الحدود المفتوحة للنص، وإلى طبيعته المزدوجة التي تثير التساؤل حول ما إذا كان مجرد أقوال أم خطاباً شفهياً، وهل يخضع النص الفلسفي لشروط النص الأدبي نفسها في التأويل؟
لقد كان النقل المفاهيمي لسلطة النص عملية تدريجية ومعقدة. بدأت بقطيعة فكرية مع الميتافيزيقا الغربية التي تبحث عن الأصل والمركز الثابت (القصد)، مروراً بتأسيس سلطة النص الداخلية والمحايثة (البنيوية)، وانتهاءً بتشريع فاعلية الذات القارئة (الهرمنيوطيقا). هذا التحول يمثل في جوهره مشروعاً تحررياً وفلسفياً جذرياً يسعى لفك ارتباط المعنى بالمرجعية الخارجية المطلقة، سواء تجسدت في ذات المؤلف أو في السلطة التقليدية الحاكمة.
القطيعة الإبستمولوجية: إعلان موت المؤلف
شكلت النظريات النقدية والفلسفية في أواسط القرن الماضي، وخصوصاً في عصر الحداثة وما بعد الحداثة، منعطفاً حاسماً في التعامل مع النصوص. كان التحدي الأول والأكثر جذرية يتمثل في إقصاء المؤلف كمرجع نهائي. لطالما اعتُبر المؤلف في الحقب النقدية التقليدية والفكر الرومانسي بمثابة "حجر الزاوية في العملية الإبداعية، وصاحب الصوت والسوط أيضاً". لقد وصلت الأمور في وقت ما إلى حد اعتبار المؤلف كياناً مقدساً، مما دفع النقاد الرومانسيين إلى التركيز عليه وعلى ظروفه (التاريخية، الاجتماعية، والنفسية) لتفسير النص، متجاهلين بذلك دور القارئ أو اللغة في إنتاج الدلالة. كان المعنى يُفترض أنه كامن في قصد المؤلف أو إرادته.
جاءت نظرية "موت المؤلف" للناقد والمنظر الفرنسي رولان بارت، التي نُشرت في مقال عام 1967، لتشكل القطيعة الإبستمولوجية الأولى. جادلت هذه النظرية بقوة ضد الممارسة التقليدية للنقد الأدبي التي تعتمد على نيات المؤلف وسيرته لتحديد "المعنى المطلق" للنص.
إن الآلية الإجرائية التي اعتمدها بارت لنقل مركز الثقل الدلالي تتمثل في تركيزه المطلق على دراسة النص ولا شيء غير النص، من خلال تفاعلاته البنيوية الداخلية. عندما يُعلن "موت المؤلف من أجل حياة النص"، يتم تحرير النص بشكل جذري من "أبوته السحرية". هذا الإعلان لم يكن مجرد صرخة أدبية، بل كان ضرورة فلسفية لتحويل مركز الثقل الدلالي من الذات المنتجة (المؤلف الغائب) إلى البنية المنجزة (النص الحاضر).
تأسيس سلطة البنية: التحول الإيديولوجي والفلسفي
إن إعلان موت المؤلف يمثل مشروعاً تحررياً أوسع يهدف إلى مكافحة الهيمنة الرمزية التي يكرسها الفكر السائد والسلطة التقليدية. التخلي عن قصد المؤلف ينسف حجة السلطة المرتكزة على مرجعية ثابتة ومقدسة. النقل لم يكن فورياً إلى القارئ، بل مر عبر تأسيس سلطة النص ككيان مستقل أولاً.
هذا يمثل تحولاً منهجياً، حيث لم يعد القارئ يقرأ النص ليفهم ما أراد الكاتب قوله، بل ليكتشف "كيف يعمل النص من الداخل" (الآلية البنيوية). هذا الاكتشاف المنهجي لآليات البناء الداخلي للنص هو أول خطوة لاستحواذ القارئ على سلطة التحليل والإنتاج؛ مما مهد الطريق للمراحل التالية في نقل السلطة.
السلطة اللغوية والاجتماعية
فلسفياً، يُنظر إلى اللغة كجهاز رمزي يتم بواسطته بناء العالم وإدراك الواقع والتحكم فيه. رولان بارت، حتى بعد إعلان موت المؤلف، ظل يركز على العلاقة بين السلطة واللغة. إن النظام الاجتماعي يفرض قواعده وتوابعه عبر سُنن اللغة، مما يؤثر على التوازن الداخلي للفرد والمجتمع. لذا، فإن تحليل سلطة النص هو بالضرورة نقد للسلطة وأنساقها الإيديولوجية التي تُبث عبر "اللغة المقنّعة".
إن هذا الربط بين السلطة النصية (اللغوية) والسلطة الثقافية والسياسية يوضح أن النزاع على سلطة التأويل يتجاوز مجرد النقد الأدبي ليطال تفكيك الهيمنة الرمزية للمنظومة الفكرية السائدة.
الهرمنيوطيقا وتفعيل دور القارئ
تُعرَّف الهرمنيوطيقا بأنها علم التأويل والفهم. تاريخياً، ارتبطت بتأويل النصوص المقدسة ونقل مقاصدها اللاهوتية إلى مستوى البشرية (كما هو شأن الإله هرمس). مع فريدريش شلايرماخر، تحولت الهرمنيوطيقا إلى منهج عام لتفسير كافة النصوص، وكان هدفها فهم النص كما فهمه مؤلفه، بل أفضل مما فهمه. لاحقاً، قام فلاسفة مثل مارتن هيدغر وهانز جورج غادامير بتوسيع النظرية لتشمل "الفهم البشري الكامل للعالم"، حيث أصبح التأويل ضرورة وجودية، و"حدث إفصاح" للحقيقة يحدث في اللغة، مرتبطاً بعملية فهم الذات والتحول.
غادامير يرفض بشكل قاطع محاولات الفهم الكلاسيكية التي تسعى للدخول إلى قصد المؤلف. بل يؤكد أن القارئ لا يمكنه "أبداً الدخول في عقل المؤلف ليكتشف نواياه الحقيقية"، وعوضاً عن ذلك، يمكن للقارئ فقط "مقابلة المؤلف في الموضوع الذي تتم مناقشته". وبهذا، يتم نقل السلطة التأويلية من البحث عن قصد المؤلف الغائب إلى فهم الموضوع من وجهة نظر القارئ الذاتية (المشروطة تاريخياً)، بمساعدة المؤلف. هذا التحول يعني أن الاستحواذ على السلطة التأويلية يتطلب من القارئ استخدام تاريخه الخاص ووعيه المتأثر تاريخياً كجزء لا يتجزأ من الإنتاج الدلالي.
تبادل مراكز القدسية ونتائج النسبية
يظهر الخطر الفلسفي عندما تعلو سلطة القارئ على سلطة النص. في هذه الحالة، يصبح القارئ موجِّه النص بألفاظه وقواعده، وينزاح مركز القدسية من النص إلى القارئ. هذا الاستحواذ يعني أن القارئ يعمل على "تكسير" بنية التعبير اللغوي للنص لتتوافق مع ما يدركه لسانياً، مما يؤدي إلى توسيع مساحة الاختلاف والخلاف في التأويل. إن هذا التحليل يربط نقل السلطة بتبادل مراكز القدسية، ويسلط الضوء على تأثير ذلك في "ثقافة الاختلاف". إن النزاع بين سلطة النص وسلطة القارئ هو الذي يشكل "محور وعماد عملية التأويل"، وأي توازن بينهما يؤدي إلى توازن في التأويل نفسه.
لقد كان الاستحواذ على سلطة النص من المؤلف إلى التابع نتيجة لثلاثة تحولات إبستمولوجية متكاملة: التحرير من القصد (موت المؤلف)، تأسيس النسق اللغوي كسلطة بديلة (البنيوية)، وتفعيل دور القارئ التاريخي والوجودي في عملية الإنتاج الدلالي (الهرمنيوطيقا والتلقي).
مع ذلك، فإن هذا الاستحواذ يطرح تحدياً مستمراً يتعلق بضبط النسبية التأويلية. إن الإصرار على وجود حدود للتأويل، كما دعا إيكو، يمثل محاولة لإبقاء الحوار مفتوحاً ومثمراً، بحيث لا يصبح النص مجرد مرآة تنعكس عليها أهواء القارئ. يجب على الدراسات الأكاديمية والفلسفية في السياق العربي أن تستمر في "الكشف عن تنازع السلطتين" في سياقاتها النصية الخاصة، خصوصاً في التعامل مع النصوص التي تحمل قدسية، وذلك لضمان التوازن بين الحرية المكتسبة للقارئ والضرورة اللغوية الموضوعية للنص. إن الاستحواذ الأمثل هو الذي يدرك قيوده ليتحول إلى عملية إبداعية مشتركة بدلاً من كونه هيمنة ذاتية مطلقة.
***
غالب المسعودي
.....................
المراجع
آل زعير، وضحاء بنت سعيد. البنيوية وسلطة النص الأدبي
تأويل القرآن سلطة القارئ أم سلطة النص (almutadaber.com).
عودة، ناظم. الفكر السائد يكرّس السلطة ويعزز الاستحواذ والهيمنة (Al Akhbar).
جماليات التلقي من أجل تأويل النص الأدبي (صحيفة المثقف).
هرمينوطيقا انصهار الآفاق عند هانز جورج غادامير (ديوان العرب).
(PDF) إشكالية المعنى بين سلطة المؤلف والقارئ (ResearchGate).
نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة: نظرية الأنساق المتعددة | مجلد 1 | صفحة 86 | الفصل الرابع مرجعيات نظرية (جامع الكتب الإسلامية).