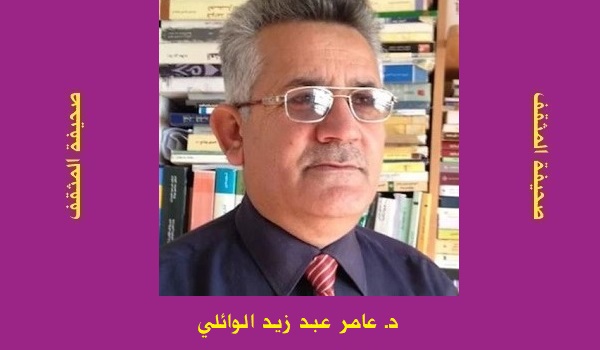أقلام فكرية
محمد أحمد عبيد: نسبية الحقيقة في الفلسفة السوفسطائيّة

تحليل أفكار بروتاجوراس وجورجياس
الملخص: تتناول هذه الدراسة فكر الشك السوفسطائي من خلال تحليل أفكار اثنين من أبرز المفكرين السوفسطائيين، وهما بروتاجوراس وجورجياس. وتشير الدراسة إلى أن الشك السوفسطائي يشكك في قدرة الإنسان على الوصول إلى معرفة ثابتة أو حقيقة مطلقة. فبروتاجوراس الذي قدم مقولة "الإنسان مقياس كل شيء"، يعتقد أن الحقيقة نسبية وتعتمد على إدراك الفرد لها وفقًا لتجاربه الشخصية، مما يعني أن الحقائق تتغير باختلاف الأشخاص والظروف. أما جورجياس فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أنكر وجود الأشياء تمامًا، معتبرًا أن الإنسان لا يستطيع معرفة أو نقل أي شيء بشكل حقيقي، مؤكداً أن الحواس تخدعنا واللغة لا تستطيع نقل الحقيقة الفعلية.
الكلمات المفتاحيّة: السوفسطائية، بروتاجوراس، جورجياس، الشك، الحقيقة.Abstract:
This study deals with the thought of Sophist skepticism by analyzing the ideas of two of the most prominent Sophist thinkers, Protagoras and Gorgias. The study indicates that Sophist skepticism questions the ability of man to reach fixed knowledge or absolute truth. Protagoras, who presented the saying "man is the measure of all things", believes that truth is relative and depends on the individual's perception of it according to his personal experiences, which means that facts change according to people and circumstances. As for Gorgias, he went further, as he denied the existence of things completely, considering that man cannot know or convey anything in a real way, stressing that the senses deceive us and language cannot convey the actual truth.
Keywords: Sophistry, Protagoras, Gorgias, skepticism, truth.
تمهيد:
لم يُعرف "الشك" كمذهب فلسفي له روّاده وأتباعه إلا في العصر اليوناني. بالطبع قبل هذا العصر كانت هناك آراء وأفكار شكيّة، لكنها كانت آراء فردية تخص بعض الأشخاص فقط، ولم تكن تشكل مذهبًا أو تيارًا فكريًا. على الرغم من أن الحضارات القديمة، مثل الحضارة المصرية والصينية والأشورية والبابليّة والهندية، قد تناولت قضايا تتعلق بالوجود والمعرفة، لم تكن هذه الحضارات تركز بشكل خاص على الشك كظاهرة معرفية أو فلسفية. كانت اهتمامات تلك الحضارات منصبّة أكثر على موضوعات مثل ماهية الكون، والموت، والحياة بعد الموت، ولم تُولِ الاهتمام الكافي بالقضايا المعرفية والنقدية التي تتعلق بالشك.
من المعروف أن الفلسفة كفكر نقدي ومنهجي بدأت بشكل جاد في اليونان. صحيح أنه كانت هناك بعض الآراء المتناثرة والحكم الشعبية والأساطير في حضارات أخرى، إلا أن هذه الآراء لم تُجمع في منظومة فكرية واحدة، ولم تُنظم في مذهب أو مدرسة فلسفية تدافع عنها كما حدث مع الفلاسفة اليونانيين. كما أن التدوين والتأريخ لم يكونا محطّ اهتمام في تلك الحضارات، على عكس ما كان عليه الحال في اليونان حيث نقلت لنا العديد من مدوناتهم الفلسفية، بما في ذلك أعمال فلاسفتهم التي تناولت قضايا المعرفة ومشكلاتها، والتي كانت الشك جزءًا أساسيًا منها.
حتى بدايات العصر اليوناني، كان الشك لا يزال يُعتبر مجرد آراء فردية ولم يكن قد أصبح مذهبًا فلسفيًا. فقد ظهرت آراء لبعض الفلاسفة اليونانيين قبل السوفسطائيين تدعو للشك، مثل قول هيراقليطس: "إن كل الأشياء في تغير مستمر، فأنت لا تنزل في النهر الواحد مرتين لأن مياهًا متجددة تجري من حولك باستمرار"(1)، وهو ما يعني نفيه لمعرفة الأشياء على وجه اليقين، نظرًا لأنها في تغير مستمر ولا يمكن الإلمام بها بشكل كامل. إلا أن الشك كحركة فلسفية منظمة لم يظهر قبل السوفسطائيين.
الشك يعبر عن حالة من التردد بين نقيضين، حيث لا يمكن للعقل البشري ترجيح أحدهما على الآخر، لوجود أسباب وجيهة لقبول كل منهما وأسباب وجيهة لرفضه. ويتصل الشك بنظرية المعرفة، حيث يفترض عدم قدرة العقل البشري على تحصيل المعرفة المطلقة في كل شيء.
ويمكننا تحديد أهم المصطلحات المتعلقة بالشك في هذا البحث على النحو التالي(2):
الجهل: وهو عدم إدراك المعلوم أصلًا.
الشك: وهو التردد بين النقيضين بلا مرجح.
الظن: وهو التردد بين النقيضين مع وجود مرجح، لكن لا يصل إلى حد اليقين.
اليقين: وهو الاعتقاد الجازم في الحقيقة.
وما يهم في هذا البحث هو "الشك المطلق" أو "الشك المذهبي"، الذي يُعتبر موضوعًا لذاته، وهو ما نتناوله هنا. وأهم رواده في العصر اليوناني كانوا السوفسطائيين، بقيادة كل من بروتاجوراس وجورجياس.
ويسعى هذا البحث للإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة:
ما هو الفرق بين الشك المنهجي الهادف والشك المذهبي الهادم؟
هل كان شك السوفسطائيين شكًا هادفًا؟
هل يمكن اعتبار الشك السوفسطائي سبيلًا سليمًا للوصول إلى المعرفة؟
الشك قبل السوفسطائية:
ظهر الشك لأول مرة في الحضارة اليونانية على شكل مقولات وآراء منسوبة إلى بعض الفلاسفة الذين عاشوا قبل عصر السوفسطائيين. ورغم أن هذه الآراء كانت شكية في بعض جوانبها، إلا أنها لم تُؤسس بعد كمنهج فلسفي واضح أو كتيار فكري مستقل. كان من بين هؤلاء الفلاسفة الذين كانت آراؤهم تميل إلى الشك، "أكسينوفان"، الفيلسوف اليوناني الذي وُلد في آسيا الصغرى واستقر في مدينة "إيليا" في جنوب إيطاليا، ويُنسَب إليه البعض تأسيس الفلسفة الإيليائية. كذلك "بارميندس"، الذي وُلد في إيليا بجنوب إيطاليا، وكان قد قدم إلى أثينا في سن الخامسة والستين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب "في طبيعة الأشياء". بالإضافة إلى "ميلسيوس" الذي لا تُعرف سنة ولادته أو وفاته بدقة، لكنه كان مشهورًا في الفترة بين 442 و441 ق.م.
ومع ذلك، يُعد هيراقليطس هو أشهر هؤلاء الفلاسفة الذين أظهروا آراء شكية تمهد لظهور مذهب الشك لاحقًا. فقد كان هيراقليطس يرى أن الحواس لا تكفي للوصول إلى الحقيقة، وأن الأشياء في جوهرها تخفي عنا حقيقتها. بالنسبة له، كانت الأشياء في حالة مستمرة من التغيير والصيرورة، وهو ما يتعارض مع الثبات أو اليقين في معرفتها. وقد قال هيراقليطس: "إن كل الأشياء في تغير مستمر، فأنت لا تنزل في النهر الواحد مرتين، لأن هناك مياهًا متجددة تجري من حولك باستمرار". وبالتالي يُعتبر هيراقليطس هو الجد الأول للفلسفة السوفسطائية "الشكية"، لأنه أنكر إمكانية المعرفة الثابتة، واعتبر أن كل شيء في حالة تغير دائم، مما يجعل من المستحيل معرفته على وجه اليقين(3).
وفيما يخص نقد أفكار هيراقليطس، نجد أنه كان يُقر بوجود قانون عام يُسمى "اللوغوس"، وهو ما يتناقض مع دعوته المستمرة للتغيير والعشوائية. فكيف يمكن أن يوجد قانون منظم في ظل العشوائية والتغير المستمر؟ إذن، رغم تأكيده على التغير الدائم، كانت أفكاره مليئة بالتناقضات التي مهدت الطريق للسوفسطائيين لتطوير مناهج شكية(4).
الشك عند بروتاجوراس:
يُعتبر بروتاجوراس (487 ق.م – 420 ق.م) من أبرز فلاسفة العصر السوفسطائي، وقد كان شخصية محورية في الفكر اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد ظهرت في عصره موجة من الشك، وكان بروتاجوراس هو قائدها الأكبر. تأثيره كان واضحًا في المجتمع اليوناني، حيث كان له تأثير قوي على رجال الحكم وعلى عامة الناس أكثر من المثقفين، مما أثار الكثير من الجدل حوله، كما كان أحد الأسباب الرئيسية في صدور حكم بإعدام سقراط(5).
إن السوفسطائية -التي تعني في الأصل "الحكمة" وكان السوفسطائيون يُعتبرون حكماء أو معلمين- تميزت بدعوتها إلى الشك والنسبية. كان السوفسطائيون يكسبون رزقهم من تعليم الشباب المهارات العملية والثقافية التي كانوا يظنون أنها ستساعدهم في حياتهم اليومية. ومع ذلك، سرعان ما ارتبطت السوفسطائية بالسلبية والتحقير، وذلك بسبب ممارساتها في الجدل والخداع. لم تكن الدولة تخصص أموالًا لتعليم السوفسطائيين، بل كانوا يوجهون خدماتهم لمن كان لديه القدرة على دفع أجورهم من الطبقة الأرستقراطية، مما أدى إلى تعزيز الفوارق الطبقية في المجتمع الإغريقي. كما كان من بين أدوارهم البارزة التلاعب بالكلمات وإلباس الباطل ثوب الحق، خاصة في ساحات القضاء مقابل أجر مادي(6).
لقد نشأت السوفسطائية في فترة كانت الديمقراطية هي النظام السائد في أثينا، وقد استفاد السوفسطائيون من هذا المناخ السياسي لتعزيز مكانتهم، حيث سعوا إلى تدريس الفنون البلاغية وتقديم الدعم للأطروحات المتناقضة في آن واحد. وقد ساعد على ظهورهم أيضًا تنوع الآراء حول موضوعات مثل الكون وتعدد الآلهة، مما عزز الشك في معرفة الحقائق المطلقة. كما كان من بين مذاهبهم مذهب "العندية" الذي يُنسب إلى بروتاجوراس، والذي يفيد بأن "الإنسان مقياس كل شيء"، أي أن الحقيقة ليست موضوعية بل هي نسبية وتختلف حسب الفرد(7).
ويُعد بروتاجوراس من أبرز دعاة النسبية في الفلسفة، حيث أكد على أن الحقائق ليست ثابتة أو مطلقة. إذ قال: "إن الإنسان مقياس كل شيء، فهو مقياس أن الأشياء الموجودة موجودة، وأن الأشياء غير الموجودة غير موجودة"(8).
وهذا القول يشير إلى أن الحقيقة ليست ثابتة أو مطلقة، بل تتغير وفقًا لرؤية الفرد. وبالتالي فقد اعتبر أن الحقيقة نسبية وتعتمد على الحواس والتجربة الشخصية، مما جعله يُسهم في بناء مذهب شكي قائم على النسبية.
تعقيب ونقد لفكر بروتاجوراس:
لقد وقع بروتاجوراس في مفارقة فلسفية حينما أرجع مصدر المعرفة إلى "الإحساس"، نظرًا لاختلاف الأفراد في سنهم وشعورهم وملكاتهم العقلية، مما يعني أن الحقيقة تصبح اعتبارية ونسبية حسب كل فرد. فعلى سبيل المثال، قد يشعر شخص بالهواء باردًا بينما يشعر به آخر حارًا، وما يعتبره البعض خيرًا قد يراه الآخرون شرًا. ونتيجة لذلك، أنكر بروتاجوراس وجود حقيقة ثابتة، واعتبر أن كل شيء نسبى وقابل للتغيير.
وبذلك، فإن هذا الموقف يطرح إشكالًا كبيرًا حول فكرة "الحق والباطل"، بل يجعل من الصعب تحديد الصواب من الخطأ.
وقد عارض فلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو أفكار بروتاجوراس، معتبرين إياها وهمًا وخداعًا، وخصوصًا في مجال الخطابة، حيث كانت أقواله تعد متطرفة وبلا أساس منطقي راسخ(9).
الشك عند جورجياس:
الشك عند جورجياس يمثل قمة التطرف في الفلسفة السوفسطائية، حيث يطرح قضايا شديدة التشكيك في الوجود والمعرفة. في كتابه "اللاوجود"، قدم جورجياس ثلاث قضايا رئيسية:
لا يوجد شيء: يشير إلى أن الموجودات لا وجود لها، واللاوجود أيضًا ليس موجودًا.
إذا وجد شيء فلا يمكن معرفته: حتى لو كان هناك شيء موجود، لا يمكننا معرفته أو إدراكه.
إذا أمكن إدراكه، لا يمكن نقله: حتى إذا تمكنا من معرفة شيء ما، فإنه لا يمكن نقله إلى الآخرين(10).
يستند جورجياس في هذه القضايا إلى حجج تركز على الطبيعة الغامضة للوجود وحقيقة الإدراك؛ فأولًا، يُجادل بأن الوجود إذا كان أزليًا، فإنه لا يمكن أن يكون له بداية أو مكان، مما يجعله متناقضًا مع مفهوم اللامتناهي. وإذا كان حادثًا، فلا يمكن أن يكون قد حدث من شيء غير موجود، مما يعني استحالة وجوده. ثانيًا، يُشير إلى أن الحواس تخدعنا وتعطي انطباعات غير حقيقية عن الواقع. ثالثًا، يؤكد على أن اللغة مجرد رموز إشاراتية لا تعكس الحقيقة الواقعية، وبالتالي لا يمكنها نقل المعرفة الحقيقية(11).
تعقيب ونقد على فلسفة جورجياس:
الفلسفة التي تبناها جورجياس قوبلت برد فعل سلبي من الأثينيين، حيث اعتُبرت مرفوضة أخلاقيًا. في كتاب "الجمهورية" لأفلاطون، يُظهر تراسيماكوس أن مذهب جورجياس يخرج عن القيم الأخلاقية لأنه ينفي وجود معيار موضوعي للعدالة. كذلك، إنكار جورجياس للوجود والمعرفة والحقيقة يقوض الأسس التي يعتمد عليها العلم والتاريخ. فمعرفة الإنسان اليومية وقدرته على نقل التجارب والمعارف عبر الأجيال تتناقض مع فكرته حول استحالة نقل المعرفة أو حتى وجود الأشياء.
بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن السوفسطائيين، رغم دورهم في إشعال الفكر الفلسفي والتوجه نحو المنطق، كانوا يمثلون خطرًا على تطور الفلسفة الغربية، لولا وجود سقراط الذي استطاع إنقاذ الفلسفة من هذا الاتجاه المدمر كما يشير الدكتور يوسف كرم(12).
رأي الباحث:
يرى الباحث أن مضمون الفلسفة السوفسطائية قد شهد رواجًا كبيرًا في عصرنا الحالي مقارنة بالعصور القديمة، فلو نظرنا إلى العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية التي نعيشها اليوم، سنلاحظ أن العديد من الأفكار التي طرحها السوفسطائيون حول نسبية الحقيقة وعدم وجود حقائق ثابتة، قد أصبحت جزءًا من التفكير السائد في المجتمعات المعاصرة. وفي الزمن القديم كانت هذه الآراء محلّ انتقاد شديد، خاصة من فلاسفة مثل سقراط وأفلاطون الذين اعتبروا أن الحقيقة مطلقة وثابتة، لا تتغير بتغير الأفراد أو الظروف. أما في العصر الحالي فقد نمت تلك الآراء على نحو لافت، إذ أصبحنا نشهد ظاهرة متزايدة من النقاشات التي تعتمد على إقناع الآخر بغض النظر عن صحة الحجة أو دقتها، بل فقط من خلال القدرة على التأثير والإقناع.
من جانب آخر، يرى الباحث أن السوفسطائيين قد ابتكروا مذهبًا لم يكن مرتبطًا بالدين أو الأخلاق، بل كان موجهًا بالأساس إلى فنون النقاش والجدال، وهذا يسلط الضوء على حقيقة هامة تتعلق بكيفية تفكيرهم في المعرفة والهدف منها. فالسوفسطائيون لم يكونوا مهتمين بإيجاد الحقيقة أو الوصول إلى مبادئ أخلاقية ثابتة، بل كانوا يؤمنون بأن الهدف هو القدرة على الإقناع والإفحام. وقد كان ما يهمهم أكثر من أي شيء آخر هو تعليم فنون الدفاع عن الآراء مهما كانت تلك الآراء صحيحة أو خاطئة. ومن هنا يمكننا أن نرى التشابه بين فلسفتهم وما يحدث اليوم في العديد من ميادين الحوار العام والسياسة والإعلام، حيث تكثر النقاشات التي تركز على الإقناع بدلًا من البحث عن الحقيقة الموضوعية أو تقديم أدلة دامغة تدعم المواقف.
إن السوفسطائيين كانوا يعلّمون تلاميذهم كيفية الدفاع عن آرائهم بغض النظر عن صحتها، فقط لأن الغاية كانت تكمن في إفحام الخصوم، وهو ما يعكس أيضًا المبدأ السوفسطائي الشهير بأن الحقيقة ليست مطلقة بل نسبية، ومصدرها هو الإنسان، وهذا يعكس واقعًا معاصرًا نعيشه في العديد من الحوارات الفكرية والاجتماعية اليوم. فكثيرًا ما نرى الأشخاص يتبنون آراءً معينة فقط لأنهم يرون في ذلك منفعة شخصية أو لتحقيق مصالح خاصة، دون أن يحرصوا على التحقق من صحة تلك الآراء أو فحصها بعناية. بل إن الغالبية باتت تعتمد على قدرتها على التأثير على الآخرين وتوجيههم بما يتناسب مع رغباتهم ومصالحهم، سواء كان ذلك في السياسة أو الاقتصاد أو حتى في الحياة اليومية.
كما يشير الباحث إلى أن السوفسطائيين قد عملوا على تعزيز فكرة أن الحقيقة تتغير تبعًا لمصالح الأفراد وأهوائهم، وهو ما يفتح الباب أمام تحليل أعمق لمفهوم الحقيقة في عالم اليوم، فالتغيير المستمر في الحقائق وفقًا للمصالح الشخصية يجعل كل شيء قابلًا للتفاوض والتعديل بما يتماشى مع رغبات الإنسان. وهنا نجد أنفسنا أمام واقع معقّد، حيث تزداد الأمور ضبابية ويفقد الناس الثقة في قدرة المعرفة على تقديم إجابات ثابتة وواضحة.
فالفلسفة السوفسطائية قد أثرت في سلوك الأفراد والمجتمعات المعاصرة، الذين أصبحوا يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة على حساب الحقائق الموضوعية، وهو ما يضعنا أمام تحديات كبيرة في كيفية الوصول إلى إجماع حقيقي في ظل هذه الظروف الفكرية المتغيرة.
الخاتمة
أولًا: النتائج:
من خلال ما سبق، يمكن استنتاج المبادئ العامة للشك السوفسطائي كالتالي:
أن الحواس وسيلة المعرفة وليس العقل: الحواس تختلف من شخص لآخر، مما يعني أن الحقائق تصبح نسبية وفردية، وبالتالي لا يمكن تحديد معيار ثابت للصواب والخطأ.
الاعتماد على مبدأ التناقض: من خلال إثبات صحة الرأي ونقيضه في نفس الوقت، مع التلاعب بالألفاظ والمغالطات، يسعى السوفسطائيون لإثارة الشكوك حول أي حقيقة ثابتة.
أهداف الشك السوفسطائي:
كسب المال: من خلال تعليم الشباب كيفية الدفاع عن المتهمين في المحاكم.
التسلية والسخرية: وإثبات عجز العقل البشري عن الوصول إلى الحقيقة.
بروتاجوراس: يعتبر أشهر الشخصيات السوفسطائية، وقد تميز شكه في جوانب عدة مثل الشك في الدين حيث رفض الدين الوثني والشك في المعرفة حيث قال عبارته الشهيرة "الإنسان مقياس كل شيء"، والتي تعني أن كل شخص هو من يحدد ما هو موجود أو غير موجود.
الفرق بين الشك المنهجي والشك المطلق:
الشك المطلق: هو مذهب يعتقد في أن كل شيء قابل للتشكيك، حتى الحقيقة نفسها. يعتبر الشك غاية في حد ذاته، ولا يسعى للوصول إلى اليقين، ويعتمد على الحواس والأدوات التي قد تكون غير موثوقة. يقول جورجياس إنه لا يمكن معرفة شيء، وحتى إذا أمكن معرفة شيء فلا يمكن نقله للآخرين. ويعتمد المشككون في هذا المذهب على حجج مثل "خداع الحواس" و"اختلاف آراء الناس" و"تعذر وجود براهين قاطعة".
الشك المنهجي: هو شك مؤقت يمر به الباحث عن الحقيقة في مسار البحث العلمي، يهدف للوصول إلى اليقين. استخدمه ديكارت في شكه المنهجي، حيث اعتبر أن الشك هو الوسيلة للوصول إلى الحقيقة المتينة، مشيرًا إلى ضرورة شك الباحث في كل شيء حتى الحواس نفسها التي قد تخدعنا. الشك هنا ليس غاية بحد ذاته، بل مرحلة ضرورية لفحص الأفكار والبحث عن أسس ثابتة لبناء المعرفة.
ثانيًا: التوصيات:
من المهم تعزيز القدرة على التفكير النقدي بين الأفراد، حيث يمكن للشك المنهجي أن يكون أداة فعّالة للوصول إلى اليقين.
يجب توعية الأفراد والطلاب بالفرق بين الشك المنهجي الذي يهدف إلى البحث عن الحقيقة وتطوير الفهم، والشك المطلق الذي يؤدي إلى الجمود الفكري والتشكيك في كل شيء بلا هدف.
رغم أن الشك السوفسطائي قد يؤدي إلى التشكيك في الحقائق الثابتة، إلا أن استخدامه لأساليب البلاغة والتلاعب بالألفاظ يمكن أن يكون مفيدًا في تطوير مهارات الخطابة والإقناع، فينبغي الاستفادة من هذه المهارات بشكل أخلاقي في المجال الإعلامي والتعليم.
بالنظر إلى أن الفلسفة السوفسطائية كان لها دور مهم في تطور الفكر الغربي، فإنه من المفيد مواصلة البحث في أفكار السوفسطائيين وكيفية تفاعلها مع الفلسفات المعاصرة، فقد تسهم هذه الدراسات في تقديم حلول لمشكلات العصر الحالي التي تتعلق بالمعرفة والمصداقية في المعلومات.
***
إعداد: محمد أحمد عبيد
كاتب وباحث دكتوراه في الفلسفة
.........................
قائمة المراجع
تاريخ الفلسفة القديمة، يوسف كرم، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1936م.
الشك – أسبابه وآثاره وعلاج الإسلام له، أحمد عسيري، موقع دراسات بحوث المعوقين.
الفلسفة اليونانية، أعلام وقضايا، الدكتور رضا الدقيقي، كلية أصول الدين بطنطا، 2018م.
التيارات الفكرية المعاصرة والحملة على الإسلام، محمد شيخاني، د.ت.ط.
تاريخ الفلسفة القديمة، يوسف كرم، مؤسسة هنداوي، 2014م.
(1) انظر: تاريخ الفلسفة القديمة، يوسف كرم، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1936م، ص 318.
(2) انظر: الشك – أسبابه وآثاره وعلاج الإسلام له، أحمد عسيري، موقع دراسات بحوث المعوقين، ص 18.
(3) انظر: الفلسفة اليونانية، أعلام وقضايا، الدكتور رضا الدقيقي، كلية أصول الدين بطنطا، 2018م، ص 137.
(4) انظر: الفلسفة اليونانية، أعلام وقضايا، الدكتور رضا الدقيقي، ص 137.
(5) انظر: التيارات الفكرية المعاصرة والحملة على الإسلام، محمد شيخاني، د.ت.ط، ص135 وما بعدها.
(6) انظر: الفلسفة اليونانية، أعلام وقضايا، الدكتور رضا الدقيقي، ص 138.
(7) انظر: الفلسفة اليونانية، أعلام وقضايا، الدكتور رضا الدقيقي، ص 138.
(8) انظر: الفلسفة اليونانية، أعلام وقضايا، الدكتور رضا الدقيقي، ص 138.
(9) انظر: الشك – أسبابه وآثاره وعلاج الإسلام له، أحمد عسيري، ص 22.
(10) انظر: تاريخ الفلسفة القديمة، يوسف كرم، مؤسسة هنداوي، 2014م، ص 61.
(11) انظر: تاريخ الفلسفة القديمة، يوسف كرم، ص 61.
(12) انظر: تاريخ الفلسفة القديمة، يوسف كرم، ص 62.