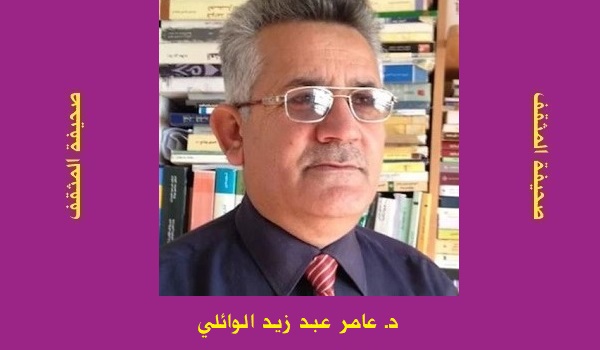قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: السيميولوجيا والأدب.. من العلامة إلى المعنى

بين التجربة العربية والغربية
منذ أن وضع فردينان دو سوسير أسس السيميولوجيا (Semiology) بوصفها "علم العلامات في حياة المجتمع"، وتطورت لاحقاً مع تشارلز ساندرس بيرس تحت مسمّى السيميوطيقا (Semiotics)، أصبح هذا العلم إطاراً تحليلياً مركزياً لفهم الأدب والفن واللغة. فالأدب، بصفته فعلاً لغوياً وجمالياً، لا ينفكّ عن كونه شبكة علامات تُحيل إلى معانٍ وتُنتج دلالات. وفي السياق العربي، ازداد الاهتمام بالسيميولوجيا منذ السبعينات، حين بدأ النقد العربي ينفتح على المناهج الغربية البنيوية وما بعدها، محاولاً استثمار هذا الجهاز النظري في قراءة النصوص الكلاسيكية والحديثة.
أولاً: السيميولوجيا بين النظرية الغربية والأفق العربي
١. في الفكر الغربي، سوسير أسّس لنظرية العلامة (Sign) بوصفها اتحاد دال (Signifier) ومدلول (Signified). هذا النموذج منح النقد الأدبي إمكانية مقاربة النص كنسق من العلاقات، لا كمجموعة معانٍ جاهزة.
رولان بارت وسّع مفهوم العلامة ليشمل الثقافة، معتبراً الأدب نظاماً دلالياً يضاعف المعنى عبر الأساطير والرموز والإيحاءات. في كتابه مبادئ في علم الأدلة ولذة النص، جعل من النص فضاءً مفتوحاً للقراءة والتفكيك.
أمبرتو إيكو نظر إلى الأدب كحقل مفتوح للقراءات الممكنة، حيث العلامات لا تتحدد بدلالة واحدة بل تُنتج "حقلاً دلالياً" يتجدد مع كل قارئ.
٢. في الفكر العربي:
مع دخول المناهج البنيوية والسيميائية إلى الجامعات العربية (خصوصاً في المغرب ومصر ولبنان)، بدأت تطبيقات على الشعر الجاهلي، الشعر الصوفي، والنصوص الحداثية.
صلاح فضل في كتبه مثل بلاغة الخطاب وعلم النص، حاول تكييف السيميولوجيا لتصبح أداة لفهم النص العربي في مستوياته الدلالية والجمالية.
يوسف وغليسي، عبد الملك مرتاض، وغيرهما اشتغلوا على السيميولوجيا في قراءة السرد العربي، معتبرين أن النص السردي شبكة علامات: الأسماء، الأمكنة، الأزمنة، والأحداث كلها علامات لها مستويات دلالية متراكبة.
ثانياً: علاقة السيميولوجيا بالأدب العربي
١. النص الشعري العربي:
الشعر العربي القديم، بما يحمله من صور وتشبيهات واستعارات، يتيح مجالاً خصباً للتحليل السيميائي. فمثلاً:
بيت المتنبي:
"إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ *** فلا تقنعْ بمـا دونَ النجـومِ"
يمكن قراءته سيميائياً باعتباره نظام علامات: النجوم هنا دالّ كوني على الرفعة والعلو، يتحول في السياق إلى مدلول رمزي على المجد والطموح.
وفي الشعر الصوفي (ابن الفارض، الحلاج، النفّري)، نجد علامات متراكبة: الخمر ليست مجرد سائل، بل رمز للمعرفة الإلهية والوجد الصوفي، مما يجعل النص فضاءً للتأويل السيميائي المتعدد.
٢. النص السردي العربي:
في ألف ليلة وليلة، تتحول الشخصيات (شهرزاد، شهريار) إلى علامات تتجاوز بعدها الحكائي لتصير رموزاً للسلطة والأنثى والمعرفة.
- في الرواية العربية الحديثة (نجيب محفوظ، الطيب صالح، إدوار الخراط)، يمكن النظر إلى المكان كشخصية سيميائية: القاهرة ليست مجرد فضاء جغرافي بل علامة دلالية على التوتر بين الحداثة والتقليد.
ثالثاً: علاقة السيميولوجيا بالأدب الغربي
١. النصوص الكلاسيكية
في الإلياذة والأوديسة، الأبطال (أخيل، أوديسيوس) علامات على قيم البطولة والمغامرة الإنسانية، فيما البحر علامة سيميائية على المجهول والمصير.
٢. النصوص الحديثة:
جيمس جويس في عوليس جعل النص متاهة علامات تحيل إلى الأساطير الكلاسيكية، الديانة، والواقع الاجتماعي لمدينة دبلن.
-فرانز كافكا في المسخ: شخصية غريغور تتحول إلى علامة وجودية كبرى، تجسد الاغتراب واللاجدوى.
- ت. س. إليوت في الأرض الخراب: النص شبكة من علامات ثقافية، تاريخية، ودينية تتفاعل لإنتاج معنى يعبّر عن الانهيار الروحي في الغرب الحديث.
رابعاً: البُعد الجمالي والرمزي
السيميولوجيا لا تقف عند حدود الوصف، بل تتجاوز إلى تحليل البنية الرمزية:
كل نص أدبي يقدّم طبقة أولى مباشرة من المعنى، وطبقات أخرى إيحائية تشتغل عبر الرموز الثقافية.
وظيفة الناقد السيميائي كشف هذه الطبقات، وإظهار كيف يُعيد النص تشكيل الواقع عبر شبكات علامات.
خامساً: شهادات وأفكار نقّاد
يقول رولان بارت: "النص شبكة من الاقتباسات، والكاتب ليس سوى ناسجٍ للعلامات".
يرى صلاح فضل أن "النص العربي لا يكتمل معناه إلا إذا أُخذ بوصفه نسقاً دلالياً متعدداً، يشتغل على مستويات: الصوت، الإيقاع، الصورة، الرمز".
ويؤكد أمبرتو إيكو أن الأدب يظل فضاءً لانهائياً لتوليد المعنى: "النص الجيد هو الذي يسمح بعدد أكبر من القراءات".
سادساً: نماذج تطبيقية
1. قصيدة السياب "أنشودة المطر":
المطر علامة طبيعية، لكنه يتحول إلى رمز للخصب والانبعاث.
العراق علامة مكانية، لكنه يتجسد رمزاً للوطن الممزق والمأمول.
- التحليل السيميائي يكشف كيف يتراكم البعد السياسي والميتافيزيقي في صورة المطر.
2. رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح:
شخصية مصطفى سعيد علامة على التوتر الحضاري بين الشرق والغرب.
- النيل علامة مزدوجة: طبيعة وحياة، لكنه أيضاً رمز للذاكرة الجماعية والهوية.
3. رواية "الحرافيش" لنجيب محفوظ:
الحارة علامة كبرى على المجتمع المصري بمرور العصور.
الشخصيات علامات أدوارية تُعاد صياغتها لتكشف جدلية القوة والضعف.
سابعاً: الخلاصة
إنّ علاقة السيميولوجيا بالأدب ليست علاقة منهج بالنص فقط، بل علاقة "علامة" بالوجود الإنساني ذاته. فالأدب العربي، من المعلقات إلى الرواية الحديثة، يتأسس على نسق إشاري متشابك يحتاج إلى عدسة سيميولوجية لفك رموزه. والأدب الغربي، من الملاحم الكلاسيكية إلى نصوص ما بعد الحداثة، يثبت أن العلامة هي اللغة العميقة للثقافة.
وعليه، فإن توظيف السيميولوجيا في النقد الأدبي العربي والغربي يكشف عن وحدة التجربة الإنسانية في إنتاج العلامات وتعدد طرائق قراءتها، ويمنحنا وعياً بأن النص الأدبي ليس مجرد كلام جميل، بل بنية من العلامات التي تحيا فينا وتعيد تشكيل وعينا بالعالم.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين