أقلام فكرية
فارديناند ألكييه: ماذا يعني "فهم فيلسوف"؟

بقلم: فارديناند ألكييه
ترجمة: عبد الوهاب البراهمي
***
" أودّ أن أحدثكم، هذا المساء عن موضوع عام جدّا: ما معنى فهم فيلسوف؟ يتطلب كل نوع من أنواع عمل الفكر فهما مخصوصا. ومن الواضح مثلا، أنّنا لا نفهم قصيدا شعريا مثلما نفهم لحنا لآلة مفردة، وأنّنا لا نفهم هذا اللحن مثلما نفهم لوحة، أو قاعدة رياضية. أقترح عليكم إذن تقديم بعض التأملات حول السمات الخاصّة لفهم الفلاسفة. علينا أن نلاحظ أولا أنّ عملا فلسفيا هو عمل للّغة، وللغة التعبيرية. قد يبدو هذا بَدَهًّيا، لكنه ليس كذلك تماما. لنفكّر مثلا، في أنّ قصيدة شعرية ليس لها من هدف سوى نقل حقيقة موجودة قبلها. يمكننا فعلا القبول بأن اللغة الشعرية تخلق، إن جاز القول، في روح القارئ، الحالة التي يستلهمها. وعلى العكس، لا أحد يضعه موضع شكّ، إذا ما كتبنا عملا فلسفيا، فذاك لأنّنا نريد التعبير وأن ننقل للقارئ حقيقة معينة، سابقة للعمل ذاته. من الضروريّ إذن، أمام العمل الفلسفي، تجاوز هذا العمل نحو هذه الحقيقة. لأجل ذلك يُطرح مشكلنا بالسؤال: أيّ نوع من الحقيقة يمكننا العثور عليه، أو أيّ نوع من الحقيقة يجب البحث عنه في أثر فلسفي، أو انطلاقا من أثر فلسفيّ؟
أعتقد أنّ هذا السؤال ليس عديم الأهمية. وإذا لم نتوصّل غالبا إلى فهم بعض الأعمال، فذاك لأنّنا لا نتساءل عن أيّ حقيقة تزعم هذه الأعمال نقلها أو إثارتها. يبدو أنّ الشعر، من هذا الجانب، موضوع سوء فهم مستمرّ. فالناس حينما يقفون أمام قصيدة لا يفهمونها، ولا يعرفون غالبا ما معنى قصيدة، وما تعني اللغة الخاصّة للقصيدة ويبحثون في اللغة الشعرية عن شيء آخر غير ما تحويه. ليس من اللازم أن يوجد سوء فهم مماثل في الفلسفة: يستوجب إذن معرفة أيّ نوع من الحقيقة يزعم أثر فلسفي التعبير عنه. بيد أنه، حينما، نكون قد تحدثنا مع شخص ما، وسمعناه، أجبناه: " مثلما فهمتني جيدا"، يمكننا أن نعني بهذا عدّة أشياء، التعبير عن عدّة أفكار مختلفة. يوجد مثلا،" فهمتني جيّدا" لرجل العلم، للرياضي. فذاك يعني بالتأكيد:" لقد فهمتَ ما أردتُ قوله". يتعلّق الفهم هنا بالحقيقة المعبّر عنها. أن نقول:" قد فهمتني" هو أن نقول:" لقد فهمت منطق الاستنتاج، وأدركت دقّة القانون". يوجد أيضا " لقد فهمت " التي للمرأة، وغير المفهومة إلى حدّ الآن. لستُ بحاجة أن أقول لك بأنه ليس نفس الشيء. بما أنّ، ما يجب فهمه هنا، ليس حقيقة لاشخصية بل الكائن ذاته هو الذي على المحكّ، أناه الخاص، بسيكولوجيته. وما يجب بالتالي أن نتساءل عنه أولا، في أيّ من هذين المعنيين (وسنرى أنه لا في هذا ولا في ذاك)، يجب فهم فيلسوف، هل كما نفهم رياضيا أو كما يريد كائن بشري التعبير عن حالة وجدانية شخصية. لقد قلت لكم، بالطبع لا في هذا المعنى ولا في الآخر. أوّلا، ليس في المعنى الذي نفهمه فيه رياضيا. من اليقين حتى نفهم فيلسوفا فلابدّ أولا من فهم ما يقصد بقوله، ولا أريد أن أنكر ذلك، لكن ليس لحقيقة فلسفية بالتأكيد، الطابع اللاشخصي لحقيقة رياضية. ولكي نقتنع بذلك، أعتقد أنه يكفي أن نفكّر فيما يكون لنا جميعا في الفكر حينما نقول بأنّنا نفهم أوقليدس، مثلا. فحينما أفهم قضية هندسية اوقليدية، فليس لي الانطباع بأني أفهم اوقليدس، فهو إمّا بواسطة ذكرى وفية، حتى أحيل إلى من اكتشف أو صاغ الحقائق التي أفهمها، وإمّا، منذ أن نقول بأننا نعرف أنه توجد هندسات أخرى غير هندسة أوقليدس، هندسة ريمان مثلا، حتى أقول أني أتموقع ضمن نسق مرجعيات معيّن وضمن مصادرات تكوّن بالتحديد هندسة أوقليدس. لكننا يمكن أن نشير بوضوح إلى هذا النسق بحرف، ونقول هندسة " أ "، أو هندسة "ب" أو " س"؛ فذاك يعني نفس الشيء. إنّ فهم العلوم، وحقائق العلم ليست فهم العلماء الذين اكتشفوها، ولأجل ذلك، فإنّ تاريخ العلوم ليس ضروريا للعلم؛ يمكننا فعلا أن نشتغل بالعلم دون الاشتغال بتاريخ العلوم، و، إذا اشتغلنا بتاريخ العلوم، فنحن نقوم بالتأكيد بشيء آخر غير العلم. بل نحن نتناول في الواقع، تخصّصا فلسفيا، بما أنّنا نبحث كيف أن فكر رجل العلم قد ارتقى إلى هذه الحقيقة أو تلك. وعلى العكس، فلكي نفهم فلسفة ديكارت أو فلسفة كانط، يجب بالضرورة فهم ديكارت وفهم كانط. أعتقد أن هذا المثال يبيّن أننا بفهم أوقليدس وبفهمنا ديكارت لا نستدعي نفس الجنس من الفهم. هل يعني هذا القول بأنه لابدّ من الرجوع إلى المعنى الثاني لكلمة فهم، والإقرار بأنه يجب فهم ديكارت كفرد، وبوصفه إنسانا عاش في مرحلة ما، وكان له هذه الخصوصية البسيكولوجية أو تلك؟ أعتقد أنّ دراسةَ مثل هذه ليست بالتأكيد عقيمة بل هي من وجوه كثيرة ذات أهمية قصوى، وسأستشهد بمثال أو اثنين على هذه الأهمية. لكن ليست هذه الدراسة هي ما يجعلنا نفهم فيلسوفا، وما سيسمح لنا بفهم ديكارت بوصفه فيلسوفا. أعتقد يقينا، أنه من الصعب الفصل بين التجربة الفلسفية لديكارت، ولكانط أو لسبينوزا وبين تجربتهم الوجدانية، وبين تجربتهم الشاملة. لا يتردّد سبينوزا كما تعرفون، في بداية كتابه" في إصلاح الذهن" في أن يقول لنا في أنه لم يصبح فيلسوفا إلاّ لأنه وجد نفسه في أزمة أخلاقية؛ ويفسّر لنا أصل فلسفته بواسطة صعوبات عاشها. ولا يتردّد ديكارت بالمرة في أن يرسم لنا حكاية فكره؛ وأنه إذ يروي لنا هذه الحكاية، فإنه بالتأكيد يقدّر أنها قد تسلط ضوءا على فلسفته بالذات. ولكن لا يزال فهم فلسفة ما يتجاوز بسيكولوجيا مؤلفها. ويبدو لي أنه ممّا لا يقبل الشكّ أنّ الخوف من الخداع، وأن يخدع من إنسان آخر، هو أساسي عند ديكارت. ولكن ماذا يمكننا أن نفسر بهذا؟ يفسّر هذا الخوف، في التأمل الأوّل، بأن ديكارت يحدّثنا عن الحواس بوصفها خادعا وجدانيا. ومن الغريب جدا أنه يحدثنا عن الحواسّ بوصفها ملكات غير يقينية، وهو ما سيكون عاديا، بل ككائنات قد تؤدي به إلى الخطأ. لأجل هذا، فيما بعد، في نهاية التأمل الأوّل، يمكن للشيطان الماكر أن يتقبّل، إن جاز لي القول، خاصية الخداع التي للحواس بوصفه شخصا حقيقيّا. تفسّر أيضا الطبيعة الخاصة للخداع التي يخشاها أن ديكارت التجأ إلى الحقيقة الإلهية: فلم يتخلص تماما من شكّه إلاّ بوضع علاقة بينذاتية لوعيه بوعي الإله، الذي يكلّمه بلغة لن تكون كاذبة. لكن بعد كل هذا الذي قيل، وهذا السمات التي فُسٍّرت بسيكولوجيا (إذ يمكننا، إن شئنا، البحث عن مبررات طبيعة هذه المباحث، واكتشافها في طفولة ديكارت، في خوفه من أن يكون قد خُدع، في إحباط الخ.)، يظلّ أننا، في تسليط الضوء على مثل هذه السببية، لم نفسّر في الواقع، فلسفة ديكارت، أي حقيقة " التأمل الأول". إذ يتعلق الأمر دوما بمعرفة ما إذا كان التأمل الأول صالحا، أي معرفة ما إذا كانت مبررات الشك التي يقدمها هي مبررات حسنة أو سيئة. ويتعلق الأمر، بإتباع هذه المبررات، أن يقنعنا ديكارت وليست المعرفة بسيكولوجيا بديكارت التي يمكن أن تساعدنا على التقدّم في هذا الاتجاه. سأضرب مثلا آخر أيضا من ديكارت. يقول ديكارت في التأمل الثاني، بأنه، وهو يُطلّ من النافذة ويرى المارّة، قد يخطأ، إذ ماذا يرى، غير معاطف وقبّعات يمكن أن تغطّي بشرا مزيّفين وأشباحا تحرّكها آلات تحكّم ؟ ولا أعتقد أنه غير قابل للإنكار، فيما يخصّني(لكن يمكن أن نتفق مع هذا الرأي)، أنه إذا ما أردنا فهم اختيار هذا المثال، وإذا ما أردنا فهم طبيعة هذا المبحث، يجب أن يتدخّل اضطرابٌ ما في إدراك ديكارت للواقع، اضطراب نرى له تمظهرات أخرى لديه، وبالخصوص حينما كتب ديكارت عام 1631، أنه يتجوّل في المدينة كما لو كان يتجوّل في الغابة، وان المحادثات التي يسمعها تبدو له كما لو كانت صخب ينابيع المياه أو الريح في الأشجار. توجد فعلا صعوبة في إدراك الآخر كآخر، صعوبة أراها أساسية لدى ديكارت؛ وأعتقد أنه حينما يتساءل إذا ما كانت المعاطف التي يراها تغطي بشرا مزيفين يتحركون بأجهزة تحكّم، فإن بسيكولوجيا ديكارت في خطر. لكن لستُ في حاجة إلى أن أقول لكم إنّه حينما أشرنا إلى هذا، فنحن لم نتقدّم قيد أنملة في فهم قوة الحجة لدى ديكارت ! فما يريد أن يبيّنه ديكارت هو أنّ كل إدراكٍ حُكْمٌ؛ ويبيّنه بطريقة رائعة، بما أنه يقرّ، لا، كما زعمنا، ما يمكن العثور عليه، داخل الإدراك بالذات، حكما قد يحصل لوعينا الخاص، بل إني إذن أحكمُ بما يمكنني أن أرتكب من أخطاء في رؤية أناس، إذ لا يمكن أن يوجد خطأ إلا في الحكم. وبالإمكان، وهو كل ما يقرّه ديكارت، أن هذه المعاطف وهذه القبعات تغطّي خيالاتٍ لبشر تحركها أجهزة تحكم. وقد يقال إنه لا يوجد، من أجل ذلك، إمكانية من ألف، وربما أقلّ أيضا، وأنه توجد إمكانية ضئيلة حتى نقوم بالتجوّل مع أناس آليين (إذ هذا ما نفكّر فيه) في الطريق وحيث يقيم ديكارت، بعدما ألبسناهم معاطف وقبعات. ولكن في النهاية ليس هذا من المستحيل منطقيّا؛ وهذا وحده ما يؤكّد أنه " برؤيتنا" أناس، يمكنني رؤية شيء ليس من قبيل الإنسان، وهذا يعني إذن أن الإدراك هو الحكم. وفي الحقيقة، فإنّ التفسير بأسباب بسيكولوجية (بل وكلّ تفسير بسيكولوجي هو تفسير بالأسباب) يحوّل الحقيقة الفلسفية إلى مجرد واقعة محدّدة من وقائع أخرى، وينكر إذن الحقيقة الفلسفية بما هي كذلك، وبالتالي لا يفهمها. نفسّر بسيكولوجيا خطأ ما، وليس فكرة؛ نفسّر بسيكولوجيا بأنّ إنسانا قد أصبح فيلسوفا أو عالم أحياء، لكن لا نفسّر أنه قد وُجد، في الفلسفة أو البيولوجيا، فعلا هذا الاكتشاف أو ذاك وأنه قد بلغ الحقيقة. ترون إذن بأنّ، فهم فيلسوف ليس، فهم الحقيقة اللاشخصية بمثل الحقيقة الرياضية التي يقولها، ولا فهم خصوصيته المجردة البسيكولوجية. فماذا يعني فهم فيلسوف، وهل يوجد فهم آخر غير هذين الضربين من الفهم ؟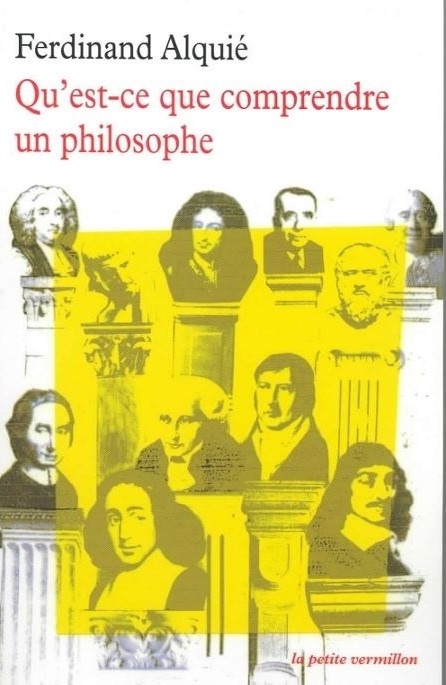
تلك هي النقطة التي وصلنا إليها الآن. تقودنا الصعوبات السابقة إلى التفكير بأنّ الحقيقة الفلسفية ستكون لها منزلة خاصّة جدّا. فلن يكون لها، لا حياديةَ حقيقةٍ علميةٍ ولا الطابع الشخصي الذي للطبعٍ. ولكي ندقق هذا، ونتأمله بوضوح أكثر، فلنلتفت الآن نحو الفلاسفة ذواتهم، ونتساءل كيف أرادوا أن يُفهموا، أو كيف اشتكوا من عدم فهمهم. بيد أنّه يبدو لي التعارض بين مبحثين، يستجيبان لمفهومين من التعارض المشار إليه، مبحثان يمكننا استنباطهما من دراسة سقراط كما ديكارت أو كانط، باركلي أو أي فيلسوف آخر: من جهة مبحث عزلة الفيلسوف، ومبحث الطابع الكوني للحقيقة التي يفصح عنها من جهة أخرى. توجد كونيةُ عزلةٍ، ويبدو لي أنها للفيلسوف وفي هذا تكمن كل مأساته. ليست الحقيقة لا شخصية بل هي كونية. إنّ ما يشكّل صعوبة في كلامنا بالتحديد، هو فهم ماذا تعني كونية شخصية، شيء لا يدركه أغلب البشر، إذ اعتادوا إمّا على العلم، حيث تكون الكونية تحديدا لاشخصية، أو حقائق بسيكولوجية هي شخصية، لكنها شخصية لكونها خاصّة. بيد أن ما يجب علينا اكتشافه، هو كونية ذاتية. توجد كما قلت، عزلة الفيلسوف. فإذا ما وَضع الفيلسوف موضع السؤال العالَمَ، ردّه عليه العالمُ فعلا. كلّ منّا يعرف أنّ ديكارت، وكانط وباركلي اشتكوا باستمرار من عدم فهمهم. يكفي قراءة مراسلات ديكارت أو ردوده على الاعتراضات عليه، بعد " تأملاته"، ويكفي التذكير بردود فعل كانط بعد النسخة الأولى من " نقد العقل المحض" حتى نقتنع بذلك. لكن، لنفهم جيدا ماذا تعني مأساة الفيلسوف. من دون شكّ، فالإحساس بعدم فهمه لا يخصّ الفيلسوف وحده، فالشعراء يشعرون أكثر بعدم فهمهم؛ توجد عزلة الشعراء. بيد أنها تبدو جدّ مختلفة عن عزلة الفلاسفة. فليست مأساة الفيلسوف اكتشاف الذات لحالة أنفس نادرة لا يشعر بها آخرون. بل إنّ مأساة الفيلسوف هي مأساة إنسان يعرف أنه حامل لحقائق كونية، ويكتشف أنه لا يستطيع مشاركة هذه الحقائق مع آخرين، بالرغم من إقراره ببداهتها. عام 1630، أي اللحظة التي أتمّ فيها ديكارت وضع نظريته المشهورة في إبداع الحقائق الأبدية، كتب ديكارت إلى الأب مارسان جملة تبدو لي مميّزة تماما في هذا الصدد. يصرّح ديكارت، من جهة، بأنه قد عثر على وسيلة للبرهنة على الحقائق الميتافيزيقية بطريقة أكثر بداهة من الحقائق الرياضية، وسرعان ما يضيف " لكن لا أعرف ما إذا كنت استطيع إقناع الآخرين". يبدو لي أنه، لو فكّرنا في هذا الإقرار المزدوج، فسنجد فيه كلّ معطيات المشكل: بداهة أسمى من كل بداهة أخرى، بما أن ديكارت ذهب إلى حدّ القول بأنها أسمى من البداهة الرياضية، بداهة كونية من جهة الحقّ، بداهة يتساءل بشأنها هل تكون مجهولة من الجميع. بيد أنّ عدم الفهم هذا للفيلسوف من وسَطه يُعبّر عنه في مسار التاريخ بألف طريقة وطريقة، وتبدو لي دهشة الفيلسوف من عدم فهمه هي المنبع بالذات لكلّ الفلسفة الغربية، في معنى أنّ الفلسفة الغربية قد تكون ناشئة من دهشة أفلاطون أمام واقعة الحكم على سقراط بالإعدام، ومن أنه لم يُفهم. لماذا حُكم على هذا الرجل الذي لم يكن له أعداء، ولا يُلحق أحدا بأذى، ولا يُبدي أيّ دغمائية، ويساعد الناس على التعرف على ذواتهم، ويكتفي فحسب بإلحاق العلم الفيزيائي حتى بالفكر الذي صنع العلم الفيزيائي، لماذا حَكَمت عليه المدينة بالإعدام؟ نشعر فعلا حينما نقرأ لأفلاطون، أنّ هناك فضيحة حقيقيّة بالنسبة إليه: موت سقراط. لكنني لا أقول بشأن هذه الفضيحة أنه لم يوجد دوما نفس العنف إلاّ في حالة سقراط، بل يوجد دوما، من حيث أنّ الفيلسوف يندهش ويظلّ مطابقا لفكرة كون الحقائق التي يرى أنه ينفيها هي الحقائق التي تبدو له من الواجب أن تُفرض على كل معرفة نزيهة. مثلا، هذه الحقيقة: الفكر الذي يصنع العلم أرقى من العلم الذي يصنعه، وليس للعلم من معنى إلاّ بالنسبة لصانعه. هذه حقيقة لا نرى كيف يمكننا الشك فيها، لو فهمناها جيّدا. ومع ذلك نراها في الواقع مجهولة باستمرار بل ننفيها بعنف. إذن، توجد عزلة الفيلسوف، وهي عزلة الكونية. ليست عزلة العلم عزلة كونية، إنها كونية محظوظة، حتى عندما تكون غير مفهومة من الجميع، تحظى بالانتشار بين الناس، وتجعلهم يعترفون بها. هنا، على العكس، لنا نمط من الحقيقة وحيد، في ذات الوقت الذي هو كوني، وبموجب هذا تحديدا، كما سنرى بشكل أفضل فيما بعد، تكون هذه الحقيقة مرتبطة بشخص معيّن، وغير قابلة للانفصال عنه. أعتقد أيضا أنّ هذه العزلة للفيلسوف هي بالخصوص خطيرة، في عصرنا وها هو لماذا. وهو أنه، بينما كانت هذه العزلة بسيطة صارت الآن مضاعفة؛ فلم تعد عزلة فحسب أمام التاريخ، بل هي أيضا عزلة أمام فكرة التاريخ. إنّ المجتمع والتاريخ يبدوان دوما بالنسبة إلى الفيلسوف الكلاسيكي، كوقائع عرضية. إلاّ انه، في الواقع، يقابل الفيلسوف دوما الحقّ، والتحوّل بالأبدي. إلى هذا الحدّ كلّ شيء واضح، الفيلسوف مهزوم بحكم الواقع والزمن، لكن ليس له ما يشكو منه، بما انه اختار الواقع ضدّ الزمن، وبهذا هو فيلسوف. يدمّر التاريخ إذن الفيلسوف دون أن يلغيه. ألحّ على ذلك، رغم انّه يبدو بديهيّ. ذلك أنه،مع الأسف، حاليا ليس بديهيا. من الواضح أنه، مثلا، لم يعتبر أفلاطون أبدا بأنّ إدانة سقراط قد ألغت سقراط. ولأجل هذا، وبالرغم من التساؤل باندهاش عن مبرر الحكم على سقراط بالإعدام، لم يذهب إلى حدّ التساؤل عما إذا كان سقراط على باطل، بحكم كونه قد أُدِين. ولأجل هذا وصف أفلاطون " المدينة الفاضلة"، مضيفا انه لا يعرف ما إذا كان بالإمكان وجود مثل هذه المدينة، لكنه يعرف حقا بأن الحكيم لن يقبل حكم مدينة أخرى غير هذه. هنا، كلّ شيء واضح، وانه، إذا ما وجد تراجيدي، فإنه تراجيدي واضح. يوجد، من جهة، أولئك، الذين يريدون فهم الفلاسفة ويكرهون التاريخ أو يعتبرونه بمثابة وقائع متتالية، ويوجد أولئك الذين يريدون فهم التاريخ وسير العالم، ويكرهون الفيلسوف. وهؤلاء أكثر عددا، لكن لهم إلى حدّ هيجل، على الأقل الفضل في عدم الرغبة في أن يكونوا فلاسفة أكثر من الفيلسوف نفسه. نحن نعرف أننا لم نعد في هذه الحالة. فليس تاريخ الوقائع فحسب هو ما يمنع اليوم من فهم الفيلسوف، بل أيضا فكرة التاريخ بوصفه حقّا أو قيمة. إنّ أسباب هذا التحوّل عديدة، وليس لي من السذاجة حتى أفكّر بأن هيجل هو وحده المسئول عن ذلك. أعتقد أنه من بين الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية، هو أنه، يجب، في بِنْيِة الدول الحديثة، أن يشارك الشعب في الشؤون السياسية: أصبحت الدعاية إذن ضرورة. ففي حكم لويس الرابع عشر يمكن لباسكال أن يكتب بأنه يجب أن نحيي الملك لأنه يقود أناسا يحملون حِرابا. كل شيء إذن قويّ وواضح؛ فإذا لم نحيّي رمينا بالرمح. يفصل باسكال بهذا بين نظامين، نظام قويّ في الواقع، ونظام ما هو محترم من جهة الحقّ. راهنا، لا يبدو هذا الفصل ممكنا. فهو لا يبدو ممكنا لأنّ الديمقراطية (التي لا أزعم أنني أحكم هنا مؤكّدا على جوانبها الحسنة والسيئة) تجبر السلطة على توسّل الانخراط الجامع. وبالتالي، على تلوين الأفكار، بقيم ومصائر ملموسة. ومهما يكن من أمر، فإنّ أغلب الفلاسفة أو المثقفين الحديثين يريدون في الآن نفسه فهم التاريخ والفلسفة. فهم لا يريدون الاختيار بينهما. ومن هنا، بما أنه محتّم، فهم يضحّون بالفلسفة من أجل التاريخ، إذ لا أرى أبدا إمكان فهم الاثنين معا، أو على الأقلّ في ذات اللحظة. وإذا ما شئنا فهم الفلسفة والتاريخ في نفس الوقت، فسيؤدّي بنا ذلك إلى فهم الفلسفة بواسطة التاريخ، أي وضع الفلسفة في التاريخ، وهو ما يعني عدم فهمها. نجد هنا، بالفعل درجة من الدقّة أكبر، ضربا من الفهم غير القابل للفهم، شبيها بذاك الذي أشرنا إليه منذ قليل، في تفسير الفلاسفة بواسطة الأسباب البسيكولوجية. أود الحديث عن الفهم الهيجلي. ولا أريد هنا إطلاقا الحكم على فلسفة هيجل في كليتها، ولا أعتبر هذه الفلسفة وخاصة تبعاتها، إلا من حيث أنها تزعم فهم فلاسفة الماضي بطريقة جديدة. بيد أنه، ليست فلسفة هيجل، بهذا الإجراء، التاريخ الذي يسجن الفيلسوف، بل فكرة التاريخ محيطةٌ، إن جاز التعبير، بفكرة الفلسفة. فهيجل على قناعة بأنّ كل فكر معبّر عنه فعليّا هو لحظة من التاريخ. ويتساءل كانط كيف يكون العلم ممكنا. ويتساءل هيجل كيف توصّل كانط إلى طرح هذا السؤال. وكيف ارتقى إلى مستوى الوعي الترنسندنتالي؟ يتساءل هيجل كيف توصّل كانط إلى الوعي الإشرافي أو الترنسندنتالي. تُمثّل الأخلاق، كما يقول هيجل، لحظة أخلاقية، تصبح مجرد لحظة تاريخية. ولن ننتهي من تعداد نتائج هذه الفكرة، سواء في فلسفة هيجل، أو في فلسفة ماركس. من هنا يبدأ تاريخ كل الجهود لفهم الفلاسفة بربطهم بزمانهم، ببيئتهم الاجتماعية، وبالطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو يعبرون عنها، وبالاقتصاد الخ. إنّ ما أريد إقراره ببساطة، هو أنّه، في كل هذه الحالات، لا نفهم الفيلسوف، وذلك من حيث أننا نرفض الاستماع لندائه. هذا النداء كما قلت سابقا هو نداء إنسان يشعر أنه وحيدا لكنه يشعر بأنّ عزلته هي عزلةَ حقيقةٍ كونية. فيدعو إذن، باسم هذه الحقيقة الكونية، شبيهَهُ. وهذا الشبيه بالتحديد هو ما يجب أن نبذل جهدا حتى نَكُونَهُ، إذا ما أردنا فهم الفيلسوف. بيد أن التفسير الهيجلي الذي قد عرفته أو أيضا التفسير الماركسي للفلسفة، هو بالتحديد التفسير الذي يقطع هذه العلاقة بالأشباه، ذلك الذي يجعلها مستحيلة، والذي يلغي، بهذا بالذات، ما هو في رأيي ماهية الفلسفة ذاتها، أي الحوار. لقد عبّر أفلاطون بوصفه أب الفلسفة الغربية، بواسطة المحاورات. وكتب مالبرانش محاورات وباركلي كذلك. غير أنّ المحاورة، هي دوما دعوة للآخر بوصفه شبيها. تفترض المحاورة دوما ذاتين واعيتين لهما أرضية مشتركة. لننظر في باركلي، حتى نختار هنا محاورات أكثر معاصرة من محاورات أفلاطون. يفترض " فيلونوس" Philonous دائما أنّ إيلاصHylas الذي يحاوره، وبرغم اختلاف منطلقاتهما، له وعي شبيه بوعيه؛ وان المعيار الأسمى، ليس برهانا قوليا، وليس خطابا، وليس تأليفا جدليا، بل هو موافقة الوعي الآخرَ. يقول فيلونوس لألياص:" تعتقد أنه توجد مادّة. ربما كنتَ على حقّ. ولكن ماذا تفهم من ذلك؟" وفي كلّ مرّة يقول فيها ألياص:" أعني بذلك هذا أو ذاك "، يجيبه فيلونوس:" ألا ترى أنّ ما تسميّه مادّة هي فكرة لعقلك؟". يوجد في كل هذه الحالات تساوي العقول، تماثل الذوات ويمكننا أن نتوجّه إذن نحو هذه الجمهورية للعقول، التي يتطلع إليها كلّ فيلسوف بما أن فضيحة كلّ فيلسوف وما يحركه ويزعجه ويألمه ويحبطه هي عزلة عقله الخاص، أي كون هذه الحقائق التي يشعر أنها كونية ليست مفهومة من آخرين سواه. بيد أنه تحديدا مع هيجل، وأكثر أيضا مع أولئك اتبعوه، لا يوجد شبيه. لاوجود لشبيه لسببين. أولا، إذا كان كلّ فيلسوف هو لحظة من التاريخ، والفلسفة هي نتاج بيئة معينة، فها أنّ الفلاسفة بعدُ متفرقين عن بعضهم بعض. كلٌّ يعبّر عن زمانه وليس وعيَه نقطة مرجعيه أخيرة لما يريد قوله. لكن ها هو شيء أخطرَ، انفصال الفيلسوف عمّن يريد فهمه، عمن يزعم فهمه، إذ الفيلسوف هو الذي يفهم الفيلسوف الآخر، أي أن الفيلسوف الهيجلي والفيلسوف الماركسي، يؤكّد ذاته تحديدا بوصفه أرفع من الفيلسوف المفهوم؛ فالفيلسوف المفهوم هو لحظة من التاريخ، أو نتاج اجتماعي معين، بينما الفيلسوف الذي يَفهم، فهو وعي التاريخ، هو من يعرف ما يعني التاريخ. ومن ثمّ، فإنّ كل الأسئلة المطروحة من الفيلسوف الذي نفهمه أسئلة فقدت قيمتها، بقدر الأجوبة التي اعتقد وجوب إنجازه لها. هل يجهد باركلي نفسه حقا في معرفة ماهية المادّة وهل يجد نفسه مكرها على الاعتراف أنه لا يقدر على الوصول إلى تكوين فكرة عن شيء لن يكون فكرة للعقل، فنجيبه بأنّ السؤال المطروح ليس عن معرفة هل توجد مادّة، وان السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو معرفة لماذا يطرح على نفسه سؤالا مماثلا. بيد أنه، قد يزعم أنه يطرح هذا السؤال لأنّ وعيه يترجم هذه اللحظة أو تلك من التاريخ. وبعبارة أخرى، يبدو أكثر فطنة في هذا المنهج، التساؤل لماذا يطرح الناس أسئلة بدل أجوبة على ما يسمّى أسئلة، لأجل هذا، أعتقد أنّ تلاميذ هيجل هم غالبا فلاسفة الكراهية، فلاسفة يكرهون أمثالهم. ذلك أنه لابدّ من الإجابة على كلّ الأسئلة، ولا يجب ترك الفيلسوف في وضعية غير مقبولة عرفناها جميعا عندما كنا أطفالا، عندما كنا نجيب على الأسئلة بهزّ الكتفين، ونقول لأنفسنا بأنّ الكبار لا يطرحون على أنفسهم أسئلة غبيّة جدّا. وبالفعل، فللفيلسوف شيء من الطفولة. يطرح أسئلة يمكن اعتبارها فعلا كأسئلة غبية أو بوصفها، على أيّ حال، عديمة الجدوى. والفيلسوف يعرف جيّدا بأننا إن لم نجب على أسئلته، فليس ذاك لأن الناس الجدّيين لهم ما يشغلهم، ولهم شيء آخر يفعلونه غير التساؤل عما هو الكائن، أو إذا كانت المادة موجودة في ذاتها؛ ولهم ما ينشغلون به من الفيزياء والسياسة وألف شيء آخر من هذا القبيل. يعرف الفيلسوف جيّدا بأنه، إذا لم نجب على أسئلته، فذاك لأننا لا نعرف أيضا الجواب عليها. يظلّ سؤاله إذن، وهو غير مفهوم، مطروحا وغير قابل للحلّ. ألخّص ما قلت. لقد بينت بأنّ فهم الفيلسوف ليس من نوع فهم الرياضي أو العلمي، وأنه ليس من نوع بسيكولوجي، وأنه ليس من نوع تاريخيّ، وانه يجب أن يلحق بضرب من الكونية، بضرب من الشخصية؛ وانه يجب أن يكون فهما ذي كونية شخصية، أو كونيةَ شخصيةٍ كونية كما تشاءون. لكن ألا ننتهي، هذه المرّة، إلى دراسة نسق كلّ فيلسوف، أي بجعل تاريخ الفلسفة، تاريخ أنساق ؟
هنا نجد فعلا تاريخ الفلسفة، بالمعنى المعروف والأكثر كلاسيكية لهذه الكلمة. من البَدَهِي أنّ هذه الدراسة لها مطلق المشروعية، وأنتم تسيئون فهمي كثيرا بالاعتقاد بأنّ أودّ اتهامها أو إقصاءها. إنها نقطة الانطلاق الضرورية. إنه لا جدال فيه بأن كلّ جزء فلسفي ليس له من معنى إلاّ بالنسبة إلى المجموع المنطقي الذي ينتمي إليه، وانه بالتالي، لا يمكن له أن يفهم إلاّ في مستوى النسق الذي يشترك معه. لا أحد يستطيع أن ينكر أنه من الضروري فهم نسق كانط حتى نفهم كانط، وفهم نسق سبينوزا لفهم سبينوزا. ومع ذلك، فنخن نخطأ في الاعتقاد، كما يغرينا ذلك غالبا، بأنّ إنشاء النسق كان هدف الفيلسوف. إنه بالأحرى رأي كثير الانتشار بقدر يبدو فيه بديهيا . يبدو لنا بأنّ هدف ديكارت كان كتابة " نسق ديكارت، وتأسيس الديكارتية، وأنّ هدف كانط هو إنشاء ما نسميّه الكانطية. بيد أنّ هذا الخطأ يجعلني أفكّر في تاريخ فرسان مشهورين، نفترض أنه يقولوا:" نحن الآخرين، فرسان القرون الوسطى..." لا يعرف فرسان القرون الوسطى أنهم كانوا فرسان القرون الوسطى. وفي هذا المعنى فديكارت ليس ديكارتيا. وبالفعل، لا يريد ديكارت تأسيس نسق هو نسق ديكارت؛ بل يريد العثور على الحقيقة، وهو شيء مختلف تماما، وهو يريد هذه الحقيقة بكل إخلاص. وكذلك يصنع كانط وباركلي. ستقولون لي بالتأكيد، أنه من حيث أنّ الفيلسوف قد بدأ في إنشاء نسقه، فهو يدافع عن هذا النسق، ويثبّته. هذا حقيقيّ، وهو يظهر ببساطة أننا لن نكون تماما فلاسفة، وأنّ الفلاسفة ليسوا بمنأى عن الكبرياء وفي ضرب من سوء النية في دفاعهم عن أفكارهم الخاصّة، التي يسندونها لأنّها أفكارهم. ويمكن أن تقولوا لي أيضا بأنه يوجد بعض الفلاسفة القاصرين الذين لم يفهموا ما هي الفلسفة، وأنهم يقدّرون بأّنه يجب عليهم، مهما كان الثمن، بناء نسق جديد. غير انّه لا أهمية كبيرة لكلّ ذلك. فالمهم، هو أنه، إذا كنا نتّبع فكر ديكارت أو كانط، فعلينا أن ندرك بأيّ حماس هم يبحثون عن الحقيقيّ انطلاقا من بعض المشكلات المطروحة، ويبحثون باستمرار ويعمّقون. وهم لا يعرفون إذن إلى أين سيقودهم هذا البحث. نحن سرعان ما نتبيّن على أيّ حال، أنه على مستوى دراسة الأنساق لوحدها لا نستطيع الإفلات من الخطأ الذي كان أصل كل المناهج القاصرة التي حاولنا مقاومتها. و، بالفعل، فإنّ أصل كلّ هذه المناهج، المنهج النفسي والمنهج الرياضي والمنهج التاريخي هو أن يجعل من الحقيقة الفلسفية موضوعا. بيد أنّ النسق هو أيضا على نحو ما، موضوع، وموضوع يتنزّل في عصر وفي بيئة معطاة. إنّ النسق هو ما يتبقّى لنا من فيلسوف. وأعتقد من جهتي بأنّ الكاتب، بإنشاء نسقه، وبالرغم من انه يزعم الخضوع لقوانين محض منطقية، لقوانين بالتالي لازمانية، يجازف أكثر بالتعبير رغما عنه عن عصره وأخطاء هذا الزمان، وبالتالي بالخضوع أو الوقوع تحت سيطرة تفسيرٍ على نمط هيجلي. ذلك أن النسق، هو دائما تأويل لبدهية باسم ما ليس كذلك. آمل أنّنا سنفهم ذلك أكثر في لحظة ما. توجد أنساق عديدة. وتختلف الأنساق فيما بنيها أيّ كانت البنية اللازمانية والمنطقية للنسق. فهي لا تمثّل إذن البداهة الكونية بأنّ المفكّر يبحث. فنسق لابنيتز ليس نسق سبينوزا، ونسق مالبزانش ليس نسق كانط. إنّ تاريخ الفلسفة بوصفه تاريخ أنساق يقدّم إذن نفس الخطر الذي يقدّمه التاريخ كما يتصوّره هيجل، إضافة إلى كونه يعدّه. ينفي هذا التاريخ إمكان أن يكون للفلاسفة أشباها حقيقيين. إنها تسجن كل فيلسوف في خصوصيته؛ وتجبره على التنازل عن مطلبه الأساسي. بيد أنه، إذا لم يكن هناك شكّ بأنّ كل فيلسوف له خصوصية معيّنة، فيما تعبّر عنه كل فلسفة، خلافا لما يفعله العلم، فإنّ ردّ فعل وعي شمولي في الوسط الذي يوجد فيه، أفلا تكون هذه الخصوصية أيضا خصوصية غير منغلقة، بل منفتحة. وإذ ما اقتصرنا إذن على النسق، فسيجب، إمّا الوصول إلى منطقانية logicisme مجرّدة، أو إلى ريبية جمالية، إلى إستيتيقية تقود إلى ريبية. وستبدو كل فلسفة مثل رؤية للعالم. في حين أنّ رؤى العالم مختلفة. يجب إذن النظر إليها بإعجاب لجمالها، أي تناولها بوصفها ضروبا من القصائد، لا النظر إليها من جهة الحقيقة. فكونها متعدّدة بالذات يبيّن أنها خاطئة، ولأجل ذلك، ففي كلّ مرّة أدرك فيها المفكر بأن الأنساق متعدّدة، فَهِمَ أو ظن أنه فهم بأنّ هذه الأنساق كانت خاطئة. يسخر فولتير من أنساق القرن الذي سبقه، ويقدّر كانط نفسه بأنّ تعدّد الأنساق يدين الميتافيزيقا ويقدّر أن الميتافيزيقا ليست مستحيلة بينما العلم ممكن (لو علمتم فهذا من أهم نقاط الانطلاق لنقده العقل المحض)، ولا يريد أي دليل آخر غير كون العلم يجعل جميع عقول العالَم متفقة، بينما الميتافيزيقا مجعولة من عدة انساق ومتناقضة. حقيقة أراد هيجل انطلاقا من هذه الفكرة، إنقاذ الميتافيزيقا. والمصيبة انه في محاولته إنقاذ الميتافيزيقا أنقذ ميتافيزيقاه هو، بما أنه أنقذ تلك التي تزعم أنها فكر كلّ فكر آخر، باعتباره بمثابة لحظات تطوّر كوني اكتشف هيجل وِحدته. أعتقد إذن أنه لا يجب أن نتمسّك بالأنساق. بالتأكيد لكل مناهج الفهم التي استعرضناها، حقيقة معيّنة، ومما لا جدال فيه أنه يجب، كما الشأن في الرياضيات، فهم ما يريد الفيلسوف قوله؛ ولا يمكن، باللجوء إلى علم النفس إنكار ضرورة محاولة النظر في كيفية إيجاد الفكر الفردي والعيني للفيلسوف هذه الحقيقة أو تلك، أو، إن جاز القول، قد طُبع ببصمته هذا المبحث أو ذلك. وبالمثل، يوجد فهم تاريخي للفيلسوف، إذ أنه من البديهي أن الفيلسوف ليس فكرا خالصا، ومن الواضح أن فيه عناصر هي بالفعل، خاضعة للتاريخ، مرتبطة بالطبقة الاجتماعية، الخ. إنّ الفيلسوف إنسان. ومّما لا جدال فيه أيضا أنه يجب فهم النسق. لكنني أعتقد أنه بالذات في اللحظة التي نفهم فيها النسق، يجب أيضا فهم أن النسق، وبخلاف بنيته المنطقية بالضرورة، المعطاة والمتناسقة، هو أيضا من نوع الموضوع، ومن نوع علمي، وأن النسق، إن جاز القول، هو ما به، استسلم الفيلسوف، وقد فارق، كما سأحاول بيان في القسم الأخير من هذه الحديث، هذا العالم، قد استسلم للحنين إلى عالم آخر، لحنين عالم، وأنه، بعدما أظهر لنا أنّ هذا العالم ليس الكائن، يقدّم لنا عالما آخر، خياليا هو ذاك، لكن ليس له سمة الموضوع، أو عالم موضوعات. أعتقد إذن أنه، إذا ما أردنا حقّا فهم الفيلسوف، وإذا ما أردنا فهم هذه الصلة الحميميّة حقا بين حقيقة كونية وذاتيةِ شخصيّة، فعلينا البحث عن هذا الفهم، لا في مستوى النسق، بل في التمشيّ، أو التمشّيات التي تولّد منها النسق. أي أنه يجب الاستعاضة عن كونية موضوع بكونية تمشّ، هذا التمشّي الذي ليس هو موضوعيا، ولا بسيكولوجيا، بل راسخ في حركة معيّنة للذات نحو الكائن: ذلك هو التمشي الفلسفي تحديدا، في معنى مميّز لكلمة فلسفي بما هو كل ما ليس ميتافيزيقي: علم وشعر، الخ. كنت دائما مندهشا للغاية من أنّنا نجد، لدى نفس الفيلسوف، وتحت موضوعات مختلفة في ظاهرها، والتي لم يتصوّر الكاتب ذاته ربطها منطقيا، نجد تمشيا متماثلا تماما. سأضرب مثلا غالبا ما سُقته؛ لكني لا أعرف أفضل منه. إنه مثال الأطروحة المعروفة لخلق الحقائق الأبدية لديكارت. تعرفون أن هذه الأطروحة التي صيغت لأول مرة عام، 1630 يقرّ فيها ديكارت بأن الإله قد وضع الحقائق الأبدية بمطلق الحرية، أي أن الحقائق التي تبدو لنا منطقية، رياضية وعلمية، ليست بالمرّة حقائق ضرورية على صعيد أنطولوجي تحديدا. كان بإمكان الإله أن يصنعها بخلاف ما هي عليه. لقد تجاوز ديكارت بمثل هذا التمشّي، بما لا جدال فيه كل موضوع، وحتى العلم الذي بناه، نحو الكائن الذي يعتقد أنه الأصل في هذا العلم وهذا العالم. بيد انه، لو اعتبرنا الشكّ، الذي استأنفه ديكارت سنة 1641، واعتبرنا " الأنا أفكّر"، وكثيرا من المباحث الأخرى أيضا، أفليس التمشي الثابت الذي تأسست عليه هذه المباحث، هو التجاوز الأبدي لما هو نهائي نحو ما هو لانهائي، ويتضمن سبب وجود النهائي، وسبب وجوده بالمعنى القويّ، وبمعنى فعل ؟ أريد أن أقول بهذا من أنّ الإله ليس المبرر المنطقي للعالم، لكنه من يصنع العالم، ومن هنا نرى بالنتيجة أن ّ العالم مثله ليس كائنا كاملا. إنّ الشكّ الذي يتجاوز الحقائق الرياضية، والفيزيائية يستعيد هذا الحدْس. فـ"الأنا أفكّر" ذاته، هو كما يقول ديكارت، فكرة الإله، بما أنه في التأمّل الثالث، كتب ديكارت بأنه ليس من الضروري أن يجعل الإله، وقد وضع علامته في هذا الأثر، هذه العلامة مختلفة عن هذا الأثر ذاته.على نحو يكون فيه " الأنا أفكّر" أيضا تجاوزا للنهائي نحو اللانهائيّ، وهو ما لأجله يظهر أوّلا كشكّ، وما يبدو بعد ذلك ككوجيتو. إنّ هذه المباحث، التي لم يصل ديكارت بينها (إذ لا يتكلّم ديكارت بالتحديد، لا في " التأملات"، ولا في القسم الأول من "مبادئ الفلسفة "، عن صنع الحقائق الأبدية؛ ولا يمكننا القول انه يربط نسقيّا (في نسق) بين هذا المبحث والمباحث الأخرى)، ومع ذلك أعتقد أن لهذه المباحث أساس وحيد، إنها تعبّر بعضها البعض عن تمشّ متشابه، عن تمشّ متماثل، تمشيّا أجده علاوة على ذلك هو الأصل في كثير من المباحث لديكارت، مبحث العالم معتبرا بوصفه حكاية، ومبحث الطبيعة معتبرة بوصفها ميكانيكا لها مبرر وجودها خارج ذاتها، ومبحث الحيوانات الآلية، والخلق المستمرّ، الخ. وإذا ما أخذنا الآن كانط بعين الاعتبار، أمكننا أنّ نكتشف جيدا وجود ماهيات مماثلة. على سبيل المثال، منذ محاولته إدماج مفهوم المقادير السالبة في الفلسفة، كان كانط مندهشا من أن الشرّ والألم والمعاناة وفي كلمة المحسوس، وخلافا لما يعتقده ليبنتز أو وولف، لا يمكنها أن تُختزل في مفهوم. توجد هنا تجربة عميقة جدّا، حيويّة بالتحديد، تكشف عن أن المحسوس لا يردّ إلى مفهوم. بيد أننا نجدّ هذه التجربة في " نقد العقل المحض"،حيث سنرى الذات البشرية تنقسم إلى تقبل حسّي، وفهم عفوي يفرض قوانينه من خارجٍ على المحسوس. سنجدها في نقد العقل العملي، في فكرة أن القانون الأخلاقي هو قانون "شيء في ذاته" يُفرض على الذات الحاسّة. سنجده في نقد ملكة الحكم، عندما يبيّن لنا كانط، بالتحديد، أن الحكم الغائي هو حكم تأمّلي، وليس محدِّدا، أي حكما يتّجه، انطلاقا من المُعْطى، نحو مفهوم لا يمكن بلوغه ولا يمكن أن نستنتج منه المحسوس ذاته. وأستطيع مضاعفة الأمثلة. ولكن أعتقد أنه ليس من الضروريّ. نحن نرى كفاية، انه لدى الفيلسوف ذاته، يوجد تجانس في التمشيّ، حتى حيثما لا يوجد نسق منطقي، أي صلةٌ منطقية بين المباحث. لكن يجب أن نذهب أبعد من هذا، وهنا ربّما أمكن لنا لإنقاذ الفيلسوف من هذه العزلة التي وصفناها. وسيسمح لنا هذا السلوك الثابت فعلا، توحيد لا المباحث لنفس الفيلسوف فحسب، بل مباحث أنساق هي في ظاهرها متعارضة. لا شيء قد تمنحونني إياه أكثر اختلافا، لمارلوبرانش أكثر من باسكال، ولهيوم أكثر من كانط. ومع ذلك فالدهشة أمام ما نسمّيه القانون الفيزيائيّ، أي أمام كوننا نكتشف باستمرار في الطبيعة علاقات ثابتة ولا ضرورية، علاقات لا تحكميّة كونية لكن ليس لها سببا مفهوما، موجودا في كلّ شيء. إنّ الحلم العقلاني القديم: السبب أو إن شئنا، المبرّر، قد ضاع حقّا (يفكّر كانط باستمرار في مثال نيوتن الذي أسّس علما قوانينُه هي عبارة عن وقائع معمّمة). ومن دون شكّ سنلتقي بهذا المبحث في أشكال مختلفة جدّا وفي أنساق متعارضة تماما، بما أنّ مالبرانش تحديدا يعلّق على هذه الحقيقة بنظريته عن الأسباب العرضية ومفكرا في الإله سببا وحيدا، ويعلق هيوم على هذه الحقيقة بالدعوة إلى ذات حاسّة، تنزاح من السبب إلى النتيجة بحكم العادة، ويعلّق كانط على هذه الحقيقة بالمقولات. لا شيء مختلف، ومع ذلك فالاعتراف بهذه الاعتباطية للضرورة ذاتها أو الانطباع، هي جوهريةٌ على وجه الإطلاق، أكثر من الموضوع غير الكافي انطولوجيا، ويجد نفسه في هذه السياقات المتنوّعة؛ سواء في فلسفة مالبرانش، الذي يستخلص منها فرصة للسموّ إلى الإله، ويبّن لنا بأنّ هذه الطبيعة، التي نحيا فيها، هي طبيعة دون اتساق، وانّ الإله هو وحده السّبب في كلّ ما يحدث فيها وانّ الطبيعة لدى هيوم التي هي على العكس طبيعوية naturaliste والذي يزعم أنّ سبب وجود العلاقات لا يكمن في الموضوع بل في الذات، وفي ذات تمنح لنفسها الحدْس ذاته. أقدم مثالا آخر أعتذر أيضا عن الرجوع إليه، لكنه من الوضوح بمكان بحيث يستلزم الرجوع إليه، هو أمثولة الكهف لأفلاطون. يلتفت الفيلسوف، أي يتخلّص من الضلال حتى يلتفت إلى الوراء؛ توجد هنا حركة حقيقيّة للالتفات توصف بشكل فيزيائيّ. غير أنّ الشكّ لدى ديكارت، يلفت أيضا الفكر، وينثني به إلى الخلف، ويقول ديكارت، إنه يفصله عن العالم الحسّي وعالم الموضوعات، عن عالًم العلم، ليصرفه صوب "الأنا أفكّر" وصوْبَ الإله. وينعطف الفكر لدى كانط، بما أنه، وبعد البحث عن أساس العلم في الموضوع، يبحث عنه في الذات. وهوسرل أيضا، حتى نأخذ مثالا لفيلسوف حديث، " ينعطف " بالسلوك التلقائي الذي يقصد العالم. يبدو لي بأنّ كل هذه الانعطافات لا تختلف فيما بينها إلاّ حيث تختلف النقاط التي تعطفها.
إذن هؤلاء فلاسفة مختلفون تماما بعضهم عن بعض، إذا ما نظرنا إليهم من جهة أنساقهم، أي من جهة الطريقة التي أوّلوا بها ضربا من البداهة الأساسية. غير أن الطريقة، التي قادتهم إلى هذه البداهة والتي، إذا ما استبدلنا مباحثهم بالمحتوى الحقيقيّ لهذه المباحث، فسيبدو في نقائه، ويجعلهم جميعا في اتفاق. لا أيد أن أقول فعلا، وأعتقد بأنه لا أحد هنا لا يقدر أن يصفني بمثل هذه التبسيطية، بانّ أفلاطون هو ديكارت ولا أنّ ديكارت هو كانط، وكانط هو هوسرل. من البديهي فعلا أنّ كل واحد قد وجد نفسه في صعوبات شخصية، وانه قد وجد نفسه في عوالم مختلفة، وأنّ عالم أفلاطون ليس عالم ديكارت، وأن عالم ديكارت ليس عالم هوسرل. ومن البديهي جدا أن كلٌ منهم كان عليه أن ينثني، حتى لا نقتصر على هذا الانثناء، بطريقة تخصّه هو. لكن يبدو لي واضحا، أيضا، أنّ كل هذه الانثناءات تنطلق من الموضوع، هذا الشرط هو الأفكار بالنسبة إلى أفلاطون، و" الأنا أفكّر" والإله بالنسبة إلى ديكارت، والمقولات بالنسبة إلى كانط. وهذا يفسّر أيضا أمرا لا نعطيه في نظري، حيّزا كافيا: هو إننا نلاحظ باستمرار انه في تاريخ الأفكار، توجد انقلابات فردية، انقلابات غريبة. هكذا لم تكن ريبية هيوم الملحدة سوى امتدادا لمقولة النفس للمنهج الذي أراد باركلي تطبيقه على المادّة، لهدف دفاعي أساسا. لقد أراد باركلي دحض الماديّة، وبالتالي بيان أن الماديون يقرّون باطلا بأولوية المادّة.لأجل ذلك هل توجد طريقة أفضل من بيان أنه لا توجد مادّة البتة؟ سيجد الماديون أنفسهم إذن في حرج. بيّن باركلي إذن انه لم توجد المادّة؛ غير أن الحجج التي برهن بها مماثلة لما طبقه هيوم، مستعيدا المنهج، على النفس، وطبقه على الإله وأصبح بالتالي ملحدا وفق درس باركلي القسّيس.حسنا، إذا كان هذا ممكنا، فذلك لأنّ تمشي باركلي هو متميّز حقا عن نسق باركلي، وهو ما سأبيّنه باعتبار آخر. مَن مِّنا، - وربما قد وُجد، واعتذر منهم في هذه الحالة - من يعتقد حقّا اليوم في نسق باركلي؟ لكن قد نحتفظ بتمشي بلاركلي بوصفه ذا صلوحية وراهنية. لا أريد سوى دليلا. افترضوا أنّ هيلاص Hylasقد عرف اكتشافات العلم الحديث، وانه عرف الذرّة. نرى بوضوح أنّ الحوار بين هيلاص وفيلونس كان سيتضمّن بعض الصفحات زيادة، وانّه سيكون بإمكاننا كتابة هذه الصفحات بيسر. نرى بوضوح أنّ هيلاص، وبعد أن قال بأنّ المادّة قد تكون هذا أو ذاك، يضيف:" ربما كانت المادة الذرّة، الإلكترون والبروتون والنيترون." ونسمع فيلونوس يجيبه:" ولكن ما هو البروتون سوى الفكرة التي لدينا عنه؟". إنّ هذا التمشّي النقدي هو إذن مستقل تماما عن النسق، بما انه سمح لهيوم بالوصول تحديدا إلى نقيض ما كان يريده باركلي، وبما أنه سمح لنا، نحن، بالقيام بنقد لمفهوم المادّة على نحو ما عرفه علم قد عرفه باركلي. هنا يجب أن نذكّر بأننا لا نُولَد فلاسفة، بل نصير كذلك، وأننا نصير فلاسفة بتفاعل ضدّ كلّ معرفة ليست فلسفية. ذلك أنّ الفلسفة لم تكن أبدا معرفة من درجة أولى، إنها معرفة المعرفة، كما قيل؛ وليس لنا رغبة في معرفة ما هي المعرفة إلاّ بوجودنا بعد في وسط معرفة من درجة أولى، لا تبدو كافية تماما. وما يُحيّر فهم مثل هذه المعرفة هو أنّ هذه المعرفة من درجة أولى، بالنسبة إلى أفلاطون، هو الرأي. يقابل أفلاطون إذن الرأي بالعلم. لكن تمشّيه لم يكن مع ذلك، مجرّد طريقة انتقائيّة، كما يمكن أن نتصّوره. والدليل هو أن العلم، وحالما نشأ بوصفه علما، وأنه بالتالي هدّم الرأي، لم تقتل الفلسفة نفسها من أجل ذلك: بل على العكس، اتخذت بالنسبة إلى العلم، سلوكا مماثلا تماما للسلوك الذي اتخذه أفلاطون بالنسبة إلى الرأي. لقد أرادت الفلسفة أن تحدّد للعلم موضعا وتجعل العلم مكانها، وبمثل سقراط الذي يقضّي وقته مع الناس في الاستدلال على أنه لا يعرف ما يعتقد معرفته، وبمثل كانط مثلا، الذي يقرّ بأنّ العلماء لا يعرفون ما يعتقدون معرفته، وأنهم يعرفون العلم ويعرفون العلاقات بين الظواهر، لكنهم لا يعرفون الكائن الذي قد يخلطونه دائما بالموضوع. لأجل ذلك، أعتقد أنه من الضروريّ، لفهم فيلسوف، وهذا ما أودّ أن أنهي به هذه الملاحظات، والتساؤل أوّلا كيف أصبح الفيلسوف فيلسوفا؟ نادرا ما نطرح هذا السؤال، ونفضّل تناول الفيلسوف على صعيد النسق. يبدو لي من المفيد إذن أن نعود أيضا على مفهوم التمشيّ أو المنهج. نقف على المستوى لأنه لنا دوما خشية من الوقوع على نحو ما في ضرب من القصّة الفلسفية أو البسيكولوجية. أعتقد أنّي بيّنت بما فيه الكفاية أنه لن ننزلق أبدا في نزعة بسيكولوجية باستخدام المنهج الذي أنصح به. وأعتقد أيضا أنه، إذا ما أردنا تجنّب فلسفة التاريخ، فيجب أن نكون أيضا مؤرخين أكثر من فلاسفة التاريخ؛ يجب أن نشتغل بالتاريخ الفردي لكلّ فيلسوف. لقد قلنا هذا منذ قليل، فديكارت لم يخش كتابة تاريخ فكره. ولا يجب أن نكون أكثر خجلا منه. بيد أن ديكارت يتعارض، كما تعرفون، مع الفلاسفة الجوهرانيين؛ أي مع فلسفات ميّتة، مع فلاسفة دون كائن، بما أنّ الفلسفة هي البحث عن الكائن: من جهة، فلسفة سواريز الذي دُرّس لديكارت من معلّميه والذي لم يكن سوى طوماوية ماهوية. غير أنّ ديكارت بدأ بإدانة السواريزية le suarezisme بالعلم. لكن عام 1630، وضع ديكارت، لحظة اكتشافه نظرية خلق الحقائق الأبدية، في ضوء النهائي المبدع الذي أسسها. وفي النهاية، وضعها، لحظة كتابة التأملات، أو بعدُ مقالة الطريقة، في ضوء " الأنا" الذي يفكّر. وبالمثل فإنّ كانط انطلق من فلسفة وُولف الذي تغذّى هو الآخر من سيوراز. اعتقد أنه سيكون هناك الكثير مما نقوله عن الدور الذي لعبه سيوراز على هذا النحو في الفلسفة. ننطلق دائما من سيوراز لبيان أنه ليس هكذا يجب أن نتفلسف. يعترض كانط على ُوولف بانشغال معين على الكائن، انشغالا حادّا لديه، وعلى أساسه يُنشأ فلسفته الخاصةّ. أعتقد أنه يجب، إذا ما أردنا بلوغ، كما أصرّ على فعله منذ بداية هذا الحديث، حقيقة تكون في الآن نفسه كونية وشخصية، اعتبار تمشي أو نهج الفيلسوف. يمكننا بلوغ الحقيقة المنشودة بقدر ما نستطيع إتباع تاريخ كلّ فيلسوف بطريقة دقيقة. هذه الدراسة ليس لها أي قاسم مشترك مع الطريقة الهيجيلية في تصوّر التاريخ، إذ بعد أن يملك تاريخا، وبعدَ أن يقوم بعَوْدٍ معين في الزمان، يسمو الفيلسوف بتاريخه إلى الماهية. انا على اتفاق مع الرأي الذي يقرّ بأنّ كل فلسفة حقيقية هي تاريخ سَموْنَا به إلى الماهية: لأجل ذلك هي (أي الفلسفة الحقيقية) شخصيةٌ وكونيةٌ في الآن نفسه. أما فيما يخصّ ديكارت، فاستدلالي سيكون سهلا جدّا. يكفي النظر في فقرة من مقالة الطريقة عام 1637، ففي "المقالة" ليس للكوجيتو أيّ منزلة حقيقية فهو في كل مكان وفي أيّ مكان. هو في القسم الرابع من "المقالة" حيث يقول لنا ديكارت:" أنا أفكّر، إذن أنا موجود". يزعم ديكارت إذن أن الكوجيتو هو أساس كل فلسفته، بالرغم من أنه صرّح بعدُ، في الأقسام السابقة من المقالة، بنظريته في الأخلاق والمنطق.
يوجد مع ذلك كوجيتو يسند في الواقع كليةً مقالة الطريقة. لكنه الكوجيتو التاريخي، الكوجيتو الذي يصنع وحدة كل تمشيات أو طرائق ديكارت، بالرغم من كونه، إن أمكن القول، لاواع بذاته، كوجيتو يصنع وحدة كل أقسام المقالة. إنه هذا " الأنا" الذي يقول في الجزء الأوّل:" أنا خرجت من المعهد، واستقبلني مُعلمِّيَ، والذي يقول: هذه أخلاقي وميتافيزيقاي، الخ. لكن يصبح هذا الكوجيتو في "التأمّلات" واع بذاته كلية؛ لأجل ذلك يصبح " الأنا أفكّر" للتأملات هو منبع التوازن لكل ما بَقِيَ. هذا " الأنا أفكّر" يضع في المنظور كلّ الحقائق التي أراد ديكارت إنشاءها، من جهة عالم الموضوعات، الذي يعتبره بوصفه أدنى منه، يمكن له معرفته، والفعل فيه، ومن جهة أخرى، الإله الذي يخضع له، والذي يجعله موجودا. أعتقد أن استدلالا مماثلا يمكن أن نقيمه بالنسبة إلى فلاسفة آخرين، وانه قد يكون دوما من اليسير بيان أن التفلسف، هو أن نسمو بتاريخه الخاص إلى الماهية، على كون " تاريخه الخاص" تعني بالطبع هنا تاريخ فكره، لا تاريخ أهواءه، أو مختلف مغامراته. على هذا النهج إذن يمكننا العثور على ماهية هذا التمشي الذهني أو الطريقة التي نعتقد أنها الفلسفة. قال لنا ديكارت إنه، حتى نفهم تأمله الأوّل، لابدّ لنا من أشهر وأسابيع. ولكن يكون الأمر بديهيا في هذه الحالة لو اختزل التأمّل الأوّل في الحقائق العقلية التي يتضمنها، بما انّه لفهم هذه الحقائق، يكفي نصف ساعة. لكن لابدّ من حياة حتى أصير فيلسوفا، حتى أصير شبيها بالفيلسوف الذي حاولنا وصف دعواه. ذلك أنه حتى نصير شبيهه، يجب أن نكتشف بأنفسنا أنّ كلّ المشكلات ليست مشكلات موضوعية، لكن الإنسان، بتصوره ذاته أولا مشدودا إلى عالم الموضوعات، يصير فيلسوفا، بالعود إلى الشروط الموضوعية ذاتها. نجد هذا النهج لدى أفلاطون كما لدى كانط، أو سبينوزا أو مالبرانش. بالتأكيد أن منهج هؤلاء الفلاسفة يختلف لكن الحركة التي يقومون بها في اتجاه هدفهم متشابهة، ذلك أن الفلاسفة، وهذا هو خاصة ما أردت وضعه، لا يذهبون بالتحديد نحو أيّ عالم. فالآخر الذي يتّجهون إليه ليس عالما. وأعتقد أن كل الأخطاء التي عرضناها تتلخّص فيما يلي: ننتظر دائما أنه بعد التخلص من عالم، سيقدّم لنا الفلاسفة عالما آخر. نحن في هذا ضحيّة فخامة الموضوع وخطأ النسق. إنّ الفلاسفة، بإظهارهم أن العالم لا يتضمّن شروطه الخاصّة، يتّجهون نحو كائن ليس بعالَم. يقول مالبرانش ذلك في "محادثات"، جملة بدت لي دائما أفضل تعريف يمكن أن نقدّمه للفلسفة. يصرّح مالبرانش انه لن يقودنا إلى أرض غريبة بل سيعلمنا أّن نكون غرباء في بلدنا. لاشيء أفضل من هذا يجعلنا ندرك لماذا هو من الصعب فهم الفلاسفة. هو أننّا لا نريد أن نكون غرباء ولا شيء يجعلنا كذلك أكثر من الفلسفة، بما أنها تجعلنا تحديدا نمرّ من -عالم إلى شيء آخر ليس بعالم. لا يهتمّ الناس سوى بكونيةٍ موضوعية، سوى بكونية لاشخصية تسمح بالفعل في الموضوع. ولا يهتمون إلاّ بالكوسمولوجيا. فمن العادي تماما أن يغويهم النسق أيِ، بما يشبه أكثر لدى الفلاسفة أو ما يشبه نسق العالم، مثل العلم. والمصيبة أنه بعد أن يقع الإغواء بالنسق، سرعان ما سخروا منه. فيقابلون الأنساق بعضها ببعض، مثلما فعل فولتير، ويقابلون الميتافيزيقا بوصفها نسقا بالعلم، وهو أعظم الأخطاء، باعتبار أنّ الميتفيزيقا ليست نسقا يمكن أن يوضع على صعيد العلوم ومعارضتها، لكن ما تكشفه لنا هو أنّ الكائن لا يمكن أن يُضَمَّن في أيّ نسق كان. وحتى نستخلص، سأقول إنّ ما يمنعنا من فهم الفلاسفة، هو الجهل من موقعنا بما تعنيه غالبا الفلسفة. لكن أود أن أضيف، أنه لفهم الفلسفة، يجب فهم الفلاسفة. فالفلسفة ليست العلم، وليست نسقا، أو مجموع أنساق بل هي تمشّ أو نهجا، وليس للتمشي من معنى إلاّ لأنّ إنسانا ينفّذه. وهذا لا يعني أنّ هذا التمشي هو تمشّ فردي، ليس له من معنى ولا قيمة إلاّ بالنسبة إلى فرد يحتلّ موقعا في الفضاء والزمان. إنّ التمشي الفلسفي ليس تمش يمكن فهمه بمبررات بسيكولوجية، وليس تمشّ يمكن فهمه بالتاريخ، أو انطلاقا من حالة اجتماعية معينة. إنّ التمشي الفلسفي هو تمشي الفكر ذاته، ولأجل ذلك هو دائما للإعادة مجدّدا: إذ للفكر دوما أن ينقذ نفسه. لا يوجد في الفلسفة تقدم تاريخي ّحقيقيّ، من تقدّم إلى الأمام، كما يوجد في العلوم. ولا يمكننا القول بوجود حقائق جديدة في الفلسفة يجب بلوغها. لكن إذا ما أردنا أن نكون فلاسفة، يجب على كل منّا، بتمشّ مماثل للذي انتهجه الفلاسفة، أن يصير شبيها للفلاسفة. لا يمكننا فهم فيلسوف دون أن أصير أنا بذاتي فيلسوفا، ودون أن نصنع عبر التاريخ وبالرغم عنه، الشبيه للفلاسفة، ودون العثور على هذه الأبدية التي للفلسفة. "
***
..........................
* فارديناند ألكيه " ما معنى فهم فيلسوف؟ّ": درس افتتاحي في الخمسينات نشره مركز التوثيق الجامعي 1956، وأعيد نشره من "المائدة المستديرة" باريس 2005.






