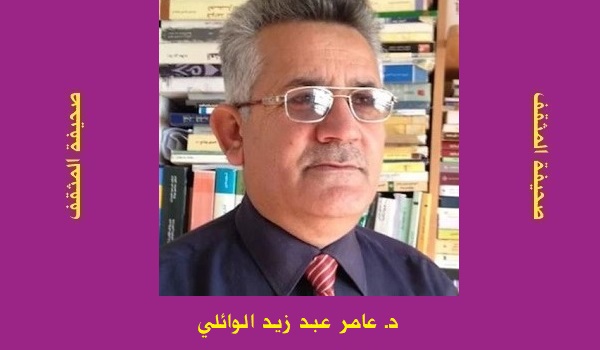اخترنا لكم
السيد ولد أباه: إعادة بناء سؤال التراث

في مقالة أخيرة بعنوان «القديم والجديد»، يتساءل الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن: لماذا يتمكن الإنسان دوماً من وصف وتحليل الماضي دون أن يتمكن من تخيل الجديد؟ أغامبن يجيب عن هذا الإشكال المعقد بالقول: إن ضبط الجديد الحالي يتم حتماً من خلال الرجوع للماضي وإعادة تأويله. فالراهن هو في عمقه بقية باقية من الزمن المنقضي، أي ما لم يتم إنجازه أو ما نُسي أو ما ينتظر التفعيل والتحيين.لقد قامت الحداثة على وهم القطيعة مع الماضي، في حين أن ما نعتقد أنه معاصر ليس سوى ظل من الحقبة الفائتة، باعتبار أن الماضي هو مخزون إمكانيات الفعل غير المتحقق وليس المستقبل في ذاته هو صانع الجديد بل إن الذاكرة هي المحددة والحاسمة في ضبط وتوجيه الزمنية الحالية.
في هذا السياق، يستعيد أغامبن فكرةَ «الولادة الجديدة» لدى الفيلسوفة الألمانية الأميركية حنة أرندت التي تعني امتدادَ التقليد في الزمنية الطويلة، دون أن يكون عائقاً أمام التجديد والتحول. كما يستعيد أطروحةَ الفيلسوف الفرنسي بول ريكور حول استقلالية النص إزاء شروط تشكله التاريخي، بما يسمح بالنظر إليه بعيون جديدة تمكّن من تحويله إلى نص معاصر جديد.
ما يخلص إليه أغامبن في مقالته المذكورة هو أن المعنى الوحيد للجديد هو الممكن (فالمستحيل ممتنع التحقق)، وإذا أصبح قائماً بالفعل تآكل وانقضى. ومن هنا فإن الأساس في رصد الحالي هو الماضي وليس المستقبل، أي ما جاز أن يكون ولو لم يتحقق، وبالتالي فالإنسان لا يبصر الجديدَ إلا بالانطلاق من ماضيه.
لا شك في أن أطروحة أغامبن مفيدة لنا في إعادة بناء سؤال التراث الذي سيطر على الفكر العربي منذ سبعينيات القرن الماضي. لقد برز هذا السؤال في الأدبيات التاريخانية المتأثرة بالمنهج الجدلي الماركسي، انطلاقاً من مفهومين أساسيين هما: مفهوم التقدم التاريخي الذي يعني النزعة الخطية الغائية المؤسسة لقوانين التطور الاجتماعي الكوني، والنظرة البنيوية المزدوجة للفكر بصفته انعكاساً للصراع الطبقي المجتمعي، بحيث يكون بنيةً فوقيةً تفسر بالرهانات المادية الإنتاجية التي هي البنية التحتية المحددة والمؤثرة. ووفق هذا التصور، فالتراث جزء من الماضي التاريخي المندثر، وليس له سوى قيمة معرفية محضة لا صلة لها بالواقع الراهن.
ومع أن المدرسة التراثية العربية انتقلت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين إلى الانفتاح على المناهج الابستمولوجية والتأويلية الجديدة، إلا أنها حافظت على جوهر المقاربة الاختزالية للتقليد بتوظيفها مقولةَ «القطيعة الابستمولوجية» التي بلورها أصلاً الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار في تاريخ العلوم وفي ضبط ارتباط المعرفة الموضوعية المخبرية بالتجربة العامة المباشرة، فأصبحت تَعني في نظريات نقد العقل العربي الاختلاف الجوهري بين الأنظمة المعرفية والأنساق الدلالية.
ورغم هذا التصورات الانفصالية القطائعية، إلا أن المفكرين العرب المشتغلين بالمسألة التراثية خاضوا صراعات الحاضر على أرضية الماضي، فاحتفى حسين مروة وطيب تزيني بالنزعات «المادية» في الثقافة العربية الوسيطة، ودافع الجابري عن «عقلانية» ابن رشد ومنهجه «الأكسيومي»، ونوه أركون بالنزعة الإنسانية العربية القديمة.
ما تعبر عنه هذه المفارقة، أي رفض الماضي مع الرجوع الانتقائي إليه، هو الخلل المنهجي الكبير في مقاربة سؤال التقليد، بالنظر إلى الماضي كأفق منقض ومندثر، بدلاً من تصوره في دائرة الترابط التأويلي بين الذاكرة والتطلع التي هي محور القراءة الثرية للسردية الفكرية.
في أعمال جورجيو أغامبن نفسه حول التاريخ السياسي والقانوني الغربي، نجد تطبيقاً حصيفاً لهذه الجدلية التأويلية، مبيناً أن المفاهيم المؤسِّسة للحداثة الأوروبية، من مقولات السيادة والتمثيل والضبط والرقابة.. إلخ، ترجع في جذورها البعيدة لخلفيات لاهوتية وعرفية وقيمية قديمة، وإن تمت إعادة توظيفها وتأويلها في استراتيجيات ومواقف معاصرة.
لا نجد لدى مؤرخي السياسة والفكر في عالمنا العربي نماذج من هذا القبيل، بل إن أغلب من اشتغل بالمسألة التراثية يتأرجح بين وهم التماهي مع الأصل المنقضي الذي لا يمكن استكشافه في أفقه المرجعي الأول، ووهم القطيعة مع الجذور الثقافية في دلالتيها التاريخية والابستمولوجية (المعرفية).
في كتاباته التأويلية حول العهدين القديم والجديد، يعترف بول ريكور بأنه يقرأ النصوصَ المقدسةَ بعين الحاضر غير مستنسخ الموروث القديم، مردداً: إن المؤوِّل لا يمكنه التملص من تهمة «الخيانة»، لكن الفرق كبير بين الخيانة الضحلة العقيمة والخيانة الثرية التي تغني النص وتوسع إمكاناته الدلالية.
***
د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني
عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 7 سبتمبر 2025 23:30