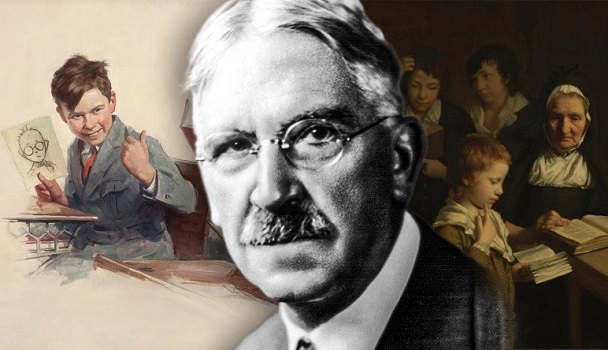اخترنا لكم
فهد سليمان الشقيران: ابن رشد.. منقذ الفلسفة من الضلال

في القرن الثاني عشر، كان الصراع على أشدّه بين الفقهاء والفلاسفة، فبعد ازدهار الترجمات في العلوم والفلسفة والمنطق، بات المشهد المعرفي يشهد تحوّلاتٍ كبرى شديدة التعقيد. حينها تغيّرت طرق النقاش والسجال، وتبدلت لغة تناول الحقائق، واغتنت سبل التأويل.. وقد كان لزاماً على الفلاسفة الدفاع عن أنفسهم أمام سيلٍ من التهم، وكان لابن رشد دوره البارز في خوض تلك الحرب. لم يتصدّ فقط للغزالي، بل لكل النسخ الفقهية التي تجعل الفلسفةَ رديفاً للزندقة والخروج من دائرة الدين.
اتجه ابن رشد في فترة لاحقة نحو نفي التضاد بين الحكمة والشريعة، فألف كتابه الشهير «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». وقد ضمّن هذا الكتاب محاولة توفيقية منطلقاً فيها من مقولة: «إن الحق لا يضاد الحق»، موضحاً أن لكل من الدين والفلسفة وظائف لا يتداخل بها مع الآخر، ولا يعترض عليها.
وبحسب الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري، في تحليله للمنهجية التي اتبعها ابن رشد في ذلك الكتاب، فإنه قد «انطلق في تصوره المنهجي الجديد للعلاقة بين الدين والفلسفة من مبدأ أساسي سبق التأكيد عليه، وهو الفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة فصلاً جذرياً أساسه أن لكل منهما طبيعته التي تختلف جوهرياً عن طبيعة الآخر، ومن هنا كان الفصل قضية منهجية أساسية، وهي تأكيد ابن رشد على خطأ استعمال قياس الغائب على الشاهد في معالجة العلاقة بين الدين والفلسفة، بل معالجة قضايا كل من الدين والفلسفة، وبالتالي التأكيد على الخطأ الناجم عن محاولة دمج قضايا الدين في قضايا الفلسفة، أو العكس، لأن عملية الدمج هذه غير ممكنة في نظر ابن رشد إلا بالتضحية، إما بأصول الدين ومبادئه، وإما بأصول الفلسفة ومبادئها.
إن ابن رشد يرى أن للدين مبادئ وأصولاً خاصة، وإن للفلسفة كذلك مبادئ وأصولاً خاصة، الشيء الذي ينتج عنه حتماً اختلاف البناء الديني عن البناء الفلسفي، ولذا كان من غير المشروع في نظره دمج أجزاء من هذا البناء في البناء الآخر، أو قراءة أجزاء من هذا البناء بواسطة أجزاء من ذاك». (انظر كتاب الجابري، «نحن والتراث»، ص: 238). والخلاصة في رأيي هي أن الردّة المنهجية حول الفلسفة تشكّلت تدريجياً، لكنها أخذت أوجهَا مع كتاب الغزالي «المنقذ من الضلال» الذي لقي رواجاً لدى الفقهاء، وبات حجةً بين أيديهم لإمام دخل الفلسفة وخرج منها محطّماً. وكما في ثنايا الكتاب، فإن الرحلة نحو الحقيقة كانت عصيبة. المناوئون التراثيون للفلاسفة قالوا إن ابن سينا وابن باجه والكندي والفارابي وابن رشد.. مجرد مقلّدين للفلسفة اليونانية، إلا أنهم لم يكونوا كذلك، بل ساهموا في رسم مناهج ونحت مفاهيم أساسية ميزتهم عن غيرهم.
لم ينجح الغزالي في مسعاه لشيطنة الفلسفة، وإنما انتصر ابن رشد لأنه استطاع إنقاذها من تهمة الضلال التي زعمها الغزالي، ورماها بها.
***
فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي
عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 4 نوفمبر 2025 00:52