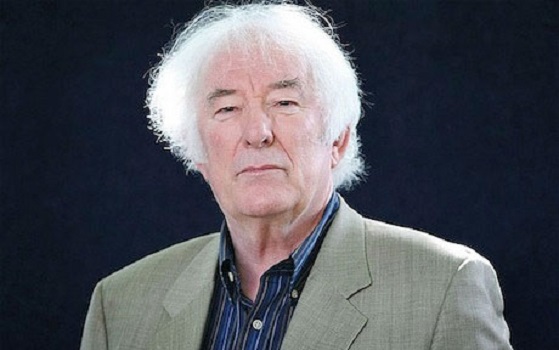نصوص أدبية
حسن لمين: الدرس الأخير

لم يكن الصباح مختلفاً عن سابقيه حين خرج حسن من بيته في الحي الشعبي، إلا أنه شعر، وهو يغلق الباب الخشبي خلفه، بأن شيئاً غير مرئي يتحرك في الهواء. كان البرد يلسع أطراف أصابعه، لكنه لم يعره اهتماماً. شدّ ياقة معطفه البني المهترئ، وسار ببطء نحو المدرسة. خطواته على الإسفلت كانت كأنها لا تخصّه، كأنها خطوات شخص آخر، رجلٍ يشبهه ولكنه ليس هو تماماً.
السماء كانت رمادية، غائمة، لكنها ليست غيوم المطر. كانت غيوماً ثقيلة، تشبه صفحة كتاب قديم امتلأت بهامشها خربشات لا يستطيع أحد قراءتها. شعر فجأة بأن تلك الغيوم تتبعه، كأن بينها وبينه وعداً لم يُكشف بعد.
اقترب من باب المدرسة، فهبت رائحة الطباشير القديمة، رائحة يعرفها منذ عشرات السنين. تمنّى لو يضمّ أنفه بيديه كي لا يستنشقها، لكن العادة أقوى من الإرادة.
دخل الفصل. كان التلاميذ يتحركون كأسراب عصافير صغيرة، لا تهدأ. وما إن رأوه حتى هدأوا جزئياً، إذ لم يكن حسن معلماً صارماً، بل معلماً مرهقاً، يمرّ بينهم كنسمة ثقيلة.
كتب التاريخ على السبورة، فلاحظ أن أصابعه ترتجف قليلاً. حاول أن يخفي ذلك، لكن الطفل الجالس في الصف الأمامي لاحظ الارتجاف.
– أستاذ.. واش يدّك مريضة؟
– لا.. غير البرد، غير البرد.
كان يقول دائماً إن البرد هو السبب.
لكن الحقيقة أعمق. الارتجاف يأتي من شيء داخلي، شيء لا يعرفه أحد، ولا يستطيع هو نفسه إعطاءه اسماً.
بدأ الدرس. وبدأ صوته يتردد داخل الفصل بشكل غريب، كأن صدى خفيفاً كان يرافق كلماته، وكان الصدى يأتي متأخراً بنصف ثانية. لم يستغرب حسن كثيراً، فقد صار يسمع أشياء منذ مدة، يظنها أحياناً تعباً أو وسواساً. لكن هذا الصدى بالذات جعله ينظر إلى التلاميذ ويتأكد أنهم لا يسمعونه. كانوا يتابعون الدرس بشكل عادي، لكن الصدى كان حاضراً.. فقط في رأسه.
اقترب من السبورة ورسم دائرة.
فجأة، تحركت الدائرة بشكل طفيف، كأنها نبضت.
لم يتأكد إن كان الأمر حقيقياً أم وهماً.
مرّ الإصبع عليها فوجد الطباشير عادياً، خاملاً.. كما يجب أن يكون.
أدار ظهره للتلاميذ، وأحسّ بثقل كبير على كتفيه.
لم يكن هذا الثقل جسدياً فقط، بل كان ثقل السنوات، ثقل العمر الذي مضى دون أن يترك وراءه سوى إرهاق لا نهاية له.
عند نهاية الدرس، خرج دون أن يتكلم كثيراً.
لم يودّع أحداً.
كان يعرف جيداً أين ستقوده قدماه: الدكان.
الدكان يقع في زقاق ضيق يتسلل إليه الضوء بصعوبة.
على بابه يقف الحاج عبد المولى، رجل كبير السن، بطيء الحركة، لكنه يملك عينين لا يمكن خداعهما.
حين رآه قال:
– مرحبا حسن.. داكشي المعتاد؟
– المعتاد.. آه.
كانت بينهما لغة صامتة.
لا أسئلة، لا نصائح، لا عتاب.
كلّ منهما يعرف أن الآخر يحمل حملاً لا طائل من الكلام فيه.
دخل حسن إلى الزاوية الخلفية حيث الكرسي المعدني.
جلس.
كان المكان مظلماً قليلاً، لكن الظلام كان يناسبه.
رفع الكأس، قربه إلى شفتيه، وشعر بأن السائل ينزل كما لو كان يسقط في بئر بلا قاع.
في تلك اللحظات، كانت الواقعية السحرية تتسلل دون أن ينتبه.
رأى في الزجاجة ظلّ شخص يشبهه، يجلس قبالته داخلها، يحرك شفتيه دون صوت.
فرك عينيه.
اختفى الظلّ.
ابتسم بسخرية من نفسه:
"بدأت أرى أشياء لم تعد موجودة إلا في رأسي."
مرت الأيام، وكل يوم بعد المدرسة يتكرر المشهد نفسه:
الفصل.. الطباشير.. الصدى.. الزاوية.. الكأس.. الصمت.
لكن الليلة التي تغيّر فيها كل شيء كانت باردة بشكل غريب.
الهواء كان ثقيلاً، والضوء الأصفر للدكان بدا أكثر اهتزازاً من المعتاد، كأن المصابيح تتنفس ببطء.
سمع حسن صوتاً خفيفاً، كأن أحداً يناديه باسمه من بعيد.
لم يكن الحاج في الدكان، فقد خرج لشراء شيء ما.
وقف حسن بقلق.
الصوت تكرر، هذه المرة أوضح:
"حسن.."
التفت.
لم يجد أحداً.
ثم رأى شيئاً جعله يحدق:
قطعة الطباشير البيضاء التي حملها معه دون أن ينتبه، كانت في جيبه.
أخرجها.
كانت تشعّ بخفوت، كأن داخلها ضوءاً صغيراً.
ثم انطفأ الضوء.
لم يعرف ما يقول.
عاد إلى كرسيه بسرعة، كأن الحركة ستجعله ينسى ما رأى.
لكن لم يُتح له الوقت.
فجأة سمع ضجة في الخارج.
خرج مسرعاً.
وجد الحاج عبد المولى ملقى على الأرض، يتنفس بصعوبة.
حاول أن يرفع رأسه، وصاح في الناس أن يتصلوا بالإسعاف.
حين حمل الحاج رأسه، رآه يفتح عينيه بصعوبة ويقول:
– حسن.. مفتاح الدكان.. خلي بالك منه..
– الله يرضي عليك حاج، غير تهوّن.
– الدنيا ما كتسوا والو.. ما تبقاش تهرب..
وتوقف الكلام.
أغمض الحاج عينيه.
لم يعرف حسن ما إذا كانت غفوة أم شيئاً آخر، لأن وجه الحاج صار شاحباً بطريقة غريبة، تكاد تكون شفافة.
في تلك اللحظة، ظنّ أن جسد الحاج أصبح خفيفاً لدرجة أنه يكاد يطفو.
حضر الإسعاف متأخراً.
وحسن بقي واقفاً في الزقاق، يده تمسك المفتاح الذي وضعه الحاج في يده قبل أن يغيب.
كان المفتاح ساخناً كأنه خرج لتوّه من النار.
مدّ يده ورأى أن حرارته تُكوّن ضوءاً خفيفاً، يشبه ذلك الضوء الذي رآه في الطباشير.
أغمض عينيه.
وحين فتحهما.. اختفى الضوء.
عاد إلى الدكان تلك الليلة، لكنه لم يستطع الجلوس.
جال ببصره بين الرفوف.
كان كل شيء هادئاً.. أكثر من اللازم.
ثم رأى شيئاً غريباً:
قطعة الطباشير التي كانت في جيبه، ظهرت فجأة على الطاولة، رغم أنه لم يضعها هناك.
اقترب منها ببطء.
كانت تتحرك قليلاً، كأنها تتنفس.
ابتعد، مذهولاً.
ثم ضحك على نفسه مرة أخرى.
"أصبحت أعيش في أوهام.. أو ربما تعب.. أو ربما شيء آخر."
في اليوم التالي، ذهب إلى المدرسة بوجه مختلف.
كان هادئاً بشكل غير مألوف.
وقف أمام التلاميذ، كتب كلمة واحدة على السبورة:
"البداية"
لكن لحظة كتابتها، انكسرت قطعة الطباشير نصفين.
وسمع الصوت بوضوح:
صدى جديد.. لكن هذه المرة كان الصدى يسبقه، لا يتأخر عنه.
لم يفهم.
نظر إلى السبورة.
الكلمة التي كتبها لم تعد "البداية".
صارت كلمة أخرى:
"البقية"
تراجع خطوة للخلف.
التلاميذ لم يلاحظوا شيئاً.
فقط حسن رأى الكلمة تتغير ببطء، كأن يداً غير مرئية تكمل ما بدأه.
خرج من الفصل مرتبكاً.
لم يعد يستطيع التمييز بين ما يراه وما يتخيله.
عند المساء، عاد إلى الدكان.
جلس في المكان نفسه.
كانت الزجاجة على الطاولة كما تركها.
لكنه لم يلمسها.
نظر إليها طويلاً، فرآها تتحول تدريجياً..
ظلّه داخلها صار واضحاً هذه المرة.
يحرك شفتين لا يسمع صوتهما.
مدّ يده نحو الزجاجة.. ثم سحبها.
كان يشعر أن حياته كلها تختصر في تلك اللحظة:
أن يلمس.. أو لا يلمس..
أن يختار.. أو يترك غيره يختار عنه.
في الخارج، سمع صوت الأطفال يلعبون.
ثم صوتاً آخر..
صوت الحاج عبد المولى.
لم يكن متأكداً إن كان الصوت يأتي من الخارج.. أم من داخله.. أم من مكان ثالث بينهما.
"حسن.. ما تبقاش تهرب."
أغلق عينيه.
لما فتحهما، وجد الكرسي أمامه فارغاً، والزجاجة فارغة..
أو ربما لم تكن هناك زجاجة أصلاً.
لم يكن متأكداً.
خرج من الدكان، والمفتاح في جيبه.
مشى في الزقاق ببطء، والهواء صار أثقل من العادة.
اختفت الأصوات تدريجياً، كأن المدينة تنام ببطء.
حين وصل إلى تقاطع الزقاق، توقف.
سمع خطوات خلفه.
التفت..
لكن لم يكن هناك أحد.
رفع عينيه إلى السماء.
الغيوم نفسها التي رآها صباحاً كانت ما تزال معلّقة، لكن بينها فتحة صغيرة، يظهر منها ضوء غامض، ضوء يشبه..
ضوء الطباشير.
وضوء المفتاح.
وضوء الحاج.
مدّ يده كأنه يريد لمس الفتحة.
لكن الهواء نفسه صار كثيفاً.
لم يعرف هل هو يحلم.. أم يستيقظ..
هل هو يبدأ.. أم ينتهي..
هل يسير إلى الأمام.. أم يعود إلى الوراء..
ولم يعرف أحد بعد ذلك إلى أين مضى حسن تلك الليلة.
هل عاد إلى الدكان؟
هل ذهب إلى المدرسة؟
هل تبع الصوت الذي يناديه؟
أم مشى نحو الضوء الذي فتح ثغرة صغيرة بين الغيوم؟
لا أحد يعرف.
فقط شيء واحد بقي مؤكداً:
الزقاق في تلك الليلة كان يقول اسمه بصوت خافت..
وحسن كان يجيب دون أن يفتح فمه.
***
حسن لمين - كاتب مغربي