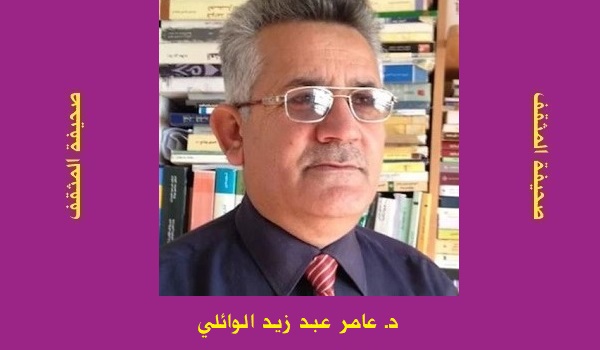آراء
توفيق السيف: انخفاض الخصوبة وتحدي الهوية

هذه خلاصة نقاش حول العوامل البنيوية التي تضغط على توجهات السياسة في أوروبا الغربية في الوقت الحاضر. وتلعب هذه العوامل أدواراً متفاوتة في كل المجتمعات الصناعية، كما أنها تُمثل تجربة متقدمة للمجتمعات التي تتجه نحو الاقتصاد الحديث بشكل عام.
تجدر الإشارة أولاً إلى فائدة التمييز بين نوعين من التحليل السياسي، أكثرهما شيوعاً هو الذي يُركز على التجاذب بين الأطراف الفاعلة في الميدان، بناءً على أن نتائج التجاذب، وما يكسبه كل طرف وما يخسره الآخر، هو الذي يُشكل الصورة الواقعية للحياة السياسية. أما النوع الثاني فهو الذي يُركز على العناصر الجيوسياسية، أي مصادر القوة، وأسباب الضعف الثابتة، التي لا تتغير بتغير الحكومة ولا البرامج السياسية، فهذه المصادر والأسباب تواصل تأثيرها في المشهد السياسي، أيّاً كانت المجموعة الحاكمة.
سوف أركز في هذه الكتابة على انخفاض معدل الخصوبة، وهو أحد العناصر الجيوسياسية المؤثرة على مسارات السياسة. وأشرحه مع الأخذ في الاعتبار تفاعله مع نموذج «دولة الرفاه»، الذي تقوم عليه الدولة الأوروبية، وربما نعود للحديث عنه بشكل مستقل في مقالة مقبلة.
معدل الخصوبة هو عدد الولادات المتوقعة لكل امرأة، ويجب ألا ينزل دون 2.1 مولود لكل امرأة، للحفاظ على عدد السكان نفسه من دون هجرة. ولهذا أطلق على هذا الحد اسم «معدل الخصوبة الإحلالي». ولو أردنا المقارنة، فإن السعودية مثلاً تحظى بالمعدل الأعلى عالمياً، أي 2.3 مولود حي لكل امرأة. أما في دول الاتحاد الأوروبي فقد انخفض المعدل إلى 1.34 مولود لكل امرأة في عام 2023. معدل الخصوبة مهم، لأنه هو الذي يُحدد قابلية المجتمع لتوفير اليد العاملة الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية، فإذا تناقص عدد المواليد، تناقص معه عدد الأشخاص المهيئين للعمل، في حين يزداد بشكل معاكس، عدد المتقاعدين الذين يحتاجون إلى مَن ينفق عليهم. في الوقت الحاضر تصل نسبة كبار السن (65 عاماً وأكثر) في الاتحاد الأوروبي، إلى 21.6 في المائة من السكان، وهي نسبة تتصاعد باستمرار.
انخفاض عدد العاملين، يعني تقلص الحراك الاقتصادي، ومن ثم انكماش موارد الدولة، التي تعتمد على الرسوم والضرائب، وهذا يقود طبعاً إلى زيادة الضغوط على نظام الخدمات العامة، وتجميد أي توسع أو تطوير يتطلب استثمارات كبيرة.
جرّب عدد من الدول، ولا سيما فرنسا والسويد، تشجيع الإنجاب، لكن هذه السياسات لم تلقَ نجاحاً يذكر. الحل الآخر الذي يبدو معقولاً هو السماح بالهجرة الواسعة. ألمانيا مثلاً استقبلت 1.5 مليون مهاجر في 2022، و660 ألف مهاجر في 2023. وتقول أرقام رسمية إن تدفق 200 ألف مهاجر سنوياً يضيف للاقتصاد الألماني نحو 100 مليار يورو على المدى الطويل. أي أن الهجرة تولّد قيمة اقتصادية صافية، رغم أنها تبدو -في أول الأمر- مكلفة. في الوقت الحاضر يمثل المهاجرون 25 في المائة من الشعب الألماني.
لكن الهجرة الواسعة ليست بلا تبعات، فقد أطلقت شعوراً بالقلق من فقدان الهوية أو تحولها. الواقع أن الحكومات الأوروبية تُحاول علاج هذه المشكلة، بالتركيز على قيمة التنوع الثقافي بوصفه جزءاً حيوياً من الهوية الوطنية. ولتأكيد هذا الاتجاه، تُشجع الحكومات المهاجرين على المشاركة في الحياة السياسية، وقد تولّى بعضهم فعلياً مناصب وزارية وعضوية البرلمان. لكن كثراً من السكان، ولا سيما المحافظين التقليديين، يتساءلون بقلق: هل سيتحوّل المهاجرون من محكومين إلى حكام أو مشاركين في حكم بلدنا؟
ربما يجيب بعضهم، ولا سيما من السياسيين التقدميين: وماذا في ذلك، ما دام المهاجر يعمل مثل المواطن الأصلي، ويؤدي واجباته الضريبية، ويشعر بأن هذا وطنه، تماماً مثل بقية المواطنين، فهل نشعر بالقلق لمجرد اختلاف لونه أو دينه أو طريقة عيشه؟
على السطح، تبدو هذه أسئلة بسيطة، ويبدو جوابها بديهياً. لكنها تخفي -في واقع الأمر- تعقيداً شديداً، ويختلط فيه المنطق بالعاطفة وانعكاسات التجربة التاريخية، على نحو يستحيل أن تعالجه الأجوبة البسيطة.
***
د. توفيق السيف