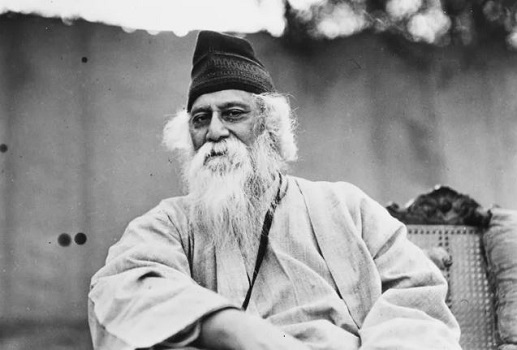آراء
صادق السامرائي: صناعة الدكتاتورية!!

الدكتاتورية كلمة أجنبية مستعربة وهي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد يسمى الدكتاتور أو جماعة أو فئة دكتاتورية. ويتم بواسطتها قمع الشعب وإبقاء الجهل والتخلف وتطويره
ووضع الناس في قوالب وتدجينهم وفقا لعقيدة السلطة، ومحاربة العقل والمنطق وتكفير العقول المنورة بالعلم والمعرفة وتهجيرها أو وضعها في المعتقلات، وإشغال الناس بالويلات والحاجات والعوز، واستغلال الدين لتثبيت الحكم، وكذلك نشر الفساد والرذيلة وتفكيك المجتمع وتدمير قيمه وأخلاقه، واستحداث أجهزة إستخبارية ذات وحشية عالية لتأمين مقومات إنتهاك الحرمات والفتك بالعباد.
وفي اللغة توجد كلمة طاغية وطغيان وهي من طَغى يَطْغى ويَطْغو طغيانا أي جاوَز الحدّ.
وكلُّ مجاوزٍ حدَّه فهو طاغيٍ، وطَغِيَ يَطْغى مثله.
وأطْغاهُ المال، أي جعلَه طاغِياً.
وطَغا البحر: هاجت أمواجُه.
وطغا السيل، إذا جاء بماءٍ كثير.
والطَغْيَةُ: أعلى الجبل. وكل مكانٍ مرتفع طَغْوَةٌ.
والطَغْيَةُ من كلِّ شيء: نبذة منه.
والطاغِيَةُ ملك الروم.
والطاغِيةُ: الصاعقةُ.
وقوله تعالى: "فأمَّا ثَمْودُ فأُهْلِكوا بالطاغِيَة" يعني صيحةَ العذاب.
وكذلك نستعمل كلمة مستبد أو إستبداد بذات المعنى، والمستبد هو الذي لا يشاور الناس ولا يخالطهم والإستبداد بالشيئ يعني إحتكاره ويسمى المستبد برأيه المستوزي.
لو أخذنا العراق مثلا في العصر الحديث فهو لم يعرف الدكتاتور منذ تأسيس دولته في الربع الأول من القرن العشرين وحتى قيام الجمهورية التي جلبت الدكتاتورية والصراعات الحزبية المدمرة. والملاحظ أنها أطلقت على أول زعيم في الجمهورية، وهو من عائلة بسيطة ومن عامة الناس، ويقال أنه صار كذلك بتفويض من نقابة المحامين في إجتماعها الذي حضره وانطلقت فيه أول مقومات صناعة الدكتاتور.
حيث وضعت الأسس الكفيلة بإخراجه من كونه من البشر وإضفاء الصفات الخيالية والفنتازية عليه، وبتكرارها مرارا صار يصدقها المعني بها، وبسببها أزرى بحاله وأحوال بلاده، مثلما فعل كل مَن جاء من بعده.
والدكتاتور الثاني في الجمهورية هو من عائلة بسيطة أيضا ومن عامة الناس، ولم يكن ذو تاريخ عائلي مهم في مسيرة البلاد، والصفات المشتركة بين الدكتاتورين الأساسيين في تأريخ البلاد السياسي المعاصر أنهما من عامة الناس.
وقد يتفق البعض أو لا يتفق على أن الزعيم الأول للجمهورية كان دكتاتورا أم لا، فهذا ليس موضع رأي وإنما نحن بصدد النظر في ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل.
ففي العهد الملكي لم يكن هناك دكتاتورا بل حكومات متعاقبة ورؤساء وزراء متعددين ولم يكونوا متعنتين، فمنذ عام 1921 وحتى عام 1958 تبدلت الحكومات وجاء عدد من رؤوساء الوزراء وأكثرهم بقاءا في منصبه لدورات متكررة هو آخر رئيس وزراء في المملكة .
ويبدو أن الزمن الجمهوري قد أطلق العنان للنوازع الدفينة والتفاعلات اللاواعية المشينة في المجتمع، مما أدى إلى التعبير عنها بالنشاطات (السياسية) التي أدت إلى إنهيار الوجود المجتمعي كحالة ثقافية حضارية وقوة فاعلة في محيطها الجغرافي.
وبنظرة فاحصة مركزة ومختصرة، يتبين أن هناك عوامل مرضية فاعلة في ديناميكية الصيرورات الإجتماعية ساهمت في تأجيج نيران الإحتدام وديمومة أسباب الصراع والتفاعل المناهض للحياة وقيمتها ودور الإنسان فيها. ومن أهم هذه العوامل:
أولا: الإذعانية
ففي أعماق لاوعينا إندفاع لصياغة حالة يكون فيها الإذعان سائدا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتفاعل بأساليب مطمئنة، وقادرة على تحقيق الرضى الإجتماعي العام، فلا يمكن للناس أن يبتكروا وسائل إتفاق وتفاعل مشترك تحقق مصالح الجميع، وإنما عندهم ميل لتحقيق (المصلحة) الذاتية أو المحصورة في عدد من الناس دون غيرهم، وهذا يؤدي إلى صراعات مدمرة، ولكي يتم تفادي هذه المرارة والقسوة الناشئة، يكون من واجب قوى اللاوعي أن تدفع بإتجاه إبتكار قوة تذعن لها جميع القوى، ولهذا فأن المجتمع بكافة ما فيه، يمضي إلى صناعة القوة الكفيلة بلجم دوافع الصراع المنطلق من أعماقه، فيكون الدكتاتور هو الدواء الدفين لمرض عضال وسرطان نفسي شرس ووقح التعبير عن وجوده الفتاك.
فترى الناس لا يعرفون إلا الركض العاطفي المنفعل خلف أي شخص يمكن تأكيد معالم الإستبداد والطغيان فيه، والخضوع له وإتباعه بلا تفكير أو سؤال، ويتحول الناس إلى وجود يهتف بإسمه ويموتون من أجله ويفدونه بكل شيئ ويضفون عليه صفات أكثر من إلهية ويقدسونه تقديسا عجيبا وغريبا.
والإذعانية المفرطة العمياء، تحرر الناس من المسؤولية وتلقيها على الآخر الذي يتبعون ويرقصون أمامه، ويهتفون بحياته وعظيم أمجاده، وما تغير هذا السلوك بتغير الوجوه والأحزاب والأنظمة، وكأن الناس لا تعرف كيف تتحمل المسؤولية ولا تريدها، وإنما أن تكون أدوات منفذة لشخص يعبر عما فيها من النوازع والتطلعات التي تخشاها.
ثانيا: السادة
وهذه الحالة السلوكية المهيمنة على المجتمع قد دمرت وجوده وأنهكت قدراته الإيجابية، وحولته إلى قطيع من الذئاب والأغنام، أو إلى ديكة تطغى ودجاج يسبط وينيخ ولا وسط بين الحالتين. وظاهرة الذئاب المفترسة والأغنام التي لا يمكنها أن تثاغي هي سمة متميزة، ففي كل مرحلة هناك ذئاب وأغنام، كما يتم تبادل الأدوار.
ذئاب تقتل وتعذب وتشرّد وتحتكر وتفترس بعنفوان وشراهة مفلوتة لا تعرف الحدود .
وهناك أغنام يتم جزرها وسلخها والتمثيل بأبدانها، ووضعها في المزابل أو في مقابر جماعية، وما إلى غير ذلك من السلوكيات التي لا يتجرأ على القيام بها أكثر الحيوانات وحشية وفتكا. والسادة بمفهومها تكون مرتبطة بالكرسي وبالمال، فما أن يمتلك الشخص المال والقوة، حتى راح يبحث عن لقب السيد، أي الإنتماء إلى النبي بصلة الدم، وتراه قد وضع شجرة العائلة ورفع راية نسبه وقال بأنه السيد، والآخرون من حوله عبيد وعليهم أن يقبّلوا يديه ويسجدوا أمامه، أو أنه الذئب ومَن حوله قطيع أغنام.
و (السيد) من أخطر العوامل التي مزقت المجتمع، وهي غير موجودة في المجتمعات العربية والإسلامية بهذه القوة والكثافة والفاعلية مثلما هي عندنا.
ولا توجد أدلة عملية وإثباتات رسمية تؤكد الإرتباط ما بين النبي والمدعي بأنه (سيّد) لأن ذلك قد خضع لإرادة الكراسي عبر العصور، ولا ندري إذا سوف يستطيع التقدم العلمي إثبات ذلك الإرتباط من خلال تحليل الحامض الأميني، ولا بد من البحث في رميم الأموات عن مادة الحامض الأميني الأساسية للمقارنة بها.
فظاهرة السادة في المجتمع قد تكون وهمية وتنافي معظم الأدلة والبراهين والمنطق.
ولا يمكن التصديق بأن هذا العدد من البشر السيد أو المتسيّد في الوقت الذي قضت الوقائع والصراعات السياسية على معظم ذلك النسل، كما أن الأمراض الوبائية كالطاعون كانت تقضي على عشرات الآلاف في وقت قصير، وتمحق عوائل بكاملها، وهناك مَن صار عدد أبنائه أكثر من أربعين لكنهم ماتوا في ظرف أيام بموجة طاعون واحدة.
وهذا يعني أن ظاهرة السادة نظرة لا تتوافق مع بديهيات الأمور، لكنها يبدو قد تم إستخدامها كوسيلة للسيطرة على الآخرين، وبسببها فأن الجالس على الكرسي يسمي نفسه سيدا وكل مَن حوله عليه أن يخضع ويتبع.
بينما حقيقة السلوك النبوي وآله وأصحابه، كان سلوكا ساميا وترجمة عملية للقرآن الكريم، وما كانت فيه الفوقية والإستعبادية والإستخواذية والإستهتار بحقوق الناس ومصائرهم، فالذي يدّعي بالسادة عليه أن يقدم سلوكا إنسانيا ساميا رحيما عفيفا نزيها، فكيف تفسر الفساد في بلدٍ كل مَن فيه يقول أنا سيّد؟!!
ثالثا: المعصومية
هذه أيضا من الأمراض الخطيرة المنافية للعقل والأصول في الحياة البشرية، حيث تعطى صفة عدم الخطأ لبشر مخلوق من الطين وسيعود إليه حتما.
ولا توجد أي نصوص قرآنية أو إثباتات عبر مسيرة البشرية تؤكد بأن البشر لا يخطيء.
وبسبب ذلك إتجهت المجتمعات القديمة إلى صناعة البشر الإله، وهذا واضح في الحضارات القديمة، وهي لا تقضي بأنه لا يخطيء وإنما لأنه إله يجب أن يطاع فهو الأدرى والأعرف، ومنها جاءت مفاهيم الكراسي أدرى وأعرف لأنها ذات مواصفات إلهية.
والمعصومية قد أجهزت على العقل وصادرت ما عنده من آليات الإبداع والتفاعل الإيجابي مع الحياة، فصار الكرسي معصوما وكل ذي قوة معصوم، كما أن الحاكم معصوم فهو لا ينطق إلا صحيحا ولا يمكن أن يقول خطأً.
ولهذا تميز الدكتاتور بأنه لا يخطيئ ويذعن له الجميع وأنه فوق القانون، وهو الذئب والناس من حوله خراف، وعليه أن يجزر منهم ما يشاء ولا مَن يحاسب أو يقول له قد أخطأت لأن ذلك يعد كفرا، ومن المحرمات والموبقات والإخلال بشرف الأخلاق والدين، أو خروجا عن شرع الذئاب المصيبة أبدا.
والمعصومية ليست مرتبطة بفئة أو مذهب، إنها تشمل جميع أطياف المجتمع وهي ظاهرة مجتمعية وليست مذهبية كما يتوهم البعض.
فكل سيد معصوم، هذا ما يدور في دياجير الأعماق الجمعية، وما دام الجميع سادة فأنهم لا يخطئون، وهذا يدفع إلى عدم الإتفاق ما بين المواطنين أينما كانوا، وفقدان قدرات الحوار والتوافق والإنسجام بينهم.
ومن هنا فأن المجتمع يساهم بتفاعلاته اللاواعية والغير مباشرة في صناعة الدكتاتور الذي يفترسه ويعذيه ويسومه سوء الويلات.
وهكذا نرى لكل حزب دكتاتور، ولكل فئة دكتاتور، ولكل تجمع مهما كان حجمه دكتاتور، لأنها حاجات نفسية منحرفة، وتفاعلات مرضية مزمنة ولها مضاعفات متطورة يصعب الإقتراب منها وعلاجها، لأن الداء قد أعيا مَن يداويه، ذلك أن الطبيب المداوي يعاني من نفس الداء، ولهذا لا يمكنه أن يشخصه ويصف أعراضه ويكتشف العلاج المناسب له.
رابعا: الشعور القاسي بالذنب
الفاعل الأليم في النفس المجتمعية شعور مروع بالإثم والذنب الكبير، الذي عمقته وجسدته الأيام والتفاعلات المتنوعة، التي تجنح للندب وقهر الذات والتلذذ بتعذيبها، ولذلك فأن الغناء والشعر والإبداع يصطبغ بالحزن والتوجع، والتلذذ بالألم وإستلطاف الظلم والإمعان بالتشكي.
ويبدو أن هذا السلوك إمتداد للعنة أكد التي فعلت فعلها في حضارات البلاد القديمة، وقد أججتها وفتقت جروحها مأساة كربلاء، التي اثرت على نفوس الناس أجمعين بلا إستثناء، وولدت عندهم شعورا عنيفا بالذنب، وكأنهم وبدون شعور منهم يتوجهون لتوفير الأسباب الكفيلة بعقابهم، وقد إزداد هذا الشعور مرارةً بعد ما جرى للعائلة المالكة والتي هي من سلالة هاشمية.
والملاحظ أن بعد مجزرة قصر الرحاب تواصلت المجازر والتفاعلات الدامية المريرة النتائج والتداعيات.
ولكي يستريح الناس من نيران الشعور بالذنب لا بد لهم من توفير القوة التي تساعد على إخمادها، ويكون الحاكم الجائر هو الدواء الذي يعالج أجيج هذا الشعور القاسي، ومعنى ذلك أن المواطن لن يعيش بسلام في زمن الديمقراطية والحرية، لأنها ستفتق جراحه وتطلق نواعير الشعور بالذنب المعتق في جيناته، والمؤزر بما يتحقق في محيطه الدامع الحزين.
وفي الختام، إن وعي هذه العوامل الجوهرية التي هي أعمدة الدكتاتورية وإدراك أن البشر من نفس واحدة وأمة واحدة، وأن هذه التوصيفات المجردة من التعبير المؤكد لها والإنجازات اللائقة بها، إنما هي أوهام على المجتمع أن يتحرر من قيودها .
فالناس سواسية ولا فرق بينهم إلا بالعمل (كلكم من آدم وآدم من تراب) وما قيمة الفرد إن لم يصنع قيمته بنفسه، وما قيمة الفرد الذي هو من نسل فلان، وما هو إلا دون كل إنسان في قوله وفعله وما عنده سوى العظام.
ووفقا لما تقدم فأن المجتمع اليوم رغم كل ما فيه من الشدائد يسعى بجد وإنفعال لصناعة الدكتاتور الذي يذعن له لبناء جمهورية التدمير الأشمل، التي توّجت عهد الجمهوريات الخائبة.
والدكتاتور القادم لا يختلف عن سابقيه، فهو من عامة الناس وزاول جميع الحرف البسيطة، وفجأة صار سيدا وذو حسب ونسب وصاحب قوة ومال وجاه ولا يمكنه أن يخطأ، وأسس فريق ذئاب من حوله تفترس الناس المقيدة بالحاجات اليومية وبلا رحمة.
وأرجو أن لا نصنع طاغية مستبدا لكي نرضي حاجاتنا الدفينة الفاعلة فينا والمتحكمة يسلوكنا وآليات تفكيرنا ونرفع رايات المظلومية!
فتحرروا من عاهات (السادة والمعصومية والإذعانية والشعور بالذنب) لكي تعاصروا الأمم وتساووا الأوطان، وارفعوا رايات العقل، فإن العقل إمام وسيد وسلطان!!
***
د. صادق السامرائي