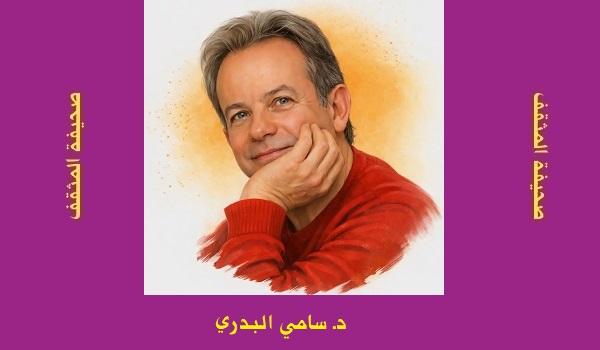قضايا
فضل فقيه: أزمة إعادة التكرار في العلم التجريبي

تُعد قابلية التكرار إحدى الركائز الأساسية للمنهج العلمي. فالمعرفة الناتجة عن العلم التجريبي يجب أن تكون قابلة لإعادة التجربة والتأكيد. إن إعادة التكرار، أي إعادة تنفيذ التجارب والحصول على نتائج مماثلة، ليست مجرد أمر تقني، بل مسألة جوهرية تعبّر عن التزام العلماء والعلم بأقصى درجات الشفافية والموضوعية في بناء المعرفة. أظهر استبيان نشر في عام 2016 أن 70% من علماء الحياة فشلوا في إعادة تكرار تجارب نُشرت في مجلات بحثية، كما أن 60% منهم فشلوا في تكرار تجاربهم الخاصة.
ما هي إعادة التكرار؟
بعد تنفيذ التجربة والحصول على نتائج، يُفترض أن يعيد الباحث التجربة تحت نفس الشروط لثلاث مرات على الأقل قبل اعتماد النتائج ونشرها. غير أن التكرار الذاتي لا يمثل جوهر المشكلة. الأزمة الكبرى تظهر عندما يحاول علماء آخرون إعادة التجربة المنشورة. هنا تبرز أنواع متعددة من التكرار: التكرار المباشر الذي يعيد التجربة تحت نفس الشروط، والتكرار التحليلي الذي يعيد تحليل البيانات الأصلية، إضافة إلى التكرار المنهجي والمفاهيمي. ويُعد الفشل في التكرار المباشر والتحليلي الأخطر، لأنه يكشف عن ثغرات عميقة في أسس المعرفة العلمية المنشورة.
أسباب الأزمة
من بين أبرز العوائق لنجاح إعادة التكرار غياب الوصول إلى البيانات الأصلية، والبروتوكولات، والمواد الحيوية المستخدمة، إذ تُنشر هذه التفاصيل غالبًا بشكل مقتضب في الأوراق البحثية. بدون الشفافية الكاملة، يصبح تكرار التجارب مهمة شبه مستحيلة.
وتتفاقم المشكلة مع الاعتماد المتزايد للعلم الحديث على تحليل البيانات الضخمة، ما يزيد من احتمالية الوقوع في أخطاء منهجية دقيقة إذا غفل الباحثون عن تفاصيل مهمة في التحليل الإحصائي وإدارة البيانات.
مع ذلك، فإن جذور الأزمة تتجاوز الإخفاقات التقنية لتصل إلى بنية الثقافة الأكاديمية ذاتها. ففي بيئة تكافئ النتائج الإيجابية وتتجاهل النتائج السلبية أو غير المثيرة، ينشأ تحيز بنيوي يُشجع على انتقاء البيانات وتجاهل النتائج التي لا تتماشى مع التوقعات. ينتج عن ذلك علم هش يخدم أهداف النشر والتسلق الأكاديمي أكثر مما يخدم البحث عن الحقيقة. ومع أن هذا الموضوع يستحق مقالة مستقلة لمناقشته بعمق، يكفي أن نشير هنا إلى أن النظام الأكاديمي الحالي يسهم في تعزيز هذه الأزمة أكثر مما يسعى إلى حلها.
الموضوعية كمطلب فلسفي
في هذا السياق، تبرز الموضوعية كمطلب فلسفي عميق، لا مجرد التزام علمي شكلي. ينبغي على الباحث أن يتبنى موقفًا أخلاقيًا يتمثل في قبول النتائج كما تظهرها التجارب، إذ تعكس هذه النتائج، مهما كانت، طبيعة الواقع كما هو، لا كما نرغب أن يكون.
يتطلب ذلك التحليل الخالي من التحيز والابتعاد عن القفز إلى تأويلات لا يسندها الواقع. فالباحث، في جوهر عمله، خادم للحقيقة، لا سيدٌ عليها. كذلك، يجب أن تمتد الموضوعية إلى المؤسسات البحثية والمجلات العلمية، إذ لا يجوز تهميش النتائج، سواء كانت إيجابية أم سلبية. فكل تجربة، أياً كانت نتائجها، تشكل لبنة ضرورية في بناء المعرفة.
إن الموضوعية، بهذا المعنى، لا تخدم فقط الاقتصاد البحثي بتقليل الإهدار والتكرار، بل تصون جوهر البحث العلمي ذاته. وكما أشار كارل بوبر، فإن العلم لا يتقدم عبر إثبات الفرضيات، بل من خلال فشلها وتصحيح الأخطاء.
في الختام: العلم مشروع إنساني في جوهره
تحاول بعض المجلات والمؤسسات العلمية اليوم اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية، ومشاركة البيانات، وضمان قابلية إعادة تكرار النتائج. لكن الطريق ما يزال طويلًا. فالتقنيات تسهّل العمل العلمي لكنها لا تستطيع أن تحل محل روح الموضوعية والشجاعة الفكرية التي يجب أن يتحلى بها الباحثون.
تذكرنا أزمة القابلية للتكرار بأن العلم، مهما تطورت أدواته، يبقى مشروعًا إنسانيًا في جوهره، مشروعًا يسعى إلى الحقيقة عبر شك دائم وتصحيح مستمر للذات. وإن أردنا أن نصون هذا المشروع، فعلينا أن نعيد إلى الواجهة تلك القيم التي تأسس عليها العلم منذ بداياته: الصدق، التواضع أمام الطبيعة، واحترام الحقيقة أينما قادتنا.
***
فضل فقيه – باحث
........................
قراءات اضافية:
Baker, M. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature 533, 452–454 (2016).