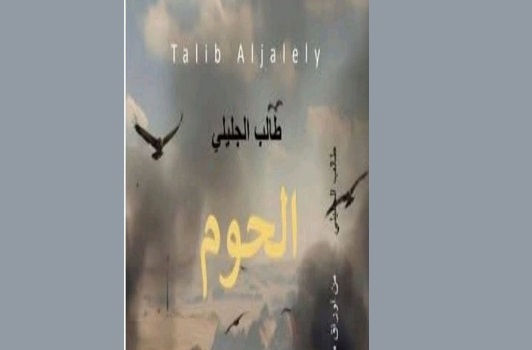قضايا
محمد الزموري: كيف يقول المرء لنفسه وداعا؟

كتب دون ديليلو في روايته ضوضاء الخلفية: "نقضي حياتنا كلها في تعلّم توديع الآخرين، ولسنا مستعدّين أبدًا لتوديع أنفسنا.".. عبارة تترك أثرًا مزدوجًا في النفس: تبدو للبعض عميقة كجرح مفتوح، وللآخرين سطحية كغبار خفيف على مرآة الوعي. لكن سواء نظرنا إليها كحكمة أم هراء، فهي تُسلّط الضوء على لحظة فارقة، لحظة المواجهة مع فكرة الفقد، لا كحدث خارجي، بل كزلزال داخلي يهزّ أعمدة الذات.
في ظاهر الأمر، يبدو أن الإنسان يعلم كيف يودّع أحباءه، أقرباءه، رفاقه، مدنه، وحتى ماضيه. ولكن الحقيقة أعمق وأكثر مراوغة. نحن لا نتعلّم شيئًا من هذا القبيل. نحن نُتقن فنّ التهرّب. نهرب من فكرة الموت، من فكرة النهايات، من هشاشة الوجود، ومن اللحظة التي يتعيّن علينا فيها أن نُسلّم بأن كل شيء مؤقت – نحن، والآخرون، وحتى هذا الحزن الذي نحمله على ظهورنا كظلٍّ ثقيل.
لقد أصبحت ثقافتنا الحديثة متخصصة في إخفاء الموت كما يُخفى الغبار تحت السجادة. المستشفيات – مع أنها أماكن توديع بامتياز – لا تملك غالبًا طقوسًا إنسانية تليق بلحظة الرحيل. وإذا كانت المؤسسة الطبية لا تعرف كيف تودّع، فكيف يكون حال الإنسان العادي؟ كيف لهذا المواطن المُثقل بالفواتير، والإعلانات، والإشعارات، وقلق المستقبل أن يفهم ما يعنيه أن تقول لشخص تحبه: وداعًا إلى الأبد؟
كتب مونتين في تأملاته: "أن نتعلم كيف نعيش، هو أن نتعلم كيف نموت." لكننا لم نتعلم لا هذا ولا ذاك. نحن لا نعيش، نحن نؤجّل. ولا نموت، بل نُخفي الموت في أركان الوعي، كضيف غير مرغوب فيه.
في زمن ما بعد الحداثة، أصبح الإنسان أشبه بمتسوّل أمام شاشة هاتفه: يشتهي الإلهاء، يطلب مهربًا من ذاته، من تأملاته، من تلك الأسئلة القديمة التي أرّقت سقراط: من أنا؟ وإلى أين أذهب؟ ولماذا هذا العناء؟ لكن لم يعد هناك سقراط ليُزعجنا، بل خوارزميات تصمّ الوعي وتصرفه عن نفسه.
الهروب من التفكير في الموت ليس امتيازًا معاصرًا، لكنه ازداد حدّة بفعل الهوس الجديد بالذات، تلك "الذات" التي تُربّى كما تُربّى نبتة نرجسية في أصيص من المرايا. أصبحت الذات مشروعًا مفتوحًا على تعديل مستمر، صفحة إنستغرامية تحتاج إلى فلاتر، وسيرة ذاتية تحتاج إلى تحديث يومي.
لكن المفارقة أن هذا الهوس بالذات لا يُقوّيها، بل يُنهكها. يقول كريستوفر لاش في كتابه ثقافة النرجسية: "في مجتمع يعاني من فراغ داخلي، تُصبح الذات صنمًا يُعبد." ونحن – دون أن نشعر – عبدنا هذا الصنم، وسمّيناه تنمية ذاتية.
يبدو أن "الوداع" الوحيد الذي يستحق أن نتعلّمه ليس وداع الآخرين، بل وداع تلك الذات المتضخّمة، المهووسة بعيوبها وتفوقها، بجمالها وانكسارها، بخوفها من الزوال وحبها للظهور. هذا هو الوداع الحقيقي، أن تودّع وهم السيطرة، وأن تعود لتكون كائنًا طبيعيًا، يأكل، يحب، يعمل، يحزن، ويموت، دون أن يحتاج كل ذلك إلى عرض مسرحي داخلي لا ينتهي.
يقول شوبنهاور: "الوعي الذاتي الزائد مرض من أمراض الحضارة." فكلما فكر الإنسان في نفسه أكثر، ازداد بعدًا عنها. يصبح وجوده شبيهًا بمن يراقب نفسه في المرآة وهو يحاول النوم. هذا هو ما يشلّ الحركة ويقتل العفوية ويحوّل الحياة إلى تجربة مختنقة.
في ضجيج ما بعد الحداثة، حيث كل شيء يُعلن عنه ويُصوَّر ويُشارَك، فإن أجمل شيء قد تفعله مع نفسك هو أن تتوقف عن مراقبتها. أن تُسلّم نفسك لما هو خارجها. أن تعيش، لا لتصنع هوية، بل لتكون جزءًا من نهر يتدفق دون أن يحتاج إلى تعريف.
وإذا كان لا بد من وداع، فليكن وداعًا لذلك الوعي الزائف الذي يجعلنا نرتجف أمام فكرة أننا لسنا مركز الكون. وداعًا لذلك الاجترار الداخلي الذي يجعل كل لحظة تحتاج إلى تحليل، وتفسير، وتبرير. وداعًا لتلك "الذات" التي لا تتركنا في سلام، بل تطاردنا كصوت خلفي في دوامة لا تنتهي.
كتب هايدغر أن: "الوجود الأصيل يبدأ عندما يواجه الإنسان موته." فربما علينا أن نكفّ عن تجنب هذا اللقاء، لا لنموت، بل لنبدأ حقًا في العيش.
***
الأستاذ محمد إبراهيم الزموري