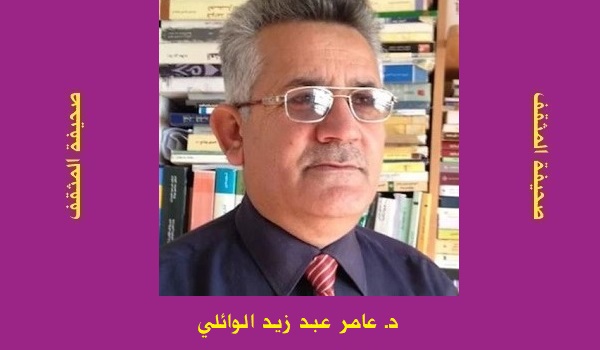قضايا
مصطفى غلمان: الهَشَاشَةُ المُنَظَّمَةُ

صُنْعُ السُّلْطَةِ لِاسْتِسْلَامِ الشُّعُوبِ وَإِعَادَةُ إِنْتَاجِهِ
نعوم تشومسكي: "من استراتيجيات التحكم في الشعوب: تشجيع الناس على استحسان الرداءة، وعلى الاعتقاد بأن من الرائع أن يكون المرء غبياً، همجياً، وجاهلاً."
في عالمٍ تتحكم فيه المعلومة كما تتحكم فيه القوانين، وتعيد فيه الخوارزميات تشكيل وعي الأفراد، يبرز سؤال استراتيجيات السيطرة على الشعوب كعنصر محوري لفهم العلاقة بين السلطة والمواطنين. يشير نعوم تشومسكي إلى أن من أبرز هذه الاستراتيجيات تشجيع الناس على استحسان الرداءة، وعلى الاعتقاد بأن الغباء والهمجية والجهل صفاتٌ “طبيعية” أو حتى مرغوبة. هذه السيطرة ليست مجرد قوة مادية أو سياسية، بل هيمنة ثقافية وإيديولوجية تعيد تشكيل مفاهيم الأفراد حول القيم والحرية والعدالة.
فالسلطة المهيمنة ليست فقط حكومة أو مؤسسة، بل بنية متكاملة تستمد شرعيتها من الهيمنة الرمزية، ومن القوة الإعلامية والاقتصادية، ومن الإطار القانوني الذي يدعم مصالحها، بحيث يصبح المواطنون يقبلون الوضع الراهن على أنه “طبيعي” ويستسلمون لهيمنتها دون مقاومة واعية. ويؤكد ميشيل فوكو أن السلطة «تُمارس داخل العقل كما تُمارس على الجسد»، فيتحول القمع الخارجي إلى رقابة داخلية مستبطَنة، تجعل الفرد حارسًا على نفسه.
تاريخيًا، لم تنشأ هذه السيطرة من فراغ. فقد ورثت الدول الحديثة استراتيجيات استعمارية قديمة تمزج بين القوة العسكرية والهيمنة الثقافية، حيث تحولت اللغة والتعليم والرموز الوطنية إلى أدوات ناعمة لإعادة إنتاج التبعية. أنطونيو غرامشي نبّه مبكرًا إلى أن أخطر أنواع السيطرة ليست تلك التي تُمارَس بالعنف الصريح، بل تلك التي تجعل الخاضعين يتبنون قيم القامع نفسه.
ومع التحولات الرقمية، انتقلت هذه السيطرة إلى مستوى جديد، رأسمالية المراقبة، كما تسميها شوشانا زوبوف، حيث تتحول بيانات الأفراد إلى مورد اقتصادي وسلاح سياسي معًا. كل نقرة، كل بحث، كل تفاعل على الشبكات الاجتماعية يصبح مادة لقياس الطاعة والامتثال، ولبناء ملفات سلوكية يمكن من خلالها توجيه الرأي العام أو احتوائه.
على المستوى النفسي، تُستَثمر سيكولوجيا الخوف. الخوف من الإرهاب، من الفوضى، من انهيار الأمن لتبرير الطوارئ وتمديد القبضة الأمنية. وتُغذّى الهويات المنقسمة طائفية، إثنية، أو جهوية، بهدف تفكيك التضامن الشعبي وتفادي أي جبهة مجتمعية موحَّدة. وهنا يستحضر بيير بورديو مفهوم «العنف الرمزي»، إذ يصبح المواطن ذاته منفِّذًا غير مرئي للرقابة، فيراقب نفسه ويعاقبها.
في مواجهة ذلك، يؤكد ألبرت كامو أن «الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع»، ما يجعل من النضالات المدنية والفكر النقدي أدوات حيوية. ورغم إحكام الخوارزميات قبضتها على المجال العام، فإنها تتيح في الوقت نفسه إمكانات غير مسبوقة للتعبئة، كما برهنت حركات احتجاجية عابرة للحدود (، الربيع العربي، حركات المناخ) التي حولت الصورة والفيديو والهاشتاغ إلى أسلحة تحرر.
في المغرب المعاصر، تتجلى هذه الديناميات في قضايا ملموسة، كاختلالات التعليم والصحة، أزمات سوق الشغل، وقمع بعض أشكال الاحتجاج السلمي. المواطن المغربي يواجه صدمة مزدوجة، ضعف منظومة الاحتجاج المدني مقابل قسوة تدخلات الأمن العمومي، ما يعكس نجاح الهيمنة الرمزية في إعادة تعريف الحرية والمعايير الاجتماعية. الصور القاسية التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات السلمية تكشف فجوة بين خطاب الدولة عن “النموذج التنموي” وبين واقع القمع أو التهميش، وهو ما يضع مصداقية الدولة أمام اختبار مستمر لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتمكين المواطنين من التعبير عن مطالبهم.
ولا يقتصر التحكم على القوة المباشرة؛ بل يتجلى أيضًا في الهيمنة الثقافية والإعلامية، عبر إعادة إنتاج القيم والمعايير لتطبيع الرداءة والامتثال، وفي الاستبداد البنيوي الذي يقيّد المجتمع المدني ويهمش مؤسسات الرقابة والمساءلة. وكما تحلل هانا آرندت، حين يُلغى الحكم الأخلاقي، ينهار شعور الإنسان بالمسؤولية، فتتحول الطاعة إلى فضيلة في الوعي الجمعي.
ومع ذلك، تُظهر التجربة التاريخية أن هذه السيطرة ليست مطلقة. فعندما تُفرط السلطة في القمع أو تفشل استراتيجياتها، تنفجر الاحتجاجات بأشكال جديدة، من الاعتصامات الميدانية إلى الفضاءات السيبرانية المفتوحة بلا حدود. وهنا يبرز سؤال ما بعد الدولة القُطرية: هل يمكن لوعي جمعي عابر للحدود أن يشكل تضامنًا كونيًا ضد هيمنة سياسية واقتصادية تتخطى الأوطان؟
إن الهيمنة في جوهرها ليست مجرد إرادة قهرية، بل شبكة معقدة من القوة والمعايير والرموز. وأي مقاومة حقيقية تتطلب وعيًا نقديًا جماعيًا يواجه هذه الشبكة في مستوياتها المختلفة: التعليم، الإعلام، الاقتصاد، والقيم. وحده هذا الوعي المتجدد عبر الفنون والفكر والحركات المدنية، قادر على إعادة توازن العلاقة بين السلطة والمواطن، وضمان كرامة الأجيال القادمة وحقها في تقرير مصيرها.
***
د. مصـطـفــى غَـــلمـان