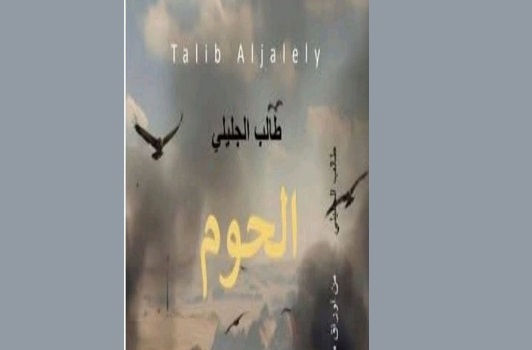قضايا
مراد غريبي: عن جينالوجيا الوهم الثقافي.. نحو تشريح ظاهرة أشباه المثقفين

مفتتح: ليس عجيبا لأي أحد أن المشهد الثقافي العربي المعاصر يعاني من تضخم مرضي في حضور فئة لا تنتمي إلى عالم المعرفة الحقيقية، بقدر ما تنتمي إلى عالم الاستعراض والمظاهر الفارغة. إنها فئة "أشباه المثقفين أو أدعياء الثقافة"، تلك الكائنات الهجينة التي تسكن الفضاءات الثقافية دون أن تمتلك أدنى مقومات الفعل الثقافي الجاد والحقيقي.
كان بيير بورديو قد أسس لمفهوم "الحقل الثقافي" باعتباره فضاءً للصراع الرمزي حول الشرعية والاعتراف¹، لكننا ما نشهده اليوم في مجالنا العربي هو احتلال هذا الحقل من قبل دخلاء لا يملكون سوى براعة التسويق الذاتي والقدرة على استثمار الفراغ المعرفي السائد وشراء مسميات لا علاقة لها بواقعهم الحقيقي.
إن ظاهرة أشباه المثقفين ليست مجرد عارض طارئ على جسد الثقافة العربية، بل هي نتاج بنيوي لأزمة عميقة تتعلق بتحلل معايير الشرعية المعرفية وانهيار أخلاقيات الممارسة الثقافية². فالمثقف الحقيقي، كما عرّفه أنطونيو غرامشي، هو ذلك الكائن العضوي المرتبط بطبقته والمنخرط في صراع الأفكار من موقع المسؤولية التاريخية³، بينما شبه المثقف او المثقف المزيفة كالعملات المزيفة- هو كائن طفيلي يعيش على هامش المعرفة، يتغذى من فتات المصطلحات ويردد الشعارات دون أن يمتلك أي ادنى عمق فلسفي أو التزام أخلاقي تجاه قضايا مجتمع. وقد أصاب علي حرب كبد الحقيقة حين شخّص أوهام هذه النخبة الزائفة، مبيناً كيف تحولت الثقافة في أيديهم إلى سلعة استهلاكية ومصدر لتراكم الرأسمال الرمزي المزيف⁴.
سوسيولوجيا الانحطاط الثقافي
إن فهم ظاهرة أشباه المثقفين يتطلب تشريحاً سوسيولوجياً لآليات إنتاجها وإعادة إنتاجها ضمن البنية الثقافية العربية المعاصرة. فهذه الظاهرة ليست محض صدفة، بل هي محصلة لتحولات بنيوية عميقة شملت السلطة الرابعة المؤسسة الإعلامية التي تحولت إلى آلة لصناعة المشاهير الثقافيين على حساب المفكرين الحقيقيين، والمؤسسة الأكاديمية التي فقدت استقلاليتها وتحولت إلى مصنع لإنتاج الشهادات دون المعرفة والضباع والذئاب والثعالب البشرية التي لا تملك حتى الطباع الغريزية الحميدة لهذه الحيوانات، والفضاء الرقمي الذي أتاح لكل من يملك حساباً على وسائل التواصل أن يدّعي صفة المثقف والمفكرو الناقد والمترجم، إن منطق الرأسمالية الثقافية الذي يحكم هذه المؤسسات يقوم على تسليع الفكر وتحويل الثقافة إلى صناعة ترفيهية، مما أفسح المجال واسعاً أمام من يُتقنون التسويق الشعبوي والاستعراض الإعلامي على حساب من يشتغلون في صمت على إنتاج معرفة حقيقية⁵.
دون أن نغفل عن غياب آليات التقويم النقدي الحازمة وضعف دور النقد الأكاديمي المستقل الذي ساهم في خلق بيئة خصبة لنمو هذه الظاهرة. ففي غياب معايير موضوعية لتقييم الإنتاج الفكري، يصبح الحضور الإعلامي والشهرة العابرة بديلاً عن العمق المعرفي والإسهام الفكري الحقيقي، وهنا تتجلى خطورة ما أسماه ليوتار "نهاية السرديات الكبرى"⁶، او ما تحدث عنه اعلامي الثقافة الفرنسية برنار بيفو في كتابه (مهنة القراءة) حيث يؤدي الانهيار القيمي إلى نسبية مطلقة تُلغي التمييز بين الجاد والهزلي، بين المعرفة والادعاء، بين الأصيل والهجين.
مسارح الزيف وسوق السفهاء
تشكل المؤتمرات الثقافية والمعارض والملتقيات الأدبية والفكرية، في كثير من الأحيان، مسارح حقيقية لاستعراض أدعياء الثقافة والاستاذية والاكاديمية والفكر والفقاهة والاعلام. فهذه الفضاءات التي يُفترض أن تكون منابر للحوار المعرفي الجاد والنقاش الفلسفي العميق والفقاهة الرصبنة، تحولت إلى أسواق للمتاجرة بالألقاب والشهادات المزيفة، يحضر هؤلاء بأناقة مفرطة، يتصدرون المنصات، يلقون خطابات منمقة محشوة بالمصطلحات الفلسفية التي لا يفقهون معناها لان اغلبهم قد تم تجهيزها لهم من لدن مريديهم السفهاء، ويتبادلون الإطراءات المبالغ فيها في عملية تشابك نفعي لا علاقة لها بالمعرفة بشتى صنوفها. إن هذه "الدبلوماسية الثقافية المزيفة" التي يمارسها أشباه المثقفين تحول هذه الفعاليات إلى طقوس رمزية تستخف بعقول الناس، هدفها تعزيز الحضور الإعلامي وتبادل المصالح، لا إنتاج المعرفة أو إثراء الحوار الفكري او التجديد والاصلاح.
إنهم "سفهاء الإعلام والثقافة"، كما يمكن تسميتهم بلا مجاملة، يتكاثرون في هذه الفضاءات كالفطريات في أرض رطبة. يتقنون فن التملق والمداهنة، يجيدون صناعة العلاقات مع أصحاب النفوذ الإداري والسياسي، ويحولون كل فعالية ثقافية إلى مناسبة لالتقاط الصور والظهور في وسائل التواصل الاجتماعي⁷. إنهم لا يقراون، لا يبحثون، لا يساهمون بأي إضافة معرفية حقيقية، لكنهم يتقنون الظهور والحضور والاستعراض.
وقد بيّن محمد أركون في تشخيصه لأزمة المثقف العربي كيف أن هذه الفئة تعيش في حالة انفصام عن مجتمعها، منعزلة في برجها العاجي، غير قادرة على تقديم أي مشروع تنويري حقيقي⁸ سوى الدجل الاعلامي والخداع الفكري والتبييت لاقصاء المثقف الحقيقي من المشهد الثقافي كله.
والأخطر من ذلك، أن هؤلاء الأشباه يحتلون أيضاً "فضاء الخطاب الديني"، حيث يتمظهرون كمتحدثين ومهتمين باسم الدين والأخلاق والتصوف والفقه واصوله ومقاصد الشريعة، دون أن يمتلكوا أي عمق معرفي في العلوم الشرعية أو قدرة على الاجتهاد النقدي، يكتفون بترديد الخطابات الجاهزة -التوصيات المسمومة- كما يمارسون الوعظ الأخلاقي السطحي، ويستثمرون العاطفة الدينية لتعزيز مواقعهم الاجتماعية⁹. إنهم يحولون الدين من منظومة قيمية وفلسفية عميقة إلى شعارات فارغة وخطابات شعبوية، مساهمين بذلك في إفقار الوعي الديني وتسطيح الفهم الإسلامي. هذا الاستثمار الأيديولوجي في الخطاب الديني يُمثل أخطر تجليات الظاهرة، إذ يجمع بين الادعاء المعرفي والاستغلال السياسي والتسويق الإعلامي في آن واحد، كشانمبو لغسيل الادمغة.
الظاهرة في بعدها العالمي
لا تقتصر ظاهرة أشباه المثقفين على السياق العربي، فقد انتقدها بورديو بشدة في السياق الفرنسي، خاصة في كتابه "Sur la télévision" حيث فضح آليات إنتاج المثقفين الإعلاميين الذين يُضحون بالعمق المعرفي مقابل الشهرة التلفزيونية¹⁰. لكن الفارق الجوهري أن الديمقراطيات الغربية تمتلك عدة مؤسسات نقدية مستقلة وآليات تقويم أكاديمية صارمة تحد من انتشار هذه الظاهرة، بينما في السياق العربي يُساهم ضعف المؤسسات الأكاديمية وخضوع الإعلام وغياب حرية النقد في تفشي الظاهرة بشكل كارثي.
إن المثقف الحقيقي في الغرب يجد فضاءات للإنتاج والنشر والتأثير بعيداً عن سيطرة الإعلام التجاري، بينما المثقف العربي الاصيل يجد نفسه مهمشاً ومحاصراً من قبل منظومة تُكافئ التملق والخضوع وتُعاقب الاستقلالية والنقد¹¹.
نحو استعادة الحقل الثقافي
إن ما يجمع كل هذه التمثلات - الثقافية والإعلامية والدينية - هو انعدام الصدق المعرفي والالتزام الأخلاقي، فشبه المثقف لا يعنيه البحث عن الحقيقة أو خدمة مجتمعه أو الإسهام في تطوير الوعي الجمعي، بل يعنيه فقط تحقيق مكاسب شخصية رمزية واقتصادية سريعة جشعة. وهذا ما يجعله خطراً حقيقياً على المشروع التنويري العربي، لأنه يشوه صورة المثقف الحقيقي ويسهم في تعميق أزمة الثقة بين النخب الثقافية والجماهير.
كوننا امام مأزق حقيقي يتطلب مواجهة صريحة وشجاعة. فالمطلوب ليس مجرد "نقد المثقف" كما دعا إلى ذلك علي حرب¹²، بل نقد جذري للمنظومة الثقافية برمتها، منظومة تسمح بصعود المزيفين والادعياء وتهميش الأصلاء، منظومة تكافئ الاستعراض والتسويق والتزييف والخداع والمتاجرة على حساب العمق المعرفي والنزاهة الفكرية والنقدية.
إن إعادة بناء الحقل الثقافي العربي تستوجب وضع معايير صارمة للشرعية المعرفية، معايير لا تعترف بالألقاب والشهادات الفارغة، بل بالإنتاج الفكري الحي والواقعيو الاستراتيجي والإسهام المعرفي الحقيقي والالتزام الأخلاقي تجاه قضايا الأمة.
لقد آن الأوان لكشف زيف هؤلاء "الضباع" الذين يفترسون الفضاء الثقافي في ظل تغييب اهله ومبدعيه، ولفضح ممارسات الادعياء الطفيلية، ولإعادة الاعتبار للمثقف الحقيقي، ذلك المفكر الحر والنزيه والجاد المنخرط في قضايا مجتمعه، الناقد النبيل الذي لا يخشى السلطة ولا يتملق أصحاب النفوذ، المفكر العضوي الذي يرى في الثقافة مسؤولية وجودية لا مجرد وظيفة أو مصدر للرزق، إن المعركة من أجل ثقافة حقيقية هي معركة ضد كل أشكال الزيف والادعاء والتسقيط للشرفاء، وهي معركة تبدأ من قرار فردي وجماعي بمقاطعة إنتاجات هؤلاء الأشباه ودعم الإنتاج المعرفي الأصيل بحريته ونقده الاصلاحي، بإعادة الاعتبار للقراءة العميقة والبحث الأصيل والنقد الحر.
استعادة الحقل الثقافي من براثن تجار الوهم ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب يقظة معرفية دائمة وشجاعة أخلاقية في مواجهة الزيف، وإيماناً راسخاً بأن الثقافة الحقيقية هي تلك التي تُحرر العقول لا تلك التي تُخدرها وتستخف بها، وأن المثقف الحقيقي هو من يثير دفائن عقول المجتمع بأسئلته الحارقة، لا من يُطمئنهم بإجابات مُعلّبة ويُسليهم بخطابات استعراضية فارغة من اي معنى حضاري سوى الاستغباء والدجال والبهتان.
***
ا. مراد غريبي
....................
الهوامش
1. Pierre Bourdieu, Les règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire (Paris: Seuil, 1992), p345.
2. العايب ربيع، "قراءات في أزمة المثقف العربي: الجابري- إدوارد سعيد- محمد أركون"، *مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية*، المجلد 4، العدد 2 (2020)، ص 507.
3. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971), p12.
4. علي حرب،أوهام النخبة أو نقد المثقف (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1996)، ص 65.
5. "أنصاف المثقفين.. ظاهرة أم ماذا؟"، *الجزيرة نت*، 2 مايو 2017.
6. Jean-François Lyotard,La condition postmoderne: rapport sur le savoir. (Paris: Minuit, 1979), p. 60
7. "واقع النقد العربي الحديث وأزماته"، *المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات*، العدد 9 (2017)، ص 41.
8. محمد أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1998)، ص-178.
9. محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1995)، ص 201-234.
10. Pierre Bourdieu, Sur la télévision (Paris: Raisons d'agir, 1996), p43.
11. "المثقف العربي والهوية المؤجلة"، *مجلة الدراسات العربية*، يونيو 2019.
12. علي حرب، "مفهوم نقد النقد عند علي حرب تعقيب وتقويم"، *المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات*، 2011، ص 103.