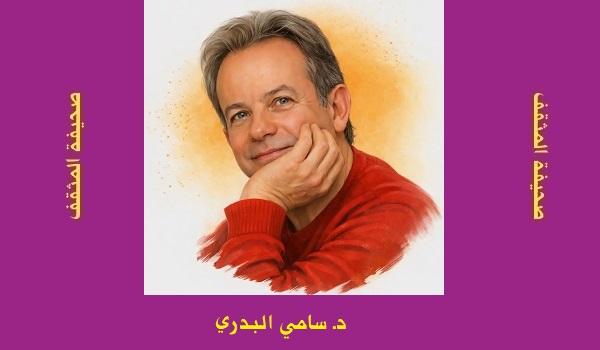قضايا
ندى صباح: منطق بلا مشاعر ومشاعر بلا منطق.. مأزق الإنسان الدائم

منذ أن عرف الإنسان معنى التفكير والشعور، وهو يواجه مأزقاً لا ينتهي، يعيش بين صوتين متناقضين يسكنانه: العقل الذي يدعوه إلى المنطق والحكمة، والقلب الذي يقوده نحو الإحساس والمشاعر. وبين هاتين القوتين المتنازعتين في أعماقه تتشكل التجربة الإنسانية بكل ما فيها من تناقضٍ وتوازنٍ وألمٍ وجمال.
العقل هو أداة الفهم والتحليل والتمييز، به نزن الأمور بميزان المنطق، ونُدرك الصواب من الخطأ. أما القلب، فهو موطن الإحساس، ومنه تنبع المشاعر التي تمنح الحياة معناها الإنساني العميق. لكن المعضلة تبدأ حين ينفصل أحدهما عن الآخر؛ فالعقل بلا مشاعر يجعل الإنسان آلة باردة، والمشاعر بلا منطق تجعله أسير اندفاعٍ أعمى.
لقد تناول الفلاسفة هذا التناقض في رؤاهم منذ القدم، فرأى أفلاطون، أن النفس تتكوّن من ثلاث قوى: العقل والعاطفة والرغبة، وأن التوازن بينها هو مصدر الفضيلة والعدالة في النفس، فحين يسيطر العقل على العاطفة والرغبة بحكمة، يتحقق الانسجام الإنساني.
بينما جعل ديكارت العقلَ جوهر الوجود الإنساني بقوله الشهير: «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، فحصر الإنسان في دائرة الفكر المجرد، متغافلًا عن عمق التجربة الوجدانية التي تمنح الفكر روحه.
ثم جاء ديفيد هيوم، ليقلب هذه الفكرة رأسًا على عقب، مؤكدًا أن العقل عبدٌ للعاطفة، وأن قرارات الإنسان لا تصدر عن تفكير منطقي بحت، بل عن انفعالات ورغبات هي التي تحرك إرادته وتوجّه أحكامه.
أما إيمانويل كانط، فقد حاول إيجاد توازن بين الطرفين، فرأى أن العقل يضع القوانين الأخلاقية، بينما العاطفة تمنحها دافعها الإنساني، فبدون الشعور لا قيمة للواجب، وبدون العقل لا معنى للمسؤولية الأخلاقية.
وفي العصر الحديث، رأى ويليام جيمس، مؤسس علم النفس الفلسفي، أن العاطفة ليست نتيجة الفكر، بل هي أصل الفعل، وأن الإنسان يتحرك بدافع شعوره قبل أن يتبنى فكرةً تبرر ذلك الشعور.
أما سبينوزا فكان يرى أن الفرح والحب هما أعلى أشكال الإدراك العقلي، فالعاطفة عنده ليست نقيضًا للعقل، بل نتيجة لفهمٍ أعمق للوجود.
ومن ناحيةٍ روحية، ذهب المتصوفة إلى ما هو أبعد من الفلاسفة العقليين، حين جعلوا القلب مركز الإدراك الأسمى، لأنه يرى بالحدس ما لا يراه العقل بالبرهان. يقول ابن عربي: «للقلب وجوهٌ كثيرة، منها ما يتجه إلى العقل، ومنها ما يتجه إلى الله.»
فالقلب عندهم ليس خصمًا للعقل، بل شريكٌ له في كشف الحقيقة، تمامًا كما يرى الغزالي أن نور القلب إذا اتحد بنور العقل أضاء طريق المعرفة الإلهية، لأن كليهما مظهران من مظاهر النور الإلهي في الإنسان.
إن العلاقة بين العقل والقلب ليست ميدان صراعٍ كما يتوهم البعض، بل هي ساحة تفاعلٍ خلاق، يتبادلان فيها الأدوار ليصنع الإنسان من مجموعهما كينونته الكاملة. فالعقل لا يكتمل إلا حين يمرّ عبر القلب، لأن المعرفة بلا شعور تتحول إلى جفافٍ فكري، والشعور بلا وعي يتحول إلى اندفاعٍ عاطفيٍّ أعمى.
العقل يرسم الطريق بخطوط المنطق والتمييز، بينما القلب يضيء تلك الخطوط بحرارة المعنى وصدق التجربة. فالأول يُرشدنا إلى الاتجاه، والثاني يمنحنا الدافع للعبور. من دون العقل قد نُخطئ الطريق، ومن دون القلب قد لا نجرؤ على السير فيه أصلًا.
حين يتصالح الاثنان داخل الإنسان، يصبح قراره أكثر حكمة، وموقفه أكثر توازنًا، لأن الحكمة الحقيقية ليست في إطفاء العاطفة بالعقل، ولا في تغليب الإحساس على المنطق، بل في خلق انسجامٍ داخلي يجعل كلًّا منهما يُكمل الآخر.
فالحياة لا تحتاج إلى عقلٍ يَحسب فقط، ولا إلى قلبٍ يَندفع فحسب، بل إلى روحٍ تُفكّر بإحساس وتَشعر بوعي.
ومن يصل إلى هذا التوازن النادر، يدرك أن العقل ليس عدوًا للقلب، بل هو بوصلته، وأن القلب ليس عبئًا على العقل، بل هو طاقته التي تمنح للمنطق روحًا، وللوعي حياة.
في حياتنا اليومية، هذا التوازن هو ما يجعلنا أكثر نضجًا واتزانًا.
نحتاج إلى القلب كي نحيا بصدق، وإلى العقل كي نحيا بوعي.
نحب بعقلٍ يحمي، ونفكر بقلبٍ يُلهم.
ومن فقد أحدهما عاش إمّا في برودٍ عقليٍ قاتل كأن آله تُسيره، أو في حرارةٍ عاطفيةٍ تحرقه.
في النهاية يبقى الإنسان كائنًا يتأرجح بين نور العقل ودفء القلب.
فالعقل هو ضوء الطريق، والقلب هو دفء السير فيه، ومن جمع بينهما أدرك معنى أن يكون إنسانًا كامل التوازن، لا حاكمًا بعقله فقط، ولا عبدًا لقلبه وحده.
***
م.م. ندى صباح أسد الله
كلية الآداب - جامعة بغداد