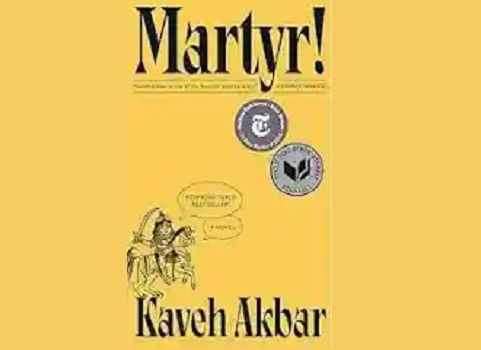قضايا
عصمت نصّار: الكذب في الثقافة الإسلامية وغرابيل الفلسفة النقدية (5)

ينزع المتشددون الذين أطلقوا على أنفسهم (السلفيون الجدد) إلى أن شيوخ المعتزلة قد جانبهم الصواب في تقديمهم العقل على السمع ودفعتهم تأويلاتهم العقلية للنصوص القرآنية إلى انزلاق أقدامهم في آتون الاجتراء كما قادتهم أهواؤهم إلى تكفير بعضهم بعضًا ثم راح الوهابيون من بعدهم يصفون التأويل والاجتهاد في إعمال العقل في السمعيات بأنه درب من دروب الهرطقة والتجديف بل والكذب على الله ورسوله مرددين (لا اجتهاد مع نص). وفاتهم أن تجديد الدين لا يكون مع غيبة المجتهدين، والاجتهاد لا يستقيم إلا إذا صدر عن عالم أريب وعقل فطن ودقة في التعبير والصياغة.
وغاب عنهم أيضًا (أنه لا اجتهاد مع نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وهذا لا ينطبق إلا على المحكم من آيات القرآن فقط) ومن أقوال فخر الدين الرازي في كتابه (مختصر الصواعق) في ذلك (المطالب الثلاثة: الأول: ما يتوقف ثبوت الشرع على ثبوته، كوجود الله وصدق الرسول، فهذا يستحيل أن يعلم بإخبار الشرع. الثاني: ثبوت أو انتفاء ما يقطع العقل بإمكان ثبوته أو انتفائه، فهذا إذا لم يجده الانسان من نفسه، ولا أدركه بحسه استحال العلم به إلا من جهة الشرع. الثالث: وجوب الواجبات، وإمكان الممكنات، واستحالة المستحيلات، فهذا يعلم من طريق العقل بلا إشكال. فأما العلم به بإخبار الشرع فمشكل، لأن الخبر الشارع في هذا المطلب إن وافق عليه العقل فالاعتماد على العقل وخبر الشارع فضل، وإن خالفه العقل وجب تقديم العقل وتأويل الخبر في قول المحققين) ولعل هذا القول يعبر عن العقل الجمعي الذي يدين به جل المسلمين.
فشيوخ المعتزلة لم يحتكموا في تأويلاتهم للسمع إلا لصريح المعقول -وذلك قبل اختلاط آرائهم بالنظريات الفلسفية - وعليه أن تأويلاتهم للمتشابه من القرآن لا يخرجهم عن رأي الجمهور وقد انحصرت مواطن انتقادات بعضهم لبعض في المسائل ذات الصلة بالتصورات الفلسفية الميتافيزيقية فحسب أما آرائهم في القضايا العقدية فقد اعتمدت على نظرية تجاور العقل للنقل ولم يقفوا من كتب جماع الحديث موقفًا استبعاديًا إلا بعد تنقيتها بغرابيل صريح المعقول. كما أن كثرة محاوراتهم ومناظراتهم مع شتى المذاهب والملل والنحل قد اكسبتهم دربه ودراية بقواعد حرية التثاقف، والالتزام بحدود الموضوعية في النقد مع الزام المحاور بعقلانية التصورات في طرح الرؤى والاتيان بالحجج والبراهين ذلك فضلًا عن مجهم للتقليد في شتى صوره وعدم الاحتكام للمألوف والموروث ولاسيما في أمور التشريع. وبهذا المنحى وبفضل غرابيلهم العقلية قد استطاعوا صد الهجمة الشرسة التي شنت على أصول العقيدة الإسلامية من قبل عشرات الفرق (الجبرية، المجسمة، الدهرية، الحلولية، الباطنية، عصبية الخوارج، بدع الشيعة، تجديف الملحدين وإفك الهراطقة) وليس هناك أدل على أهمية وعظم جهودهم في تبيان فلسفة المقاصد الشرعية إلا عودة معظم خصومهم إلى التسلل إلى الثقافة الإسلامية ثانيةً وذلك عقب غيبة المطبقين لمنهج المعتزلة العقلي ولاسيما في الفكر الإسلامي المعاصر الذي بات مولعًا بعشرات الأكاذيب التي اصطنعها الخوارج الجدد من الإرهابيين والتكفيريين من جهة وأصحاب البدع مثل عبدة الشيطان والمجدفين التفككين والارتيابيين ودعاة وحدة الأديان والعقيدة الابراهيمية وتأليف الجماعات الماثونية من جهة ثانية وتجديف المتعالمين من دعاة الحداثة وما بعد الحداثة والفوضويين والوجودين والعبثيين والاباحيين والمجترئين على النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من المأجورين ودعاة الفتن من جهة ثالثة فجلهم قد ارتدى عباءة الصدق وراح يلوح برايات العدل والحرية التي جاء بها المهدي المنتظر وخفي تحت عباءته لباس أبليس ومسبحة ترانيم الشيطان الكاذبة.
مع العلم أن جل شيوخ المعتزلة لم يلزم أحدهم باتباع اجتهاداتهم ولم يزعموا أن ما انتهوا إليه عقلًا ناسخًا لما جاء في السمع (القرآن). ولعل نهجهم يتفق مع قول الامام الشافعي (ميز يا بني، علمك الله، ما قد شرحت لك من هذا القول وتدبر ما حكيت لك من قول الكذابين على الله يبن لك الصدق وتعلم الحق، لأنه واضح مبين لا يخفى أهل المعرفة والعقل لأن العقل أكثر حجج الله سبحانه على عباده ولذلك لم يخاطب إلا ذوي الالباب والعقول).
كما يؤكد شيوخ المعتزلة أن تدبر نسقية القرآن والنظر للقضايا التي تحدث عنها في آياته تغني العابد المريد عن غرابيل الكذب وذلك لأنه قد توصل بعقله المؤمن بأنه أوشك على الوصول إلى حق اليقين وهو الممثل الأوحد إلى المقاصد الربانية ولعل ابن سينا وبن طفيل قد تأثرا بهذا المنحى العقلي في حديثهما عن قصة (حي بن يقظان) - فالحق لا يناهض أو يعارض الحق- والصدق لا يمكن أن يتخفى في رداء الكذب بل العكس صحيح لذا نجد شيوخ المعتزلة يحزرون من الآيات التي ينزعها الكذابون من سياقاتها لإضلال الناس بإسم الدين الامر الذي يوجب مقابلة الآيات بعضها ببعض إذا كانت تشتمل على حكم أو الارشاد إلى حقيقة أو الاخبار عن واقعة ولا يحتج في هذا المقام بما يقال عنه الناسخ والمنسوخ فالنسخ في القرآن عند جميع شيوخ المعتزلة لا يكون بمعنى الابدال أو الانتقال من حكم إلى نقيده فقد اعتبر جلهم أن القرآن نص متناغم ومتناسق ولا يوجد فيه نسخ، أو أن شئت قولت النسخ عندهم مقيد بأن يكون في حدود التخصيص لا الإلغاء الكامل. وقد اعتمدوا في ذلك على مبدأ أن كل آية لها حكمها الخاص، وأن الأوامر والنواهي فيه متوافقة، وربطوا ذلك بمبادئهم العقدية، كما ورد في قضية "خلق القرآن".
كما ينكرون أيضًا وصف أفعال العباد بأنها مقدرة قبل وجود أصحابها ويكذبون كل من رد المعاصي والآثام التي تدخل في بابها بأنها قدر من عند الله تجبر الانسان على فعلها بحجة أنه لا مرد لقدر الله بينما الصدق عندهم أن كل أفعال العباد قد خبرها الله بعلمه وليس بإرادته لأنه لو كان غير ذلك لبات العادل ظالمًا وحاشا لله أن يكون كذلك فقد قال تعالى في سورة فصلت ( مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيد)ِ (46) وجاء في صحيح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا".
ويجدر بنا الإشارة إلى أن شيوخ المعتزلة قد أخرجوا الخوارق والمعجزات الواردة في القرآن من غرابيل النقد التي تفصل بين الصدق والكذب فكل ما جاء في حق اليقين صادق بالضرورة والعقل عاجز عن الوصول إلى حقيقته ويرجع ذلك لأنهم اعتبروا أن علم الله وقدرته هي ذاته ومن ينكرهما يجحد وحدانيته وربوبيته وعليه فإن المعجزات الخارقة للسنن ما هيا إلا آيات يحتج بها على كذب الكاذبين وأنها تأييد لأنبيائه ورسله ضد المنكرين والجاحدين ومع ذلك فأنهم لا يسلمون بحدوث الخوارق والمعجزات والكرامات التي لم يذكرها القرآن سواء كانت منسوبة إلى الأنبياء أو الأولياء وحجتهم في ذلك أنها تحدث إشكالًا في الاستيعاب بين عين اليقين الذي يمكن للعقل تصوره وبين حق اليقين الذي أخبر عنه الله في قرآنه الكريم كما أن ذيوعها بين العوام قد يحدث فتنة ويجلب الشكوك والخلط بين الأنبياء والأولياء ويجعل الكذب يتسلل إلى ألسنة من يظنهم الناس على غير حقيقتهم مثل الافتتان بالخلفاء أو المتصوفة الاتقياء أو أصحاب المناقب والنجاحات من الأمة والزعماء أو الادعياء.
أما المعجزات الواردة في السيرة وكتب جماع الحديث مثل رواية حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع حماره يعفور، وادعاء بعض الرواة (بقيام النبي صلى الله عليه وسلم بوطء كل زوجاته وسراريه في ليلة واحدة)، ووجود الحمامتين والعنكبوت في مدخل غار ثور أثناء الهجرة لإخفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عن عيون مطارديه. فإن مثل هذه القصص والروايات المختلقة يأبها صريح المعقول شكلًا وموضوعًا ويسهل على غلاة المستشرقين والطاعنين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقدها وهدم أركانها وقد شكك فيها جمهور العلماء.
أما موقف شيوخ المعتزلة من قضية خلق القرآن فهي أيضًا تعبر عن وجهتهم العقلية النابعة من عمق إيمانهم بعدم الفصل بين علم الله وذاته وأن إعجاز القرآن ليس في صياغته اللغوية وروعته البلاغية التي لا يدركها إلا أرباب تلك اللغة فحسب بل أن نسقيته وبنيته المعرفية وموضوعيته التي تفوق كل تصور في صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وجمع فضائله الأخلاقية بين الثوابت والأصول الركينة والقابلة دومًا للتجديد والتطويع وفق المتغيرات الثقافية والبيئات المتغايرة هي المعجز الحقيقي الذي يمكن التحقق منه بعين اليقين ويمهد للذهن سبيله إلى قبول الغيبيات التي تحدثت عنها الآيات في حق اليقين وقد تأثر بهذا المنحى ابن رشد.
كما قام شيوخ المعتزلة بالرد على مخالفيهم بنهجهم الجدلي المفحم مبينين أن القرآن باعتباره كلام الله فهو صادر عنه وكل ما يصدر عن الله من أشياء فهي من خلقه سبحانه وتعالى كما أن الألفاظ والحروف والكلمات والتراكيب اللغوية أشياءً قد اكتسبت دلالاتها من البشر وقد خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها وعاءً لحمل أوامره وشرائعه ومقاصده بلسان يفقهوه شأن الكتب السابقة على الإسلام التي تنزلت على أقوام بلغات شتى أما القول بقدم القرآن فهو لا يكون لأن الله سبحانه هو الأول والأخر والأول لا يشاركه أحد في وجوده.
وخلاصة قول المعتزلة أن حلاوة وجمال الالفاظ القرآنية لا تعد وجهًا للإعجاز فقط إذا ما قورن هذا المعجز بتلك الحكمة النسقية والمنطق المكين والحجج التي سوف تظل من المستحيلات التي لا يستطيع العقل الاتيان بمثلها، ولعل قول الله (إنَ نحن نزلنا الذكر وإنَ له لحافظون)، (سورة الحجر الآية 9) يتضح فهمه على الوجه الأمثل الذي يكشف أن سر حفظه كامن في جوانية النص وجوهره وبنيته التي يصعب تزييفها أو تسلل الكذب إليها، وكيف لا وكل الواقعات والمعارف والمعلومات تؤكد حجيته الصادقة وعظم خالق آياته وإن كره الجاحدون.
ويترئ لي أن قضية خلق القرآن وقدمه من القضايا المفتعلة التي أثارها الأغيار من لاهوتي أصحاب الكتب المقدسة، وذلك خلال مساجلات المعتزلة معهم وإن حجة شيوخ المعتزلة وردهم تبعًا للسياق السالف كان في شدة العبقريّة؛ لأنهم لم يقولوا بأن القرآن مخلوق بالمعنى الدلالي الذي ينظر إليه الذهن بأن كل المخلوقات ناقصة ومصيرها للهلاك شأن الإنسان ذاته، كما أنهم لم ينظروا إلى القول بالقدم على أن دلالة القدم هي (السرمديّة أي القبلية المطلقة) فقالوا إنّ القرآن هو المرآة التي جعلها الله صورةً تعكس جانبًا من علمه الذي يسهل على البشر رؤيته واستيعابه.
وعليه؛ يمكن اعتبار (جبريل) مرآة ناطقة للآيات، وأن الأثر الذي يُحدثه وقع القرآن في القلوب هو شكلٌ من أشكال المرآة الشعوريّة التي تلحق بوجدان الذين يستمعون إلى القرآن دون علمًا منهم بلغته وما تحمله الآيات من معاني ودلالات.
ومن زاوية أخرى - لقراءتنا لكلام المعتزلة - نجد أن خلافهم مع الأشاعرة في هذه القضية يكاد يكون خلافاً دلاليًا حول دلالة الكلام وظاهر الألفاظ؛ ولعل مضمون هذا التصور يتفق مع رؤية الامام أحمد بن حنبل الذي ذهب إلى أن القرآن هو كلام الله فحسب. وحديث الجرجاني (1339:1413 م) في كتابه (دلائل الاعجاز) عن المعجز الدلالي للقرآن الكريم.
وللحديث بقيّة حول الجانب التطبيقي من آراء المعتزلة المستنبطة من غربلتهم للآراء التي طرحت في الثقافة الإسلامية ولحقت بعقائدها.
***
بقلم: د. عصمت نصّار