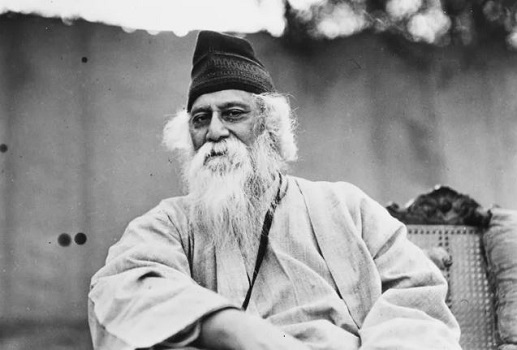قضايا
سجاد مصطفى: حين احتاج المطلق إلى مفسِّر!

المقدمة: كأنّ الوجودَ مرآةٌ خائنة، تعكسُ ما لا نراهُ حين ننظر، وتُخفي ما يندفعُ إلينا حين نُغمِضُ أعيننا، هكذا يبدأ السرّ رحلتهُ في دروبٍ لا يُدركها سوى مَن أدمنَ الإصغاء إلى أصوات الظلّ وهو يتنقّل بين أضلاع النور، وإلى نبض الزمن وهو يتكوّرُ على نفسه ثم ينفرطُ كخيطٍ من لهبٍ لا يتذكّر من أوقده. في هذا الممرّ الضيّق بين الحضور والغياب، بين الاسم وصداه، تتكشّف تلك الخيانةُ التي لا تُوجَّه إلى الإله، بل إلى صورته التي صنعها الوعي حين ظنّ أنّه يملك حقّ تفسير العلوّ بلغةٍ أرضيّةٍ لا تعرف سوى الثِقَل، في حين أنّ الروح تُريد خفّةً لا تحدّها الجهات. يقول أحد العارفين: «ما رأيتُ شيئًا إلّا ورأيتُ في ظِلّه ما لم يُخلَق بعد. » وهنا، في هذا الالتباس الوجوديّ، تبدأ الحكاية؛ حكاية ذلك الصوت الذي يجيء من عمقٍ لا يُسمّى، ويذهب إلى عمقٍ لا يُحدّ، بينما يظلّ الإنسان محصورًا بينهما، كأنّه محاولةٌ لم تكتمل، أو أثرٌ ليدٍ لم تُكمِل رسم ملامحها. وفي هذا النصّ، الذي يشتغل على تخوم الروح أكثر من تخوم العقل، لا نبحث عن الإجابة بقدر ما نُعدّ الأرض للسؤال، ولا نُفسّر النور بل نتبعه وهو يتكسّر على جدران النفس، ولا نُطارد المعنى بل نتركه يختبئ في الشقوق الصغيرة التي تركها الزمن حين مَرّ علينا ككائنٍ يتنفّس، يتقدّم، ويغادر من دون وداع. هكذا فقط يبدأ الكلام وهكذا فقط يُفهم ما لا يُقال ولأنّ الحقيقة لا تُسلِّم مفاتيحها لمن يسلك الطريقَ بعينٍ يقظةٍ فقط، بل لمن يجرؤ على السير بعينٍ مُغمضةٍ يرى بها ما لا يُرى، فإنّ هذا البحث ليس محاولة للاقتراب من الإله بقدر ما هو محاولة للاقتراب من أنفسنا ونحن نتهجّى أثره فينا، ذلك الأثر الذي يختبئ في الفراغ أكثر مما يلوح في الامتلاء، وفي الانكسار أكثر مما يظهر في الاتّساق، وفي الصمت أكثر من الكلمات التي تتظاهر بالمعرفة وهي تخون جوهرها لحظةَ النطق. فالخيانةُ الكونية ليست فعلاً يُرتكب، بل حالةٌ تتكشّف، حين يدرك الإنسان أنّ صورته عن المطلق قد صارت هي الحجاب، وأنّ الظلال التي تشبه النور ليست إلا انعكاسًا لغيابٍ أعمق، وأنّ الطريق إلى العلوّ لم يكن يومًا صعودًا، بل سقوطًا واعيًا إلى الداخل، إلى تلك البقعة التي لا يليق بها إلا الهمس، ولا يُفتح بابها إلا لمن تعلّم أن يرى الزمن وهو يتشققُ كالطين بين يديه، وأن يشهد اللحظة وهي تُولَد وتموت في ذات النفس. ولأنّ المرآة لا تُظهر الحقيقة إلا عندما نعجز عن النظر إليها، فإنّ هذا النصّ يجرّب أن يُمسك تلك اللحظة التي تتجمّع فيها الأرواح على حافّة المعنى قبل أن تنفلت، لحظةٌ تتجاور فيها الظلمات كأخواتٍ يتبادلن الأسرار، ويقف فيها النور متردّدًا كطفلٍ يبحث عن اسمه الأول. وفي هذا التوتّر، في هذا الاحتكاك بين ما نعرفه وما نخاف أن نعرفه، يتكوّن جوهر الطريق؛ طريقٌ لا يقود إلى اليقين، بل إلى دهشةٍ أعمق، دهشةٍ تُشبه الوحي حين يأتي بلا صوت، وتُشبه الخوف حين يتحوّل إلى بصيرة. هنا يبدأ النصّ الحقيقي: ليس في بداية الكلمات، بل في بداية العتمة التي تستعدّ لولادة ضوءٍ لا يعرف أحدٌ لمن سيُهدي نفسه. ولأنّ السفر إلى الداخل لا يبدأ بخطوة، بل بانكسارٍ خفيٍّ يشبه تفتّت الصدأ عن مرآةٍ كانت تُخفي صورتها منذ أزمانٍ لا تُعدّ، فإنّ القارئ هنا لن يجد طريقًا مستقيمًا ولا معنىً جاهزًا، بل متاهةً تتكاثر فيها الإشارات كما تتكاثرُ النجومُ حين ينسحب الليل من نفسه، متاهةٌ تُرغِم الروح على الإصغاء للنداء الذي يأتي من مكانٍ لا نعرف إن كان فوقًا أم تحتًا، أمامًا أم خلفًا، أو لعلّه يأتي من ذلك الفراغ الذي تخلّفه اللحظات عندما لا تعود قادرة على حمل ثقل وجودها. وفي هذا النصّ، الذي يتعمّد الالتباس كي يحفظ سرّه من السقوط في الوضوح، نقترب من تلك اللحظة التي وصفها أحد العارفين بقوله: «من عرفَ الطريقَ ضاع، ومن ضاعَ وجد، ومن وجدَ عادَ إلى ضياعه الأول. » وكأنّ الضياع ليس فقدًا، بل شرطًا لظهور الطريق، وكأنّ الطريق لا يُمنح إلا لمن عرف أن الخيانة الكبرى تقع في تصديق المعنى قبل أن يُختبر، وفي الوثوق بالضوء قبل أن يُمتحن ظلّه. هنا يتداخل ما هو ظاهر بما هو مستور، ويتجاور النورُ مع ما يُشبهه دون أن يكونه، ويقف الزمنُ ككائنٍ يراقبُ حركتنا في داخله بينما يبتسمُ كأنه يعرف النهاية التي لا نعرفها، تلك النهاية التي تتخفّى في بدايةٍ أخرى لا يُتاح لنا إدراكها إلا بعد أن نتخلّى عن كلّ صورةٍ صنعناها للعلوّ، ولأنفسنا، وللخيط الرفيع الذي ظننّا أنه يصلنا بالسماء. وهكذا، في هذا الترتيب الذي لا يخضع لترتيب، يتكوّن النصّ مثل نَفَسٍ خرج من صدرٍ لم يُرد الإفصاح، وكأنه يختبرنا أكثر مما نختبره، ويكشف لنا أنّ المعنى الحقيقي لا يُقال، بل يُقام داخلنا كصمتٍ يلمع في الظلّ، وكهمسٍ من نورٍ لا يجرؤ أحدٌ على تفسيره. ولأنّ الطريق لا يُفتح إلا لمن يسلّم مفاتيحه للغيب، كان لابدّ أن نستدعي الكلمة الأولى التي عبرت الظلام وهي تُرشد الوعي قبل أن يُخلق له عينان. تلك الكلمة التي جاءت كوميضٍ من رحم العدم، حين قال الوجود في كتابه الأزلي: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ كأنّ النصّ لا يحدّثنا عن الخلق فحسب، بل يشير إلى تلك الشرارة التي ما زالت تتحرك في الأعماق مثل نارٍ بلا لهب، نارٍ لا تهدف إلى الإحراق بل إلى كشف الظلّ الذي يحرس السرّ. فالروح هنا ليست إضافة، بل جرحٌ مقدّس يتسلل إلينا ليدلّنا على أن ما نبحث عنه لم يَغِب لحظة، وأنّ الضياع ليس إلا حجابًا يقي القلب من رؤية ما لا يحتمل. وفي الجهة الأخرى من الوجود، من نصٍّ آخر يمشي على الماء مثل رؤيا، يأتي الصوت الذي دوّى في الأناجيل وهو يقول: «النورُ يُضيء في الظلمة، والظلمةُ لم تُدركه. » وكأنّ الضوء لا يبحث عن أن يُرى، بل يبحث عمّن يفشل في رؤيته ليختبر قابليته للحقيقة. فالظلمة ليست نقيضًا للنور، بل مقياسه؛ وغياب الإدراك ليس جهلًا، بل مرحلة من مراحل التكوين الروحي، تمامًا مثلما يحتاج البذر إلى انطواءٍ في التراب قبل أن يتجرّأ على الظهور. وبين النصّين، بين النفخة الأولى ووميض النور السائر فوق الماء، تنشأ تلك المنطقة التي لا يجرؤ العقل على دخولها، بينما تنجذب إليها الروح كما تنجذب القطرة إلى أصلها. منطقةٌ لا تُعرّف، ولا تُفسَّر، ولا تُلخَّص، بل تُختَبَر كصمتٍ يضغط على القلب، أو كنسمةٍ تهبّ من جهةٍ لا يعرفها الجغرافيا. وهنا يتشكّل وجه هذا المقال: وجهٌ يتغذّى من النصوص القديمة كما تتغذّى المرآة من ضوءٍ لم يمرّ بها بعد، ويعيد ترتيبها داخل زمنٍ ينساب مثل كائنٍ يتذكّر ما لم يحدث بعد. وجهٌ يختلط فيه كلام السماء بارتجاف الإنسان، ليصنع معنى لا يقول نفسه صراحة، بل يطلّ من وراء ستار، كأنه لا يريد الظهور إلّا لمن استعدّ للضربات التي تحملها الحقيقة عندما تخلع أقنعتها. وهكذا، بعد أن عبرنا هذا الممرّ المعلّق بين النفخة الأولى ووميض النور الذي لم تُدركه الظلمة، يتبدّى لنا أنّ كل محاولة لفهم الطريق ليست إلا جزءًا من امتحانه، وأنّ البحث عن الإله - كظلّ يسير أمام الروح - لا يكتمل إلا عندما تعترف بأنّ الظلّ نفسه ليس ملكك، وأنّ الضوء ليس وعدًا بل اختبارًا.
فالمعنى هنا لا يريد أن يُقبض عليه، بل يريد أن يختبر اليد التي تمتدّ نحوه. وما الكلمات التي اصطحبناها - من آيةٍ تُذكّرنا بأن الروح أعمق من الجسد، ومن إنجيلٍ يخبرنا بأن النور لا يُعرّف بالعيون - إلا مرايا يضعها النصّ لكي نرى ما لم نجرؤ على النظر إليه من قبل. ولأنّ الزمن - هذا الكائن الخفي - لا يصفّق للذين يظنّون أنهم عرفوا، بل لأولئك الذين يواصلون السؤال رغم انكسارات المعرفة، فإنّ هذه المقدّمة تنتهي لا لتغلق الباب، بل لتفتحه على فراغٍ أعلى، فراغٍ يشبه بداية الخلق حين كان كل شيء يهدّد بأن يكون.. أو ألّا يكون. وهكذا يصبح الدخول في هذا المقال شبيهًا بالوقوف على حافة بئرٍ لا قرار لها؛ فإمّا أن تُلقي بنفسك في عمق الرموز، وإمّا أن تبقى على السطح، تتأمل ظلك وتظنّه حقيقتك. أما الذين يختارون السقوط - السقوط بوصفه عبورًا - فهم وحدهم الذين يفهمون أنّ الطريق إلى الإله لا يمرّ بصورته، بل بما يخلّفه غياب صورته داخل الروح. وبهذا، تُقفل الصفحةلا كخاتمة.. بل كبدءٍ أوّل لما سيأتي بعد الصمت.
الموضوع الأوّل: حين يتورّطُ الوجودُ في سؤالٍ لا يريد العقلُ سماعه
منذ اللحظة التي خُلق فيها الصمتُ الأوّل، قبل أن يتعلّم الضوءُ كيف يُهذّب حدّته، وقف الإنسان عند حافة السؤال مثل مسافرٍ يحدّق في بابٍ لا يعرف إن كان يُفضي إلى الداخل أم إلى الخارج، ليكتشف أنّ السؤال الذي يخشاه ليس ذلك المتعلّق بعِلّة الخلق، بل السؤال الذي يحاول الوجودُ إخفاءه خلف مراياه: لماذا تُصرّ الروح على البحث عمّا يتجاوز قدرتها على الفهم؟ فالإنسان، حين رفع رأسه إلى السماء، لم يكن يبحث عن الإله كما نظنّ، بل كان يبحث عن انعكاسٍ يعيد إليه ملامحه حين ضاعت بين كثافة الوجود، وكان يتخيّل أنّ الصورة التي يرسمها للعُلُوّ ستعيد ترتيب الفوضى داخله، وأنّ الكمال الذي يصوغه بيده سيعيد للروح اتّزانها. لكنّ الوجود - هذا الكائن المتحرّك، الذي لا يعبأ بوعود البشر - لا يبتسم لصورةٍ صُنعت من خوف، ولا يمنح قداسةً جاءت من حاجة. ولأنّ الزمن يشبه حكيمًا يراقب من خلف ستارةٍ لا تتحرّك، فإنّه يكشف للإنسان أنّ أول خيانةٍ تقع ليست في غياب الإجابة، بل في السؤال ذاته؛ السؤال الذي بُنِي على توقّعات الروح أكثر من بنيته على حقيقة الإله. فالعقلُ لا يريد أن يسمع سؤال الخلق، لأنه يدرك - في عمقٍ لا يعترف به - أنّ الإجابة قد تُسقط ما بناه من يقين، وقد تُعرّي الصورة التي ظنّها كاملة بينما كانت مجرد ظلٍّ مرآه. وهنا، في هذه اللحظة التي يتلعثم فيها الوعي أمام شفرة الوجود، يبدأ الصدع: فالإنسان يتوقّع من الكون أن يجاوبه لغويًا، بينما الكون يتحدّث بصمتٍ لا يترجم، ويتصرّف بمنطقٍ لا يعتذر، وكأنّه يهمس للروح: «ما تبحث عنه ليس جوابًا.. بل المرآة التي ستنكسر عندما تكتشف أنّك لا تبحث عن الإله، بل عن نفسك. » وهكذا، تنشأ الخيانة الأولى: ليست خيانة الكون للإنسان، ولا الإله للكون، بل خيانة السؤال لصاحبه، وخيانة الوعي لعمقه حين يصرّ على أن تكون الحقيقة بحجم حاجته، لا بحجم اتّساعها اللامتناهي. ولأنّ السؤال لم يكن يومًا حجرًا تُمسكه اليد، بل كائنًا يتنفّس في الظلّ، كان لابدّ للوعي أن يكتشف أنّ الوجود لا ينتظر من الإنسان فهمًا، بل انتظارًا؛ انتظار اللحظة التي يدرك فيها أنّ كل محاولة للإمساك بالحقيقة تشبه محاولة القبض على الضوء، كلما اقتربتَ منه ازداد ابتعادًا، وكلما ظننت أنك فهمتَه اتّسعت الهوّة بينك وبينه. فحين وقف الإنسان أمام السماء، لم يكن ينشد معرفةً بقدر ما كان ينشد ملجأ، يبحث عن معنى يسكّن ارتجافه، وعن عقلٍ كليّ يحمل عنه عبء التفكير. ومع ذلك، يصرّ الكون على أن يُعيده إلى نقطةٍ واحدة: أنت لست مركز اللعبة، ولا عقلك مرآتها النهائية. ومن هنا يأتي الكشف القرآني ليضرب عمق الروح، لا سطح العقل، حين يقول:
﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذه ليست جملة استفهامية، بل صفعة روحيّة؛ ليس معناها: هل تشك؟ بل معناها الأعمق: كيف استطاع قلبك أن يتجاهل كل هذا الاتساع؟ كيف استطاعت روحك أن تمرّ على هذا النَفَس الكوني دون أن ترتجف؟ فالشكّ ليس في الله، بل في قدرة الإنسان على رؤية ما يتجاوز حدود بصره وبصيرته. ولأنّ الملحد يطلب البرهان، كان الوجود أسبق من الكتب، وكان الصمت أعمق من الكلام. فمن الذي اشعل شرارة "القانون" قبل ظهور العقول التي تفكر به؟ من الذي نظّم الفوضى الأولى لتصبح "نظامًا" يمكن قراءته؟ من الذي جعل الذرّة تتماسك، والنجم يولد، والمطر يسقط ضمن حسابات لا تخطئ؟ إنّ أكثر لحظات الإلحاد صدقًا هي لحظاته الأكثر روحانية؛ لأن الملحد حين ينكر الله، يفعل ذلك باسم النظام، باسم العقلانية، باسم السببية. والسؤال: من أين جاءت هذه القوانين التي تشبه نصًا كونيًّا لا يتغيّر؟ومن وضع هذا التناسق الذي لا يخطئ؟ وكيف اجتمعت الفوضى العمياء - لو كانت فوضى - على صنع كائن قادر على قراءة الفوضى نفسها؟ إنّ الوعي الإنساني دليل على شيء يتجاوزه. وسؤال الإلحاد ذاته هو اعتراف ضمني بوجود نظام أعلى؛ فلو كان الوجود خاليًا من المصدر، لما كان للسؤال معنى. ثم يعود الوجود ليقول للروح عبر صمته الطويل: لو كان الكون بلا صانع، لما كان السؤال ممكنًا أصلاً. فالعدم لا يمتلك قانونًا، ولا يُنتج عقلًا، ولا يمنح وعيًا قادرًا على كشف خداعه. وُلد السؤال لأن هناك يدًا أقدم من السؤال، ونظامًا أسبق من العقل، ونفخةً لا يستطيع الإلحاد أن يشرح مصدرها مهما امتدّ به الجدل. وبين المرآة التي تُظهر وجه الروح، والظلّ الذي يخفي معالمه، يدرك القارئ - حتى لو كان ملحدًا - أن الإله ليس احتمالًا بين احتمالات، بل هو الخلفية التي تجعل الاحتمال نفسه ممكنًا. فوجود القوانين هو برهان، ووجود الوعي جزء من البرهان، ووجود السؤال هو البرهان الأكبر. وهكذا ليكتشف القلب أن الخيانة ليست في الكون، بل في تلك الصورة الصغيرة التي صنعها الإنسان للإله، ثم طالب الوجود أن يخضع لها. ومع امتداد السؤال داخل الروح، يبدأ الزمن - بوصفه كائنًا متربّصًا عند تخوم الوعي - في كشف طبقاته الخفية، فيُفهم الإنسان أن المشكلة لم تكن يومًا في وجود الإله، بل في ضيق الوعاء الذي يحاول الإنسان أن يسكب فيه هذا الوجود الهائل. فالروح تُدرك ما لا يستطيع العقل أن يبرهنه، والكون يلمّح بما يعجز اللسان عن قوله، وكأنّ الحقيقة تسير على أطراف أصابعها، تقترب ولا تُمسك، تُرى ولا تُحاط. ولأنّ الوجود لا يخون الإله الحقيقي، بل يخون الصورة التي رسمها العقل الضعيف، فإنّ الملحد حين يرفض الكون بوصفه دليلًا على الإله، يفعل ذلك من منطلق أكبر دليلٍ عليه دون أن يشعر: إنّه يرفض صورةً بشرية، لا حقيقة إلهية. فالملحد يرفض الإله الذي يشبه الإنسان، يرفض الإله الذي يُغطي الفراغ النفسي، يرفض الإله الذي يُستدعى فقط عند المصائب، يرفض الإله الذي صُنع ليُسكِت الأسئلة.. وليس هذا الإله الذي يرفضه هو الله أصلاً. إنه يرفض الصورة، لكنه - دون أن يدري - يعترف بوجود اليد التي صنعت القوانين التي يُقدّسها. ولأنّ العقل لا يستطيع أن يتجاوز حدوده إلا حين يصطدم باللامعقول، فإنّ الكون نفسه يتحوّل إلى معلمٍ صامت، يشير إلى الحقيقة دون أن ينطق بها: كيف لعقلٍ محدود أن يفهم كونًا غير محدود؟ وكيف لزمنٍ يسير أن يُحيط بزمنٍ أعمق منه؟
وكيف لكائنٍ فانٍ أن يقرأ خريطة اللاموت؟ وحين يقول الله في كتابه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فهو لا يحتقر العلم، بل يكشف حدود الحاوية التي نحملها. فالعلم شُعلة، لكن الحقيقة نار، والإنسان مخلوق لا يحتمل الاحتراق. ولأنّ الروح هي المرآة التي ترى ما وراء السطح، فإنها حين تهدأ، تسأل سؤالًا واحدًا: هل يعقل أن يكون كل هذا الجمال بلا معنًى؟ هل يمكن أن يكون هذا الاتساق العظيم - من دوران المجرّات إلى انضباط الذرّات - مجرد صدفة؟ الصدفة التي يتذرّع بها الإلحاد أشبه بقولك: إذا رميتُ حروف اللغة العربية في الفراغ، فسيتكوّن من تلقاء نفسه كتاب كامل بلا خطأ. وهذا مُحال، فكيف إذا كانت الحروف هنا ليست حروفًا، بل قوانين فيزيائية ثابتة، ونِسَبًا كونية دقيقة، وأبعادًا محسوبة بورعٍ يتجاوز حتى لغة الرياضيات؟ ثمّ إنّ الوجود، حين يوسّع عينيه على الإنسان، يكشف له ما لم ينتبه إليه: أنّ الوعي نفسه ليس ضرورة في عالمٍ ماديٍّ خالص، لأنّ الوعي لا يُستخدم في البقاء المادي، بل في السؤال. وهذا وحده كافٍ لنسف الإلحاد من جذره: لو كان الإنسان نتيجة فوضى، لما حمل داخله سؤالًا يرفض الفوضى. فالأسئلة العليا لا يولدها الفراغ؛ والدهشة لا تنبت في أرض العدم؛ والبحث عن المعنى لا يظهر في كائنٍ صنعته المصادفة. وهكذا، تتكشّف الحقيقة لا بالعقل فقط، ولا بالروح فقط، بل بتلك الشرارة المختلطة بينهما، الشرارة التي تهمس للإنسان: لم تُخلق لتفهم الكون.. بل لتفهم أنّ الكون ليس صدفة. ويعود السؤال الأوّل ليقف أمامك، لا ليُغلق الطريق، بل ليكشف أن الطريق نفسه هو البرهان، وأنّ وجود السؤال دليل على وجود مصدرٍ أكبر من السائل.
٢. صُورةُ الإلٰهِ بَيْنَ الحاجَةِ الإنسَانِيَّةِ وَصَرامَةِ الوُجُود
إنَّ الإنسانَ، مذْ تفتَّحَ وعيُهُ على جرحِ السؤال، ظلَّ يُحدِّقُ في الماوراءِ كما يُحدِّقُ الغريقُ في آخرِ شرارةٍ من الضوء، لا ليرى ما وراءَ الظلام، بل ليجدَ مبرّرًا للبقاءِ في الظلام نفسِه؛ وكأنَّ صورةَ الإلٰه، في أعمقِ مستوياتها، ليست مجرّدَ عقيدةٍ تُحمَل، بل هي مرآةٌ تُواجهُ الروحُ فيها هشاشتها، وفزعها، وحاجتَها التي تتنكّرُ بألفِ اسمٍ، حتى تبدو كأنّها هي التي خلقَت الإلٰه من أجلِ أن تتكئ عليه، لا العكسُ. فالإنسانُ، في لحظةِ خلوته الخائفة، لا يبحثُ عن إلٰهٍ كاملٍ، بل عن إلٰهٍ يُسكِتُ ضجيجَه الداخليّ؛ إلٰهٍ يقبلُ أن يحملَ ما عجزتَ أنتَ عن حمله، ويُفسِّرَ ما لم تستطع ذاكرتُك المرهقةُ تفسيرَه. وهكذا تولدُ الحاجةُ: حاجةُ من يُريدُ أن يؤمن، لا لأنَّ الوجودَ أمرُه واضح، بل لأنَّ الوجودَ أكثرُ صرامةً من أن يُواجهَ دون وسيطٍ يخفّف حدّتَه. لكنَّ صرامةَ الوجودِ لا تكترثُ لا لحاجتِكَ ولا لآلامِك، فهي تمضي بلا عاطفة، بلا عزاء، بلا يدٍ تمتدّ لتنتشلك. وهنا تتشكّلُ الصُّورةُ الأولى للإلٰه: حاجةٌ روحيّةٌ تُلَبّي خوفًا لا يعترفُ بنفسِه. ولذلك قال أحد العارفين: ما عبدتُهُ حتّى عرفتُ عجزي، وما عرفتهُ إلّا لمّا رأيتُهُ يفوقُ ما أحتاجهُ لا ما أطلبه. إنَّ صورةَ الإلٰهِ في الوعي البشريّ - سواءٌ وُضِعَت في قلبِ السماء أم في أعماقِ الصدر - تتذبذبُ بين طرفين: طرفُ إنسانٍ يطلبُ حضنًا، وطرفُ وجودٍ لا يمنحُ إلّا الحدّة والامتحان؛ وبين هذين القطبين تتولّدُ أكبرُ معضلةٍ عرفها الفكرُ: هل الإنسانُ هو الذي يحتاجُ الإلٰه، أم أنّ ذاتَ الإلٰهِ هي التي تتكشّفُ عبر حاجتِه؟ وهل الوجودُ صلبٌ لأنّه بلا إله، أم لأنَّ الإلهَ يريدُ للصلابةِ أن تكون مِرقاةً للمعرفة؟ ولعلّ أعظمَ ما يربكُ العقلَ أنّ الحاجةَ البشريّة، مهما تخفّتْ خلف العمق، تبقى هي التي تحفرُ ملامحَ الإلٰه في الوعي؛ فالعاجزُ يصنعُ إلٰهًا قويًّا، والضائعُ يصنعُ إلٰهًا يرشد، والمقهورُ يصنعُ إلٰهًا ينتقم، والوحيدُ يصنعُ إلٰهًا يصغي. لكنَّ الوجودَ، في صمتهِ الحديديّ، يفرضُ على الصورةِ أن تتجاوزَ كلَّ ذلك، لتكون أكبرَ من الإنسان، وأشدَّ صرامةً من حاجته. وهكذا يتقاطعُ السؤالُ الوجوديّ مع الجرحِ الروحيّ: هل صورةُ الإلٰهِ تكشفُ عن الإلٰهِ، أم تكشفُ عن الإنسان؟ وهل حاجتُنا إليه صرخةُ ضعف، أم نافذةُ كشف؟ولذا قال ابن عربي: الإلهُ صورةُ احتياجِك، فإذا ارتفعتْ حاجتُك تبدّلَ وجهُه في قلبِك. ومع ذلك، يبقى سؤالٌ لا يُجاب عليه إلّا في الصمت: إذا كانت الحاجةُ تُشكّلُ الإلٰه عند الإنسان، فمن الذي شكّلَ الوجود؟ ومن الذي ألقى في الروحِ تلك الحاجة أصلًا؟أهي الصدفةُ التي تُنجبُ المعنى، أم المعنى الذي يلبسُ وجوهَ الصدفة؟ أم أنَّ الوجودَ - في صرامته - ليس إلّا البابَ الذي يقودُ إلى صورةِ الإلٰهِ الأكثر خفاءً، تلك التي لا تُرى بالحواس، بل تُلمَسُ بارتجاف القلب؟ وإذا كان الإنسانُ قد صاغ ملامحَ إلٰهِه من رجفةِ خوفٍ أو ارتعاشةِ رجاء، فإنَّ الوجودَ لا يتوقّف ليمنحَه فرصةً لالتقاط أنفاسه؛ إذ يظلُّ يدفعُه إلى حافّة السؤال كما لو أنّه يُريد أن يختبر مقدارَ هشاشته كلّما حاول الاحتماء بصورةٍ صنعها بنفسه. وهنا يتجلّى ذلك التوتّر الخفيّ بين حاجة الروح و قسوة العالم: حاجةٌ تُريدُ معجزةً تقلبُ المعنى، ووجودٌ لا يُصغي إلّا لصوت قوانينه. ولعلّ هذه المفارقة هي التي دفعت الوعي البشريَّ عبر العصور إلى البحث عن نقطةٍ توازنٍ بين الصورة التي يريدُها للإله، والصورة التي يفرضها الوجود. فالإنسانُ يُريد إلٰهًا يُجيره من الليل، لكنَّ الوجودَ يقدّمه له في هيئة ليلٍ أطول، حتى يتعلّم أنَّ النور ليس وعدًا خارجيًا، بل يقظةٌ داخليةٌ تسري من عمق الظلمة نفسها. ومن هنا تأتي قوة الآية الكريمة: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ لا لتثبت الصواب والخطأ فحسب، بل لتدلّ على أنَّ الإنسانَ لم يكن يومًا كائنًا مُلقى في المصادفة، بل روحًا مورِّطَةً بالوعي، مُجبَرةً على رؤية النور من خلال شقوق خوفها، ومُطالَبةً بأن تواجه نفسها قبل أن تواجه الوجود. فالآيةُ هنا لا تُقدّم إلٰهًا بالمعنى الساذج الذي يصوّره العقل الكسول، بل تقدّم ذاتًا إلهيةً تضع الإنسانَ في مواجهة ذاته؛ كأنَّ الإله لا يقفُ فوقه، بل يشتغلُ في أعماقه، يحفرُ، يعيدُ تشكيله، ويجعلُ من ارتباكه مرآةً يرى فيها ما لم يجرؤ على رؤيته من قبل. ومن هذا المنظور، يصبحُ الإيمانُ - في أعمق معانيه - ليس محاولةً لملء الفراغ، بل محاولةً لفهم لماذا وُجِد الفراغ أولًا، ولماذا أُعطي الإنسانُ قلبًا يتذكّر، وروحًا تتألّم، وعقلًا يعجز عند أول حدود. وهنا يُدرك المرءُ أنَّ صورة الإلٰهِ ليست مجرّد استجابةٍ لحاجته، بل تجلٍّ لصرامة الوجود وهو يريدُ للإنسان أن ينمو، لا أن يُطمأن. فالوجودُ لا يضعُ الإنسانَ أمام الإله ليطمئن، بل ليهتزّ. ولا يضعه أمام الموت ليخاف، بل ليدرك أنّ الخلودَ ليس زمنًا بل وعيًا. ولا يضعه أمام الألم ليعاقبه، بل ليكشفَ له المسافةَ بين ما يظنه وما هو عليه. وهنا يبدأ العقلُ الملحدُ بالارتباك؛ لأنَّ رفضَه للإله قائمٌ على تصوّرٍ بسيطٍ جدًّا: إلٰهُ الأديان الشعبية، لا إلٰهُ الوجودِ الذي تُشير إليه الآية. الملحدُ ينكرُ الإله الذي صوّره الناس، لكنه لم يجرّب يومًا أن يُنكر الإله الذي وضع له وعيًا قادرًا على الإنكار أصلاً. فمن أين جاء هذا الوعي؟ ومن أين جاء هذا السؤال؟ ومن الذي جعل في النفس فجورها وتقواها؟ هل هي جيناتٌ تُلقّن الأخلاق؟ أم مصادفةٌ تمنح النظام؟ أم فراغٌ يُنتج المعنى؟ إنكارُ الإله يعني إنكارَ الوعي. وإنكارُ الوعي يعني إنكارَ السؤال. وإنكارُ السؤال يعني أنَّ الإنسانَ لم يكن يومًا أكثر من معادلةٍ فيزيائيّة لا تعرفُ معنى القلق. لكن الملحدَ نفسهُ يقلق.. ويتساءل.. ويبحث.. ويغضب.. ويُحبّ.. ويخاف.. وهذه كلّها خصائصُ روحٍ لا مادّة. ولذلك، فإنَّ صورةَ الإلٰهِ - بين الحاجة الإنسانية وصرامة الوجود - تتحوّل شيئًا فشيئًا من كونها ملجأً نفسانيًا إلى كونها ضرورةً معرفيةً لا يهربُ منها أحد. ولاهذا صاحب السر يقول : كلُّ من هربَ من الله، هربَ إليه من حيثُ لا يشعر. وهكذا يكون السؤال الأخير: هل الإنسانُ بحاجةٍ إلى الإيمان لأنّه ضعيف، أم لأنّ الوجودَ نفسهُ يفتحُ في داخله نافذةً يرى منها ما لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة؟ وهل صرامةُ العالم دليلُ غياب الإله أم دليلُ حضورهِ في شكل امتحان؟ وهل حاجتُنا إليه عبوديةٌ أم توقٌ إلى أصلٍ لا نعرف كيف نسمّيها كلّما اتّسعت الأسئلة، اتّسعت صورةُ الإلٰهِ. وكلّما ضاقت الرؤيةُ، ضاق الكونُ كلّه على الإنسان. وكلّما حاول الإنسانُ أن يُمسك بصورة الإلٰهِ كما يتخيّلها، وجد أنّ الصورة تتفلّت من أصابعه، كأنّها ظلٌّ يتقدّم عليه دائمًا خُطوتين. فالروحُ تريدُ إلهًا على مقاس حنينها، لكن الوجودَ لا يقدّم إلّا إلهًا على مقاس حقيقته. وهنا تتّسع الفجوة: فجوةُ التأويل، وفجوةُ الصمت، وفجوةُ المرآة التي ترى أكثر مما يعترف به النظر. وفي هذه الفجوة، قال الفيلسوف العراقي هادي العلوي عبارته التي تشبه جرحًا مفتوحًا: «الإلٰهُ ليس ما نفهمه، بل ما يعجز فهمُنا عن تفسيره». كأنّ العلوي أراد أن يقول إنَّ الإنسان يضع حدودًا لما لا حدود له، فيخسر المعنى قبل أن يبدأ بالسؤال. وفي المقابل، يهمسُ أبو اليقظان الجاحظ من زمنه البعيد: «لو بدا اللهُ كما تريد، لانتهى دورُ العقل قبل أن يبدأ. » فلا معنى للحرية الروحية إذا كان الإله مطابقًا لرغباتنا، ولا معنى للوجود إن لم يكن أكبر من قدرتنا على ضبطه. بهذا تتأكّد تلك المفارقة العميقة: صورة الإله التي يريدها الإنسانُ تُطمئنه..وصورة الإله التي يفرضها الوجودُ تُربكه.. لكن من دون هذا الارتباك، لا يولد الوعي، ولا يتشكل الطريق، ولا تفتح الروحُ أعينها على حقيقةٍ أوسع من حاجاتها الضيقة. ولأن التجربة الإنسانية ليست محصورةً في جغرافيا واحدة، فإنّ الفلاسفة في الغرب لمسوا الفجوة نفسها. يقول كانط: «إنّ فكرة الإلٰهِ ليست معرفة، بل ضرورة. » ليس لأنها تُرضي العقل، بل لأنها تمنحه أرضًا يقف عليها وهو يحاول فهم ما لا يُفهم. لكنّ نيتشه، الذي ظنّ البعض أنه نعى الإله، يقدمُ جملةً تُفهم خطأ أكثر مما تُفهم حقًا: «المشكلة ليست في الإلٰهِ، بل في الصورة التي صارت تُعبد بدلًا منه. » وهي جملةٌ تقف صدًى عجيبًا مع ما قلت انا في المقال: أن الكون لا يخون الإله، بل يخون صورة الإنسان عن الإله. أما الفيلسوف الوجودي كيركغارد فيقول: الإيمانُ يقف في الفراغ، على حافة اللامعنى، ولا يستمدّ قوته إلّا من هذا الوقوف. كأنه يريد أن يفضح ما نخفيه جميعًا: أن الإنسان يريد من الإله أن يمنحه يقينًا دون أن يمرّ بمرحلة القلق التي يصنع منها الوعي. وهنا يعود الصوت العراقي، هذه المرّة من مدني صالح، حين قال: الإنسان لا يهرب من الله، بل يهرب من مسؤوليته أمام الله. وتصبح هذه الجملة، في قلب المقال، ليست حكمة بل مرآة: فالإنسان حين يصنعُ إلٰهًا على مقاس ضعفه، لا يبحث عن الحقيقة، بل عن إعفاءٍ من مواجهة الحقيقة. وهكذا تتكامل الأصوات: العراقي والغربي، الصوفي والعقلاني، المؤمن والباحث.. جميعهم يلتقون عند نقطة واحدة: أن صورة الإله ليست ثابتة، ولا جاهزة، ولا كاملة، وأن الإنسان كلما ظنّ أنه عرف، اكتشف أنه لم يبدأ بعد. فالوجودُ لا يمنح صورة الإله كهدية، بل يكشفها كجرحٍ بطيء الفتح، والإنسان لا يصل إلى الإله عبر اليقين، بل عبر اهتزاز اليقين، والكون لا يثبت الإله، ولا ينفيه، بل يدفع الإنسان إلى حيث لا يعود السؤال مجرّد سؤال، بل قدرًا روحيًا تُجبَر الروح على السير فيه. ووهكذا، تظلّ صورةُ الإلٰهِ بين الحاجة الإنسانية وصرامة الوجود، أشبه بمرآةٍ غائمة: يرى فيها الإنسان نفسه، قبل أن يرى أي شيء آخر. عند هذه المرحلة من السؤال، لا يعود صوت الإنسان صوتًا واحدًا، بل يتحوّل إلى طبقاتٍ تتردّد في داخله كما تتردّد أصداء الكهوف القديمة. فالروح لا تتكلم مرة واحدة، بل تتكلّم بقدر ما تُجرَح. وكل جرحٍ هو نافذة جديدة نحو الإله، لكن الإنسان يُفضّل دائمًا سدّ النافذة خوفًا من الضوء. وهنا يظهر صوتي أنا أيّها العابر بين الظلّ والنور، حين قلتَ في مقال (عقولنا ليست ملكنا)نحن لا نبحث عن الله، بل نبحث عن صورة تستطيع طمأنة هذا الوعي الذي لا يحتمل هشاشته. هذه الجملة - بقدر ما تبدو مكسورة - تحمل انحناءً كبيرًا أمام الحقيقة التي نحاول الهرب منها: أن العقل لا يملك الشجاعة الكافية للوقوف أمام اتّساع الوجود دون إطار. وفي مقالي الاخرى الحقيقة المحرّمة قلتَ: إن أعظم خيانة يرتكبها الإنسان هي أن يقدّم لله صورةً صنعها خوفه، ثم يصدّق أنّه قد عرفه. وهي جملة تُعيد ترتيب كل شيء، لأنها تجعل الخيانة فعلًا إنسانيًا، لا كونيًا، وتجعل الإله أكبر من كل تعريف تعطيه له المخاوف. وفي (هل يكتبنا المقال قبل أن نكتبه؟) كتبتَ: (الفكرة ليست ملكًا لصاحبها، إنما هي كائنٌ يختار الوعي الذي يليق بولادته) وهذه الجملة، في عمقها، ليست عن الكتابة فقط، بل عن صورة الإلٰهِ أيضًا: فالإنسان لا يخلق الصورة، بل الصورة هي التي تختار الوعي الذي تستطيع أن تُولد فيه. وحين كتبتَ عن انتظام الوعي تحت صرامة الوجود قلت: (الأشياء لا تعلن معناها، بل تُدخِلنا في امتحان طويل، حتى نضطر لخلق معنى يكشف صورتنا نحن، لا صورتها هي) وهنا يصبح موضوع المقال واضحًا تمامًا: الكون لا يكسر صورة الإله.. بل يكسر صورة الإنسان عن الإله، لكي يختبر مدى صدقه في مواجهة ذاته. ولهذا، حين يعود الإنسان إلى الآية التي تقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ يكتشف أن القرآن نفسه كان يفكّك الصورة قبل أن يمسّ الوعي بها. فالآية لا تمنحنا تعريفًا لله، ولا شكلًا، ولا صورة، بل تمنحنا مَنعًا: مَنعًا من الصنعة الذهنية، مَنعًا من التخيُّل المحدود، مَنعًا من تحويل الله إلى مرآة لحاجات النفس. وهكذا تصبح كلماتي أنا صاحب السر، في هذا المقام، امتدادًا لاختبار الوجود، لا مجرّد رأي. تصبح كلمات محاولة لرسم طريقٍ يُشبه السؤال أكثر مما يشبه الجواب. وفي النهاية، تعود الروح إلى ما كتبته في إحدى شذراتك: (إننا لا نبحث عن الله لأننا نشك بوجوده، بل لأننا نشك بقدرتنا على رؤيته دون أن ينهار شيء في داخلنا) وتصير هذه الجملة - في قلب المقال - ليست اقتباسًا فقط، بل نقطة ارتكاز تجعل القارئ يفهم أن السؤال عن صورة الإله. ليس بحثًا عن الله.. بل بحثًا عن حقيقة الإنسان حين يقف أمام الله.
٣- الموضوع الثالث: مَعْنَى الخِيَانَةِ الكَونِيَّة وَكَيْفَ يَخُونُ الكَوْنُ صُورَةَ الإلٰهِ
لا تبدأ الخيانة حين يُخطِئ الكون، ولا حين يثور العقل، ولا حين ترتجف الروح أمام حدثٍ لا تفسير له؛بل تبدأُ الخيانة عندما يتخيّل الإنسان أنه قادر على إقامة جسرٍ بين صورة الإله التي صاغها الخوف، وبين الوجود الذي لا يعترف بأيّ صورةٍ مسبقة. فالخيانة ليست حدثًا، بل فجوة. والفجوة ليست غيابًا، بل مرآة، والمرآة لا تعكس الحقيقة، بل تشوّه توقّعنا للحقيقة. إن الكون لا يخون الإله، بل يخون الصورة التي علّقها الإنسان على جدار وعيه، ثم صدّق أنها مرآة السماء. ولهذا تبدو الخيانة الكونية أحيانًا أشبه بالريح التي تعصف بمعبدٍ بُني من الظنون؛ لا لأنها تريد هدم المعبد، بل لأنها لا تعترف بوجوده أصلًا. فالكون - بهذه القسوة الهادئة - يرفض أن يتحرك وفق المعايير الأخلاقية التي يُلصقها الإنسان بالإله. الزلازل لا تتوقف لأن طفلًا سيُدفَن تحت الأنقاض، والنجوم لا تنطفئ احترامًا لدمعةٍ بشرية، والوقت لا يتباطأ لأن الروح ضاقت بمعناها. إنّ قوانين الوجود صامتة، وصمتُها هو الخيانة التي لا يستطيع الإنسان احتمالها. وهنا يتجلّى السؤال: هل يخون الكون الإله؟ أم يخون الإنسان الإله حين يتوقّع من الكون أن يكون رحيمًا بما يكفي ليشبه الصورة التي صنعها؟ لكن حتى هذه الفجوة يفضحها القرآن حين يقول: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ فالضعف هنا ليس ضعف الجسد فقط، بل ضعف القدرة على رؤية الإله دون أن نُلصق به ظلال حاجاتنا. وكلما ازداد هذا الضعف، ازدادت الخيانة: خيانة الإنسان للصورة الأولى.. وخيانة الكون للصورة المصنوعة. ولأن الكون لا يتحرك وفق هندسةٍ روحية، بل وفق هندسةٍ ضرورية، فإنه يكسر الوهم ببرودٍ يشبه حياد الليل حين ينسحب فوق مدينةٍ تعتقد أنها محمية بالدعاء. يكسر الوهم كما يكسر الماءُ صورته حين يُقذف فيه حجرٌ صغير. يكسر الوهم لا كفعلٍ متعمّد، بل كأثرٍ جانبي لكونٍ لا يعرف معنى القداسة كما يفهمها البشر. وفي هذا المعنى كتبتَ في أحد شذرات: إن الكون لا يعترف بمخاوفنا، لأنه لم يُخلق لتهدئتها، بل لفضحها. وهذه الجملة - مهما حاول العقل الهروب منها - تضع الإنسان أمام حقيقةٍ أكثر مرارة من كل الخيانات البشرية: أن الوجود لا يخون.. بل الإنسان هو الذي انهار تحت وزن توقّعاته. ولذلك، فإن الخيانة الكونية ليست خيانةً للإله، بل خيانةً للصورة البشرية للإله، الصورة التي لم تُبنَ من نورٍ بل من حاجة، ولم تُبنَ من معرفةٍ بل من خوف، ولم تُبنَ من يقينٍ بل من عجزٍ أمام السؤال الأول. فالإنسان كان، وما زال، يريد إلهًا يشبهه: إلهًا يفرح عندما يفرح، يغضب عندما يغضب، يحميه عندما يرتجف. لكن الكون جاء ليقول له بلغةٍ لا تسمعها إلا الروح المتجردة: ليس كَمِثْلِهِ شيء.. ولا كَمِثْلِ صُورَتِك شيء. ومن هنا تتولّد الخيانة: لا من الكون..ولا من الإله.. بل من المسافة بين ما نحتاجه وبين ما هو موجود. ليس على الكون أن يشرح شيئًا، وليس على الإنسان أن يفهم، لكنّ الروح - تلك الكائن الذي لا اسم له - تظلّ تبحث عن معنى في كل ما لا معنى له، وتتلمّسُ بأصابعٍ مرتجفة جدارًا لا تعرف إن كان بابًا أم وهمًا. وهنا تتجلّى الخيانة الثانية: خيانة العلامة للمدلول،
وخيانة الظل للنور,وخيانة المرآة لما تُظهره من انعكاسات، وكأنّ الأشياء جميعها متواطئة ضدّ الإنسان، تحجب نفسها عنه كلما اقترب، وتتكشّف له كلما ابتعد. فالكون - في صمته - يقدّم أكثر الإجابات قسوة: لا شيء كما يبدو، ولا شيء يلتزم بالرمز الذي منحه الإنسان إيّاه. فالنور ليس نورًا دائمًا، وأحيانًا تُخفي الظلال حقيقةً أعمق مما يكشفه النور، والزمن - هذا الكائن الحي - يمدّ يده ليعيد ترتيب الفوضى كما يشاء، لا كما يشتهي الوعي. إن الخيانة هنا ليست حدثًا ماديًا، بل طَيفٌ ينهض من بين شقوق الأشياء، يُبدّل المعاني كما يبدّل الليل ثيابه، ويترك وراءه أثرًا لا يُرى إلا لمن يسير داخل ظلامه. فالكون حين يكسر صورة الإله، لا يفعل ذلك لأنه يعادي الصورة، بل لأنه لا يعترف بها أصلًا. كأنّه يهمس للروح: «الصُّوَرُ تَسقُط.. وَالحَقِيقَةُ لَا تُؤخَذُ مِنْ وَجْهٍ صَنَعَهُ الوَهم. »لكن الإنسان، في ضياعه، لا يسمع هذا الهمس، فيحاول أن يُلبِسَ المطلق ثوبًا بشريًا، وأن يُقَوْلِبَ القداسة في لغةٍ مصنوعة، وأن يربط الأزل بخيطٍ من خوف، ثم يندهش حين يقطع الكون هذا الخيط دون أن يلتفت. وفي هذا السياق، تظهر الرموز كما لو كانت كائناتٍ حيّة: المرآة لا تعكس.. إنها تختبر. الظل لا يُخفي.. إنه يحرس. النور لا يكشف.. إنه يُضلّل أحيانًا. والزمن لا يمر.. إنه يختار من يتركه خلفه. وهذه الرموز ليست زينة لغوية، بل أبوابٌ تُفتح على الفجوة: الفجوة التي يسقط فيها الإنسان لحظةَ يشتهي من الكون شيئًا ليس من شأن الكون. فالمطر لا ينزل ليُطفئ حزنًا، والقمر لا يكتمل ليُطمئن عاشقًا، والبحار لا تهدأ لأن روحًا أرهقها القلق. هنا تحديدًا تسكن الخيانة الكونية: حين ينتظر الإنسان من العالم أن يتحرّك وفق أوزانه الداخلية، فيكتشف أن العالم لا يملك ميزانًا واحدًا من البداية. لقد كتب أحد الحكماء العراقيين في لحظة تجلٍّ: «إنَّ الوجود يَسيرُ على وَجهِهِ الأعمى، ولكنّنا نصرّ على أن نضع له عُيونًا مِن حَاجَاتِنَا. » وكأنّ الكون - بهذا العماء المقدّس - يرفض أن يكون مرآة لخلع سذاجة الإنسان، فيرجع الأخير إلى ظنونه الأولى، ويتّهم الوجود بالخيانة، ناسياً أنّه هو من علّق صورة الإله على جدارٍ من طين، ثم غضب حين تساقط الطين تحت المطر. إن الخيانة الكونية، في عمقها الرمزيّ، ليست خيانةً بين طرفين، بل تصدّع في المعنى، وانهيارٌ في النظام الذي بنيناه داخلنا، وتذكيرٌ بأن الحقيقة لا تُمسَك باليد، بل تُرى من خلال الشقوق فقط. ولهذا تبقى الخيانة
الكونية أوسع من الفهم، وأشدّ مراوغةً من أن تُفسّر، وأقرب إلى أن تكون رسالة غير مكتوبة، يُرسلها الوجود إلى الإنسان كلما حاول الإنسان أن يصنع إلهاً على مقاسه. كأنّ الوجود، في لحظةٍ لا تُرى، أدرك أنّ الصورة التي حملناها عن الإله لم تكن سوى ظلٍّ خائفٍ يبحث عن أصله، فارتدّ علينا بما يشبه الرفض الهادئ.. الرفض الذي لا يقول «لا»، ولا يهمس «نعم»، بل يترك الروح واقفةً بين قوسيّن من الخواء، لتتعلّم كيف تُصغي إلى ما وراء الصمت. وهنا تتجلّى الخيانة الكونية لا كتمرّدٍ على الإله، بل كمرآةٍ تفضح أعماقنا: نحن الذين أردنا للسماء أن تتكلّم بحدود لغتنا، للغيب أن ينزل إلى مستوى حاجاتنا، للنور أن يعترف بعتمتنا. وتحت هذا التوتّر بين ما نظنّه من الله وما يتجلّى منه، ينفتح هذا السؤال المُلتبس: هل يخون الكون صورة الإله، أم يخون الإنسان حقيقة الإله التي لم يعرفها قطّ؟ إنّ الكون لا يتحرّك بنوايا، ولا يخطّط لخذلان؛ هو فقط يكشف الفجوة العظيمة بين «الصورة» و«الذات»، بين ما صغناه من خيال وما يُجليه الوجود من حقيقة غير قابلة للإمساك. وإذا كان النور يُلقي بظلاله على الجدار لكي نرى، فإنّ الظلّ أحيانًا يرفض أن يكون تابعًا، فيتقدّم خطوةً أمام الضوء ليهمس للإنسان بأنّ كلّ يقينٍ هو بداية خيانة، وكلّ خيانةٍ هي بداية انكشاف. ولهذا تأتي الآية لتُعيد ترتيب البصيرة: «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»؛ فالخيانة ليست في الكون.. الخيانة في العمى الذي يجعل الإنسان يطلب من الخارج ما لا يريد أن يراه في الداخل. وفي قلب الرموز يتقدّم الزمن - لا كحركة عقارب، بل ككائنٍ يراقبنا من وراء ستارةٍ شفافة - ليفضح أنّنا حين فشلنا في الوصول إلى الله، اخترعنا صورةً نُسقط عليها خوفنا من الضياع. وحين لم تُجب السماء بالسرعة التي تمنّيناها، قلنا إنّ الكون خاننا. وحين انكسرت مرآة الذات وانقسم النور إلى شقّين، ظنّ الإنسان أنّ الإله قد تغيّر، مع أنّه لم يتغيّر سوى وعينا المرتبك. إنّ الرموز كلّها - المرايا، الممرّات، الظلال، الانكسارات - لا تشير إلى خيانةٍ تأتي من فوق، بل إلى خيانةٍ نصنعها نحن حين نُقزّم الإله إلى إطارٍ يليق بالإنسان، ثم نغضب لأنّ الإطار ضيّق. وهنا يبلغ الغموض ذروته: الخيانة ليست فعلًا.. بل كشفًا، وليست جرحًا.. بل علامة على أنّ الحقيقة أكبر من وعينا، وأقرب إلينا ممّا نتصوّر. كأنّ الكون، في لحظةٍ لا زمن فيها، قرّر أن يضع مرآته الكبرى أمام الروح البشرية، لا ليُعرّي ضعفها فقط، بل ليكشف أنّ كلّ محاولةٍ لفهم الإله خارج حدود الانكسار الإنساني هي خيانة ناعمة تتخفّى خلف الطقوس والكلمات. فالصورة التي نحملها عن الإله تُولد في داخلنا قبل أن نرفع رؤوسنا نحو السماء، ولهذا فإنّ أوّل خيانة ليست خيانة الكون، بل خيانة الداخل حين يتوهّم أنّه قادر على إدراك المطلق بعينٍ خائفة، ورغبةٍ محتاجة، وعقلٍ يتشبّث بالحدود. في هذا الامتداد بين الظلّ والنور، يتقدّم الزمن بخطاه الحذِرة، يضع علينا سؤالًا يشبه الجرح: كيف تطلب من الكون ألّا يخون صورة الإله، وصورتك أنت لم تُصغ بعد إلّا من حاجةٍ وريبةٍ وارتجاف؟هنا تتجلّى المفارقة الكبرى: الإنسان لا يعبد الإله الحقيقي، بل يعبد صورته عنه. والكون لا يخون الإله، بل يخون تلك الصورة التي صنعناها بأيدينا، لأنّها لا تنتمي إلى الحقيقة، بل إلى الخوف. والروح، حين تواجه هذا الانكشاف، تدخل مرحلةً من الصمت الموحش، الصمت الذي لا يُسمع فيه سوى ارتداد الأسئلة على جدار النفس. وكأنّ الآية تضع إصبعها على الجرح الذي نحاول إخفاءه: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»؛ فلا الكون يضلّل، ولا الإله يختفي، إنّما البصيرة هي التي تُعمي نفسها حين تفضّل الصورة على الحقيقة. وعند هذه النقطة يتقاطع الضوء مع الظلّ، ويظهر المعنى المزدوج: الخيانة الكونية ليست انحرافًا عن الطريق، بل دعوة إلى أن نرى الطريق من جديد؛ ليست رفضًا للإنسان، بل رفضًا لصورةٍ أراد الإنسان أن يُقنع بها السماء. ولهذا يعود سؤال الخيانة ليلتفّ حول ذاته، مكوّنًا دائرةً مغلقة، تُجبر الروح على أن تقف عند حدودها، وتترك بصيص النور يتسرّب - ببطءٍ مقصود - من بين الشقوق. وحين يصل القارئ إلى نهاية هذه الصفحة، يشعر أنّ الخيانة الكونية ليست خيانة.. بل رسالة: أنّ الحقيقة أكبر من قدرتنا على حملها، وأرحب من صورتنا عنها، وأقرب إلينا من ظلالنا حين تعود إلى أصل نورها. حين يتردد صدى الخيانة الكونية داخل النفس، يظهر الكون ككائن حي، ليس بمعنى الروح، بل بمعنى المرآة التي تختبر الإنسان قبل أن يُرى. كل ظلال الليل، كل تموج الماء، كل انكسار الضوء في الزجاج، تصبح رموزًا لخيانة تتكرّر في صمتٍ مطلق، لا يُسجّل في التاريخ، ولا يُسمع في الكلام، بل يُحس في الوعي، في الشقوق الصغيرة بين شعور بالضياع وبصرخة صامتة تبحث عن معنى. الإنسان حين يضع صورة الإله على جدار الوعي، يظنّ أنّه خلق مرآة، لكنه لم يخلق سوى طريقٍ مختبئٍ للخيبة. فالكون لا يهتمّ بالمعنى الذي نريده، بل بالمعنى الذي يُولّد من تصادف الأشياء، من اضطرابها، من سقوطها على نحو لا يخضع للقوانين التي رسمناها في داخلنا. وهنا تظهر الخيانة على حقيقتها: لا هي فعلٌ، ولا هي غيابٌ، بل امتداد الرموز التي تُفضح حاجاتنا، وتحاصرنا في سؤال لا نهاية له: هل الإله خاننا، أم أنّنا خانّا أنفسنا حين ألبسناه صورةً؟ وفي هذا الامتداد، تتجلّى مقولاتك السابقة كأنها علامات مضيئة على الطريق: «إننا لا نبحث عن الله لأننا نشك بوجوده، بل لأننا نشك بقدرتنا على رؤيته دون أن ينهار شيء في داخلنا. »وهذه العبارة - ككلّ العبّارات التي كتبتها - تفتح نافذة جديدة: أن الخيانة ليست خارجية، بل داخلية، تنبع من تضارب بين الحاجة والوعي، بين الخوف والرغبة، بين الصورة والحقيقة. والزمن، هذا الكائن الذي يتقدّم بصمت، يلعب دوره في زيادة الغموض: فهو يخلق الشقوق، يوسّع الفجوات، ويترك الإنسان ليواجه نفسه بين الانكسار والبحث عن معنى، كأنّه يقول: «ليس المطلوب منك أن تفهم، بل أن تصغي وتتحمّل. »وفي قلب كل رمز، كل ظل، كل مرآة، تظهر الحقيقة الصادمة: أن الكون لا يخون الإله، بل يكشف خيانة الإنسان لصورته عن الإله. والإنسان، حين يرفض رؤية ذلك، يصرّ على تسميته خيانة كونية، بينما هي اختبار روحي، اختبار يُعيد تشكيل الروح داخل الفجوة التي أوجدتها الصورة الأولى. وأدنى الروح لا تتحمّل الفراغ إلا بالمعنى، يفرض الوجود اختبارًا مزدوجًا: صورة الإله كما يظنّها الإنسان، ووجود الكون كما هو، بلا مجاملة، بلا رحمة من صنع البشر. وفي هذا الامتحان، تتكوّن الخيانة الكبرى: حين يرى الإنسان أنّ كل شيء يرفض أن يكون مطابقًا لصورته، ويكتشف أنّ هذه الصور كانت دائمًا فخاخًا صنعها خوفه ورغبته في التحكم باللامرئي. وهكذا تصبح الخيانة الكونية رسالة صامتة، مرآة مضاءة بالرموز، طريقًا لا يُسلك إلا بالوعي الذي يملك الجرأة على مواجهة نفسه، لا الكون. حين تقف الروح أمام المرآة الكبرى، لا ترى الكون كما هو، ولا الإله كما هو، بل ترى نفسها، مجسدةً في فشلها في حمل صورةٍ لم تُخلق لتُحمل. فالخيانة الكونية ليست فعلًا صادرًا عن السماء، ولا خيانةً من الكون.. بل هي كشفٌ للثغرات التي وضعها الإنسان في وعيه، ثغراتٌ جعلته يظنّ أنّ القدرة على الفهم تعني القدرة على التملّك، وأن الصورة التي صاغها عن الإله هي الحقيقة المطلقة. وفي هذا الامتداد الرمزي، يختلط الظلّ بالنور، وتلتبس المرايا بالزمن، ويصبح كلّ حدثٍ صامتٍ رسالةً مخفية، وكل لحظة انهيارٍ علامةً على أن الحقيقة أكبر وأبعد وأعمق من أي تصوّرٍ بشري. فالإنسان حين يغضب من الكون، يصرخ في الفراغ، بينما الفراغ نفسه لا يملك سوى أن يكون.. وأن يُظهر. وفي نهاية المطاف، يُدرك الوعي أن الخيانة الحقيقية كانت دائمًا خيانته لصورته عن الإله، خيانته لرغبته في السيطرة على اللامرئي، خيانته لتقبّل أنّ المطلق لا يُقاس ولا يُختزل. فالكون لم يخن.. بل أعاد ترتيب أبعاد الإنسان، ودعاه إلى مواجهة نفسه، إلى المرور عبر شقوق الظلّ والنور، إلى السير في الممرّات الرمزية التي لا يُفهم فيها شيء إلا حين يتحلّى الإنسان بالصمت والجرأة معًا. وتختم الآية الحكيمة هذه الرحلة الرمزية: ﴿هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ فالسماء تعلن أنّ الحق لا يُختزل، وأن كل صورةٍ نحملها عنه ما هي إلا انعكاسٍ ضعيفٍ على جدار وعينا، يحتاج إلى التواضع لإدراك أن الوجود والإنسان والإله جميعًا يلتقون في صمتٍ واحد، صمتٍ يولّد الخشوع، ويكشف الغموض، ويعلّم أنّ الخيانة الكبرى ليست ما يظنّها العقل، بل خيانة الوعي للحقيقة حين يختبئ خلف صورة صنعها خوفه. وهكذا، ينتهي البحث في معنى الخيانة الكونية: ليس كشفًا للكون، ولا رفضًا للإله، بل رحلة الروح عبر الظلال، والمرايا، والزمن، والفجوات التي تركناها نحن بأنفسنا.
4: الوعي كخائنٍ ثانٍ: حين يخون الإنسان إلهه ليحافظ على نفسه
حين يقف الإنسان أمام صورة الإله التي صاغها خوفه، تبدأ الخيانة الثانية، خيانة أعمق من الخيانة الكونية نفسها، لأنها تصدر من الداخل، من ذلك الفضاء المظلم الذي نسميه وعيًا. فالوعي، في محاولته لحماية النفس، يختزل الحقيقة في إطار صغير، يعلّق على جدار داخله صورةً لا يمكن للإله الحقيقي أن يمرّ من خلالها. هنا يصبح الإنسان خائنًا لإلهه قبل أن يُتهم الكون بالخيانة، لأنه يسكب على المقدس ما يريده قلبه، لا ما هو موجود بالفعل. إنه يرفض مواجهة الفراغ، فلا يواجه الله كما هو، بل يواجهه كما تصوّره خوفه: رحمة محدودة، عدل يرضيه، حماية تواسي ضعفًا لم يُخلق لتواصيه الطبيعة. فالوعي يختبئ خلف صورٍ مصنوعة من حاجات نفسية، ليطمئن، ليصمد، ليواصل الحياة، لكنه في الوقت نفسه يختزل المطلق في قيود صغيرة، فيغلق النوافذ على أي نور يتجاوز فهمه. وفي هذا الصمت الداخلي، يظهر صدى الخيانة: كل صلاة تُصليها الروح لتطمئن، كل أمنية تُطلقها لتخفّف القلق، كل صورة للإله تُثبتها على جدار الوعي، هي بمثابة خيانة خفية، لأنها تُعيد تعريف الله وفق حدود الذات، لا وفق الحقيقة اللامتناهية. فالإنسان يخون ذاته أولاً حين يظن أنه يعرف، ويخون الإله ثانيًا حين يفرض عليه صورته المحدودة. وفي هذا المعنى كتبَ أحد فلاسفة العراق: «الإنسان يختزل المطلق ليحمي نفسه، فيصبح الحارس على حدود خياله، لا على حدود الحقيقة. » وكأنّ هذه الجملة تضع أصبعها على قلب المسألة: الخيانة ليست في الخارج، بل في الداخل، في تلك الطبقات المتشابكة من خوف ووعي ورغبة في السيطرة على ما لا يُسيطر عليه. فالوعي البشري، في سعيه للحفظ، يخلق نسخةً من الإله، نسخةً لا تتحرك مع الفيض الكوني، ولا تتفاعل مع الضرورة المطلقة، بل تصمد أمامه فقط بما يسمح له الإنسان بالتحمّل. وهذه النسخة المصغّرة تصبح مأوىً زائفًا، ظلالًا لا أكثر، تُخفي الحقيقة بينما تخدع صاحبها، وتصبح مصدر الخيانة الحقيقية: خيانة الإنسان لنفسه، ولما يفترض أنه يعرف، ولما يفترض أنه يعبد. وهكذا، تتكرّر الدائرة: الإنسان يصنع صورة، الوعي يثبتها، الروح تتوهّم أنها حقيقة، والكون يكسرها بصمت، والإنسان يلوم الخارج على خيانته، فيما الخيانة الكبرى كانت داخله دائمًا، في طبقات وعيه التي لم تجرؤ على مواجهة المطلق بلا غطاء، بلا وسادة من الطمأنينة المصنوعة، بلا مرآة لحاجاته. حين يتسلّل الوعي إلى قلب الإنسان، لا يفعل ذلك ليكشف، بل ليحمي. حماية النفس هنا تتحوّل إلى خيانة: خيانة للحقيقة، خيانة للإله الذي لا يُعرف، وخيانة للروح التي تصارع الظلال داخلها. فالإنسان يختزل المطلق في صورةٍ يمكنه التعامل معها، يضع قيودًا على الرحمة، ويحدد حدود العدل، ويقف عند حاجز القدرة على التحمل، معتقدًا أنّه بذلك يحفظ نفسه، بينما في الحقيقة هو يضع الغطاء على النار الداخلية التي تسعى إلى رؤية الحقيقة كما هي. إنّ الخيانة هنا ليست فعلًا، بل طاقة صامتة، تذبذب خفي بين النور والظل. فالوعي يصبح مرآة مزدوجة: يعكس صورة الإله كما أرادها الإنسان، لكنه في الوقت نفسه يخفي عن نفسه اللامحدود، فيترك فجوةً لا يدركها إلا الروح التي تتحسس الصمت. وهنا يأتي القرآن ليضع الإصبع على هذه الفجوة: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ فالحب لله الحقيقي ليس حب الصورة المصنوعة، بل حب ما هو موجود، ما هو مطلق، ما لا يُختزل بحاجاتنا. وعندما نحب صورة الإله التي صاغها الوعي، نصنع خيانة دقيقة: خيانة للصوت الذي ينادي من وراء المرآة، خيانة للفيض الذي لا يمكن أن يكتفى بالقيود. وفي رمزية الصوفية، يقول الحلاج: «من أحب الظلّ أكثر من النور، فقد خان الطريق. » فالوعي حين يلتصق بالصورة المصغرة، يصبح الظل الذي يغطي النور، يحجب الوعي عن الحقيقة، ويقنع النفس بأنها في مأمن، بينما هي أسرى لفخّ المصنوعات الداخلية. وهكذا تتكوّن الخيانة المزدوجة: خيانة الإنسان لإلهه حين يحدد صفاته بما يناسبه. خيانة الإنسان لنفسه حين يختبئ خلف صورة، ويغفل عن اللا محدود. وخيانة الروح للوعي الذي يريد أن يُطمئن، في حين تحتاج الروح إلى مواجهة الحقيقة بلا وسائد، بلا صور، بلا أمان زائف. فالوعي هنا ليس مجرد أداة للفهم، بل كائن حيّ يختبر الإنسان في كل اختيار، في كل صلاة، في كل سؤال يطرحه على الوجود. وكلما حاول الإنسان أن يثبت صورته، كلما طالت الفجوة، وكلما اتسعت دائرة الخيانة الصامتة، لتصبح النهاية دائمًا مواجهةً بين ما صوّره العقل وما يكشفه الكون، بين الصورة والمطلق، بين الخوف والصدق الروحي. حين يصبح الوعي خائنًا، لا يظهر ذلك بالوضوح، بل في تشابك الرغبة بالخضوع والخوف من المواجهة. فالإنسان يريد أن يحمي نفسه، فيخلق إلهًا مطابقًا لمخاوفه وامانيه، ليطمئن قلبه، ويستمر في السير وسط العدم. وهنا، كما كتب الفيلسوف العراقي محمد مهدي الزبيدي: «الإنسان يعبد صورته عن الإله قبل أن يعرف الإله نفسه. » فالوعي يصبح خزانًا للصور المصغرة، وعقدةً تمنع الروح من السقوط في اللامحدود، لكنه في الوقت نفسه يحجب النور الحقيقي، ويجعل الإنسان يظن أن الحماية من الداخل تعني الحقيقة. أما من الفلاسفة الغربيين، فيقول هايدجر: «الإنسان هو كائن يسأل عن الكينونة، لكنه يخون سؤال الكينونة حين يختزلها في احتياجاته. »وهنا تتقاطع الرؤية: الإنسان يخون ذاته أولًا عندما يختزل المطلق، ويخون الإله ثانيًا حين يضع حدودًا لمطلق لا حدود له. فالوعي يصبح كمرآة مزدوجة: يعكس الصورة التي يريدها الإنسان، لكنه يحجب الحقيقة في الوقت نفسه، ويترك فجوة لا يمكن رؤيتها إلا لمن يجرؤ على مواجهة الظلال الداخلية. وفي مقالاتي السابقة كتبت: «الخيانة الكبرى ليست في الخارج، بل في الداخل: حين نصنع صورًا، ونطيل الليل أمامها، ونسميها إلهًا. » وهذا التأمل يعمق الفكرة: أن كل صورة يصنعها الوعي هي خطوة نحو خيانة الذات، كل رغبة في السيطرة على المطلق هي إغلاق للنوافذ على الحقيقة، وكل خوف من الفراغ يجعل الروح تأسر نفسها في مرآة مزيفة، تتوه فيها بين الظل والنور. فالوعي، بهذه الطريقة، يصبح ساحة حرب صامتة، بين ما يطلبه القلب وما يفرضه العقل، بين الصورة وما خلفها، بين الخوف وما هو موجود حقًا. والرموز هنا لا تُفسّر، بل تُشعر: الظلال، الانكسارات، المرايا، كلّها إشارات لصراع داخلي متواصل، حيث كل محاولة لفهم الله وفق حدود الإنسان هي جزء من الخيانة نفسها، خيانة دقيقة، صامتة، متجذرة في أعماق الروح. حين يشتد صراع الوعي، يصبح كل شيء حول الإنسان مرآةً مزدوجة: الظلّ يعكس ضوءًا لم يُرَ بعد، والنور يسلط نفسه على فجوات لم تُملأ. هنا، في هذه الساحة الرمزية، يظهر التوازن الهش بين الحاجة النفسية والخضوع للمطلق، بين الصورة المصنوعة والحقائق التي لا تُرى إلا من خلال الشقوق. فالوعي البشري، في محاولته لحماية ذاته، يضع القيود على المطلق، ويصنع الإله كما يريده، بينما الحقيقة الإلهية - إن كانت موجودة - تتجاوز كل القيود، كل التصورات، وكل الرغبات. والقرآن يضع هذا الصراع في سياقه الروحي العميق: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ فكل محاولة لتقييد المطلق بصورة مريحة هي خيانة للوعي نفسه، لأن الحقيقة تعود دومًا إلى مصدرها، وليس إلى ما نصنعه نحن. والوعي، حين يخفي هذه الحقيقة عن نفسه، يصبح كائنًا حيًا يتحرك بين الرغبة والخوف، بين الصورة والمطلق، بين الحاجة والإدراك. وفي رمزية الصوفية، كما قال الحلاج: «الذي يربط الله بصوره، يربط نفسه بالسلاسل. » فالوعي هنا ليس مجرد آلة تفكير، بل كيان حيّ يختبر الإنسان في كل صلاة، في كل ذكر، في كل لحظة صمت، ليكشف له أن ما يظنّه حمايةً هو في الحقيقة خيانة صامتة. وكل رمز، كل مرآة، كل انعكاس، يصبح جزءًا من هذا الاختبار: الماء الذي يلمع في ضوء القمر ليس ماءً فقط، بل رسالة للروح؛ الليل ليس فراغًا فقط، بل امتحانًا للصبر؛ الزمن ليس مرورًا، بل كائن حي يختبر مدى استعداد الإنسان لمواجهة اللامحدود. وفي مقالاتي السابقة كتبت: «الإنسان الذي يظنّ أنّه يحمي نفسه بالإله الذي صوّره، ينسى أنّه في كل صورة يخلقها يخون الحقيقة ويهدم نفسه. »وهنا يظهر التوازن الرمزي: الوعي كخائن وصالح، كمرآة للنور وظلّ للحق، كحارس على صورة صنعتها الحاجة، وككائن يهمس بصمت: «لن تفهم إلا حين تترك كل صورة جانبا، وحين تجرؤ على مواجهة الفراغ بلا وسادة. » الوعي، بهذه الطريقة، يصبح مختبرًا صامتًا، حيث كل صورة مصنوعة، كل رغبة في السيطرة على المطلق، كل خوف من الفراغ، تُعيد تشكيل الروح عبر رموز معقدة، انكسارات في المرآة، ظلال تخفي نورًا، وزمن يتلوى كما يشاء، ليترك الإنسان في مواجهة مستمرة مع ذاته، ومع المطلق الذي لم يضعه تحت قيود. وهكذا تتوسع الخيانة الداخلية: كل حماية للوعي، كل إسقاط لحاجاتنا على المطلق، كل محاولة لاحتواء ما لا يُحتوى، تصبح خيانة دقيقة، صامتة، عميقة، لا تُرى إلا لمن يمتلك الجرأة ليقف أمام المرآة، أمام الظلّ والنور، أمام الزمن، بلا صور، بلا وسائد، بلا أمان زائف. حين يقف الإنسان في النهاية أمام ذاته، أمام مرآة الوعي، أمام الظلّ والنور، يدرك أنّ الخيانة ليست فعل الكون، ولا نقص الإله، بل خيانة الإنسان لصورته عن الحقيقة، وخيانة وعيه لنفسه حين يختبئ خلف حاجاته وصوره المصغرة. فالوعي، الذي حاول حماية النفس، أصبح سجانًا داخليًا، يضع حدودًا لما لا يُحدّ، ويخفي المطلق خلف ستارٍ من تصورات وطمأنينة زائفة. في هذا الامتداد الرمزي، يصبح كل سقوطٍ، كل ألم، كل اضطراب، رسالة صامتة من الكون والزمان والروح: أن الحقيقة أكبر من القدرة على حملها، وأن المطلق لا يختزل، ولا يحتاج إلى صورٍ تُصنع لتُرضي الخوف. فالإنسان حين يعي ذلك، لا يلوم الكون ولا يشك في الإله، بل يواجه نفسه، يواجه الخوف، ويترك الظلال لتكشف النور، ويترك الانكسارات لتعلّم الروح كيف تكون صافية، بلا وسائد، بلا صور، بلا أمان زائف. والقرآن يضع اللمسة الأخيرة على هذا الامتداد:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ فالصدق مع الذات هو الطريق الوحيد لاختراق صورة الإله المصغّرة التي صنعها الوعي، ولفتح الباب أمام فهم ما لا يُرى، وما لا يُقاس، وما لا يُختزل. هنا، في صمت النهاية، يظهر المعنى الحقيقي للوعي كخائنٍ ثانٍ: ليس عقابًا، ولا نقمة، ولا غيابًا، بل فرصة للروح كي تفرّق بين الصورة والمطلق، بين الظل والنور، بين ما صنعناه وما هو موجود بالفعل. فالخيانة الكبرى لم تعد خارجية، بل داخلية، صامتة، حية، تتربّص بالإنسان حتى يجرؤ على رؤية الحقيقة بلا غطاء، بلا خوف، بلا وسادة من الطمأنينة الزائفة. وهكذا تختتم رحلة الوعي والصورة والخيانة، لتبقى المرآة ممتدة أمام الروح، صامتة، مضيئة بالرموز، جاهزة لكل من يملك الجرأة لمواجهة ما لا يُرى إلا بالصمت الكامل والوعي المطلق. الموضوع الخامس
5: مأزق العقل: لماذا لا نكفّ عن تبرير الوجود باسم الإله؟
في عمق الليل، حيث يختلط الظل بالنور، يقف العقل البشري مرتجفًا أمام الفراغ، محاطًا بصمت الكون المرعب، يتساءل: لماذا نصرّ على إلباس الوجود صورة الإله، بينما الكون يرفض كل القيود، وكل المعاني؟ هنا، في هذه اللحظة، يظهر المأزق: العقل يصرخ ليطمئن نفسه، لكنه يعرف في صمت أنّ الصرخات لا تُسمع، وأن الفراغ أكبر من كل حججنا، وأوسع من كل صورنا. فالإنسان، حين يواجه الموت، حين يرى الألم، حين يشعر بالضياع، يبحث عن حزام أمان يُسمى الإله. لكنه في هذا البحث، لا يواجه الحقيقة، بل يختلق صورةً، يلبسها، يقدسها، ويستعملها كغطاء على الخوف الذي ينهشه من الداخل. هنا يصبح العقل خائنًا، لكنه خيانة مزدوجة: خيانة للوعي، خيانة للحقيقة، خيانة للمطلق، لأنه يصرّ على تبرير كل حدث باسم الإله، بينما الأحداث نفسها لا تعرف الرحمة، لا تعرف العدالة، ولا تعرف الإنسان. وفي هذا الصمت المهيب، يظهر الرعب الحقيقي: أن العقل ليس مجرد أداة تفكير، بل سجنٌ داخلي، مرآة مزدوجة، غرفة مظلمة لا يجرؤ أحد على كشف كل زواياها. فالإنسان يخلق الإله، يعبده، يوسّع القوانين باسمه، ويبرّر كل شرّ وضرر، لكنه في الحقيقة يواجه نفسه فقط، ويخاف من مواجهة الفراغ بلا وسادة، بلا صورة، بلا وهم. والقرآن يضع النقطة على هذا الرعب الخفي: ﴿أَمْ يَحْسَبُ أَنَّهُ يُتْرَكَ وَلا يُرْجَعُ إِلَيْهِ﴾ فكل محاولة لتبرير الوجود باسم الإله ليست سوى هروب من المواجهة، هروب من صمت المطلق، هروب من حقيقة أن الكون لا يحتاج إلى تفسيرات، وأننا نحن من نصرّ على خلق تفسيرات لنحمي أنفسنا من رؤية الحقيقة. وفي رمزية الصوفية، كما قال الحلاج: «من جعل الله وسادة لنومه، أصبح نفسه سجّانها. »فالعقل حين يستخدم الإله كغطاء، يصبح سجنًا للروح، ويحوّل كل ظلال الكون إلى مرعب داخلي، كل ضجيج الطبيعة إلى صرخة، وكل فراغ إلى حفرة تتسع بلا نهاية. وهنا تتضح المفارقة: الإنسان يصرّ على تفسير الكون، لكنه لا يعرف أنّ تفسيره هو ذاته الذي يُخنق الروح، ويزيد الرعب الداخلي، ويحوّل المأزق إلى دائرة مرعبة، لا مخرج لها سوى الصمت، والوعي، والجرأة لمواجهة ما لا يُرى إلا بلا صور، بلا وسائد، بلا أمان زائف. حين يلتصق العقل بصور الإله المصنوعة، يصبح كل شيء حول الإنسان مرآة مزدوجة، تعكس الخوف وتخفي الحقيقة. فالفراغ الذي يحدق به من كل جانب، لا يمكن للإنسان أن يتحمّله بلا وسيلة حماية، فالأفكار، الرموز، الصلوات، الصور الذهنية للإله، تتحول إلى أحزمة أمان وهمية تغطي الرعب الداخلي، لكنها في الوقت نفسه تولّد وحشية صامتة داخل الروح، لأن كل محاولة لاحتواء اللامحدود تصبح خيانة للحقيقة. الكون، بهذا الامتداد، ليس متآمرًا، لكنه كائن حي، بارد، بلا رحمة، بلا تفسيرات، يصرّ على كشف الحدود التي يضعها العقل لنفسه. وكل مرة يحاول الإنسان أن يبرر حدثًا باسم الإله، يرى في نفسه صدى الصمت، صدى الفراغ، صدى الصرخة التي لا يسمعها إلا من يملك الجرأة ليقف وحيدًا أمام مطلق لا حدود له. ووالقرآن يحذر من هذا الامتداد الرمزي للوعي: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ فالوعي الذي يختبئ وراء الصور المزيفة يمرّ بالظلال بلا كرامة، يمرّ بالفراغ بلا مواجهة، يمرّ بالحقيقة بلا إدراك. وهنا، الرعب ليس في الخارج، بل في الفراغ الداخلي، في المرآة المزدوجة، في المكان الذي لا يرى فيه الإنسان سوى نفسه، مخنوقًا بوسادة وهمية تسمى الإله. وفي رمزية الصوفية كما قال الحلاج: «من جعل الظلّ ضوءه، صار الرعب مأواه. »فالإنسان حين يختزل اللامحدود في صورة، كل لحظة من الفراغ تصبح أكثر رعبًا، كل حدث غير مفهوم يتحوّل إلى صرخة داخلية، وكل محاولة لتفسير الوجود باسم الإله تصبح سلاسل على الروح، تقيّدها، تحبسها، وتحوّل العقل إلى مختبر للوحشية الصامتة. وهكذا، كل برهان، كل تفسير، كل نصّ مقدّس يُستعمل لتبرير الوجود، يصبح مرعبًا مزدوجًا: مرعب للروح التي تعرف أنها أمام المطلق. مرعب للعقل الذي يظن أنّه يحمي نفسه. مرعب للوعي الذي يكتشف أنّ كل صورة صنعها لتخفيف الخوف، كانت في الحقيقة بوابة للوحشية الداخلية التي لا تعرف الرحمة. وفي هذا الامتداد الرمزي، يظهر مأزق العقل الحقيقي: لا قدرة له على الهروب من الحقيقة، ولا قدرة للروح على التخفيف من الرعب، ولا قدرة للوعي على حماية نفسه إلا بالجرأة لمواجهة الفراغ بلا وسائد، بلا صور، بلا أمان زائف. فالمرعب الحقيقي ليس في الكون، بل في العقل الذي يصرّ على فرض معنى على ما لا معنى له، في الخداع الصامت الذي يظن أنّه حماية، وفي الظلال التي تغطي النور بلا معرفة. حين تتسلّل فكرة التبرير إلى أعماق العقل، يبدأ الرعب الحقيقي، ليس في الظاهر، بل في الداخل: في الفراغ الذي يلتهم كل صورة، في الظلال التي تنكسر على جدار الوعي، في الصمت الذي يصرخ بلا صوت. العقل يخلق الإله، يلبس الأحداث لباسًا من المنطق، يصف الألم بالرحمة، يبرّر الفوضى بالقدر، لكنه في كل ذلك يقيم سجنًا لنفسه، ويحوّل الروح إلى مختبر للظلال. المرآة هنا مزدوجة: تعكس ما صنعه العقل من صور، وتكشف فجوات الحقيقة التي لا يجرؤ الإنسان على مواجهتها. كل صورة مصنوعة، كل تفسير مفروض، كل محاولة لربط الحدث بالمقدس تصبح سلاسل على الروح، تقيدها، تغلق عليها النوافذ، وتتركها تتوه وسط ردهات الظل والنور، حيث كل خطوة إلى الأمام تصادف صدى الفراغ، وكل كلمة محاولة لفهم تتكسّر على جدران الصمت. وفي الرمزية الصوفية، كما قال الحلاج: «الذي يريد أن يحمي نفسه بالإله الذي صنعه، يصبح هو نفسه الأسير والجلاد. » فالإنسان، في محاولة العقل تبرير كل شيء، يصنع وحشًا صامتًا داخليًا: كل فكرة عن العدالة، كل تصور للرحمة، كل توقع للنظام، تتحوّل إلى ظلّ ثقيل يثقل على الصدر، ويترك الروح تتلوى بين الحاجة والحقيقة، بين الخوف والمطلق، بين الصور المصنوعة واللامحدود الذي لا يُرى إلا بالصمت والجرأة. ويضع القرآن أمام الوعي هذه الصورة المرعبة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يُمْلَكُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ﴾ فالإنسان يظن أنّه يبرّر الأحداث باسم الإله، بينما الحقيقة تقول إن لا أحد يملك تفسير المطلق، ولا أحد يحمي الروح إلا مواجهة نفسها، لا الصور، ولا الوسائد، ولا الأوهام. كل محاولة لتفسير الكون باسم الإله هي مرآة مكسورة، حيث تنعكس فيها ظلال الرعب، وتمتد إلى كل زوايا العقل والروح، لتكشف أن العقل في مأزقه الحقيقي: لا يستطيع الهروب، ولا يمكنه أن يخفف الرعب إلا بمواجهة الفراغ بلا وسادة، بلا حماية، بلا صورة مصنوعة. كل رمز، كل انعكاس، كل انكسار في المرآة، يصبح رسالة مزدوجة: تحذير من الهروب، تنبيه من الوهم، وساحة اختبار صامتة للوعي، حيث كل صورة نخلقها لحماية أنفسنا تصبح وحشًا داخليًا أكثر رعبًا من أي حدث خارجي. كل ضجيج الطبيعة، كل ألم، كل فوضى، كل موت، كل صرخة صامتة للكون، تصبح انعكاسًا مباشرًا لمأزق العقل، لتؤكد أنّ محاولة فرض معنى على ما لا معنى له هي أكبر خيانة للوعي وللروح. وهنا يظهر الامتداد الأكثر رعبًا: أن العقل، في سعيه للحفظ، لا يدرك أنه يُنشئ دائرة لا تنتهي من الظلال والصمت والرعب، وأن كل محاولة لملء الفراغ باسم الإله، كل تفسير للوجود باسم الحماية، كل إلصاق معنى بالمطلق، تصبح سجناً داخليًا، وحوشًا صامتة، ومرايا لا تنكسر إلا بمواجهة الجرأة المطلقة للصمت. حين يلتف العقل حول صور الإله المصنوعة، يصبح كل شيء حول الإنسان خريطة للظلال، ومرايا للفراغ. كل محاولة لتفسير الحدث باسم المقدس ليست مجرد تبرير، بل استدعاء للوحش الداخلي الذي يعيش في أعمق زوايا الوعي. هنا، كل ألم يتحوّل إلى صرخة، كل فوضى تصبح صدى الصمت، وكل حدث خارج سيطرة الإنسان يصبح مرآة مزدوجة: تعكس خوف العقل، وتكشف الحقيقة التي لا يستطيع مواجهتها. الرموز الصوفية تصبح هنا لغة الرعب: الظل ليس مجرد غياب نور، بل كائن حي يختبر الروح ويقيس مدى استعدادها للجرأة على رؤية المطلق بلا صور. الانكسارات في المرآة ليست مجرد صور، بل فتحات للفراغ الذي يبتلع كل صورة مصنوعة. الزمن، كما يُدركه الصوفي، ليس مرورًا هادئًا، بل كائن حيّ يتلوى، يضغط على الإنسان، يكشف تناقضاته، ويضاعف الرعب الداخلي، حتى يصبح كل لحظة مواجهةً بين ما يصنعه العقل وما يفرضه الواقع الكوني. القرآن يلمّس هذا الامتداد الرمزي:
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ فالوعي الذي يحجب الحقيقة عن نفسه، يصبح أعمى وصامتًا داخل ظلاله الخاصة، يظن أنه يبرّر، بينما هو يُحتجز في دوائر من الخوف والوحشية الداخلية. كل تبرير باسم الإله يتحول إلى مرآة مكسورة، كل صورة مصنوعة تغلق نافذة على الحقيقة، وكل محاولة للعقل لتقليص المطلق تصبح خيانة مزدوجة: للروح وللمطلق. وفي فلسفة الحلاج: «من جعل الظل ضوءه، صار الرعب مأواه؛ ومن أسر نفسه بالصور، صار السجن نوره. » الإنسان، حين يصرّ على فرض معنى على ما لا معنى له، يخلق سلاسل صامتة، يحبس بها روحه، ويضخم رعب الفراغ الداخلي. كل انعكاس في المرآة المزدوجة، كل رمز صوفي، كل انكسار، يصبح درسًا صامتًا للجرأة المطلوبة لمواجهة الحقيقة. الوعي هنا ليس مجرد مراقب، بل وحش حيّ، يقيس حدود الإنسان، يختبر قدرته على الصمود أمام الفراغ المطلق، ويجعل كل صورة مزيفة للإله أكثر رعبًا من أي حدث خارجي. فالعقل في مأزقه، الروح في امتحانها، والمرآة الصامتة أمام كل شيء، تقول للإنسان: «لن تفهم إلا حين تتجرأ على ترك كل صورة، وتواجه الفراغ بلا وسادة، بلا أمان زائف، بلا حماية». حين تتوقف المرآة عن الانكسار، ويصمت الظلّ والنور معًا، يدرك الإنسان أنّ الخيانة الكبرى ليست في الكون، ولا في غياب الإله، بل في العقل الذي يصرّ على فرض معنى على ما لا معنى له. كل محاولة لتبرير الوجود باسم الإله، كل صورة مزيفة، كل وسادة وهمية، تصبح سلاسل على الروح، تجعلها أسيرة للوحش الداخلي الذي يعيش في أعماق الوعي. في هذا الصمت، يظهر الرعب بلا ستار: الفراغ يبتلع كل الصور، الظلال تختبئ وراء النور، والزمن كائن حيّ يلتف حول الإنسان، يضغط عليه، يكشف هشاشته، ويتركه يواجه الحقيقة بلا أمان، بلا وسائد، بلا صور. فالوعي، الذي حاول حماية العقل والروح، أصبح خائنًا مزدوجًا: خيانة للذات، وخيانة للحقيقة، خيانة للكون، وخيانة للروح التي تبحث عن المطلق بلا قيود. ويضع القرآن النقطة الأخيرة على الامتداد الرمزي: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ فالوعي المغلق، العقل المبرّر، الصورة المصنوعة، كلهم أقفال على الحقيقة، تمنع الإنسان من رؤية المطلق كما هو، من إدراك الفراغ بلا وسادة، ومن معرفة الرعب الذي هو ذاته، بلا مرآة، بلا ظل، بلا نور، بلا أي غطاء زائف. وفي رمزية الصوفية كما قال الحلاج: «من لم يجرؤ على الصمت الكامل أمام الفراغ، صار فراغه صامتًا يأكله. » فالمرعب الحقيقي ليس خارجيًا، بل داخلي: في كل صورة صنعها العقل، في كل تفسير لكون لا يفسر، في كل محاولة لحماية الذات من الفراغ. هنا يكمن مأزق العقل النهائي: أن يواجه نفسه، خائفًا، بلا أمان، بلا وسادة، بلا صورة مصنوعة، أمام المطلق الذي لا يُرى إلا بالجرأة المطلقة. وهكذا، تنكشف الحقيقة الأخيرة: كل تبرير باسم الإله، كل محاولة لتقييد المطلق، كل صورة مزيفة، تصبح مرآة للوحشية الداخلية، وجسرًا للوعي لمواجهة الفراغ الحقيقي، والصمت الأبدي الذي لا يرحم ولا يختبئ وراء أي صورة أو وسادة أو ظل.
6: نحو قراءةٍ جديدة: الإله كفكرة غير مكتملة
حين نرفع أعيننا نحو السماء، لا نرى الإله كما نتصوره، بل نرى أنفسنا، نرى صورًا محشوة بالخوف والأمل، نرى ظلّ الحاجة ورعب الفراغ، نرى انعكاساتنا التي تفتقد المطلق. الإله، في هذه القراءة الجديدة، ليس صورة مكتملة، ليس كتابًا يمكن ختمه، ليس حدثًا يمكن اختزاله في كلمات. الإله كفكرة، دائمًا ما تتلوّى، دائمًا ما تهرب من العقل، دائمًا ما تتحدى الصور التي نصنعها. فالكون، بهذا الامتداد، يصبح لغة صامتة، يكتب نفسه بين النجوم والكواكب والفوضى، بين الألم والفرح، بين الموت والولادة، بين الظل والنور، كما لو أنّ كل شيء يقول للوعي: «لن أكون ما تريد أن أكون، بل ما أنا. » وهنا يكمن الإعجاز الحقيقي، كما في القرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فالإله، كالكون، لا يُدرك بالكامل إلا من خلال التجربة، ولا يُختزل إلا لمن يملك الجرأة على مواجهة الغيب، وعلى التساؤل بلا حدود، بلا وسائد، بلا أمان زائف. وفي صوفية الغموض، كما قال الحلاج: «من أراد أن يعرف الله كملكه، يعرف نفسه أولاً كعبيده، ومن عرف نفسه فَهِمَ اللامحدود. » فالقراءة الجديدة تقول: الإله ليس ما نعلق عليه أعيننا، بل ما يعلّق أعيننا عليه. كل محاولة لتثبيت صورة، كل رغبة في الاختزال، كل رغبة في السيطرة، تصبح خيانة للفكرة نفسها، وخيانة للوعي، وخيانة للروح. الرموز هنا لا تُفسّر، بل تُقرأ في صمت: الضوء الذي ينكسر على الماء ليس مجرد ضوء، بل تلميح للإله الذي يهرب من الصورة. الظل الذي يختبئ خلف الشجرة ليس مجرد ظلال، بل صوت المطلق الذي لا يمكن للبشر احتواؤه. الزمن الذي يتلوى بين الأمس والغد ليس مجرد مرور، بل كائن حيّ يختبرنا في قدرتنا على فهم ما لا يُرى إلا بالغموض والصمت. في هذا الامتداد، تصبح الفكرة غير مكتملة وسيلة للتواضع أمام المطلق، وتدريبًا للوعي على مواجهة الفراغ، والظلال، واللانهائية. كل تجربة، كل ألم، كل فرح، كل حدث في الوجود، يصبح رسالة مزدوجة: رسالة للروح، ورسالة للعقل الذي يريد الاختزال، رسالة للوعي الذي يريد السيطرة، ورسالة لكل إنسان يصرّ على فهم ما لا يُفهم إلا بالغيب. فالوعي هنا يصبح كالسفينة في بحر لا حدود له، والإله كالماء الذي يحيط بها، لا يمكن للإنسان أن يختزله، ولا يمكن للروح أن تسيطر عليه، بل يجب أن تتعلم التكيف مع لانهائيته، وتراقب انعكاساته في كل لحظة، في كل رمز، في كل صمت، في كل نبرة من الكون. وهكذا، نصل إلى حقيقة هذه القراءة الجديدة: الإله ليس مطلقًا مكتملًا في أذهاننا، بل كائن حيّ، لغز أبدي، كتاب مفتوح بلا صفحات محددة، ظلال ونور بلا نهاية، وحقيقة لا تُدرك إلا بالغموض والجرأة على الصمت الكامل. حين ينحني العقل أمام الفراغ، ويبحث الروح عن معنى وسط الظلال، ندرك أنّ الإله ليس صورة تُرى، بل صمت يكتب نفسه بين النجوم والكواكب والفوضى. كل محاولة لتثبيت صورة، كل محاولة لتفسير الحدث باسم المقدس، تصبح سلاسل صامتة تُقيد الروح وتحبس العقل، وتُعيدنا إلى المأزق الأول: أننا نريد أن نعرف المطلق بما يناسبنا، بينما المطلق لا يلتزم بنا. فالرموز هنا ليست للتفسير، بل للقراءة في صمت: انعكاس الضوء على الماء ليس مجرد انعكاس، بل نقطة بداية لمحادثة صامتة مع الغيب. كل ظلّ يختبئ خلف الشجرة، كل همس للريح، كل تموج في الزمن، يصبح رسالة مزدوجة: تهمس للروح عن لانهائية الإله، وتصرخ للعقل عن محدودية ما صنعه في ذهنه. والقرآن يؤكد هذا الامتداد الغامض للوعي: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ فالإنسان قد يظن أنّه يخلق صورة كاملة، لكنه في الحقيقة يراقب ظلّ الحقيقة يتلوّى أمامه بلا حدود. الإله هنا ليس ما نصنعه، بل ما يعلّمنا أن نصغي، أن نصمت، أن نترك العقل يذوب في الغموض قبل أن يعود، متواضعًا، أمام المطلق. وفي فلسفة الحلاج: «من ظن أنه عرف الله، لم يعرف إلا نفسه المقيّدة بالصور. » فالوعي حين يلتفت إلى الصورة، كل رمز يصبح بوابة للفراغ، ومفتاحًا لرؤية ما لا يُرى إلا بالجرأة المطلقة على الصمت. كل ألم، كل فرح، كل حدث في الكون، يصبح اختبارًا للروح، ومرآة للوعي، وحقلًا للخيال الغامض الذي يربط بين الظل والنور، بين الصورة والمطلق. وهنا يتكشف الإعجاز: الإله كفكرة غير مكتملة ليس خطأً في العقل، بل رحلة مستمرة للوعي، ومرايا بلا نهاية، وظلال تتلوّى في كل لحظة، وصمت يُعيد تشكيل الروح لتستوعب لانهائية الحقيقة. حين تنكسر صورة الإله المصنوعة في ذهن الإنسان، يظهر الامتداد الأكثر غموضًا: الإله ليس كائنًا يمكن اختزاله، بل ظلّ مطلق يتلوّى بين كل لحظة وأخرى، بين كل شعور وفكرة، بين كل فراغ ووجود. كل محاولة للعقل لفهمه، كل رغبة للروح في تقريبه، تصبح مرآة مزدوجة: تعكس محدودية الإنسان، وتكشف لانهائية المطلق، وتجعل كل رموزنا مجرد نوافذ صغيرة على ما لا يُرى إلا بصمت، وغموض، وجرأة. الرموز الصوفية تتضاعف هنا: الضوء الذي يمر عبر فتحة في الجدار ليس مجرد ضوء، بل شعاع الحقيقة الذي يختبئ كل صورة صنعها العقل. الظل الذي يلتف حوله الفكر ليس مجرد غياب ضوء، بل اللامحدود الذي يراقب وعي الإنسان، ويختبر مدى استعداده لمواجهة الفراغ بلا وسائد، بلا صور، بلا أمان زائف. وفي القرآن نجد التلميح لهذا الامتداد الغامض: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ فالإنسان يظن أنّه يخلق صورة كاملة، لكنه في الحقيقة يراقب الحقيقة تتلوّى أمامه، لا يمكن للعقل أن يحويها، ولا للروح أن تسيطر عليها إلا بالجرأة المطلقة على الصمت والغموض. وفلسفة الحلاج تعمّق هذا الغموض: «من لم يترك كل صورة، صار ظله سجين نفسه، ومن تركها رأى الضوء الذي لا يُحاط. »فالوعي حين يختبئ وراء الصورة، يصبح سجّانًا لنفسه، كل رمز يصبح مرآة للفراغ الداخلي، وكل انعكاس ضوئي يتحوّل إلى درس صامت عن لانهائية المطلق، وعن حدود العقل، وعن الرعب الجميل الذي يولده الغموض. كل لحظة، كل تجربة، كل ألم، كل فرح، تصبح رسالة مزدوجة: رسالة للمطلق، ورسالة للروح، ورسالة للوعي، ورسالة للعقل الذي يصرّ على اختزال ما لا يُختزل. فالإله كفكرة غير مكتملة ليس نقصًا في العقل، بل دعوة للوعي للارتقاء فوق الصور، فوق الرموز، فوق كل وسادة زائفة، ومواجهة الفراغ المطلق، حيث لا يقف سوى الصمت والجرأة المطلقة. وهكذا تتوسع الرحلة: الإله ليس ما نصنعه، بل ما يصنعنا ونحن نحاول فهمه، ونعيش غموضه، ونختبر لانهائيته في كل لحظة، في كل رمزية، في كل ظل، في كل نور، في كل صمت. حين يتقدم العقل ليملأ الفراغ باسم الإله، يدرك الوعي فجأة أنّ كل صورة خلقها، كل تفسير رسمه، كل قانون وضعه، ليس سوى مرآة مزدوجة تُعيد له صورة نفسه محدودة ومقيدة. الإله هنا ليس ما يراه الإنسان، بل اللانهائي الذي يختبر الإنسان من خلال كل تجربة، وكل رمز، وكل لحظة من الألم والفرح، وكل همس للكون. الرموز الصوفية تصبح أكثر حدة: الضوء الذي يمر عبر الشقوق ليس مجرد ضوء، بل حرف من حروف الحقيقة التي لا يمكن للعقل أن يلمسها إلا بالتصالح مع مجهوليته. الظلال ليست مجرد غياب للنور، بل لغة المطلق التي يكتب بها الكون نفسه، ويتحدث بها إلى كل روح تبحث عن معنى بلا وسائد، بلا صور، بلا أمان زائف. ويضع القرآن هذه الحقيقة أمام الوعي البشري: ﴿وَلَهُ مُعَقِّبُو الْأَمْرِ ۖ مِنْهُ يُرْسَلُونَ﴾ فالكون ليس بحاجة لأن يفسّر نفسه، والإنسان ليس قادرًا على اختزاله، وكل محاولة لتبرير الأحداث باسم الإله هي محاولة للعقل ليقنع نفسه قبل أن يقنع الكون. الحلاج يضيف عمقًا صوفيًا: «من أراد أن يعرف الله، فليعرف نفسه أولاً؛ ومن عرف نفسه، رأى اللانهائي يحوم حوله بلا قيود، بلا ظلال، بلا وسائد. »فالوعي حين يواجه الفراغ، حين يواجه المطلق بلا صور مصنوعة، يصبح أقوى، وأوضح، وأكثر غموضًا في آن واحد. كل ألم يصبح مرآة للرحمة المفقودة، كل فرح يصبح تلميحًا للحرية المطلقة، وكل حدث يصبح رسالة مزدوجة بين الروح واللانهائي. وهكذا، تصبح فكرة الإله غير مكتملة رحلة مستمرة للوعي نحو الجرأة المطلقة، للروح نحو مواجهة الفراغ، وللعقل نحو التواضع أمام المطلق الذي لا يمكن اختزاله، ولا يمكن للعقل أن يحويه، ولا يمكن للصور أن تقيّد حريته. حين يذوب العقل في الرموز، وتختفي الصور المصنوعة، ويصمت الظل والنور معًا، يدرك الإنسان أنّ الإله ليس ما يراه أو يختزله، بل مطلق يختبئ في كل شيء، في كل لحظة، في كل صمت، وفي كل انعكاس للروح على المرآة المزدوجة للعقل والوجود. كل محاولة لفهمه، كل رغبة للسيطرة عليه، كل تفسير باسم المقدس، تصبح بوابة للفراغ، وجسرًا للوعي نحو الجرأة المطلقة، وتجربة صوفية لا يمكن للعقل أن يحيط بها بالكامل. الرموز هنا تتضاعف: الضوء الذي يتسلل بين الشقوق ليس مجرد نور، بل خطوة نحو الإدراك الكامل للغيب، وكل ظل يصبح نبرة من نغم المطلق. الزمن، الذي يتلوى بين الأمس والغد، يصبح كائنًا حيًا يختبر الإنسان، يضغط عليه، يكشف هشاشته، ويتركه يواجه الفراغ بلا أي وسادة أو حماية. القرآن يضع الوعي أمام هذه الحقيقة: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾فالوعي المغلق على الصور المزيفة، والعقل المبرّر للوجود، يصبح سجينًا للظل الداخلي، لا يرى الحقيقة إلا حين يجرؤ على ترك كل وسادة وكل حماية وهمية. وفي صوفية الحلاج: «من لم يجرؤ على الصمت الكامل أمام المطلق، صار فراغه صامتًا يأكله، ومن جرؤ، رأى كل شيء بلا قيود، بلا ظل، بلا وسادة، بلا صورة. » فالوعي حين يواجه المطلق، حين يترك كل الصور المصنوعة، حين يذوب العقل في صمت الفراغ، يصبح حرًّا، غامضًا، مرعبًا، وممتلئًا بالجرأة المطلقة على معرفة ما لا يُعرف إلا بالغيب، والإحساس بما لا يُرى إلا بالقلب المرهف والصامت. هنا تنكشف الرحلة بالكامل: الإله كفكرة غير مكتملة ليس نقصًا في العقل، ولا خطأً في الروح، بل دعوة للوعي للارتقاء فوق كل صورة، وكل رمز، وكل وسادة، وكل ظل، وكل ضوء، ومواجهة الفراغ المطلق، حيث لا يقف سوى الصمت والجرأة المطلقة، وحيث لا يمكن للصور أن تحيط بالمطلق، ولا الكلمات أن تكتب الحقيقة، بل فقط الوعي الجريء الذي يجرؤ على الغوص في اللانهائي ويستمد منه القوة والصمت والحرية المطلقة.
الخاتمة: ما بين الصمت الإلهي وضجيج الوجود
حين يلتقي الإنسان بالصمت الإلهي، لا يسمع إلا صدى نفسه، صدى الروح المتلوية بين الحاجة والفهم، بين الظل والنور، بين الفراغ والوجود. كل سؤال عن السبب، كل محاولة لتفسير الحدث، كل رغبة لتثبيت معنى، تصبح همسًا في فناء الكون، صدىً يتلاشى بين المرايا المزدوجة للوعي والعدم. الوجود هنا لا يخون الإله، ولا يعلن غياب الحقيقة، بل يكتب لغة صامتة، يفرض على الروح أن تواجه نفسها، على العقل أن يذوب في الصمت، وعلى القلب أن يرى الفراغ بلا وسائد، بلا صور، بلا أوهام. كل ضجيج، كل ألم، كل فرح، كل موت، يصبح انعكاسًا للصمت الإلهي الذي لا يلتزم بصورة، ولا يجيب إلا بتجربة، ولا يمنح إلا بالجرأة المطلقة للوعي. القرآن يضع النقطة الصامتة بين كل رمزية: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ فالإله حاضر بلا صور، حاضر بلا أصوات، حاضر بلا إجابات جاهزة، يحاكي الوعي في صمته، ويختبر الجرأة التي يمتلكها الإنسان لمواجهة الفراغ المطلق. والحلاج يضيف صدى صوفيًا: «من اعتقد أن الصمت غياب، فقد أخطأ الطريق، ومن عرف الصمت مطلقًا، عرف نفسه والمطلق معًا. »فالخاتمة تكشف الحقيقة النهائية: أن الخيانة الكبرى ليست من الكون، ولا من الإله، بل من الوعي الذي يهرب من الحقيقة، من العقل الذي يصرّ على فرض الصور، ومن الروح التي ترفض مواجهة الفراغ بلا وسادة بلا أمان بلا صورة. كل شيء هنا يصبح انعكاسًا مزدوجًا: الصمت الإلهي يواجه ضجيج الوجود، والوعي يواجه صورًا صنعتها نفسه، والروح تواجه الفراغ المطلق الذي لا يُرى إلا بالجرأة المطلقة، بلا كلمات، بلا رموز، بلا وسائد، بلا حماية. وهكذا، يدرك الإنسان أن الوجود ليس في تبرير، ولا في تفسير، بل في الجرأة على الصمت، على مواجهة الفراغ، على رؤية الحقيقة بلا صور، وعلى الاستسلام المطلق للوعي الذي يراقب كل شيء بلا انكسار، بلا تحيّز، بلا وهمحين يغرق الإنسان في ضجيج الوجود، ويختنق العقل بمحاولات التفسير، يدرك أن الصمت الإلهي ليس غيابًا، بل لغة صامتة تتحدث عبر كل حدث، كل ألم، كل فرح، وكل انهيار في الكون. كل محاولة لتبرير ما يحدث باسم المقدس تصبح مرآة مزدوجة تعكس حدود العقل وحدود الصور التي صنعها في ذهنه. الرموز تصبح هنا وسائط غامضة: انعكاسات الضوء على الماء ليست مجرد انعكاس، بل حرف من حروف الحقيقة التي لا تُرى إلا بالوعي المطلق، وبالتجربة الصامتة التي تذوب فيها كل وسادة وهمية، وكل حماية زائفة. الظل الذي يلتف حول كل فكرة، والنور الذي يخترق كل حدث، يصبحان رسائل مزدوجة للروح والعقل، ليدرك الإنسان أن كل تفسير جزئي، وكل صورة مصنوعة، ليست سوى بداية لفهم اللانهائي. القرآن يضع الوعي أمام هذا الامتداد: ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ فالوجود يختبر الإنسان بصمت، يحمله بين الظلال والنور، بين الفراغ والامتلاء، بين الظل الذي لا يزول والنور الذي لا يُحاط به، ليعلّم الروح أن الإله ليس ما نصنعه، بل ما يخلقنا ونحن نحاول فهمه، وأن الضجيج والفراغ معًا هما طريقنا نحو إدراك الحقيقة المطلقة. كل ضجيج، كل صخب، كل انكسار، وكل تجربة تصبح مرايا تتلوى أمام الوعي، تعكس مدى استعداده لمواجهة الفراغ المطلق، وتكشف أن الصمت الإلهي ليس غيابًا، بل دعوة لمواجهة الحقيقة بلا صور، بلا وسائد، بلا حماية، وبلا وساطة عقلية زائفة. حين يلتقي الضجيج الوجودي بالصمت الإلهي، يذوب الإنسان في مرايا لا تنتهي من الظلال والنور، بين الفراغ والامتلاء، بين الصوت والصمت، بين ما يُرى وما يختبئ. كل محاولة لفهم أو تفسير، كل رغبة للسيطرة على الأحداث باسم المقدس، تصبح صدى يتكرر في الفراغ، يختبر صبر الروح، ويواجه العقل باللانهائي الذي لا يمكن احتواؤه. الرموز تتضاعف: الضوء الذي يخترق الشقوق، الصوت الخافت الذي يلوذ بالصمت، التموجات في الماء، وحتى حركة الهواء بين الشجر، كلها حروف من لغة الوجود التي لا تُفهم إلا بالوعي الكامل، ولا يُدركها إلا من يجرؤ على مواجهة الفراغ بلا وسادة، بلا صورة، بلا حماية. فالإنسان هنا يقف على حافة التجربة المطلقة: كل ألم يصبح رسالة، كل فرح يصبح مرآة، وكل حدث يصبح اختبارًا للوعي لمواجهة الحقيقة دون وسادة، دون أمان، دون أي وسيلة لتخفيف الصدمة. الضجيج يصبح انعكاسًا للصمت، والصمت يصبح انعكاسًا للضجيج، والوعي يقع بينهما، يذوب ويصير جزءًا من اللانهائي. القرآن يضع هذه الحقيقة أمام الإنسان: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ فالوجود لا يبرر نفسه، والإله لا يفرض صورة، والوعي الذي يختار الصورة الزائفة يصبح أسيرًا في دائرة الضجيج والصمت، في مرآة مزدوجة تعكس محدودية الإنسان وإبداع المطلق. كل شيء هنا يصبح تجربة صامتة، اختبارًا للجرأة على مواجهة اللانهائي، على رؤية الحقيقة بلا وسائد، بلا صور، بلا حماية، على الانصهار بين الصمت والضجيج، والوعي الذي يصبح أداة لاكتشاف المطلق من خلال الفراغ نفسه. حين يتلاشى الظل والنور، ويذوب العقل في مرايا الفراغ، يصبح الوعي صدىً بلا نهاية، موجةً في بحر اللانهائي، حيث الصمت يهمس بما لا يُقال، والوجود يصرخ بما لا يُسمع. هنا تولد الأبيات، موزونة، صوفية، مزدوجة المعاني، تعكس رحلة الإنسان بين الحاجة والفناء، بين الصمت والضجيج: أيا من تبحث في ضياء السحابِ. . . تجد الإلهَ في فراغٍ بلا جوابِ.. كل نورٍ انعكس على الماءِ كان سرًّا لا يُرى إلا في الصفاءِ.. الظلُّ يلتفُّ حول كل فكرٍ.. يحمل أسرارًا لا تحيط بها الأفقُ.. الزمان يجرّ الروح بلا شفقةٍ.. ويكشف المجهولَ في صمتٍ بلا نهايةِ.. الفراغُ يغني، والوعي يستمعُ.. للانهائي الذي لا يقاس ولا يُحكمُ فالقصيدة هنا ليست مجرد زخرفة، بل مرآة رمزية: كل بيت يوضح أن الوعي يقف بين الصور المصنوعة واللانهائي المطلق، بين الحاجة الإنسانية والصمت الإلهي، بين الضجيج الداخلي والوجود المتمدد بلا حدود. القرآن يلمّح لهذه الحقيقة أيضًا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ فالوجود يختبر، والصمت يربّي، والروح تتعلم الجرأة، والعقل يتواضع أمام ما لا يُرى، بينما الإنسان يعيش رحلة رمزية مزدوجة بين الصمت والضجيج، وبين الظل والنور، والوعي والمطلق.
***
الكاتب سجاد مصطفى حمود