قراءة في كتاب
عبد السلام فاروق: "الجيل العثماني الأخير".. الذاكرة الممزقة بين المحو والتأويل

منذ طرح الفيلسوف بول ريكور سؤاله الجوهري: "كيف نعيد سرد الماضي دون أن نقع في أسره؟"، ونحن نعيش أزمة الذاكرة الجمعية في العالم العربي. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، "الجيل العثماني الأخير وصناعة الشرق الأوسط الحديث" لمايكل بروفانس، ضوء كاشف ساطع على منطقة الظل في تاريخنا الحديث، حيث تلتقي الذاكرة المنسية بالوعي المكبوت. إنه يضعنا أمام مرآة كاشفة لتلك الفجوة بين ما كنا نعتقد أننا نعرفه، وما كنا بحاجة ماسة لمعرفته.
في عالم تسيطر عليه سرديات القومية والاستعمار، يأتي هذا العمل ليكشف كيف أصبحت "الحقيقة التاريخية" ساحة معركة تخضع لصراع القوى والمصالح. إنه يذكرنا بمقولة ميشيل فوكو عن "العلاقة بين الحقيقة والسلطة"، حيث لا توجد حقيقة بريئة تنفلت من شبكات القوة التي تنتجها. الكتاب يشق طريقه كسكين في جسد التاريخ الرسمي، ليكشف عن طبقات من الواقع ظلت مطمورة تحت ركام من "المسلمات" التي زرعها الفكر الاستعماري ثم رعتها النخب القومية لاحقاً.
يقدم بروفانس قراءة مغايرة تماماً للرواية السائدة عن مرحلة ما بعد سقوط الدولة العثمانية، حيث يكشف عن استمرارية خفية بين العهدين العثماني والاستعماري، على عكس فكرة القطيعة التي رسختها الكتابات التاريخية السابقة. من خلال تتبع سير الشخصيات العسكرية والسياسية التي تشكلت في المدارس والمؤسسات العثمانية، يظهر كيف أن "الجيل العثماني الأخير" ظل يحمل رؤية جامعة لم تستطع الحدود المصطنعة محوها بين ليلة وضحاها.
اللافت في تحليل بروفانس هو كشفه عن التناقض الجوهري في المشروع الاستعماري: فبينما ادعى البريطانيون والفرنسيون أنهم جاءوا لتحرير الشعوب من "الاستبداد العثماني"، كانوا في الواقع يدمرون بنى الدولة الحديثة التي أقامها العثمانيون في قرنهم الأخير، من مدارس وجامعات وبنى تحتية وأنظمة إدارة. هذا التناقض يذكرنا بمقولة إدوارد سعيد عن "الاستشراق" الذي يصوّر الشرق كياناً متخلفاً يحتاج إلى حضارة الغرب، بينما هو في الواقع يدمر مقومات نهضته الذاتية.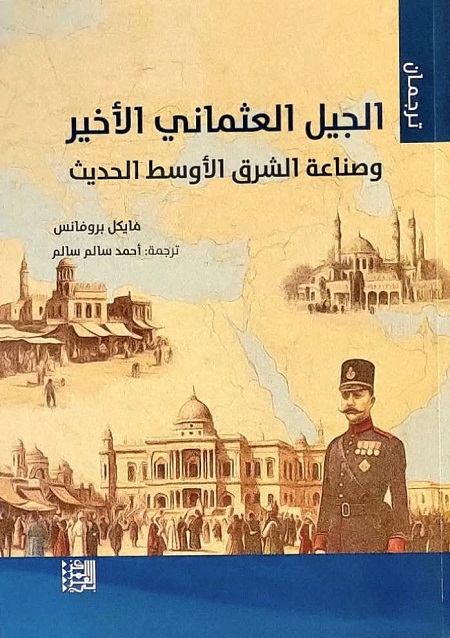
الذاكرة المنسية
أحد أهم إسهامات الكتاب هو كشفه عن حقيقة الولاءات في المرحلة الأخيرة من الدولة العثمانية. بعكس الرواية القومية التي تصور العرب كضحايا للاضطهاد العثماني، يظهر بروفانس من خلال الوثائق أن النخب العربية - وخاصة العسكرية منها – ظلت موالية للدولة حتى النهاية، وأن ما سمي "الثورة العربية" لم يكن سوى حركة هامشية لا تعبر عن عموم النخب العربية.
هذه النقطة بالتحديد تضعنا أمام مفارقة تاريخية كبيرة: فبينما صور الاستعمار البريطاني نفسه كمحرر للعرب من "النير العثماني"، كان في الواقع يدمر النخبة التي شكلت العمود الفقري لأي مشروع نهضوي عربي لاحق. يروي بروفانس كيف أن الضباط العرب الذين تخرجوا من الكليات العسكرية العثمانية مثل الكلية الحربية في إسطنبول، كانوا يشكلون النخبة الأكثر كفاءة وتقدماً في المنطقة، وكيف أن الاستعمار عمل على تحييدهم أو تصفيتهم لضمان سيطرته.
الاستعمار وإعادة هندسة الوعي
يقدم الكتاب تحليلاً دقيقاً لكيفية عمل الآلة الاستعمارية على (إعادة تشكيل الوعي) الجمعي في المنطقة. ليس فقط من خلال ترسيم الحدود، بل من خلال تفكيك الروابط الاجتماعية والثقافية التي كانت تجمع النخب في مختلف أرجاء الدولة العثمانية. يظهر بروفانس كيف أن الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان على وجه الخصوص، عمل على تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية بطريقة لم تعرفها المنطقة من قبل، وذلك لضمان استمرار سيطرته.
هنا يلتقي التحليل التاريخي لبروفانس مع رؤية المفكر علي الوردي عن "طبيعة المجتمع العراقي"، حيث يظهر كيف أن الاستعمار لم يخترع الانقسامات من العدم، لكنه أعطاها أبعاداً سياسية ومؤسسية لم تكن لها من قبل. هذا التحول في بنية الوعي الجمعي هو ما يفسر استمرار العديد من الإشكاليات التي نعيشها حتى اليوم في منطقتنا.
نحو تاريخ إنساني متصل
ما يميز عمل بروفانس هو محاولته تقديم سردية بديلة لتاريخ المنطقة، لا تنطلق من منظور قومي ضيق ولا من رؤية استعمارية، بل من محاولة فهم تجارب الناس كما عاشوها بالفعل. من خلال التركيز على "الجيل العثماني الأخير"، يقدم لنا منظوراً إنسانياً يظهر كيف عاش أفراد هذا الجيل صدمة التحول من دولة جامعة إلى كيانات مقسمة تحت السيطرة الأجنبية.
هذا المنهج يذكرنا بأسلوب المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم في كتابه "عصر التطرفات"، حيث يقدم التاريخ ليس كسلسلة من الأحداث السياسية الكبرى، بل كتجربة إنسانية معقدة يعيشها الناس العاديون. بروفانس ينجح في إضفاء بعد إنساني على فترة غالباً ما يتم تناولها من منظور جاف وبيروقراطي.
التاريخ ساحة صراع
الدرس الأهم الذي نستخلصه من هذا العمل هو أن التاريخ ليس حقائق جامدة، بل هو ساحة صراع دائمة على المعنى والهوية. قراءة هذا الكتاب هي بمثابة رحلة استكشافية في الذاكرة المنسية لأمتنا، ذاكرة قد تكون مفتاحاً لفهم حاضرنا واستشراف مستقبلنا.
ففي زمن تكثر فيه السرديات المتنازعة، يأتي هذا العمل ليعيد الاعتبار لتاريخ منسي، وليذكرنا بأن الحدود التي نعيشها اليوم ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج ظروف تاريخية معينة يمكن تجاوزها إذا أردنا. كما يقول بروفانس نفسه في الكتاب: "إن فهم الماضي المشترك هو الخطوة الأولى نحو تخيل مستقبل مختلف".
الذاكرة الممزقة
يضيء بروفانس ببراعة ظاهرة "أرشيفية الاستعمار" التي عملت على: تزييف التسلسل الزمني: تقديم الحقبة العثمانية كعصور ظلامية متخلفة تسبق "النهضة الاستعمارية"، إعادة تعريف المفاهيم: تحويل مصطلح "المواطنة العثمانية" إلى "احتلال أجنبي" في الخطاب التاريخي اللاحق، وانتقاء الوقائع حسب الحاجة السياسية، كما يظهر في تضخيم أحداث مثل "سفر برلك" وإهمال مشاريع التحديث العثماني.
يكشف الكتاب عن التحول الجذري في تمثيل الشخصيات التاريخية: الضباط العرب: من قادة عسكريين محترفين في الجيش العثماني إلى "خونة" أو "أبطال تحرير" حسب السرديات القومية، وتحويل النخبة المثقفة العابرة للحدود إلى "أدوات استعمار" أو "أبطال قومية"، أما الفلاحون فتم اختزالهم إلى كتلة صامتة في الصراع، بينما يظهر الأرشيف أنهم كانوا طرفاً فاعلاً في مقاومة التقسيم.
خرائط العقل والحدود
يقدم الكتاب تحليلاً دقيقاً لـ"تسييس الجغرافيا": تحويل التقسيم الإداري العثماني إلى حدود قومية مقدسة، اختراع التمايز الثقافي بين مناطق كانت متجانسة ثقافياً، تأميم التاريخ المحلي وإعادة كتابته وفقاً لخرائط الدول الجديدة.
نحو إعادة تأهيل الذاكرة
يتركنا الكتاب أمام أسئلة جوهرية هي: كيف يمكن إعادة بناء وعي جمعي يتجاوز ثنائيات (عثماني/ قومي، مستعمر/ مقاوم)؟ وما هي أدواتنا لمقاومة "عنف الأرشيف" الذي فرضته القوى الاستعمارية؟، كيف نقرأ تاريخنا دون الوقوع في فخ النوستالجيا أو الكراهية الذاتية؟
***
د. عبد السلام فاروق






