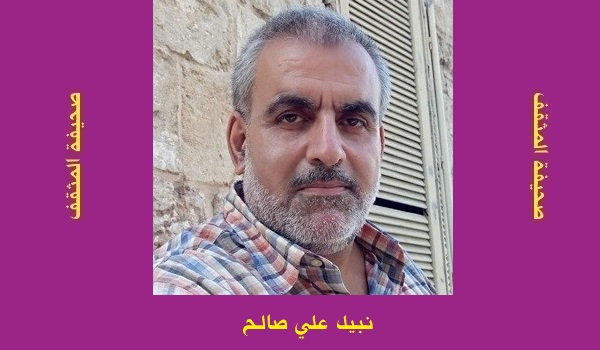دراسات وبحوث
جعفر نجم نصر: المدينة وعطالة المثقف العراقي..

ملاحظات أولية حول الوسط الحضري
منذ أكثر من أربعين عاماً كتب هنري لوفيبر "Henry Lefeber" في مؤلفه (الحق في المدينة) أن المدينة (شيء افتراضي)، وقد جرى بعدها تأكد هذا الزعم الذي يحتاج إلى التعمق، من خلال ملاحظة أن المناطق الحضرية تتجاوز المدينة، يتوقع الفيلسوف من خلال استقراء المدنية الحالية، ولادة مجتمع (متحضر كلياً). وقد أعطى ذلك المزيد من القوة النظرية والسياسية لفكرة افتراضية المدينة، ولكن بأية سياسة يمكن للمدينة أن تظل المكان والهدف، حتى الموضوع، إذا لم تعد موجودة؟ ففي الآونة الأخيرة لاحظ الجغرافي والفيلسوف ديفيد هارفي "David Harvey" بعد هنري لوفير أن (الحق في المدينة) يشير في نهاية المطاف إلى (مسألة لم تعد موجودة) أي دلالة فارغة "Signifiant vide" و(هذا يتوقف على من سيعطيها معنى) (1).
ان المثقف وفي أي مجتمع كان يحتاج إلى وسط اجتماعي/ مديني لكي لا يتشكل تكوينه الثقافي فحسب، بل لكي يكون صورة عاكسة لهذا الوسط البيئي الذي نشأ فيه، وتعد المدينة بوصفها الوسط الحضري الأرفع هي المسؤولة عن كل ذلك، وأن أي خلل يحدث في داخل بنية المدينة ونسقها الحضري، إنما ينعكس سلباً على المثقف وأدواره الاجتماعية، ونحن إذ نتكلم عن المثقف هنا، فأننا لا نعني فئة محددة ، بل ان الامر يشمل كل من يعمل على الثقافة والمعرفة مستهلكاً ومنتجاً أي كان أسمه (أديباً، فيلسوفاً، أكاديمياً...الخ).
فالمعرفة على علاقة وثيقة بالمدينة، لأن المعرفة غايتها الأساسية تحقيق السلام وتبسيط الحياة وتسهيلها على الإنسان وتحقيق أكبر قدر من الحرية له، وهكذا فأن المعرفة والمدينة يشتركان في نفس الغاية ألا وهي توفير السلام والأمن، وهذا ما جعل المعرفة مصاحبة في تاريخ تطورها للمدينة، فالشتات التي تعيشه المدينة المعاصرة، ما هو إلا دليل قاطع على الانفصال الرهيب الذي حدث بين المدينة والمعرفة، وهي الآن تعيش عقبات ذلك لتصاب المدينة بالخواء السحيق والجفاف المعرفي الواضح، فالمعرفة الآن تبحث عن موطن لها لتفرخ فيه، ونحن هنا مطالبين بإعادة قراءة المدينة وإصلاحها من الداخل لإعادتها إلى الغاية التي وجدت من أجلها الا وهي مدينة السلام والرقي (2).
تأسيساً على هذا المعطى نطرح مجموعة من التساؤلات ما هي مسوغات قولنا بعطالة المثقف؟ وكيف تولدت أو نشأت هذهِ العطالة إن وجدت (أي موضوعة فقدانه التأثير في الوسط الاجتماعي الذي يحيا بهِ؟) بعبارة أخرى أليست عملية اتساع الفجوة بين المثقفين العراقيين والمجتمع الذين يحيون وسطه بدأت تتسع إلى حدٍ كبير وملاحظ بنحوٍ جلي؟ وما هي صلات الوسط الحضري الذي نقول بأنهياره بتلك العطالة؟ وما هي دلائل وعلامات ذلك الانهيار؟ وما صلة ذلك بموضوعة تدفق الفكر (الشعبوي) و(الشعبي) في المشهد الحضري؟ وكيف يمكن قراءة ذلك في ضوء الأطر الأنثروبولوجية والسوسيولوجية بوجٍهٍ عام؟
تنطلق هذهِ المقالة من فرضية جوهرية مؤداها: ان هناك عطالة واضحة في دور المثقف العراقي على مستوى النشاط الثقافي، من خلال غياب الحضور النقدي/الثقافي وظهور الجماعات الثقافية أو (الشللية الثقافية) التبادلية المنافع والمصالح، وفقدان المشروع الثقافي أو الفكري العراقي، سوى أطروحات مستنسخة عن مدارس فكرية اسلامية أو عالمية وتقديمها بوصفها العلاج السحري/النهضوي للمجتمع العراقي بل وللعالمين العربي والاسلامي.
وأن مرتكز هذهِ الفرضية أعلاه ينطلق من تصوراتنا النظرية التي تبين انهيار الوسط الحضري/ المديني الذي يعبر عن الحاضنة الثقافية التي تسهم في انتاج واعادة انتاج النسق الثقافي الحضري/البغدادي الذي بدا واضحا انه يفتقر إلى الحد الادنى للأشتراطات الثقافية لمسات الحضرية العقلانية التي يجب ان ينتظم بموجبها السلوك الثقافي العام.
أننا وإذ نمضي نحو ايراد الملاحظات الخاصة بعناصر وسمات الحياة الحضرية التي أسهم فقدانها في بغداد في عطالة المثقفين، إنما نأم وجهنا شطر الكتابة ونحن نتفق كلياً مع اطروحة علي حرب بأنه قد آن الأوان للمثقفين عموماً من التخلي عن أوهامهم في أرشاد العامة أو الوصاية على المجتمع وترشيد سلوكه، إذ قال: أعني هذا الوهم سعي المثقف إلى تنصيب نفسه وصياً على الحرية والثورة، أو رسولاً للحقيقة والهداية، أو قائداً للمجتمع والأمة، ولا يحتاج المرء إلى بيانات لكي يقول بأن هذه المهمة الرسولية الطليعية قد ترجمت على الأرض فشلاً ذريعاً وأحباطاً مميتاً (3).
ثم يقول: فليتواضع أهل الثقافة والفكر، انهم ليسوا نخبة المجتمع أو صفوة الامة، وانما هم اصحاب مهنة كسائر الناس، ولا أفضلية لهم على سواهم من العاملين أو المنتجين في سائر مجالات العمل وقطاعات الانتاج. بالطبع الافضلية هي لمن يتقن مهنته ويخلص لها، والاسبقية هي لمن ينتج أو يبدع في مجال عمله أو حقل اختصاصه (4).
ثم يمضي حرب بعد ذلك بإيراد مجموعة هذهِ الاوهام (وهم الحرية، وهم الهوية، وهم المطابقة، وهم الحداثة...)، ويمكن لمن أراد التفحص اكثر مراجعة تفاصيلها في مظانها التي احتضنتها، ولعل الوهم الاخير (وهم الحداثة) يستحق التوقف عنده، لأنه يلتقي مع الحياة الحضرية التي ندعو لها، وقد يساء فهمنا ونتهم بالتناقض على اعتبار ان اشتراطات الحياة الحضرية المفقودة هي حداثوية بالضرورة، وهذا الأمر يرد عليه كل من يعرف الحياة المدنية التي كانت تسود المدن العربية والاسلامية منذُ القرون الوسطى في طليعتها بغداد، أحيل القارئ الكريم على سبيل المثال لا للحصر إلى ما كبته البحاثة المعروف محمد مكية عن الحياة الحضرية والعمرانية والثقافية لمدينة بغداد في القرون السالفة!! (5).
يبقى الفهم الانثروبولوجي والسوسيولوجي الخاص بذلك الوسط الحضري يمثل مدخلاً تأطيراً نظرياً لا غنى عنه لبيان ان جدلية الثقافة أو الفكر والمدينية أو الوسط الحضري يمثل معياراً علمياً لا مناص من التسليم بوجوده لأجل الكشف عن تلك العطالة التي نفترض وجودها لدى المثقفين العراقيين.
ولما كان المثقف قد غدا وسيطاً فاعلاً في تقديم الفكر والمعرفة والثقافة إلى جانب المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية (الاعلام)، وكما يرى علي حرب:...، بذلك يعمل المثقفون بخصوصيتهم كمنتجين للأفكار والمعارف والسلع الرمزية، بقدر ما يظهرون ميزتهم ويمارسون فاعليتهم المجتمعية، لا بوصفهم نخبة تقود الامة والمجتمع، بل بوصفهم وسطاء يعملون على توسيع المجال العمومي بتكوين مساحات للقاء والتفاهم أو للتواصل والتبادل .... (6).
ولكن هذا الوسيط (المثقف) يحتاج إلى وسيط أو وسائط حضرية أو مدينية تساعده على تحقيق وظيفته أو عمله الثقافي بوصفه محترف مهنة تشتغل في حقل الفكر والمعارف الانسانية، فالثقافة تحتاج إلى حواضن لها، ولا يوجد عبر التاريخ أفضل من المدينة وفضائها التداولي بالضروري أن تكون هي الوسيط الناجح لذلك.
نحن قدمنا وجهة نظر أهل الفلسفة (علي حرب) عن دور المثقفين أو النخبة في الوسط الحضري أو في المجتمع بوجهٍ عام، ولكن الانثروبولوجيون لهم وجهة نظر مغايرة، إذ يرون ان الصفوات الحضرية من كافة اصناف الزعامات والقيادات المحلية وفي مقدمتهم الموظفين والمثقفين انما يسهمون في احداث عملية التغيير الحضري، وذلك عبر نشر التعليم وزيادة الفوارق الطبقية وتصاعد الاستهلاك المظهري وتحفيز التحديث، بل والسعي نحو تكوين رأي عام ''Public Opinion'' (7).
وهذا الرأي آنف الذكر إنما يقدم للصفوات الحضرية أدواراً واسعة في احداث عمليات التحضير Urbanization، ونحن نريد ان نذهب باتجاه آخر في المقال لبيان ان انهيار الوسط الحضري قد قلل من حضور وتأثير هذه الصفوات لأن (أن قبلنا التصور الانثروبولوجي)، بعد قص اجنحته كما قدم علي حرب فيما تقدم ذكره.
ان الانثروبولوجيا قدمت منظورات ميدانية تأسيسية لفهم الوسط الحضري، وذلك بعد أن أعلن راد كليف براون R.K.Brown ان مجالات الدراسة الانثروبولوجية قد اتسعت لتشمل كل انماط المجتمع الانساني، وقد أكد بعد ذلك رالف بيلز R.Beels ان الانثروبولوجيا حان لها ان تسهم بمنهاجها وطرقها الخاصة في دراسة المجتمعات الحضرية بصفة عامة (8).
ثم أخذ الانثروبولوجيون بدراسة العلاقة بين المدينة والحضارة أو الثقافة Culture التي يرون فيها الروح العميقة للمجتمع، في حين ان المدينة هي الآلة الصماء الحاملة في طياتها الجوانب الجامدة فيها، بينما الحضارة أو الثقافة هي صورتها العاطفية ذات المظهر الروحي الأصيل لتجمع حيوي، فالعمليات الثقافية - الحضارية في المدينة تعتمد على استمرار العقل وتقدمه الذي لا يتوقف، فتمثل المجهود الانساني بغزوه ميادين الطبيعة عن طريق العقل في محيط العلوم والفنون وما إلى ذلك، وهكذا نرى ان اهتمامات الانثروبولوجيين الحضريين توزعت على موضوعات عدة لا حصر لها كان أبرزها: دراسة المشاكل الحضارية التي تمثلت في ازدياد اقتراف الجرائم وارتكاب الرذائل وظهور الاتجاهات الانانية واساليب الاستغلال التي يمارسها الانسان ضد أخيه الانسان في مجتمع المدينة (9).
ولعل هذا الأمر آنف الذكر هو بيت القصيد بالنسبة لأهتمامات المقالة الان انهيار الوسط لحضري لا يختصر بتراجع البعد العقلاني أو الترشيد العقلي أو سيادة القانون، أو طغيان القبيلة والقبائلية أو عودة الشعبويات الايديولوجية/ الريفية أو الطرفية (أطراف المراكز)، بل يشمل كذلك على أنهيار المنظومة الاخلاقية التي عطلت كذلك من السلوك الاخلاق للكثير من المثقفين العراقيين الذين يتسمون بالانتهازية والشعاراتية والتسلق وتملق الجماهير على وسائل الميديا أو نحوها.
ولكن الانثروبولوجست ميشال أجيي Michel Agier يقدم منطق أنثروبولوجي للمدينة التي شكلتها الديناميات الاجتماعية والمكانية والثقافية، عاداً انتاج ما يسمى (مدينة) عملية مستمرة تسهم بها جهود متعددة ولهذا هو يتسأل عن الكيفية التي تتشكل أو تقام بها (المدينة)؟، فوجد ان هناك ثلاثة خصائص للمدينة موضع التنفيذ، التعقيد والحركة والعلاقة، ونحن نوجزها على النحو الآتي:
- التعقيد: هذهِ المدينة التي تنبثق من مراقبة الحياة اليومية هي اكثر تعقيداً على نحوٍ متزايد، وتتكون من أمكنة معينة يعاد استثمارها وتحويلها واحتلالها مدة طويلة أو قصيرة، من شبكات اجتماعية تهيكل التنقلات والترابط الاكثر عمقاً أو الاقل عمقاً مع أماكن الاقامة، وأخيراً الاحداث العامة - السياسية أو الفنية المرتقبة - المنتجة للتبادلات، العابرة اولاً.
- الحركة: وهنا يجري تصور المدينة كمكان للتلاقي والاجتماع ولكن العنصر الابرز المسؤول عن ذلك هو حركة الناس، لاسيما الحركة نحو المركز انطلاقاً من الضواحي، والمناطق المحيطة بالمدينة (مناطق البؤس) و(الاطراف)، تعد تنقلاً على طريقة الغزو المكاني.
- العلاقة: وهنا يرى أجيي انه ليس هناك مركز في حد ذاته، بل على العكس إنها علاقة تحدد المركز بنفسه، كما تظهره، وفقاً للأوقات وللأماكن ما يريد قوله ان المركزية بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً بين المركز والاطراف وأصبح دور المركز رمزياً وهامشياً (10).
وكما يوجد جدل محتدم ومنذُ سنين خلت بين علماء الاجتماع حول معايير التحضر هل هي (كمية) أم (كيفية) أي هل تتصل بعناصر مادية يمكن ملاحظتها والتدليل عليها قياسياً وعمرانياً بنحوٍ واضح للعين؟ أم هي (كيفية) تتصل بنمط الحياة أو اسلوب الحياة الحضرية، أي تتصل بالذهنية الحضرية وطراز الثقافة الحضرية لطريقة التفكير والسلوك؟.
لعل عملية التشبث بالعناصر أو بالطريقة الكمية لا تدلل أو تبين لنا مغزى عطالة المثقف العراقي، وذلك لأن العمران والتوسع لمدينة (بغداد) على عدة صعد على وفق المعايير المادية تلك ستكون إلى جانب الطراز الحضري ستبين قوة زخم الوسط الحضري (ظاهرياً)، ولكن البحث في المعايير والبنى المضمرة لهذا التحضر على وفق المعايير الكيفية (نمط الثقافة وطرزها) ستبين لنا معالم تلك العطالة التي نبحث عنها في ورقة عملنا هذا.
وسنحاول التأطير النظري لذلك عبر اعتماد مراجعة سريعة/ مقتضبة لرؤية بعض علماء الاجتماع الذين درسوا المدينة ووسطها الحضري العام، فضلاً عن التوقف عند بعض أشارات المعايير الكمية حتى تكون الصورة جلية وواضحة عند الحديث عن الحضرية "Urbanism" التي: هي نمط من أنماط السلوك، ولاشك ان كل سلوك، هو سلوك هادف ومنضبط، فتصبح أذن أنماط السلوك الحضري وضوابطه وأهدافه، هي بالضرورة ظواهر مستمدة مما يسود "البناء الحضري" من معايير ونظم(11) (*).
يمكن عد المعيار الكمي لعدد السكان هو أساس جوهري للدراسات الحضرية وعلى مدى أجيال متعاقبة، فلقد تم التركيز على معيار التركيب الحضري للجماعات الحضرية، أي طبيعة الولادات والوفيات ونسبة الخصوبة ونسبة السكان، وهذا الأمر تمت مناقشته بإستفاضة من عدة باحثين لا عد لهم (12).
فالتحضر بوجهٍ عام يشير إلى الكثافة السكانية وتلاصق الدور من بعضها البعض، وعلى الرغم من ذلك فأنهم لا يعرفون بعضهم، وهذا ما تضمنه تعريف فيبر الشهير للمدينة: يمكننا أن نحاول تعريف "المدينة" بطرائق متعددة. وكل التعاريف تشترك في نقطة واحدة، وهي ان المدينة لا تكمن في سكن واحد أو سكنات متعددة منتشرة بشكل مبعثر، تتشكل المدينة على كل حال من السكن المجتمع (ولو نسبياً) أي من "محلة" "Localite" وفي المدن (وليس فيها وحدها)، تبنى الدور بالقرب من بعضها البعض، والقاعدة العامة هي أن تبنى حائطاً لحائط، ان التصور الشائع في الوقت الحاضر يربط المدينة بخصائص كمية محضة: إن المدينة هي المحلة الكبرى، والواقع ان هذا المعيار ليس خاطئاً، ومن وجهة النظر السوسيولوجية فإن هذا يعني تجمعاً لدور متلاصقة، وبشكل كثيف، تشكل معهُ تجمعاً سكانياً من قطعة واحدة، تكون من الشناعة والكبر بحيث أن الاجتماع العادي والخاص بالجوار يصل حداً يصبح فيه التعارف الشخصي والمتبادل بين السكان متعذراً (13) .
نحن لا نعول على كل ما تقدم على الرغم من أهميته في فهم الوسط الحضري ولكن لفهم عطالة المثقف التي نقول بوجودها في الوسط الحضري (المنهار) في مدينة بغداد، نحن نحتاج إلى الذهاب إلى المعايير (الكيفية) لفهم ذلك وأدراكه بنحوٍ جلي.
سنبدأ بآراء جورج سيمل "G. Simmel" (1858 - 1918) حول ثقافة المدينة الحديثة، أو المدينة الكبرى أو التجمع الحضري المتروبوليتان "Metropolitan"، والذي كان موضع اهتمام سيمل(*)، والذي ركز فيهِ على موضوعة "الذهنية الحضرية" وسماتها العامة.
في عام 1903 كتبَ سيمل مقالته السوسيولوجية الشهيرة (المتربول والحياة الذهبية)، وهي المقالة التي يعتبر العديد من الكتاب أنها أُسست لبدء الاهتمام السوسيولوجي الفعلي بالمدينة، ويندرج تحليل سيمل للعلاقة بين المتربول والذهنية في إطار ما يمكن التعبير عنه اليوم بالعلاقة بين الثقافة والمجال. ومنهج سيمل الشكلاني -الذي ستتأثر بهِ مدرسة شيكاغو- يمهد لوجهة نظره الخاصة في تناول هذهِ العلاقة، إن الاشكال "Formes" العامة التي تجري فيها الحياة الاجتماعية يمكنها لوحدها أن تمكننا من فهم محتوياتها، والأشكال كما يقول سيمل هي "التجليات المكرسة" "Configurations Cristallisees" وهذا التكريس يعني انها اصبحت مستقلة عن الفعل أو الذات المؤسسة لها، ولكنها في نفس الوقت وحتى وهي تعيش من خلال منطقها الخاص بها فإنها تجد نفسها في تعارض وتناقض مع الكائن الذي هيأ نشأتها ووجودها (14).
ان الأشكال بمثابة الأطر الاجتماعية المتنوعة التي يعاد بها صياغة ذهنية الانسان، بعد ان أوجدت هذهِ الأطر، ولكنها بتقادم الزمن تستقل رويداً رويداً عن مؤسسها الأول وتغدو بمثابة كيانات عامة، وهذا الأمر يتصل بفضاءات المدينة المتنوعة التي ستجترح الموجهات الثقافية الجديدة وتفرض شروطها الحياتية على ممارسات الإنسان وطرز تفكيره.
ولقد عبر سيمل عن هذهِ الأطر بعبارة "تراجيديا الثقافة" حيث يقول عنها: تلك هي تراجيديا الثقافة... فمفهوم الثقافة يفيد أن الذهن هو الذي يخلق الأشكال الموضوعية المستقلة والتي من خلالها يمر طريق الذات التي تذهب من نفسها لنفسها، وهكذا فإن العنصر المدمج والذي يكيّف الثقافة قد أصبح بدوره محدداً سلفاً بتطور خاص يستعمل ومن دون شك دوماً قوى الذوات الفردية، ويجرها إلى مجراه(15).
من الواضح ان سيمل يتحدث عن عملية قهر ثقافي تقوم الاشكال الحضرية للمدينة بتأديتها، مما تجعل الافراد ملزمين بالسير على وفق قواعد ذهنية خاصة على وفق رغائبها الثقافية تلك، وذلك لأن الافراد على الرغم من أنهم هم من صنع هذهِ الأشكال إلا انهم اصبحوا مسلوبين الإرادة إزائها لتنميطها الثقافي لهم.
بعبارة أخرى يرى سيمل ان الحقيقة الحتمية للحياة الحضرية لكل الانواع سواء في الاسرة أو القانون الحضري كانت متمثلة في الشعور بالقهر ذلك الشعور الذي يحيط بالإنسان في المدينة التي يعيشها إلى جانب الافراط في الحافز النفسي يقود الناس إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم برد الفعل العاطفي بالنسبة لمن يحيطون بهم في المدينة، وهذا يعني إلا تحاول القيام برد الفعل كما يفعل جميع البشر، وكدفاع ضد تعقيد الحياة الحضرية، يحاول الناس ان يعيشوا في علاقة غير عاطفية وعقلية ووظيفية مع الآخرين، وهذا الدفاع يجعل الحياة منفصلة ويطبق الضبط على كل واحد على حدى، وإذا حاول الناس في المدينة ان يعيشوا حياتهم في الأسرة وفي العمل وفي الصداقة، فإنهم يتحطمون عن طريق التعقيدات الكامنة في كل من هذهِ الوقائع التي يعيشونها في الوسط الحضري (16).
وهذا الأمر يعني بطبيعة الحال أن المدينة تعيد تشكيل ابنائها أو سكانها بنحوٍ يجعلهم يتشابهون في طرز التفكير وأنماط السلوك، ولهذا وجدنا ان السكان المدينيين يمتازون بخصائص وسمات تفرقهم وتميزهم عن سكان الريف أو البوادي، ولقد اجمل سيمل خصائص الحياة المتروبولية في مظاهر عدة، يمكن أن ينظر لها كذلك بوصفها تعريفات للمدينة ذاتها، وهي كالآتي:
المتربول هو مجال (الاستقلال الفردي).
المتربول هو مجال (أولوية العقل على العاطفة).
المتربول هو مجال (سيادة العقل التجريدي).
المتربول هو مجال (سيادة العقل الحسابي).
المتربول هو مجال (إنتاج السأم).
المتربول هو مجال (العقل الحذر) (العقلية المتحفظة).
المتربول هو مجال (الحرية الممنوحة للأفراد).
المتربول هو مجال (تحقيق الكونية).
المتربول هو مجال (ألفردية والعقلنة).
المتربول هو مجال (ثقافة الموضوع) (الثقافة الموضوعية).
المتربول هو مجال (التقسيم الاكبر للعمل) (17).
ان المرتكز الرئيس الذي تدور حوله خصائص الحياة الحضرية هي "العقلانية"، وهذا الامر هو ذاته ما اهتم به ماكس فيبر عندما ولجَ الى موضوعة (المدينة) والحياة الحضرية، ومن ثم فان الذهنية الحضرية مدارها الرئيس هو (التفكير والسلوك العقلاني/ الحضري).
لقد كان جل اعمال ماكس فيبر -M.weber (1864- 1920) تدول حول محورين اساسيين هما (العقلنة) و(الشرعية) أو (السيادة) "Herrschaft". ان المسألة التي ينبغي التنبيه إليها هي: ان ماكس فيبر هو يسعى الى وضع النموذج المثالي للمدينة كان يعتبر انه لا وجود للمدينة بالمعنى الذي يقدمه الا في اوروبا الغربية، لان المدينة الغربية هي قمة ما بلغته العقلنة الحضرية والتي تتجسد في مختلف تنظيماتها، وسيتضح هذا الموقف اكثر عندما يخصص لهذه المدينة صفحات عديدة للإشادة بالديموقراطية المحلية التي نشأت وازدهرت فيها (المجالس السلطوية والقضائية والمالية المنتخبة، ووضع دستور خاص بكل مدينة)(*) . فهو يؤكد دائماً على الأصالة المتميزة والفريدة للحضارة الاوربية وللمدينة الغربية بالخصوص والتي عرفت وحدها نظام الجماعة الحضرية المنتخبة (النظام البلدي) الذي يعني المدينة في اوجه اشتغالها، إنها قمة العقلنة الحضرية التي تنتهي بإندماج وانصهار كل العناصر البشرية مهما كانت أصولها الجغرافية أو مكاناتها الاجتماعية في المواطنة الحضرية (وهذهِ المسألة سنعود لها لاحقاً)، ان الحضارة الغربية هي التي اكتشفت وابدعت المدينة(*)!! (بحسب رؤيته) (18).
إن الخلاصة العامة التي يمكن الخروج بها من أطروحات فيبر هو تركيزه المستمر على العقلانية التي تجد ممارساتها أو تطبيقاتها في الفعل الاجتماعي (الرشيد) كما حددهُ هو، ولما ربط بين انماط السيادة فأنه عول على أهمية المدينة بوصفها حاضنة اجتماعية لذلك النمط العقلاني، ولكونه مسؤولة بعدئذ عن ترسيخ معالم (عقلنة حضرية) بوصاية ورعاية سياسية مباشرة.
لو أردنا أن نذهب نحو العمق لفهم أصول تلك العقلنة الحضرية التي يتحدث عنها فيبر وصلاتها بالنظام السياسي العام، لنجد ان الامر يرتبط بالنموذج الاوروبي بدرجة معتد بها، وأن ظلت بعض الأمور التي ترتبط بمسارات حضارية خاصة، لعلنا نستطيع ان نفهم بعض هذهِ الأمور لو أننا تتبعنا بعض أطروحات شارلز تايلر ''Charles Taylor'' (وهو أحد الفلاسفة السياسيين المعاصرين) في كتابه المترجم مؤخراً إلى العربية المتخيلات الاجتماعية الحديثة ''Modern Social Imaginaries'' وهو ينطلق من مصطلح "المتخيل الاجتماعي" في تتبع تشكل الذات الغربية وهويتها، وبعض مسارات الحداثة التي مرت بها إزاء موضوعات إنسانية متعددة.
ويعني "بالمتخيل الاجتماعي" شيئاً أوسع وأعمق من الصيغ الفكرية التي قد يعتمدها الناس عندما يفكرون في الواقع الاجتماعي بعيداً عن الانخراط فيه، وأنا أفكر في الطرائق التي يتصور الناس من خلالها وجودهم الاجتماعي، وكيف ينسجمون مع الآخرين، وكيف تجري الأمور بينهم وبين أقرانهم، وكذلك في التوقعات التي تجري تلبيتها عادةً، إضافة إلى الأفكار والصور المعيارية الأعمق الكامنة خلف هذهِ التوقعات (19).
إن أنعكاسات الواقع الاجتماعي وطرائق الناس في تصور وجودهم الاجتماعي والتوقعات المتفق عليها، كل هذه الامور تجد صداها في الوسط الحضري (المدينة) بوصفها دائرة أوسع لعمل هذا التخيل الاجتماعي الذي يعكس هيمنة النزعة العقلانية الحضرية على حياة الافراد، ولقد فسرت اشتغالات كل من ماكس فيبر وجورج سيمل بوصفها متقاربات لموضوعة المخيال(*) أو التخيل الاجتماعي لحياة المدينة. وذلك على اعتبار ان هناك مجموعة من الصور التي تحكم الوعي والحياة الاجتماعية الحضرية داخل المدينة، ومن ثم فهي تسيّر أفرادها بموجبها، وهي تعبر ضمناً عن تصارع توجهين داخل المدينة بين العقلاني واللاعقلاني.
أبدت السوسيولوجيا الألمانية نهاية القرن التاسع عشر وتحت تأثير فينومنولوجيا هوسرل، نزوعاً إلى "الليونة المنهجية" مقارنة بنظيرتها الفرنسية، مبتعدة من هيمنة العلموية الوضعية من أجل دراسة حقيقة الموضوعات المعيشة، قيمها ومقاصدها، وذلك بإنجذاب بيّن إلى المظهر اللاعقلاني والعاطفي للحياة الاجتماعية، وضمن هذا السياق، يمكننا وصف خصائص فكر ماكس فيبر، فبحسب السوسيولوجي الالماني فإن رابطاً صارماً يوجد بين الدين والفن، وهو المتعلق بالحقل "اللاعقلاني" وبالمتعالي، يسبق النزعة الفكرية العقلانية في الغرب، في تحليل فيبر للسلطة الكاريزمية(*) وللجماعة العاطفية، كان البدهي ان يمنح دوراً مركزيا ًلقدرات اللاعقلاني في اقتحام الحياة اليومية من أجل شرعنة سلطة تستدعي اللاوعي الجماعي. ويفصح فيبر عن ذلك بوضوح، العقلانية تعمل من الخارج، بينما قد تكون الكاريزما تغيراً من الداخل. الأفكار العقلانية نشعر بها ونتابعها كثيراً من الخارج، بينما المقدس هو شيء يندرج في قرارة أعضاء الجماعة (20).
وعلى الرغم من اهتمام فيبر بالأصول اللاعقلانية للذهنية الغربية، عبر حديثه عن الكاريزما، الا انه بين بلا لبس مآلاتها العقلانية المؤسساتية داخل بنية المدينة التي ستبلع كل تلك الحماسة العاطفية ومؤيدوها وتجعلهم أمام ضروريات الحياة المدنية/ البيروقراطية التي لا مناص منها، بوصفها مرتبط بالبنية الداخلية لأسس التغيرات الاجتماعية المتسارعة لذلك العقل الغربي الذي عمدَ عبرَ حداثته إلى فك السحر عن العالم وأصبح العالم خاضعاً لتغير العقلاني والنمط السلوكي العقلاني فحسب، وأن تبلورات كاريزمية تنشئ في احضان الدين أو البنى التقليدية/ الأبوانية مصيرها المحتوم هو الانصهار في بوتقة الوسط المديني/ العقلاني الذي يصهر كل التوجهات اللاعقلانية استناداً إلى العقلنة الحضرية وقوتها على التحويل والتغيير.
لقد نـُفي اللاعقلاني في الحياة البشرية بطريقة حددتها عملية فك السحر عن العالم، من خلال حرمان الإنسان من الاشباع العاطفي لشعوره الديني الحقيقي: أينما حققت المعرفة الامبريقية العقلانية، وبطريقته منهجية، عملية فك السحر عن العالم، وتحولهِ إلى آلية سببية، تجلى بشكل نهائي التوتر مع إدعاءات المسّلمة الأخلاقية التي تقول إن الكون ينظمه الله (...) التفكير الامبريقي في العالم خصوصاً ذلك الذي يحمل خلفيات/ رياضية/ يرفض مبدئياً كل تفكّر يبحث بصفة عامة عن معنى لما يطرأ ويستخدم في العالم (21).
أما بالنسبة إلى جورج سيمل فلقد ربط بين الأشكال الاجتماعية (لتجليات الوسط الحضري/ المديني) والتي أصبحت مستقلة عن الأفراد بعد أن كوّنوها وبين التخيل الاجتماعي، الذي ينجم عن هذهِ الاشكال، وبحسب مراجعات غراسي: بالمنظور نفسه، يرتبط سيمل بالنظريات عن المخيال، خصوصاً في ما يتعلق بمفهوم "الشكل" ووظيفته الكشفية. هدف علم الاجتماع هو تحليل أشكال العلاقات الاجتماعية التي هي مستقلة عن المضامين التي تحملها في مختلف أوضاع الحياة التاريخية - الاجتماعية، يمثل الشكل "الرابطة الضرورية... بين التجربة وجوهر الاشياء بين المعيش الاجتماعي والتمثلات القائمة تجاه ذلك المعيش، الاشكال يمكن أن تقارب النماذج الأصلية، بمعنى أنها ثابتيات (لا تغيّرية)، ثوابت تتُرجم في "وضعيات معتادة" ووفق ما يشير ميشيل مافيزولي، فإن شكلانية "Formisme" جورج سيمل يمكن ان تخفف من صرامة البنيوية، لأنه مع احتفاظه بمقاربته السديدة عن الثابتية، فإنه يمكنه افتكاك الهشاشة والتيارات الحيوية في الواقع المعيش (22).
لو قمنا بدمج هذهِ الأطروحات مع الفهم الذي تبناه تشارلز تايلر حول "المتخيل الاجتماعي" لوجدنا اننا نتحدث عن وسط حضري (المدينة) التي أنبجست من خلالها الحداثة الغربية برمتها والتي طالت كل جوانب الحياة، وهذا عين ما تحدث عنه فيبر وسيمل، إذ أن الذهنية الحضرية المتعقلنة التي تحدثوا عنها انما هي خلاصة (السيادة/ العقلانية (السياسية) من جهة و(الأشكال الاجتماعية لصيغ التحضر) فكلاهما صنعا عقل حداثوي/مديني عبَر عن تزاوج وتماهي (السلطة بمحددات الحياة الحضرية).
وخلاصة كل ذلك هو نشأة نظام اخلاقي للمجتمع (المديني)، وهذهِ هي الفرضية الأساسية لتشارلز تايلر والتي يحاول البرهنة عليها من خلال تلك المتخيلات الاجتماعية أو كما قال: "فرضيتي الأساس هي أن المفهوم الجديد، مفهوم النظام الأخلاقي للمجتمع، أمر مركزي في الحداثة الغربية ، وكان هذا في البداية مجرد فكرة في أذهان بعض المفكرين من أصحاب التأثير الواسع، لكنه صار في وقت لاحق يشكل المخيلة الاجتماعية لشرائح اجتماعية واسعة. ومن ثم المجتمعات بأسرها في آخر المطاف، وصار من الواضح بذاته الآن أننا نجد صعوبة في النظر إليه بإعتباره مجرد مفهوم محتمل من بين مفاهيم محتملة متعددة، وانتقال هذهِ النظرة إلى النظام الاخلاقي إلى متخيلنا الاجتماعي يعني قيام أشكال اجتماعية بعينها، هي تلك الأشكال التي تتصف حداثتنا الغربية بها من حيث الأساس: اقتصاد السوق، والمجال العام، والشعب الذي يحكم نفسه بنفسه، وغيرها"(23).
ولقد آن لنا نتسأل هنا؟ هل يمكن عدَ المعايير الحداثوية الغربية ولاسيما الوسط الحضري/المديني الغربي الذي صنع أو ولدَ ذهنية حضرية متعقلنة، بمثابة المقياس الذي ننطلق منه لفهم مزايا وسمات الوسط الحضري بوجهٍ عام لمدننا العربية لاسيما بغداد على وجه الخصوص؟ أم ان المسألة بها مجازفة ومغالاة ومماثلة غير متكاملة في ظل وجود أمرين يجادل عنهما الآن بقوة وهما:
أولاً: وجود حداثات متعددة وليس حداثة واحدة مركزية (الحداثة الغربية).
ثانياً: أن تطور الوسط الحضري/ الغربي بكل عناصره وسماته مختلف عن الوسط الحضري/ العربي والاسلامي والذي اقترن بخصوصيات ثقافية وجغرافية متعددة.
لعل المنطق السوسيولوجي الداخلي سيجعلنا أمام أهمية وجدوى الارتكاز على مقولات واطروحات علماء الانثروبولوجيا والاجتماع، ما دمنا نحاول اجراء مراجعة فعلية للوسط الحضري لمدينة بغداد، والوقوف على إنهياره، إذ كيف نشخص الانهيار في من دون مجسات ومقاييس اجتماعية نعرفُ بها مصداقية قولنا بحدوث هكذا انهيارات حضرية، لاسيما على المستوى (الكيفي/ الثقافي).
أن ورقة العمل هذه تقدم التأطيرات النظرية/الغربية على حذر شديد بطبيعة الحال، ولكنها في الوقت عينه تنظر اليها كذلك، بوصفها معايير عالمية لا يمكن تجاوزها أو اغغالها، أياً كانت الشروط الثقافية أو النقل السياقات الثقافية/ المحلية التي نرى وجودها في مدينة بغداد.
أننا نريد القول ان هذه التأطيرات النظرية عندما نجعلها أمامنا أو نعدها بمثابة المنظار الذي نسعى من خلالها ادراك ماهية المثقف العراقي في الوسط الحضري، فأننا لا نجد للوهلة الاولى وكقراءة أولية إلّا عطالة ثقافية واضحة، وذلك لأن المدينة انما تتحرك بموجب السلوك الثقافي لأبنائها، والمثقفون كما يفترض هم أعمدة هذا السلوك، وهم غائبون بغياب (المدينة) ذاتها، وصهرتهم العصبويات (القبلية والطائفية والحزبية...) التي جرتهم إلى ساحتها فأطلوا كسياسيين!! أكثر من كونهم مثقفين.
وبمقاربة أخيرة نقول اننا ننشد (المواطنة الحضرية) ''Citizenhood'' والتي يراد بها السلوك الثقافي المعبر عن الوسط المديني/الحضري الذي يجعل الافراد يتصرفون بنحو مماثل ومطابق من جهة الولاء للثقافة التي يحيون فيها في الوسط الحضري، انها بحسب ندوة لندن المنعقدة عام 1984 انما هي دلالة على الهوية، إذ تؤدي الولادة والنشأة في الشارع نفسه والعيش في الحي عينه إلى تآزرات بين الاشخاص تتجاوز الانشقاقات السياسية أو الايديولوجية. وأظهرت اعمال لاحقة ان المواطنة الحضرية متلازمة مع المكان: تفتح المواطنة الحضرية منفذاً آخر للمكان الجغرافي.... وهي أرض تتبلور فيها مختلف طرق تنظيم المجموعة الحضرية (24).
فالفكرة الجوهرية لمفهوم المواطنة الحضرية تركز على: ممارسات التمايز التي تسمح للافراد بتأكيد انتمائهم إلى الجماعة وهو ما يسمح للربط بين المواطنة الحضرية والهوية، ومن ثم يتم التشديد على عمليات الاندماج في المدينة واكتساب ثقافتها وهويتها عبر ممارسات فردية أو جماعية تفضي إلى الاستمدان (أو التمدين)(25).
انها بعبارة مكثفة العلاقة مع العالم الحضري الذي يحيا بوسطه الانسان، أو الجماعة، أو المجتمع مثل ما قال ميشال لوسو ''Mishe Lussault'' عالم الجغرافيا الشهير بعد سؤاله المركزي: ما هي المواطنة الحضرية؟ وتبدو إجابته عن السؤال بديهية: هي بكل بساطة العلاقة بين أي فاعل اجتماعي فرد، سواء أكان شخصاً أو مجموعة أو مؤسسة، وبين محيطه، اي العالم الحضري الذي لا يمكن انتقاصه بحيث يلخص ببعده المكاني فقط (26) .
ان مفهوم (المواطنة الحضرية) إذا استدمج مع سائر المفاهيم والقضايا السابقة التي تم الحديث عنها من منظار انثروبولوجي وسوسيولوجي، انما تفضي بحسب اتخاذ كل ما تقدم كمعايير موضوعية للنظر إلى مدينة بغداد إلى صورة سوداوية ضاعت بها القيم المدينية/ العقلانية بل وتفسخت المدينة بنحو جلي.
مما يجعل من عطالة المثقف فيها تحصيل حاصل للوهلة الاولى وبحسب المقاربة النظرية (المعيارية)، وذلك لأن السلوك الثقافي/ الحضري المفترض وجوده بالنسبة للمثقف قد غاب بغياب المدينة ووسطها الحضري ذاته.
وما مقالتنا إلّا ملاحظات نظرية/ أولية لا يسمع المقام تفصيلها بأمثلة وبراهين للتدليل على ما قلناه حول عطالة المثقف العراقي، ولكننا نكتفي بالمعايير النظرية ذاتها كيما ندشن لرؤية مستقبلية لتحليل وافٍ عن فرضينا الجوهرية التي ابتدأنا بها المقال وهي قولنا: بأفتقار الوسط الحضري/البغدادي لأدنى حد من الاشتراطات الثقافية/المدينية لانتاج سلوك ثقافي/عقلاني يضطلع به هؤلاء (المثقفون) الذين تاهوا في صحراء المدينة!! ومنطقها الايديولولوجي الطاحن!!؟.
***
د. جعفر نجم نصر - أستاذ الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع
الجامعة المستنصرية
....................
الهوامش والمصادر
(1) ميشال أجيي، أنثروبولوجيا المدينة، ترجمة ومراجعة: سعيد بلمخبوت، اصدارات مجلة الفيصل، المملكة العربية السعودية، ط1، 2016، ص113.
(2) مونيس بخضرة، تاريخ الوعي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، دار الأختلاف (الجزائر)، ط1، 2009، ص45
(3) علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط5، 2012، ص98.
(4) المصدر نفسه، ص99.
(5) ينظر: محمد مكية، بغداد، دار الوراق ، لندن، بيروت، ط2، 2009، ص149-176.
(6) علي حرب، المصدر نفسه، ص175.
(7) ينظر: قيس النوري، الانثروبولوجيا الحضرية بين التقليد أو العولمة، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص132-136.
)(8) G.M.Faster & Kemper, Anthropologist in cities, Little Bounce Co. Boston, 1979, PP.16-19.
(9) ينظر: مجيد حميد عارف، انثروبولوجيا التنمية الحضرية، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1990، ص18-19.
(10) ينظر: ميشال أجيي، المصدر السابق نفسه، ص115-117.
(11) د. قباري محمد اسماعيل، علم الاجتماع الحضري، الناشر: منشأة المعارف، الاسكندرية، ط1، 1986، ص49.
(*) ومما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا هو أن "حضارة المدن" إنما تكمن في ماضيها وتاريخها، أما الحضرية فلا تاريخ لها فقد تنشأ وتصدر المدن طفرة، وتسمى بـ"المدن الشيطانية" تلك التي تظهر فوراً لكي تلمع فجأة حول المناجم، ثم سرعان ما تخبو مدن الاشباح "Ghos Cities" نتيجة استهلاك ما فيها واستغلال معادنها، وتتحول مدن التعدين بعدها إلى "جبانات من المدن الخربة والمهجورة" على العكس من هذه النظرة القائمة، لقد ازدهرت الحياة الحضرية وتفتحت في دويلات الخليج العربي، لتفاصيل اكثر ينظر: المصدر السابق نفسه، ص48-50.
(12) ينظر: المصدر السابق نفسه، ص407-413.
(13) د. عبد الرحمن المالكي، مدرسة شيكاغو، ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة، افريقيا الشرق، المغرب، ط1، 2016، ص29.
(*) لقد كان سيمل أحد اربعة علماء اجتماع عرفتهم ألمانيا بين 1890-1920، ونعني بهم: فرديناند تونيز F. tounes""، وماكس فيبر، ورنر سومبارت "R. Soumparte"، فلقد اهتم هؤلاء الأربعة بالتغيرات الاجتماعية الكبرى التي فجرها التصنيع في ألمانيا وباقي الدول الأوروبية الأخرى التي كانت تشهد عملية الانتقال السريع والمثير في الحياة القروية إلى الحياة الحضرية المعقدة، ويعتبر ستيفان جوناس ان هؤلاء العلماء الاربعة هم الذين ابتكروا فكرة المدينة الكبرى كمفهوم نموذجي/مثالي، وكنمط ثقافي واسلوب في الحياة، أي كظاهرة كبرى تمس منذئذ كل المجتمع وكل الحضارة. ينظر: د. عبد الرحمن المالكي، مدرسة شيكاغو، مصدر سابق، ص40.
(14) د. عبد الرحمن المالكي، المصدر نفسه، ص42-43.
(15) المصدر نفسه، ص43-44.
(16) ينظر: محمد ياسر الخواجة، علم الاجتماع الحضري بين الرؤية النظرية والتحليل الواقعي، مصر العربية للنشر، القاهرة، 2010، ص51.
(17) د. عبد الرحمن المالكي، المصدر نفسه، ص44-45.
(*) بوجهٍ عام إن المدينة بالنسبة له، كما يتجلى من خلال التقرير حول محاضرة 1917 هي إحدى مميزات تاريخ الدستور الغربي، فهي تورد عنصراً جديداً من عناصر السيادة، وهو ما يسمى بالنموذج الرابع من شرعية السيادة، والذي يقوم على إرادة المحكومين، وبذلك فإن المدينة تسجل في نفس الوقت ميلاد الدولة القانونية، والديمقراطية الحديثة، وإن بقيت من حيث التحقق بعيدة جداً لتفاصيل اكثر ينظر: ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع، ت: محمد التركي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2015، ص69.
(*) بوجهٍ عام إن المدينة بالنسبة له، كما يتجلى من خلال التقرير حول محاضرة 1917 هي إحدى مميزات تاريخ الدستور الغربي، فهي تورد عنصراً جديداً من عناصر السيادة، وهو ما يسمى بالنموذج الرابع من شرعية السيادة، والذي يقوم على ارادة المحكومين، وبذلك فإن المدينة تسجل في نفس الوقت ميلاد الدولة القانونية والديمقراطية الحديثة، وإن بقيت من حيث التحقق بعيدة جداً. لتفاصيل اكثر ينظر: ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع، ت: محمد التركي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2015، ص69.
(18) د. عبد الرحمن المالكي، المصدر نفسه، ص35.
(19) تشارلز تايلر، المتخيّلات الاجتماعية الحديثة، ت: الحارث النبهان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، 2015، ص35.
(*) عَرَف مصطلح "المخيال Imaginaire" خلال تطوره التاريخي المفهومي معاني متعددة، فقد كان في البداية يقابل "الواقع/ الحقيقي"، فإنتهى إلى أن يقصى في مجال اللاوقعي/غير الحقيقي أي "الخيالي" أو "التوهمي" بعد ذلك، صار ينظر إليه بإعتبار مرادفاً للتخيل والفانتازيا أو الخيال النزوي "Fantaisie"، ما أفقد المفهوم أصالته خصوصاً أنه صار يستدعي تصوراً خرافياً (فانتازيا) لا علاقة له بالواقع، في المقابل، في خلال القرن العشرين، أعادت نظريات أخرى دراسة مقالة المخيال هذهِ من زاوية تتجاوز الزاوية الاختزالية للعقلانية، مفسحة في المجال لنسق حركي منظم للصور التي تتخذ معنى بفضل علاقة التفاعل الداخلية، وفاعلية هذا النسق شرعية، و لا واقعية" في آن لأنها تعتبر أداة للدخول في علاقة تفاعلية مع الكون من خلال فعل بنّاء وحيوي، من دونه سيغدو الكون مستعصياً على الإدراك، وإذا كانت العلاقة بالعالم ستمر من خلال الصور، فإن هذهِ الأخيرة تمتلك قوة عظيمة لأنها مؤسسة للمعنى، فالصورة، أو الرمز تقوم بـ"توسط الأبدي/ الازلي في الزمني". ينظر: فالنتينا غراسي، مدخل إلى علم اجتماع المخيال، ت: محمد عبد النور وسعود المولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، 2018، ص15-16. .
(*) يقول فيبر عن نشأتها: في المعنى "الخالص" الذي وقع وصفه هي دائماً وليدة أوضاع خارجية غير عادية - سواء كانت هذهِ بالأخص سياسية أم اقتصادية ام نفسانة دينية، أم كليهما معاً، فهي تصدر عن انفعال عاطفي خارج للعادة لدى مجموعة من الناس وعن تحمسهم للبطولة مهما كان مضمونها، ومن ذلك وحده ينتج: أنّ الإيمان بالكاريزما قد يؤثر بقوة لا تنفث وبوحدة ومناعة على صاحبه وحواريه -سواء كان هذا الإيمان نبوياً أم ذا مضمون آخر - مثلما يؤثر التحمس العقائدي على أولئك الذين يشعرون أنه أرسل إليهم عليه وعلى رسالته بإنتظام في حالة الصورة "Statu Nascendi" وإذا ماعادت الحركة التي رفعتها المجموعة القائدة كاريزماتياً عن المعتاد ولتشرق على الحياة اليومية، فتعظيم السيادة الكاريزماتية الخالصة على الاقل بإنتظام، إذ ستنتقل إلى "المؤسساتي" وستنثني ومن ثم ستصبح إما آلية وإمّا سيقع ردعها من خلال مبادئ بنيوية مغايرة تماماً لها أو تذوبيها بالاستعانة بهذه المبادئ في أشكال مختلفة ولغمه بحيث تكون مرتبطة بها فيما بعد بصفة وثيقة ومتغيرة غالباً إلى حد الطمس، ولا تمثل عنصراً مهيئاً للشكل التجريبي التاريخي الا بالنسبة للاعتبار النظري لتفاصيل اكثر: ينظر: ماكس فيبر، المصدر السابق نفسه، ص524 .
(20) فالنتينا غراسي، المصدر نفسه، ص51.
(21) فالنتينا غراسي، المصدر السابق نفسه، ص51-52.
(22) فالنتينا غراسي، المصدر نفسه، ص53.
(23) تشارلز تايلر، المتخلات الاجتماعية الحديثة، مصدر سابق، ص12.
(24) محمد ناصري، المواطنة الحضرية في مواجهة القرن، مقالة في كتاب: المدينة في العالم الاسلامي، المجلد الثاني، تحرير: سلمى الخضراء الجيوسي وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2014، ص1125.
(25) المصدر نفسه، ص1129.
(26) المصدر نفسه، ص1130.