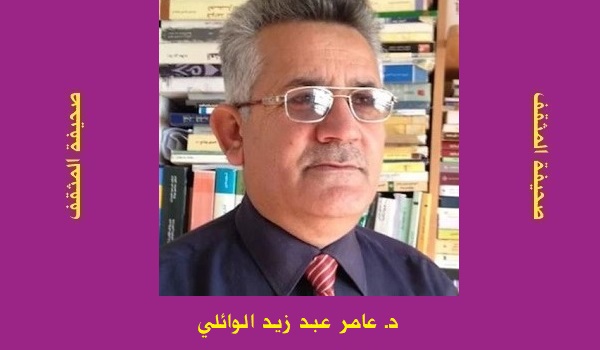أقلام فكرية
عبد الحليم لوكيلي: في السؤال الفلسفي (3): في بعض أنواع السؤال الفلسفي

هل السؤال الفلسفي واحد أم متعدد؟
تتميز الفلسفة بكونها حقلا معرفيا يتقوم على أسئلة فلسفية دقيقة، تبتغي الكشف عن أسباب الأشياء وأصولها. وإذ كان الأمر كذلك، فإنه بالنظر إلى طبيعة هذه الأسئلة في تاريخ الفلسفة الممتد لقرون (27ق)، لا نحصل على نمط واحد منها، بقدر ما أن هناك تعدد في أنماطها، بحسب مستجدات العصر الفكرية والعلمية من جهة، وبحسب تصور الفيلسوف الذي يسعى إلى إدراك حقيقة الأشياء من جهة أخرى. ولعل أبرز أنواع الأسئلة الفلسفية التي اشتهرت بها الفلسفة منذ نشأتها إلى اليوم، نجد -حسب علمنا- نوعين مختلفين من حيث طبيعتهما وزمان حضورهما. لقد اشتهرت الفلسفة اليونانية بالسؤال الفلسفي التوليدي، كما اشتهرت الفلسفة الأوروبية الحديثة بالسؤال الفلسفي النقدي.
يشاع عن سقراط (470ق.م-399ق.م) أن أمه كانت مولدة نساء، ولذلك، يعتبر نفسه مولدا للأفكار كما كانت أمه تولد النساء. إن قراءة المحاورات التي تدور رحاها حول قضايا مختلفة (سياسية وأخلاقية...إلخ) بين سقراط والسفسطائيين، يبين أنها محاورات كانت تطلق عليها اسم "مايوطيقا"؛ (la maïeutique) أي التوليد. يبدأ سقراط محاوراته بتقديم قضية محددة يتلوها بسؤال، فيستدرج المحاور للإجابة، إيمانا منه بأن المحاور لا يملك معرفة دقيقة بما يتساءل عنه، ثم بعد ذلك، ينطلق من إجابته ليولد منها سؤال آخر، يدفع صاحبها إلى التشكيك في معارفه وإجاباته. وبهذه الكيفية، يجعل سقراط من المحاور في حالة من الريبة المعرفية التي تجعله منصتا بعناية إلى ما يدعيه سقراط من تصورات فكرية ومعرفية تتجاوز فكرة السفسطائية القائلة بجعل الإنسان مقياس كل الأشياء.
يتضح إذن، أن الحوار السقراطي الذي يشترط طرفين على الأقل في العملية الحوارية، يعتمد على تقنية السؤال والجواب التي تهم تحديد بعض المفاهيم تحديدا دقيقا، يخرج بها من رتابة المبتذل إلى مقام العلو والحكمة. والانتقال من السؤال إلى الجواب يعتمد على كيفية توليدية، تنطلق من سؤال حول مفهوم محدد، واستنادا إلى جواب بعض السفسطائيين، يجعل سقراط من الجواب -وبنوع من التهكم والسخرية- بداية نحو سؤال آخر، كي يبين لهم بأن ما يدعونه من معارف ليست بالضرورة واضحة ومتميزة في الأذهان. وبالتالي، إن السؤال الفلسفي السقراطي سؤال توليدي يبتغي تفنيد كل ادعاء للمعرفة التي هي في الأصل ادعاء للجهل.
هكذا، يمكن القول بأن السؤال السقراطي التوليدي، كان موجها نحو المعرفة فقط-أي بيان تهافتها وضعفها الحجاجي، بل إن كل معرفة سفسطائية كانت بمثابة ادعاء للمعرفة، والحال أنها ادعاء للجهل فقط- ولم يكن موجها نحو منبع هذه المعرفة ومصدرها. لذلك، ومع المستجدات النظرية التي شهدها تاريخ الفلسفة منذ بداية الفكر الأوروبي الحديث، وما صاحب ذلك من تحولات رفعت مقام الإنسان في علاقته بموجودات العالم، من حيث إنه الكائن المالك لجملة من القدرات التي تسمح له ببناء المعنى والمعقولية لذاته وللعالم، لم تعد الأسئلة توجه بالضرورة نحو المعرفة، بل نحو أسسها ومصادرها.
في هذا السياق، يأتي نوع آخر من الأسئلة الفلسفية الذي طبعت مرحلة القرن الثامن عشر، أعني بذلك، السؤال النقدي الذي اشتهر به الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (1724م-1804م). نعلم بأن لهذا الفيلسوف ثلاثية نقدية (نقد العقل المحض، نقد العقل العملي، ونقد ملكة الحكم)، فيها نستشف بأن كانط لا يوجه سهام نقده للمعرفة كما دأب على ذلك الفيلسوف اليوناني سقراط، بل إلى أسس هذه المعرفة؛ أي العقل. إن الخوض فيما إذا كان ما نعرفه من أشياء صحيحا أم لا، يتوقف على مدى قدرتنا على المعرفة؛ أي فيما إذا كنا نملك عقلا يمكننا من معرفة متكاملة أم أنه محدود بحدود الزمان والمكان. ثم، إن السؤال النقدي الذي كان موجها نحو مبادئ إنتاج المعرفة، وليس المعرفة في حد ذاتها، لم يشترط وجود أطراف حوار، أو اعتماد لتقنية السؤال الذي يليه الجواب، وجعل الجواب بمثابة منطلق نحو أسئلة أخرى، أو اعتماد للسخرية والتظاهر بالجهل، بقدر ما أنه سؤال يدفع المرء نحو التفكير في الأسس التي يبني عليها فكره ومعرفته، حتى لا يكون في وضع جهل بإمكاناته الذاتية نحو بناء المعنى والمعقولية بخصوص ذاته والعالم.
***
د. لوكيلي عبد الحليم - أستاذ فلسفة
المغرب