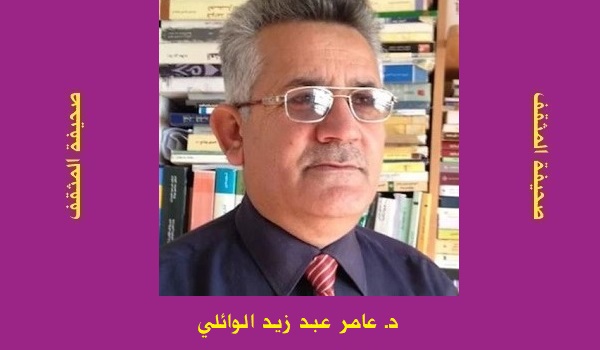أقلام فكرية
ابراهيم طلبه سلكها: مهارة التحليل

أولا: التحليل فى الفلسفة
كلمة " تحليل " analysis هى كلمه يونانية، تعنى فك كل ماهو مركب إلى أجزائه، وتقابلها كلمة "تركيب" synthesis التى تعنى بناء "الكل" من الأجزاء(1) والتحليل قد يكون عقلياً أو تجريبياً، أو منطقياً أو استقصائياً، أو نفسياً، أو ترانسندنتالياً.. إلخ.
وإذا كان عالم الكيمياء مثلاً يقوم بتحليل مركباته المادية وردها إلى أبسط عناصرها، فإن الفيلسوف التحليلي يقوم أيضَا بهذه العملية التحليلية لكنه يقوم بها في مجال اللغة. والفيلسوف التحليلي لا ينظر إلي اللغة على أنها وسيلة، بل أيضاً على أنها هدف من أهداف البحث الفلسفى. فهو لايدرس اللغة من أجل وضع فروض علمية بشأنها، بل لاعتقاده بأن مثل هذه الدراسة لها قيمتها بالنسبة للفلسفة ذاتها. ومع أن الفلاسفه التحليليين يتفقون على أهمية البدء بدراسة اللغة، فإنهم يختلفون حول نوع اللغة التى يدرسونها، وينتمون في ذلك - بوجه عام- إلى فريقين: الأول: يرى أن التحليل الفلسفي للغة يجب أن يتجه إلى تأليف لغة إصطناعية جديدة بإعتبار أن قواعد مثل هذه اللغة أوضح وأدق من القواعد التى تحكم استعمال اللغة العادية، كما هو الحال في مجال العلم. فالفلسفة يجب أن تطور مفرداتها وتصطنع سلسلة من المفاهيم لحل مشكلاتها الأساسيه. أما الفريق الثانى: فيرى أن مثل هذه اللغات الإصطناعية لا تساعد كثيراً على حل المشكلات الفلسفية إذ أن هذه المشكلات يمكن حلها على أفضل وجه عن طريق التحليل الدقيق للغة العادية التى نستخدمها جميعاً في التواصل مع الأخرين(2)
والحق أن تصور الفلسفة على أنها، بوجه عام، عبارة عن "تحليل" Analysis يشكل أساساً رؤية معاصرة، مع أن جذور هذه الرؤية قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ذلك أن جوهر أعمال جميع الفلاسفة، تقريباً، هو التحليل نفسه. فالتحليل منذ زينون الإيلى (430- 490 ق. م) مروراً بفلاسفة ميغارا philosophers of Megara وصوراً إلى الرواقيين كان مألوفاً ومميزاً بخاصته المنطقية، وكان يهدف إلى توضيح المواقف المتقابلة ومفارقتها وأنماط التفكير غير المقبولة، فالفيلسوفان الإيليان "زينون" و"بارمنيدس" وأنصارهما اعتقدوا أن هذا التحليل السلبى يؤدى أحياناً إلى معرفة موثوق بها. ومن الملاحظ أن شهرة زينون تتعلق أساساً بتميزه فى إجراءات هذا التحليل فهو أول من أوضح – فى دراسته لفلسفة بارمنيدس الواحدية من خلال هجومه على التعدديين – أن المذهب التعددى أو مذهب الكثرة يؤدى إلى مفارقات أو تناقضات ذاتية(3).
وكان "التحليل" عند سقراط يهدف إلى توضيح المعانى الأخلاقية فى ضوء منهجه الديالكتيكى... فقد حاول سقراط فى جميع تساؤلاته أن يرد جميع الفضائلvirtues إلى فضيلة واحدة وصفها بفضيلة الحكمة wisdom أو المعرفة، معرفة الخير والشر. فبعد أن حصل فى محاوره "مينون" meno مجموعة الفضائل المقبولة بصفة عامة استطرد قائلاً: و"الآن خذ تلك الفضائل التى لا تبدو لنا معرفة وانظر فيما إذا لم تكن فى بعض الأحيان ضارة مثلما تكون نافعة. مثلاً افترض أن الشجاعة Courage ليست حكمة ولكنها نوع من التهور. أليس صحيحاً أن الإنسان يصيبه الضرر عندما يكون واثقاً من نفسه بلا مبرر والعكس صحيح؟ فعندما يمارس الإنسان كل هذه الصفات ثم ينظمها فى إطار مترابط منطقى تصير نافعة ومفيدة على عكس إذا ما خلت من الوعى والمنطق. باختصار، عندما تكون الحكمة هى المرشد فإن أفعال الروح تؤدى إلى السعادة، وعندما ترشدها الحماقة تؤدى العكس. وعلى هذا فإن كانت الفضيلة خصلة من خصال الروح، أو هى بطبيعتها نافعة ومفيدة فلابد وأن تكون حكمة. فالصفات الروحية جميعها فى ذاتها وبذاتها ليست نافعة أو ضارة، ولكن عندما يحكمها الغباء والحماقة تصير ضارة". وبهذا المعيار الذى دافع عنه سقراط يقف العقل كى يميز المنفعة الحقيقية والدائمة من المنفعة الزائفة التى تؤدى إلى لذة أو صواب مصطنع(4).
وهكذا كان سقراط مهتماً بالمعانى الأخلاقية، كما كان أفلاطون فيلسوفاً تحليلاً فى كثير مما تعرض له.. فإذا كانت قواعد التحليل ذاتها يجب أن تكون ميتافيزيقية فى طبيعتها، بمعنى أنه لابد أن تتضمن مناقشة العروض الفلسفية بواسطة إجراءات العقل العامة بدلاً من الاعتماد على مضامين خاصة فإن هذه الخاصية للتحليل نجدها بوضوح فى محاورات أفلاطون التى عبر فيها عن جميع مهاراته التحليلية لا سيما عرضه لنظرية المثل(5).
ونجد فى المرحلة الحديثة أن معظم الفلاسفة التجريبيين- على حد تعبير إير- كانوا تحليليين إذ أن معظم ما كتبه هؤلاء الفلاسفة يندرج تح نظرية المعرفة، والمفروض فيها أن تحلل ضروب الإدراك المختلفة بما فى ذلك المعرفة ذاتها والخيال والاعتقاد والتمييز بين مختلف الألوان... فالفيلسوف لوك كان تحليلاً لأنه كما يتضح من كتابه "مقال فى الفهم الإنسانى" لا يثبت صحة قضايا تجريبية بعينها أو ينفيها بل نجده يركز فقط على تحليلها. وكذلك "باركلى" لم ينكر- فى الواقع- الأشياء المادية كما هو شائع عنه. وإن ما أنكره فعلاً هو تحليل "لوك" لمثل هذه الأشياء. فقد جعل "لوك" أفكار الإحساس Ideas of sensation التى نتلقاها بحواسنا من شىء ما مرتبطة بعنصر معين، أى أن للشىء جوهراً مركزياً تلتف حوله صفاته. غير أن باركلى لم يوافق على هذا التحليل، وجعل صفات الشىء لاتلتف حول عنصر أو جوهر بل يرتبط بعضها ببعض فحسب. بحيث لايكون الشىء عنده إلا مجموعة إحساساتنا به، متصلاً بعضها ببعض فحسب على صورة ما. وكان الخطأ الذى وفيه فيه "باركلى" حين تصدى لنقد "لوك" هو أنه استثنى النفس إذ جعلها عنصراً قائماً بذاته. ولهذا نهض "هيوم" ليدفع نقد "باركلى" إلى نتائجه المنطقية حتى النهاية، وإذن فالنفس أيضاً إن هى إلا حالات مجزأة متتابعة متصل بعضها ببعض على صورة ما دون أن يكون هناك عصر جوهرى مركزى تتعلق به تلك الحالات. حتى فكرة السببية التى كثيراً ما يقال عن "هيوم" أنه أنكرها لم تكن فقط موضع إنكار لأنه فيلسوف يحلل العبارات والمدركات لا يثبت شيئاً، أو ينكر شيئاً، إنه اقتصر فى فكرة السببية على تحديدها وتعريفها... إلخ(6).
كما أن "هوبز" و"بنتام" و"جون ستيوارت مل" فلاسفة تحليل فإذا تأملنا أعمال "هوبز" و"بنتام" نجد أنهما قد انشغلا بتقديم تعريفات للقضايا، وأن أعظم بعد من أبعاد فلسفة "مل" هو تطويره للتحليل عند "هيوم". وبذلك يرى غير أن مهمة التفلسف أساساً مهمة تحليلية وأن هذه المهمة نجدها متحققة بوضوح فى الفلسفة التجريبية الإنجليزية. ولكن ليس معنى ذلك أن ممارسة التحليل الفلسفى تقتصر على أعضاء هذه المدرسة الفلسفية وإنما ترتبط بهم تاريخياً بشكل قوى(7).
وهكذا يؤكد إير أنه لا جديد فى القول بأن توضيح الأفكار من أهداف الفلاسفة لأنه قول يمتد على الأقل إلى سقراط الذى كان مشغولاً أساساً بأسئلة معينة مثل ما العدل، وما المعرفة؟. ونجد ذلك عند "هيوم" فى تقسيمه كل أنواع الدراسة المشروعة إلى علم مجرد موضوعه الكم والعدد، وأبحاث فى أمور الواقع والوجود تعتمد أساساً على الخبرة، وهجومه على الميتافيزيقا المدرسية والذى نتج عنه حصر الفلاسفة فى التحليل. وقد أعلن فتجنشتين فى العشرينيات من هذا القرن أن الفلسفة ليست مجموعة نظريات لكنها نشاط يهدف إلى توضيح الأفكار ولقد تبنى الوضعيون المناطقة موقف فتجنشتين والفروض التى اعتمد عليها "هيوم" فى صورة ما سماه الوضعيون "مبدأ التحقق" الذى صاغه مورتس شليك بقوله "إن معنى قضية ما يقوم فى منهج تحقيقها"(8).
ولكن مع أن التحليل كان شائعاً فى الفلسفة منذ قديم، فإن أنصار الفلسفة التحليلية المعاصرة يتفردون بما يميزهم عن أسلافهم. وإنهم يتميزون بحذفهم للميتافيزيقا من قائمة الكلام المقبول، فهم يحذفون الميتافيزيقا حذفاً تاماً على أساس تحليلاتهم المنطقية للعبارات اللغوية، ثم يتميزون كذلك بتفرقتهم بين قضايا المنطق والرياضة من جهة وقضايا العلوم الطبيعية من جهة أخرى، على حين كان المحللون السابقون يفسرون هذه بما يفسرون تلك كما فعل هيوم نفسه أو يفسرون تلك بما يفسرون هذه كما فعل "مل" حين رد القضايا الرياضية إلى أصول حسية، وفى كلتا الحالتين يكون إشكال، ففى الحالة الأولى ينتهى الأمر بالتشكك فى العلوم الطبيعية ما دامت لا توصل إلى يقين فى الرياضة، وفى الحالة الثانية ينتهى الأمر بجعل قضايا الرياضة احتمالية لا يقينية(9).
ثانيا: التحول اللغوى
تمتاز الفلسفة التحليلية بجملة من الخصائص تميزها عن المدارس الفلسفية الأخرى فى الفلسفة المعاصرة ومنها:
1- فكرة مركزية اللغة بالنسبة للفلسفة، إذ يعتقد الفلاسفة التحليليون أن قضايا الفلسفة يمكن فهمها جيداً عن طريق العناية باللغة. وهذا الاتجاه نحو الاهتمام باللغة أصبح يسمى فى العرف الفلسفى " التحول اللغوى "وهو أصدق ما توصف به الفلسفة التحليلية وتعرف فى كلمتين.
2- الاعتماد على المنهج التحليلى سواء اتخذ هذا المنهج صورة التحليل المنطقى أو التحليل اللغوى.
3- احترام نتائج العلم والحقائق التى يسلم بها الحس المشترك، وأخذها بعين الاعتبار عند معالجة المشكلات الفلسفية (10)
ولقد نسب الفيلسوف مايكل داميت Michael Dummett الصيغة الكلاسيكية " التحول اللغوى "إلى فريجه، مؤسس المنطق الرياضى الحديث، حيث قال: "إن موضوع بحث الفلسفة لم يحدد بصفة نهائية إلا مع فريجه، بحيث تبين (1) أن هدف الفلسفة قائم فى تحليل بنية الفكر، (2) وأن دراسة الفكر ينبغى أن تتميز عن دراسة عمليات التفكير النفسية،(3) وأن المنهج الكفؤ لتحليل الفكر يستند إلى تحليل اللغة"(11).
وهذا ما أكده أنتونى كينى Anthony Kenny فى كتابه "فريجه "بقوله: ".. إذا كانت الفلسفة التحليلية قد ولدت عندما حدث التحول اللغوى، فإن ولادتها لابد من أن تؤرخ بنشر كتاب فريجه "أسس الحساب "عام 1984 عندما قرر أن الطريق إلى بحث طبيعة العدد هو تحليل الجمل التى تظهر فيها الأعداد " (12).
كما أكد داميت فى موضع آخر دور فتجنشتين المهم فى هذا الشأن فقال: ".. إذا جعلنا من التحول اللغوى نقطة إنطلاق الفلسفة التحليلية، فإننا، على الرغم من تقديرنا لأعمال فريجه، ومور ورسل التى هيأت الأجواء، لن نستطيع أن نشك فى أن الخطوة الرئيسية نحو هذا التحول خطاها فتجنشتين فى كتابه "رسالة فلسفية منطقية " (13). فقد رأى أن العمل الفلسفى هو فى جوهره توضيحات، حيث قال: "إن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقى للأفكار، فالفلسفة ليست نظرية بل هى فاعلية. ولذلك يتكون العمل الفلسفى أساساً من توضيحات لا تكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية إنما هى توضيح للقضايا. فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح الأفكار وتحديدها بكل دقة وإلا ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة إذا جاز لنا هذا الوصف " (14).
ولقد رأى فتجنشتين أن العمل الفلسفى هو فى جوهره توضيحات وقال: أن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقى للأفكار، فالفلسفة ليست نظرية بل هى فاعلية. ولذلك يتكون العمل الفلسفى أساساً من توضيحات لاتكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية إنما هى توضيح للقضايا. فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح الأفكار وتحديدها بكل دقة وإلا ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة إذا جاز لنا هذا الوصف(15).
وقد يكون الفيلسوف إير هو أول من لفت الانتباه إلى "التحول اللغوى "، فهو يقول: " إن الفيلسوف من حيث إنه محلل ليس معنياً بالخصائص الفيزيائية التى تتميز بها الأشياء. هدف الفيلسوف هو أن ينظر فى الكيفية التى نتحدث بها عن الأشياء ". أو بعبارة أخرى: "إن قضايا الفلسفة ليست قضايا واقعية، بل هى فى طبيعتها قضايا لغوية. فهى لا تصف سلوك الأشياء المادية، ولا حتى الأشياء العقلية، بل تقتصر على التعبير عن التعريفات أو النتائج الصورية التى تترتب على التعريفات. وكنتيجة لذلك تكون الفلسفة علامة بارزة من علامات البحث المنطقى الخالص " (16).
يؤكد إير ضرورة أن ينحصر دور الفلسفة فى التحليل فيقول: "إذا أراد الفيلسوف أن يثبت صدق ما يزعمه من أنه شريك فى زيارة المعرفة الإنسانية فلا يجوز له أن يحاول وصف الحقائق عن طريق التأمل الخالص، أو أن يبحث عن المبادئ الأولى، أو أن يصدر أحكاماً قبلية عن صحة ما نعتقد فى صدقه على أساس التجربة، بل ينبغى له أن يحصر مجهوده فى التوضيح والتحليل"(17).
إن الفلسفة المعاصرة – بوجه عام- تتخذ من "التحليل" منهجاً وموقفاً ثابتاً فى دراستها للعديد من المشكلات وهى تركز أساساً على "تحليل" الألفاظ والقضايا التى يستخدمها العلماء فى أبحاثهم العلمية واللغة العادية التى يتعامل بها الناس فى حياتهم اليومية. ولذا فإنها تتخذ موقفاً عدائياً من الفلسفة المثالية وتتعصب ضد الميتافيزيقا وتنحاز مع العلم. وهذا ما عبر عنه مور فى مقالته "تفنيد المثالية" the refutation of idealism الذى استهدف فيها دحض مبدأ "الوجود إدراك" باعتباره ضرورياً لكل مثالية، وأيضاً فى مقالته "دفاع عن الحس المشترك". كما راسل وفتجنشتين وفلاسفة الوضعية المنطقية عن هذا المعنى فى مواقفهم التحليلية المختلفة.
أكد مور ضرورة "تحليل" "لغة" "الحس المشترك" لتوضيحها وإبراز عناصرها، وكذلك تحديد معانى المفاهيم الأخلاقية. بل ورأى أن عدم الاهتمام الجاد بالتحليل هو السبب المباشر فى وجود مشكلات فلسفية.. وفى ذلك نجده يقول: "يبدو لى فى علم الأخلاق كما فى كل الدراسات الفلسفية الأخرى أن الصعوبات والخلافات التى يكتظ بها تاريخها إنما ترجع أساساً إلى سبب بسيط جداً هو: أننا نحاول الإجابة عن أسئلة لم نتبين على وجه الدقة معناها أوبدون أن نتبين أى سؤال هو الذى نريد الإجابة عنه. وأنا لا أعرف المدى الذى قد يصل إليه الفلاسفة باستبعادهم مصدر هذا الخطأ Error إذا ما حاولوا أن يكشفوا عن السؤال الذى يسألونه قبل أن يشرعوا فى الإجابة عنه، إذ أن القيام بالتحليل والتمييز عمل بالغ الصعوبة غير أننى أميل إلى الظن أن المحاولة الجادة القائمة على العزم والتصميم تكفى لتحقيق أو ضمان النجاح، وأن كثيراً من أصعب المشكلات وأشدها إثارة للخلافات Disagreements فى الفلسفة سوف تزول لو أننا قمنا فعلاً بمثل هذه المحاولات الجادة، ولكن يبدو أن الفلاسفة بصفة عامة لايقومون فى أغلب الأحوال بمثل هذه المحاولة الجادة، بل هم يحاولون دائماً أن يبرهنوا على أن الإجابة "بنعم أو لا" هى الإجابة الصحيحة عنها، وذلك لأنهم لا يضعون أمام أذهانهم سؤالاً واحداً بعينه بل عدة أسئلة تكون الإجابة عن بعضها بالنفى وعن بعضها بالإيجاب"(18)
ويعترف مور بأن "التحليل" هو من أهم وظائف الفلسفة وأنه يجب أن ينصب على المفاهيم. ولذلك نجده فى رده على الآراء التى عبر عنها لانج فوردLangfrd فى مقالته "فكرة التحليل فى فلسفة مور" يعلن عن خطأ لانج فورد فى افتراضه أن "التحليل الفلسفى" يرتكز مباشرة على التعبيرات اللفظية Verbal Expressions. وبين فى استخدامه لكلمة "التحليل" أنه لا يركز على تحليل التعبيرات اللفظية بل تحليل المفاهيم Concepts أو القضايا propositions. ولعل سبب رفض مور الاهتمام بتحليل التعبيرات اللفظية هو افتراضه أن مثل هذا التحليل سوف يكون نمطياً خالصاً. وعندما يتناول مور تحليل المفاهيم أو القضايا نجد تحليله لا يزيد عن كونه منصباً على ما تعنيه التعبيرات اللفظية.. ولهذا نجده يضع خمسة شروط لتحليل (المفهوم) يجب توافرها ليكون مقبولاً: الأول، لا أحد يمكنه أن يعرف أن موضوع التحليل Analysandum ينطبق على شىء بدون أن يعرف أن عناصر التحليل Analysans تنطبق عليه. الثانى، لا أحد يستطيع أن يثبت أن موضوع التحليل ينطب قعلى شىء بدون أن يثبت أن عناصر التحليل يتم تطبيقها عليه. الثالث، أى تعبير يعبر عن موضوع التلحيل يجب أن يكون مترادفاً مع التعبير الذى يعبر عن عناصر التحليل. الرابع، التعبير المستخدم لعناصر التحليل يجب أن يذكر بوضوح المفاهيم التى لم تذكر بوضوح بواسطة التعبير المستخدم لموضوع التحليل. أخيراً، التعبير المستخدم لعناصر التحليل يجب أن يذكر الطريقة التى ترتبط بها المفاهيم التى يذكرها موضوع التحليل(19). كما يؤكد مور أن الاهتمام الحاد بالحس المشترك واللغة العادية هو مفتاح حل المشكلات الفلسفية وتوضيحها(20).
وطبق رسل كذلك "منهج التحليل" على كثير من المشكلات الفلسفية. وقد استخدمه فى تحليل الموضوعات المادية إلى المعطيات الحسية أو "الأحداث" حيث كان يهدف رد الموضوعات المستدل عليها إلى عناصرها البسيطة التى نكون على ثقة منها بحيث نستغنى عن افتراض تلك الكائنات، ونكتفى بتقرير هذه العناصر، ما دامت تحقق جميع الأغراض التى تحققها تلك الكائنات المفترضة. كما طبقه أيضاً فى تحليل العقل حيث رده إلى مجموعة المظاهر، وهى الأحداث الذهنية بحيث لم تعد هناك ضرورة لافتراضه ككائن(21).
ولهذا يرى اير أن فلسفة التحليل المعاصرة تعد ثور فى تاريخ الفكر الفلسفى(22).
و" التحول اللغوى " Linguistic Turn هو التحول نحو اللغة واتخاذها موضوعاً للفلسفة ؛ وهذا التحول لم يأخذ صيغة واحدة، كما يصوره أنصار الفلسفة التحليلية، وإنما يأخذ فى الحقيقة صوراً متعددة. وأصبحت عبارة " التحول اللغوى " أكثر انتشاراً عندما استعملها رورتى عنواناً للكتاب الجماعى الذى أشرف عليه وكتب له مقدمة نشرت عام 1967. وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات أغلبها لفلاسفة مناطقة وتحليليين، ومنها: "مستقبل الفلسفة " لـ (مورتس شليك)، " التجريبية، السيمانطيقا، والأنطولوجيا " لـ)رودلف كارناب)، " الوضعية المنطقية، اللغة، وإعادة بناء الميتافيزيقا " لـ (كوستاف برجمان)، "التعبيرات النسقية الخاطئة " لـ (جيلبرت رايل) و" معضلة فلسفية " لـ (جون وزدم) و" التقدم السيمانطيقى " لـ (ويلارد كواين) و" الاكتشافات الفلسفية " لـ (ر.م. هير) و" أرامسون ودارنوك " لـ (جون أوستن)، " مدخل إلى اللغة: الكلمات والمفاهيم " لـ (ستيوارت هامبشير)، " تاريخ التحليل الفلسفى " لـ (أرامسون) و" التحليل، العلم، والميتافيزيقا " لـ (بيتر ستروسون).. الخ.
يقول رورتى فى مقدمة كتابه " التحول اللغوى ": " إن الهدف الذى يصبو إليه هذا الكتاب يتصل بتقديم معطيات تمكن من التفكير فى الثورة الفلسفية التى حدثت فى السنوات القليلة الماضية، أى فى الفلسفة اللغوية. وأعنى " بالفلسفة اللغوية " هنا " تلك الرؤية التى تقضى بأن المشكلات الفلسفية يمكن حلها سواء بإصلاح اللغة، أو بالمزيد من الفهم الذى يمكن أن نصل إليه حول اللغة التى نحن بصدد استعمالها " (23). وهو يعرف "التحول اللغوى " بأنه ذلك " التحول الذى اتخذه الفلاسفة فى اللحظة التى هجروا فيها الخبرة بوصفها موضوعاً فلسفياً وتبنوا موضوع اللغة وبدأوا فى السير خلف خطى فريجه بدلاً من لوك " (24).
وأكد رورتى هذا المعنى فى موضع آخر فقال: " لقد اتخذت صورة الفلسفة القديمة والوسيطة " الأشياء " Things منطلقاً لها، واتخذت الفلسفة فى القرون من السابع عشر إلى التاسع عشر " الأفكار " Ideas منطلقاً لها، ويتم توضيح الساحة الفلسفية المعاصرة بواسطة " الكلمات " Words (25). وأضاف رورتى أن النظام المعرفى المسمى حالياً " فلسفة اللغة " له مصدران أساسيان:
المصدر الأول: جملة المشكلات التى عالجها فريجه وناقشها، على سبيل المثال، فتجنشتين فى "الرسالة"، وكارناب فى "المعنى والضرورة ". وهى مشكلات بخصوص معرفة كيفية تنظيم أفكارنا عن المعنى والإشارة بطريقة تمكننا من الإفادة من المنطق الكمى، والحفاظ على حدوسنا عن منطق الجهة، وبصفة عامة، تقديم صورة واضحة ومرضية حدسياً تتشكل من مفاهيم " الحقيقة "، و"المعنى"، و" الضرورة " و" الإسم ". ويسمى رورتى هذه الفئة من المشكلات " موضوع فلسفة اللغة الخالصة "، وهى نظام ليس له شكل معرفى ولا حتى أى علاقة مع معظم الاهتمامات التقليدية للفلسفة الحديثة.
المصدر الثانى: هو المصدر المعرفى، ويتمثل فى محاولة استعادة صورة الفلسفة الكانطية كإطار تاريخى دائم للبحث فى شكل "نظرية المعرفة ". فقد بدأ " التحول اللغوى " كمحاولة لتقديم نزعة تجريبية غير نفسية عن طريق إعادة صياغة الأسئلة الفلسفية بخصوص المنطق. ولقد جرى الاعتقاد بأنه من الممكن الأن، تقديم المذاهب التجريبية والفينومينولوجية ليس بوصفها تعميمات تجريبية – نفسية ولكن كنتائج " للتحليل المنطقى للغة ". وبوجه عام، إن الفعاليات الفلسفية حول طبيعة المعرفة الإنسانية ومجالها (على سبيل المثال ما قدمه كانط من مزاعم معرفية حول " الإله " و" الحرية " و" الأخلاق") يجب أن تقدم من جديد فى شكل ملاحظات أو تعليقات حول اللغة (26).
ويرى رورتى أن " الفلسفة التحليلية " بوصفها صورة من التجريبية قد انطلقت فى عصرنا من أعمال رسل وكارناب – الخ- وأن الفيلسوف إير هو الذى استوعب هذه الأعمال وقام بنشرها وتفسيرها خاصة فى كتابه " اللغة والصدق والمنطق " (1936). حيث قدم من خلاله جملة من الأفكار التى تشكل ما يسمى فى عصرنا " الوضعية المنطقية " أو " التجريبية المنطقية " وهى الأفكار نفسها التى أعادت الابستمولوجيا التأسيسية للتجريبية البريطانية إلى مجراها اللغوى بدلاً من النفسى. وهذه الأفكار تختلف بشكل كبير عن الأفكار التى تشكل الأساس لما يسمى، أحياناً، " فلسفة تحليلية ما بعد الوضعية " – وهى فرع من الفلسفة يقال عنه أنه " أبعد من " أو " تجاوز " للتجريبية والعقلانية (27).
ويقول رورتى: " إن التحول الذى حدث داخل الفلسفة التحليلية منذ بداياتها فى حدود 1950 م، إلى غاية اكتمالها فى سنة 1970م، من الصعب رصده بيسر وتحديده بدقة، فهو يرجع إلى تفاعل معقد لقوى كثيرة صاحبت الفلسفة التحليلية. لكن مع هذه الصعوبة هناك ثلاثة أعمال رئيسية ساهمت فى مسار الفلسفة التحليلية وهى: "معتقدان للتجريبية " لـ (ويلارد فان أورمان كواين) و" بحوث فلسفية " لـ (لودفيج فتجنشتين) و" التجريبية وفلسفة العقل" لـ (وليفرد سيلرز) (28)
ومقال سيلرز، من بين تلك الأعمال الثلاثة، والذى يتصف بالتعقد والثراء، هو أقلها شهرة ومناقشة. فقد أكد مؤرخوا الفلسفة الأنجلوأمريكية أهمية مقال كواين فى إثارة الشكوك حول فكرة " الصدق التحليلى " وكذلك حول فكرة رسل وكارناب القائلة " بأن الموضوع الرئيسى للفلسفة يجب أن يكون " التحليل المنطقى للغة ". كما عملوا على إبراز قيمة مقال فتجنشتين ودوره فى هدم كثيراً من مشكلات الفلسفة التقليدية. ومع هذا، فإنهم لم يسلطوا الضوء بشكل كاف لتقدير دور سيلرز فى هذا المجال. وسيلرز (1912 -1982) بأعماله العديدة ورؤيته الموسوعية والعميقة بتاريخ الفلسفة قد تميز عن كثير من فلاسفة التحليل وعلى رأسهم كواين وفتجنشتين؛ فهو يقول: " إن الفلسفة من دون تاريخ الفلسفة، إن لم تكن عمياء، فإنها على الأقل تكون خرصاء "(29).
والحقيقة أن محاولة رورتى للجمع بين " التجريبية " و"العقلانية" تعتمد أساساً على أفكار سيلرز وخاصة فى كتابه "التجريبية وفلسفة العقل ". وهو الكتاب الذى أشاد به رورتى واعتبره من أكثر الأعمال جاذبية فى عصرنا، ولا يمكن التعرف على مشروع سيلرز الفلسفى من دونه. والفكرة الرئيسية فى هذا الكتاب هى قول كانط: " الحدوس من دون مفاهيم تكون عمياء ". فوجود انطباع حسى، هو فى حد ذاته ليس مثالاً للمعرفة ولا للخبرة الواعية. سيلرز، مثل فتجنشتين المتأخر، وعكس كانط، رأى أن وجود "مفهوم " يعنى " التمكن من استعمال كلمة ". ولذلك فهو يقول: " إن كل وعى بالأنواع، وبالتماثلات، وبالوقائع.. الخ، أى باختصار، كل وعى بالكيانات المجردة – بل حتى كل وعى بالجزئيات هو " عمل لغوى". ومذهبه الذى سماه " النزعة الاسمية السيكولوجية" Psychological Nominalism يوضح – كما يرى رورتى – أن لوك، وباركلى، وهيوم كانوا مخطئين فى اعتقادهم أننا " ندرك أنواع محددة.. وذلك ببساطة بفضل وجود أحاسيس وصور(30).
و" النزعة الأسمية السيكولوجية " عند سيلرز مبنية على أسلوب فتجنشتين فى كتابه "بحوث فلسفية "، والذى أكد ارتباط المعرفة بالممارسة الاجتماعية.. وتؤدى إلى تضييق الخلاف، بل والجمع بين توجهات " العقلانيين " و" التجريبيين " (31).وذلك من خلال توسط اللغة ومعالجة المشكلات الفلسفية بالرجوع إليها.. يقول سيلرز: " إن التحكم فى اللغة هو الشرط الضرورى لكل خبرة واعية " (32).
ويقسم رورتى فلاسفة العقل واللغة إلى قسمين: فلاسفة ذريين Atomists وفلاسفة كليين Holists ؛ وهؤلاء جميعاً يرون أن أهم ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات هو العقل واللغة. وقد زادت حدة الخلاف بين الفريقين منذ نشر كتاب " مفهوم العقل " لـ " رايل "، و" بحوث فلسفية " لـ " فتجنشتين "، و" التجريبية ومفهوم العقل " و" معتقدان للتجريبية " لـ " كواين ". فقد شك فتجنشتين فى منطلق النظرية النسقية للمعنى، وسخر كواين من القول " بوجود كيانات تسمى (معانى) مرتبطة بالتعبيرات اللغوية"، وشك رايل فى تصورات علم النفس التجريبى، وسار سيلرز على نهج فتجنشتين بقوله إن ما يميز البشر هو قدرتهم على التخاطب مع بعضهم البعض، وليس امتلاكهم حالات عقلية داخلية متماثلة بشكل ما مع حالات بيئتهم (33).
وبعد أن تربى رورتى فى أحضان الفلسفة التحليلية، وتمرس على آلياتها سرعان ما تمرد عليها وانتقدها بعدما اكتشف إخفاقاتها المتنوعة.
ثالثا: نظرية الأوصاف عند رسل
يعد رسل B. Russell من أهم رواد " مدرسة كمبردج Cambridge school وهى مدرسة تحاول إقامة لغة مثالية كوسيلة أفضل من اللغة العادية للتفكير الفلسفي، وتعرف هذه اللغة عند رسل بـ " اللغة الكاملة منطقياً" lofically perfect language..... وفي ضوء تصور رسل لهذه اللغة المثالية يقول، عن فلاسفة اللغة العادية، في أكثر من موضوع، إنهم قوم ينشغلون بالأشياء التافهة التى يقولها البلهاء، وهذا أمر قد يكون مسليا لكنه ليس مهما. وينتهى رسل إلى أن المأخذ الوحيد الذى يؤخذ على الفلسفة التحليلية هو أنها أدت إلى أمثال هذه الاتجاهات اللغوية المتطرفة حيث أصبحت الفلسفة معنية أكثر بفهم نفسها، وتنكرت للمهمة التى اضطلعت بها الفلسفة منذ طاليس وطوال عهودها، وهى مهمة فهم العالم.(34)
أما " نظرية الأوصاف" theory of descriptions فقد حظيت، منذ عرضها رسل، باهتمام كثير من المفكرين، سواء من قاموا بتفسيرها، والتعليق عليها، والدفاع عنها، أم من اعترضوا عليها وكشفوا عن قصورها. ونجد ذلك عند إير A.J.Ayer في مقالة "نظرية الأوصاف"، ومور G.E. moore في مقالة " نظرية الأوصاف عند رسل"، كواين V.O.Quine في مقالة "التطور الانطولوجى عند رسل"، رامزى F.P.Ramsey في كتابة "أسس الرياضيات"، وهوايت A.White في مقالة "، معنى نظرية الأوصاف عند رسل"، جرام M. Gramفي كتابة " الانطولوجيا ونظرية الأوصاف، مقالات عن برتراند رسل"، ماكس بلاك M.Black في مقالة " فلسفة اللغة عند رسل"، هوشبرج H. Hochberg في مقالة " الدليل الانطولوجى عند أنسلم ونظرية الأوصاف عند رسل "، وبورجمان A. Borgmann في مقالة " نظرية الأوصاف المحددة عند رسل".. الخ. يضاف إلى ذلك تحليلات بعض المفكرين العرب لهذه النظرية في كتاباتهم أمثال، د. زكي نجيب محمود في كتابة " برتراند رسل، سلسلة نوابغ الفكر الغربي "، د. محمد مهران في كتابة " فلسفة برتراند رسل "، د. يحيى هويدي في كتابة " ما هو علم المنطق"، د. زكريا إبراهيم في كتابة "دراسات في الفلسفة المعاصرة" الجزء الأول، د. على عبد المعطي في كتابة " أسس المنطق الرياضي وتطوره" ود. ماهر عبد القادر في كتابة " المنطق الرياضي "... الخ.
والآن: إذا كانت نظرية الأوصاف" قد لاقت قبولاً لدى كثير من المفكرين، وتعددت نواحى البحث فيها، فماذا تعنى هذه النظرية ؟ وما أهدافها ؟ وما أهم منطلقاتها أو الظروف التى أدت برسل إلى التفكير فيها
تلك هى المشكلة التى نركز عليها، ونحن إذ نسترشد بالدراسات المختلفة حول هذه النظرية ونتأمل نصوص رسل ومواقفه المختلفة حولها نستطيع أن نبحث مسألتين أساسيتين، تتعلقان بجوانب نظرية الاوصاف
جوانب نظرية الأوصاف عند رسل:
عرض رسل نظريته في الأوصاف في مقالات وكتب مختلفة منها: مقال " في الدلالة " نشرة لأول مرة عام (1905) في مجلة "العقل "، كتاب " مبادئ الرياضيات" الجزء الأول عام (1910)، مقال "المعرفة بالإدراك المباشر والمعرفة بالوصف" عام (1911)، كتاب "مشكلات الفلسفية" عام (1912)، مقال طبيعة المعرفة بالإدراك المباشر" عام (1914)، محاضراته عن " فلسفة الذرية المنطقية" عام (1918)، كتاب "مقدمة للفلسفة الرياضية" عام (1919)، كتاب "بحث في المعنى والصدق" عام (1940) وكتاب "تطورى الفلسفى" عام (1959).. الخ. وعندما نقرأ ما قدمه رسل فى هذه الأعمال نلحظ أن نظريته في الأوصاف ذات جانبين أساسيين: جانب منطقي وجانب ابستمولوجى.
1- الجانب المنطقى:
يلزم في تفسيرنا لنظرية الأوصاف أن نفكر في العلاقات بين الألفاظ والأشياء. وإذا كان من الواضح أننا لا نستطيع أن نتحدث عن أى شئ بدون استعمال ألفاظ، فإنه من الواضح أيضا أن ما نتحدث عنها ليست هى الألفاظ نفسها التى نستعملها، وعندما لا تشير الألفاظ، بطريقة ما، إلى أشياء فإن هذه الألفاظ، قد تكون عقيمة أو مضللة. والوسيلة أو الوسائل التى بها تشير الألفاظ إلى الأشياء لها أسماء عديدة في الكلام العادى، وفي المنطق مثل: التسمية naming، المعنى meaning، المغزى signifying، المفهوم connotation، الماصدق denotation.. الخ. والفكرة التى نريد إبرازها، أنه لا توجد جملة لها أى استعمال ما لم نفهم ما تشير إليه الألفاظ، ولذلك يركز المنطق جل اهتمامه على التمييز بين أنواع الألفاظ المختلفة وفقا للتمييز بين أنواع الأشياء المختلفة التى تشير إليها.(35)
ومن أهم هذه التمييزات المألوفة التمييز بين الحدود الشخصية أو الفردية singular terms والحدود العامة General Terms. والحد الشخصي هو ما يشير دائما إلى فرد واحد أو شئ معين مثل "سقراط"، " محمد " و"أحمد"، ومن أمثلة الحدود المفردة "أسماء الأعلام" proper names، وأما الحد العام فيشير إلى فئة معينة أو الخاصة التى تميز أفراد الفئة جميعا مثل "إنسان" و"حصان" ويمكننا تفسير العبارات أو الحدود سواء ما يطلق منها على مسمى واحد أو مسميات كثيرة تشترك في صفات تجعلها أعضاء في فئة واحدة. ولكن تواجهنا دائما مشكلة في تفسيرنا كثير من العبارات مثل " الغيلان هى حيوانات خرافية" و"ليس هناك ملك لباتاجونيا". ففى الحالة الأولي (وفي ضوء الفحوى العادى للكلمة) لا نجد شيئا يسمى "غول" أو ما يشكل "فئة الغيلان"، إذ ما الذى تشير إليه كلمة " غول" ؟، وفي الحالة الثانية، إذا لم يكن هناك ملك لباتاجونيا، فكيف يمكن أن يكون للحد الفردى " ملك باتاجونيا" أى إشارة ؟.(36)
والمشكلة هنا، في الحالة الأولى، أننا لم نقابل في الواقع شيئا يسمى "غول"، وكيف يمكننا أن نفهم ما نقوله عن هذا الكائن في الوقت الذى ننكر وجوده؟. ومفتاح حل هذه المشكلة يكمن في ألفاظ "تقابلت بـ" فعندما أقول أننى تقابلت بشئ ما، فأنا لا أعنى أننى قد سمعت من يتحدث عنه، أو أن هناك دليلاً على أنه غير موجود، ولكن أعنى أن لدى بالفعل اتصالاً به في خبرتى الخاصة. وكل هذه العبارات هى أسماء لعلاقة بسيطة يسميها رسل " المعرفة بالإدراك المباشر" وهذه العلاقة، وإن كان يصعب تحديدها، فإن المرء يستطيع أن يوضحها بطرح أمثلة. فأنا عندما أقابل مباشرة شيئا جزئيا تتكون لدى معرفة فعلية عنه عن طريق حواسى، ومعرفة مباشرة عن صفاته كاللون الأحمر مثلاً، وتتكون لدى معرفة عن بعض العلاقات مثل "أكبر من" أو "مساولـ". لكن كيف فهمنا ما قصدناه بلفظ "غول" على الرغم من أنه لا يوجد من البشر من التقاه ؟ لأننا بهذا اللفظ فهمنا (على الأقل عن طريق المعجم) أنه حيوان ما له جسم حصان، وقرن مستقيم وسط جبهته، وذيل أسد... الخ. ومع أن أحدا لم يلتق " الغول" مباشرة إلا أننا ندرك مباشرة تلك الصفات المختلفة المسماه في هذه الكلمة، ويمكن استعمال الألفاظ للإشارة مباشرة إليها. ولذلك فإن العبارة "لا يوجد غول" تساوى ببساطة العبارة "لا يوجد شئ له هذه الصفات" وهى جسم حصان، وقرن مستقيم وسط جبهته.. الخ، وبهذا نقف على أعتاب "نظرية الأوصاف".(37)
وقبل عرضنا لهذه النظرية يجب الإشارة إلى أن المشكلة الخاصة بالكائنات التى لا وجود لها في الواقع مثل "العنقاء"، و"الغول" و"المربع الدائرى" كانت محور اهتمام بعض الفلاسفة السابقين أمثال المنطقي الألماني "ألكسيوس مينونج" Alexius Meinong (1953- 1921).. فقد اعتقد "مينونج" أن لكل فكرة نمتلكها أو نتحدث عنها موضوعاً يقابلها، سواء أكان هذا الموضوع عبارة عن (1) موضوع حقيقي، أم (2) موضوع ضمنى أو مثالى كالعدد والعلاقة، أم (3) موضوع خالص pure object يستحيل وجوده مثل "المربع الدائري" و"الجبل الذهبى".(38) إذن للوجود درجات منها ما هو وجود حقيقي ومنها ما هو وجود ضمني ومنها ما هو وجود خالص.
ولكن هذه الأشياء التى توجد ضمنياً وأمثالها إذا دخلت في قضايا سليمة التركيب من الناحية اللغوية فإنها تشير إلى وجود منطقي وتصبح " موضوعات منطقية"؛ فقضية: "الجبل الذهبي غير موجود "قضية حملية، وعبارة " الجبل الذهبي" موضوع حمل حقيقي فيها، ويشير إلى شئ حقيقي على الرغم من أنه ليس شيئاً محسوساً لأنك إن قلت إن "الجبل الذهبي غير موجود " فإنك تكون قد أصدرت حكما على شئ ما بعدم وجوده، ومن الواضح أن هنالك شيئاً لتقول عنه إنه غير موجود هو الجبل المكون من ذهب. فهذا الجبل إذن ـ لابد أن يكون من ذهب وأن يكون موجوداً ضمنياً في عالم أفلاطونى تكتنفه الظلال، وإلا كان حديثك عن "الجبل الذى من ذهب غير موجود" ليس بذي معنى.(39)
وقد ظل رسل يشارك "مينونج" معظم أفكاره أول أمره، ولكنه راجعه مواقفه بعد ذلك وانتقد نظريته، ولذلك نجده يقول: "أعترف بأن هذه النظرية كانت تبدو لي مقنعة حتى بدت لى نظرية العبارات الوصفية".(40) كما أنه قد احتفظ في كتابة "أصول الرياضيات" (1903) ببعض المبادئ الخاصة بمذهبه الواقعي لكنه رأي بعد نشر هذا الكتاب مباشرة أن مذهبه الواقعي قد يؤدي إلى نوع من التناقض مثل القضية "المربع الدائري ليس له وجود"، فهذه قضية صادقة وذات مغزى. وعلى الرغم من ذلك فقد اقترح رسل أنه "لو كان هناك شئ معين فإنه سيكون موجوداً بالفعل، فنحن لا نستطيع أن نفترض من أول لحظة وجود شئ وبعد ذلك ننكر وجوده نفسه". فكيف يمكن أن نتحدث عن أشياء إذا لم يكن لها وجود إطلاقاً بأى معنى. وبالتخلي عن هذا المذهب وضع رسل مشكلته الخاصة بتحليل القضايا التى تتضمن رموز الموضوعات غير الحقيقية والمتناقضة ذاتياً، وهذا التحليل الذى يتعلق بإحساسنا القوى بالواقع ويتيح لنا الحديث عن هذه الموضوعات الزائفة أو " شبة ـ الموضوعات " pseudo-objects التى يمكن معرفتها. وقد توصل رسل إلى حل لهذه المشكلة من خلال " نظرية الأوصاف".(41)
وإذا كانت هذه النظرية كما وصفها فرانك رامزى F.Ramsey في كتابة أسس الرياضيات " تمثل "نموذج الفلسفة " paradigm of philosophy.(42) ما العبارات الوصفية التى تشكل هذه النظرية ؟ وما العوامل التى تجعل منها نموذجاً للفلسفة ؟ لقد استخدم رسل لفظ "الأوصاف" بمعنيين فنيين مختلفين في مواضع مختلفة من كتاباته أحدهما استخدمه في كتابه " برنكبيا ما ثماتيكا" (1910) والآخر في عملين تاليين له هما "مقدمة للفلسفة الرياضية" ومحاضراته حول "فلسفة الذرية المنطقية".(43)
وهو يوضح لنا هذين المعنيين فيقول إن الوصف قد يكون أحد نوعين: وصف محدد definite description ووصف غير محدد indefinite description. الوصف غير المحدد عبارة عن صورة " كذا وكذا" "so-and so" والوصف المحدد عبارة عن صورة "الكذا وكذا" the so-and so (في المفرد)".(44) وهذا كما يلي:
أـ الوصف غير المحدد:
الوصف غير المحدد هو ذلك الوصف الذى يخبرنا بإبهام مثل: "رجل ما"، "بعض الرجال"، "أى رجل"، "جميع الرجال"، "كل الرجال". فهب أننى "قابلت رجلا" فما الذى أقرره بحق حين أقول إننى "قابلت رجلا" ؟. هبنى صادقا فيما أقول، وأننى في الواقع "قابلت محمداً. فمن الواضح أن ما أقرره "ليس" هو "قابلت محمداً"، فقد أقول "قابلت رجلا ولكنه ليس محمداً" فإننى في هذه الحالة لا أناقض نفسي على الرغم من أننى أكذب وأننى أعنى حقا أننى أكذب، وأن الشخص الذى أحدثه يستطيع أن يفهم ما أقوله حتى ولو كان غريبا ولم يسمح قط عن "محمد".(45)
ولكننا قد نذهب أبعد من ذلك، فنقول إن محمدا ليس هو وحده الذى لا يدخل في عبارتى، بل لا يدخل فيها أى موجود بالفعل أيضا، وهذا يتضح عندما تكون العبارة كاذبة، ومن ثم لا يكون هناك سبب آخر لوجود محمد في القضية أكثر من أى فرد آخر. وبالفعل ستظل العبارة ذات مغزى، على الرغم من أنها لا يمكن أن تكون صادقة حتى ولو يكن هناك أى إنسان فعلى.(46)
بهذا يوضح رسل أن عبارتى "قابلت رجلا" وقابلت محمداً" ليستا متساويتين، ويكفى لبيان ذلك ملاحظة أننى قد أكون صادقا في العبارة الأولي، وكاذبا في العبارة الثانية؛ إذ ربما أكون قد قابلت رجلا لكن هذا الرجل لم يكن هو محمد. كما أن قولى "قابلت رجلا" لا يعنى أننى قابلت فعلا فردا بذاته من الناس.. والدليل على ذلك أننى قد أقول "قابلت غولاً" أو "قابلت عنقاء" ويكون لقولى هذا معناه على الرغم من أنه ليس هناك في عالم الأشياء الملموسة غول حقيقي أو عنقاء حقيقية لأنها كائنات من تصوير الخيال. وما يدخل في القضية ليس إلا تصور "الغول" أو "العنقاء". ففى حالة الغول ليس هناك إلا التصور التالي: لا يوجد في أى مكان شئ غير واقعي يمكن أن يسمى "غولاً"، وبالتالى فإن قولى "قابلت غولاً" له معنى (رغم أنه كاذب)، إذ من الواضح أن هذه القضية لا تحتوى على مكون الغول في مكوناتها ولا تشير إلى شئ أو مسمي واقعي في عالم الأشياء على الرغم من أنها تحتوى على التصور "غول".(47)
فأنا حين أقول "قابلت رجلا" فإنما أعنى بكلمة "رجل" مجموعة من صفات تنطبق على هذا وذاك من أفراد الناس، فهى أوصاف عامة، أتصورها بالذهن، ولو لم يكن هناك الفرد الذى تنطبق عليه. إذ الأمر هنا لا يزيد ولا يقل عن الأمر في العبارات التى تتحدث عن كائنات خيالية كالغول والعنقاء.. وعلى ذلك فالمراد بالعبارة الوصفية العامة (غير المحددة) هو المدرك العقلي لا الافراد الحقيقيون الواقعون في عالم الأشياء. كما يتضح وجه الشبه، ويتضح وجه الاختلاف، بين عبارة تتحدث عن شئ حقيقي وأخرى تتحدث عن شئ خيالي وهمي، فكلتا العبارتين تكون مفهومة للسامع على حد سواء، فلا فرق من حيث الفهم بين أن أقول: "قابلت رجلاً" أو أن أقول "قابلت غولاً" ـ إذا كان للغول صفات معلومة محدودة ـ لكن تعود العبارتان فتختلفان من حيث إن للأولي أفراداً في عالم الواقع، وأنها قد تصدق على أي فرد منهم، وأما الثانية ـ فعلي الرغم من أنى قد أفهم معناها ـ فليس في عالم الواقع أفراد تصدق على هذا أو ذاك منهم.(48)
لكن إذا كان الأمر كذلك فما مصدر الحديث عن كائنات ليست بذات وجود فعلي مثل "الغول" والعنقاء" و" المربع الدائري" ؟. لقد ذهب رسل في شرحه لهذه المسألة إلى أن مصدر افتراض كائنات وهمية هو أن معظم المناطقة انخدعوا بالنحو وتناولوا هذه المشكلة من منطلق خطأ. ذلك أنهم اعتبروا الصورة النحوية grammatical form مرشداً أوثق في التحليل مما هى عليه في الواقع، ولم يدركوا تلك التمييزات المهمة في الصورة النحوية. فالقول "قابلت محمداً " و" قابلت رجلا" عندهم من صورة نحوية واحدة، ولكنهما في الواقع من صورتين مختلفين تماماً: فالأولي تسمى شخصاً بالفعل وهو "محمد" على حين أن الثانية تتضمن دالة قضية propositional function وتصبح عندما يصرح بها كما يأتي: "الدالة قابلت س، س إنسان صادقة أحياناً وبتعبير آخر: "قابلت رجلاً" دالة قضية لا قضية وتحليلها هو {"قابلت س "،" س إنسان" دالة تصدق على فرد واحد على الأقل}.(49)
ويعتقد رسل أن الافتقار إلى جهاز دوال القضايا هو الذى أدي بالعديد من المناطقة إلى النتيجة القائلة بأن هناك أشياء غير واقعية. فلقد زعم "مينونج" مثلاً أننا يمكن أن نتحدث عن "الجبل الذهبي" و" المربع الدائري"، وما إلى ذلك، وأننا نستطيع أن نقرر قضايا صادقة هذه الأشياء موضوعاتها وبالتالي فلابد أن يكون لها نوع ما من الكيان المنطقي وإلا ستكون القضايا التى ترد فيها عديمة المعنى.(50)
وهناك سبب آخر مهم يفضح المغالطة التى أدت بالفلاسفة إلى استعمال تلك العبارات التى تقرر الوجود الضمني وهو عدم الالتزام بالواقع. وهذا ما يوضحه رسل بقوله: "يبدو لي أنه في مثل هذه النظريات هناك عجز عن ذلك الإحساس بالواقع الذى يجب أن نحافظ عليه حتى في أكثر النظريات تجريداً.. فالمنطق لا ينبغي أن يسمح بوجود غول أكثر مما يسمح به علم الحيوان، ولو أن المنطق يبحث في ملامح العالم الأكثر عمومية وتجريداً. والقول بأن للغيلان وجوداً في أخبار الفروسية أو الأدب أو الخيال هروب من الحقيقة يرثي له ولا أهمية له. ذلك أن ما يوجد في الفروسية ليس حيواناً مكوناً من لحم ودم، يتحرك ويتنفس بذاته، بل الموجود صورة أو وصف في ألفاظ ويشبه بذلك القول بأن هاملت مثلا يوجد في عالمه الخاص، نعنى عالم خيال شكسبير، كما وجد نابليون مثلا في عالمنا العادى، هو أن نقول شيئاً يدعو إلى الخلط عن قصد أو أنه شديد الخلط إلى حد لا يكاد يصدق".(51)
وهذا الخلط يرجع إلى وجود عالم واحد هو العالم الواقعى، وخيال شكسبير جزء منه، والأفكار التى وردت في ذهنه عند كتابة هاملت واقعية، وكذلك الأفكار الموجودة عندنا عند قراءة الرواية، ولكن من جوهر الخرافة أن تكون الأفكار والمشاعر وغير ذلك في كتابات شكسبير وعند قرائه واقعية دون أن يكون ثمة، بالإضافة إلى ذلك هاملت خارجى. وأنت إذا أخذت في الاعتبار جميع المشاعر التى أثارها نابليون في الكتاب والقراء في التاريخ لن تكون قد لمست الرجل بالفعل، ولكن في حالة هاملت فأنت تقتحمه في الصميم. ولو أن أحداً لم يفكر في هاملت ما بقي منه شئ، أم لو أن أحداً لم يفكر في نابليون لعهدنا على الفور إلى أحد بذلك.(52)
وإذن فالذين يستنتجون من مجرد تحدثنا عن كلمات دالة على أوصاف عامة، وجود كائنات تكون بمثابة المسميات لتلك الكلمات ـ كما فعل مينونج ـ قد أخطأوا لخلطهم بين القضية ودالة القضية، إنهم تصوروا أن قولنا "قابلت غولاً" قضية، وإذن فهى حديث عن شئ ما، وإذن فلابد أن يكون لذلك الشئ نوع من الوجود المنطقي، وإلا لخلت القضية من معناها، مع أن العبارة التى من هذا القبيل، أى العبارة التى تتحدث عن كلمة دالة على أوصاف عامة، هى دالة قضية، لا تتحدث عن شئ، ولا تتحول إلى قضية متحدثة عن شئ إلا إذا أحللنا اسم علم مكان الكلمة ذات المعنى الكلي. وهذا ممكن في مثل قولى "قابلت رجلا" ـ بأن أجعلها "قابلت العقاد" ـ وغير ممكن في مثل قولي "قابلت غولاً". ومن ثم كانت العبارة الأولي مشيرة إلى فرد ما من أفراد الوجود الواقعي، على حين أن الثانية لا تشير إلى أحد.(53)
ما الفرق بين وجود "هاملت" ـ وهو شخص خيالي في الأدب ـ وبين وجود "نابليون" ـ وهو شخص حقيقي في التاريخ ؟ ـ إن كلا منهما قد ورد اسمه في مجموعة عبارات مكتوبة في الكتب، لكن الأمر في حالة هاملت ينتهى عند حد هذه العبارات المكتوبة. أما في حالة نابليون، فقد كان في عالم الأشياء ـ بالإضافة إلى العبارات المكتوبة ـ كائن من لحم ودم يمشي ويحارب ويخطب في الناس. وهكذا قل في العبارة التى تتحدث "رجل" والأخرى التى تتحدث عن "غول". فلكل منهما معنى يفهمه السامع، وإلى هنا يتشابهان، لكنهما يعودان فيختلفان في أن الأولي يمكن تحويلها إلى قضية عن فرد معين له اسم معروف، أما الثانية فتقف عند حد فهم معناها. بعبارة اصطلاحية: الأولي دالة قضية يمكن تحويلها إلى قضية، والثانية دالة قضية لا يمكن تحويلها إلى قضية.(54)
وما يحافظ على سلامة فكرنا هو اللجوء إلى الواقع ولهذا يقول رسل: "إن الإحساس بالواقع أمر حيوى في المنطق، وأيا كان من يتلاعب بالواقع زاعما أن لهاملت نوعا آخر من الواقعية إنما يسئ إلى الفكر. إن الإحساس القوى بالواقع ضروري جداً لإجراء تحليل صحيح للقضايا التى تدور حول الغيلان، والجبال الذهبية، والمربعات الدائرية، وغير ذلك من الموضوعات الزائفة أو شبه الموضوعات".(55)
واستجابة للإحساس بالواقع سنصر عند تحليل القضايا على عدم السماح بشئ " غير واقعي". لكن إذا لم يكن ثمة شئ غير واقعي فكيف "يمكن" أن نسمح بشئ غير واقعي؟. الجواب عن ذلك عند رسل هو أننا في بحث القضايا إنما نبحث أولاً رموزاً symbols، وأننا إذا نسبنا مغزى لمجموعة من الرموز لا مغزى لها فسنقع في خطأ الاعتراف بموضوعات غير واقعية على المعنى الوحيد المحتمل لهذا المصطلح نعنى كأشياء موصوفة، ففى القضية "أنا قابلت أحد الغيلان" نجد أن مجموع الألفاظ الأربعة معا تكون قضية مفيدة، ولفظة " الغول" لها على حدتها مغزى كالمغزى نفسه للفظة " رجل". ولكن اللفظتين "أحد الغيلان" لا يكونان مجموعة تابعة لها معنى مستقل بذاته. فإذا نحن نسبنا بالباطل معنى لهاتين اللفظتين لوجدنا أنفسنا نمتطى ظهر "أحد الغيلان"، فنواجه مشكلة ترجع إلى كيفية وجود مثل هذا الشئ في عالم ليس فيه غيلان. ذلك أن "أحد الغيلان" وصف غير محدد لا يصف شيئاً، إنه ليس وصفاً محدداً يصف شيئاً ما غير واقعي. وهذه القضية من مثل " س غير واقعية" إنما يكون لها معنى عندما تكون "س" وصفاً، محدداً أو غير محدد، وفي هذه الحالة ستكون القضية صادقة إذا كانت " س" وصفاً لا يصف شيئاً. ولكن سواء أكانت "س" وصفا يصف شيئاً ما أم لا يصف شيئاً فهى على أيه حال ليست من مكونات القضية التى ترد فيها. فهى كالحال في " أحد الغيلان" ليست مجموعة تابعة لها معنى مستقل بذاته. وكل هذا ينشأ عن أنه عندما تكون " س" وصفاً، فإن " س غير واقعية" أو "س ليست موجودة ليست لغواً، ولكنها ذات مغزى في بعض الأحيان، وقد تكون صادقة.(56)
ولكن كيف يتم تحليل القضايا المحتوية على أوصاف غير محددة ؟ والجواب عن ذلك هو أن هذا التحليل يتم ـ في اعتقاد رسل ـ باللجوء إلى جهاز دوال القضايا. فلو أردنا أن نقول قولاً عن "كذا وكذا" فإننا نقوله في الواقع عن الموضوعات (أو القيم) التى لها الخاصية هـ، أى عن الموضوعات التى تكون دالة القضية هـ س صادقة بالنسبة لها، فلو كانت " كذا وكذا" هى " إنسان" مثلا، لكانت هـ س هى " س إنساني"، وهذا يعنى أن تقرير شئ عن الرجل سوف يكون تقريراً عن القيم المتعددة التى لها الخاصية هـ. أما لو أردنا أن نقرر أن "كذا وكذا" له خاصية ما، لكان ذلك يعنى أن هناك موضوعاً أو أكثر س له الخاصية هـ ـ التى هى كذا وكذا ـ له أيضاً خاصية أخرى ط. ومن الواضح هنا أن القضية القائلة أن " كذا وكذا " له الخاصية ط ليست من الصورة ط س (التى قد تعنى قابلت رجلا) لأنها لو كانت كذلك لكانت كذا وكذا متطابقة مع س. وبالتالي لكانت العبارة الوصفية تعنى موضوعاً، وهذا ما يريد رسل أن يتجنبه، وعلى ذلك فإن القول بأن موضوعاً ما له الخاصية هـ له الخاصية ط يعنى أن التقرير الخاص هـ س ليس كاذباً دائماً.(57)
ويرتبط هذا التحليل للقضايا التى تحتوى على أوصاف غير محددة بتعريف " الوجود" existence. فقد ذهب رسل إلى أننا نقول " الناس موجودون" men exist أو " يوجد رجل " a man exists إذا كانت دالة القضية "س إنسان" صادقة أحيانا، وبوجه عام يوجد " كذا وكذا " إذا كانت " س هى كذا وكذا" صادقة أحياناً. ويمكن أن نضع هذه المسألة في عبارة أخرى. فالقضية " سقراط هو إنسان" لا شك تكافئ "سقراط هو إنساني" ولكنها ليست القضية نفسها بالضبط. ذلك أن " هو is " في " سقراط هو إنساني" تعبر عن علاقة الموضوع subject بالمحمول predicate، أما " هو " في "سقراط هو إنسان" فإنها تعبر عن التطابق. لقد كان من المشين للجنس البشرى أن يختار استعمال اللفظة نفسها " هو is " لهاتين الفكرتين المختلفتين تمام الاختلاف، وهو أمر مشين تعالجه بالطبع لغة المنطق الرمزى. فالتطابق في " سقراط هو إنسان" تطابق بين شئ مسمى(بفرض أن سقراط اسم يقبل جملة من الأوصاف) وبين شئ غامض الوصف. والشئ الغامض الوصف " سيوجد" عندما تكون على الأقل إحدى مثل هذه القضايا صادقة. أى عندما توجد على الأقل قضية واحدة صادقة من الصورة " س هى كذا وكذا " حيث "س " اسم.(58)
ومن مميزات الأوصاف الغامضة (في مقابل الأوصاف المحددة) أنه قد يكون هناك أى عدد من قضايا الصادقة من الصورة السابقة: سقراط إنسان، أفلاطون إنسان.. الخ. وهكذا فإن "إنسان موجود" تلزم عن سقراط أو أفلاطون أو أي شخص آخر.(59)
ب ـ الأوصاف المحددة:
تعد "نظرية الأوصاف المحددة" عند رسل من أبرز الأمثلة التى يمكن ذكرها للفوائد الناتجة عن مواجهة اللغة العادية باللغة الاصطناعية. فلا تزال هذه النظرية تعبر عن "روح فلسفة اللغة المثالية" the spirit of ideal language philosophy وذلك لأنها صممت لحل بعض مفارقات اللغة العادية عن طريق تفسير البنية المنطقية للمفارقات، وهذه البنية ـ كما يدعي رسل ـ مضمرة في اللغة العادية.(60) وقد نشأت هذه المفارقات من عبارات في اللغة العادية تبدو وكأنها تؤدي وظيفة " أسماء الأعلام" proper names والتى يمكن إدراكها من صورتها " الكذا وكذا " حيث إن " كذا وكذا " تشير إلى حد شخصي.(61) وتبدو هذه العبارات وكأنها تصف كينونة معينة محددة وبالتالي تسمى " أوصاف محددة ".(62)
ولتوضيح هذه الأوصاف بحث رسل أداة التعريف " ال" (في المفرد)، ورأي أن إحدى النقاط المهمة جداً حول تعريف " كذا وكذا " أنه ينطبق على " الكذا والكذا " سواء بسواء. والتعريف المنشود هو تعريف قضايا ترد فيها هذه العبارات لا تعريف العبارة ذاتها على حدة. وفي حالة " كذا وكذا" هذا واضح بما فيه الكفاية: فلا أحد يستطيع أن يزعم أن " رجل " كان شيئاً محدداً (معرفاً) يمكن أن يحدد بذاته. فنحن نقول "سقراط إنسان"، "أفلاطون إنسان" و"أرسطو إنسان" ولكننا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن "إنسان" يعنى الأمر نفسه الذى يعنيه سقراط، وكذلك الذى يعنيه أفلاطون، والذى يعنيه أرسطو، ما دامت هذه الأسماء الثلاثة لها معان مختلفة. ومع ذلك، فإننا بعد أن نحصي جميع الناس في العالم، لا يبقي شئ يمكن أن نقول عنه " هذا إنسان"، وليس هذا فقط، ولكنه " ال" إنسان، ذلك الشئ بالذات الذى هو بالضبط إنسان غير محدد دون أن يكون أي " شخص بالذات". ومن الواضح، بالطبع، أن كل ما هو موجود في العالم فهو محدد: فإن كان إنساناً، فهو إنسان واحد محدد لا أى إنسان آخر. وبذلك لا يمكن أن يوجد مثل هذا الشئ مثل " إنسان " في العالم في مقابل الناس المعينين. وتبعا لذلك من الطبيعي أننا لا نحدد " إنسان" نفسه، بل نحدد فقط القضايا التى يرد فيها.(63)
ومن الأمثلة المهمة التى ذكرها رسل ليوضح المشكلات المتعلقة بالعبارات العادية ما يلي: أراد الملك جورج الرابع أن يعرف ما إذا كان " سكوت" هو مؤلف ويفرلى". والآن: فإن " سكوت" و" مؤلف ويفرلي" متطابقان أي أنهما يدلان على الشئ نفسه. فالاسم "سكوت" والوصف المحدد " مؤلف ويفرلي" يمكن استخدامهما بطريقة تبادلية أي يمكن أن نقيم تطابقاً تاماً بينهما عندما يشيران إلى كينونة واحدة. ففى الجملة:
1- جورج الرابع أراد أن يعرف ما إذا كان " سكوت" هو " مؤلف ويفرلي". يجب أن نستبدل " سكوت" بـ " مؤلف ويفرلي". وهذا يؤدي إلى الجملة التالية:
2- جورج الرابع أراد أن يعرف ما إذا كان "سكوت" هو "سكوت". ولكن نتيجة هذا التبديل أن العبارة الثانية غير متطابقة مع العبارة الأصلية، لأنه من الصحيح أن جورج الرابع أراد أن يعرف ما إذا كان " سكوت" هو "مؤلف ويفرلي". ولكن، بطبيعة الحال، فإن أحداً من الناس لم يكن ليريد أن يعرف ما هو صادق وبديهي وهو أن "سكوت هو سكوت".
والسؤال هو: أين يوجد الخطأ ؟ أين المشكلة في هذا المثال ؟. يري رسل أن الخطأ يوجد في افتراض أن الوصف المحدد له المعنى نفسه الذى يوجد للاسم وهو الإشارة إلى الكينونة بالتسمية أو الوصف. وهذا الافتراض الخاطئ نشأ من الصورة التى يتخذها الوصف المحدد في اللغة العادية. فتحليل " وصف محدد عادى" وتحويله إلى لغة معبرة منطقياً سيوضح أن " الاسم " و"الوصف المحدد" غير متكافئين ولا يمكن استبدال أحدهما مكان الآخر.(64)
لكن ما هو التحليل المنطقي الملائم للوصف المحدد عند رسل؟. يطالب رسل بضرورة أن نفسر، منذ البداية، بطريقة أكثر دقة، التمييز بين " الأسماء" و"الأوصاف المحددة" لأن فشلنا في معرفة هذا التمييز هو أساس المشكلة برمتها.(65) وهذا كما يلي:
1- الاسم رمز بسيط simple symbol معناه شئ ما يمكن أن يرد فقط بوصفه موضوعاً، أى يشير مباشرة إلى الفرد الذى يكون هو معناه، وهذا المعنى يخصه هو ويكون مستقلاً عن جميع المعاني الأخرى. أما "الأوصاف المحددة" فتفتقر إلى هذه التلقائية والفورية لأنها تكتسب معانيها بطريقة معقدة وتابعة لأشياء أخرى تظهر عندما نعكسها على الصورة العامة للسياقات التى قد ترد بها هذه الأوصاف.(66)
والرمز البسيط رمز ليست له أجزاء هى رموز. وهكذا فإن "سكوت" في القضية "سكوت مؤلف ويفرلي" رمز بسيط، فمع أن له أجزاء (هى الحروف المنفصلة) إلا أن هذه الأجزاء ليست رموزاً. ومن جهة أخرى "مؤلف ويفرلي" ليست رمزاً بسيطاً لأن الألفاظ المنفصلة التى تؤلف العبارة مركبة من أجزاء هى رموز. وإذا كان، بحسب الحالة، ما يبدو " فرداً " قابلا حقا للتحليل أكثر من ذلك، فينبغي أن نقنع بما قد نسمية " الأفراد النسبيين" relative individuals، وهى حدود terms. وبالتوفر على مشكلتنا الراهنة أى الخاصة بتعريف الأوصاف، فهذه المشكلة يمكن تجاهلها سواء أكانت الأسماء مطلقة أم نسبية فقط، ما دامت المشكلة تتعلق بمراحل مختلفة في سلم " الأنماط" حيث يجب علينا المقارنة بين هذه الأزواج مثل " سكوت" و"مؤلف ويفرلي" وكلاهما ينطبق على الشئ نفسه، ولا يشير مشكلة الأنماط.(67)
لدينا إذن أمران علينا أن نقارن بينهما (1) الاسم الذى هو رمز بسيط والذى يدل مباشرة على فرد هو معناه، ويكون هذا المعنى له من حقه مستقلاً عن معانى سائر الألفاظ الأخرى. (2) الوصف الذى يشتمل على ألفاظ عدة معانيها ثابتة من قبل، وينشأ عنها أى شئ ـ تأخذه كمعنى للوصف. (68) فالاسم رمز تام بينما الوصف المحدد رمز ناقص. نسمى الرمز تاما حين يفيد معنى تاما في ذاته ولا يعتمد فهمنا له على كلمة أخرى تعطيه معنى، وأسماء الأعلام جميعها من هذا النوع. لكنا نسمى الرمز ناقصاً إذا لم يعط في ذاته معنى تاما وإنما يكتسب هذا المعنى في سياق معين، ومن ثم فالوصف المحدد رمز ناقص. "مؤلف ويفرلي" وحدها تثير معنى ناقصا لا يتم، لأن قراءتنا لها أو سماعنا إياها يثير عدة أسئلة مثل: من هو ؟ أو ماذا تريد أن تقول عنه ؟ وقد نكف عن هذه الأسئلة حين يقال لنا، مثلاً، إن مؤلف ويفرلي شاعر ملهم.(69)
2-الاسم "رمز تام" لأنه يفيد معنى تاما في ذاته ولا يعتمد فهمنا له على لفظة أخرى تعطيه معنى، بينما الوصف "رمز ناقص" incomplete symbol ليس له معنى في ذاته وإنما يكتسب معنى إذا دخل في سياق قضية، فجملة "مؤلف ويفرلي" رمز ناقص وليست اسم علم وذلك لثلاثة أسباب هى:
أ- هى ليست رمزاً بسيطاً تدل على شئ جزئي، أو شخص بعينه متحقق في الخارج بل هى رمز مركب.
ب- يمكن تحديد معناها بمعرفة معانى الألفاظ التى تتكون منها بصورة منفصلة عن بعضها، بينما معنى اسم العلم لا يمكن تحديده بمعانى الألفاظ ولكن عن طريق معرفتنا لما يشير إليه هذا الاسم أو يدل عليه.
جـ- لو كان الوصف المحدد "اسم علم" لكانت القضية "سكوت مؤلف ويفرلي" إما أنها (تحصيل حاص) أو غير متصلة في صدقها بكل الوقائع الموجودة في العالم (والتساوي عندما نقول "سكوت" هو "سكوت")، أو كاذبة (إذا كان "مؤلف ويفرلي" يدل على أي شئ آخر لا يتصل بسكوت"). ولكن القضية إخبارية (أى ليست تحصيل حاصل) وصادقة تعبر عن واقعة في تاريخ الأدب.(70)
3- القضية التى تشتمل على وصف ليست متطابقة مع ما تصير إليه تلك القضية عند استبدال اسم حتى إن كان الاسم يسمى الشئ نفسه الذى يصفه الوصف. فقولنا "سكوت مؤلف ويفرلي" من الواضح أنها قضية مختلفة عن "سكوت هو سكوت" فالأولي حقيقة واقعة في تاريخ الأدب، والثانية تحصيل حاصل. ولو أننا وضعنا أي شخص آخر مكان "مؤلف ويفرلي" لكانت قضيتنا كاذبة، وما بقيت عندئذ القضية نفسها. ولكن قد يقال إن قضيتنا هى أساسا من نفس الصورة كالقضية (مثلاً) "سكوت هو سير ولتر" حيث فيها اسمان يقال أنهما ينطبقان على الشخص نفسه.(71)
وجواب رسل عن ذلك أنه إذا كانت "سكوت هو سيرولتر" تعنى حقا الشخص المسمى "سيرولتر" فالأسماء إذن مستعملة كأوصاف؛ أى أن الفرد بدلاً من تسميته فهو موصوف على أنه الشخص صاحب ذلك الاسم، وهذه طريقة كثيراً ما تستعمل فيها الأسماء عادة، ولن يوجد ـ كقاعدة ـ شئ في الصياغة اللفظية يبين هل هى مستعملة على هذا النحو أو على أنها أسماء. وعندما يستعمل الاسم مباشرة للدلالة فقط على ما نتحدث عنه، فهو ليس جزءا من "الحقيقة المقررة" أو من الخطأ إذا ما حدث وكان تقريرنا كاذب: فهو جزء من الطريقة الرمزية التى بها نعبر عن فكرنا. وما نريد أن نعبر عنه شئ يمكن أن نترجمه إلى لغة أجنبية، وهو شئ تكون الألفاظ بالنسبة له أداة دون أن تكون جزءا منه.(72)
ويرى رسل، من ناحية أخرى، أننا عندما نعقد قضية عن "الشخص المسمى سكوت"، فالاسم الواقع بالفعل وهو" سكوت" يدخل فيما نقرره، وليس فقط في اللغة المستعملة لعمل التقرير. والآن ستصبح قضيتنا مختلفة لو استبدلنا "الشخص المسمى " سيرولتر"، فلا مدخل لذلك فيما نقرره تماما كالحال إذا تحدثنا الإنجليزية أو الفرنسية سواء بسواء. وبالتالى فما دامت الأسماء تستعمل كأسماء فإن "سكوت هو سيرولتر" هى القضية التافهة نفسها مثل "سكوت هو سكوت". وهذا يكمل الدليل القائل بأن "سكوت مؤلف ويفرلي" ليست القضية نفسها كتلك التى تنشأ عن استبدال اسم مكان "مؤلف ويفرلي" مهما يكن شأن الاسم الذى نستبدله.(73)
4- إن الاسم كما هو واضح هو ما يسمى به شخص من الأشخاص، وهو تعسفي تماماً، فليس في طبيعة الأشخاص ما يجعل من الضروري أن يسمى كل شخص باسم بعينه دون غيره من الأسماء، أما "سكوت" فقد كان "مؤلف ويفرلي" في وقت لم يكن أحد يسميه بهذه الطريقة، بل حين لم يكن أحد قد عرف ما إذا كان هو سكوت أم غيره فكونه مؤلف ويفرلي كان واقعة فيزيقية، وهى أنه جلس على مكتبه وكتبه بيده، ولم تكن لهذه الواقعة علاقة بما كان يسمى به، وهذا أمر ليس تعسفيا بأي حال من الأحوال فليس لنا الخيار في أن نسميه مؤلف ويفرلي أولا نسميه، لأنه في واقع الأمر اختار أن يكتب هذا الكتاب، وهذا ما يفسر كيف أن "مؤلف ويفرلي" شئ مختلف تماما عن الاسم.(74)
5- وهناك تمييز آخر بين "الاسم" و" الوصف المحدد" ينطلق من تحليل رسل للعبارة الوصفية المحددة عن طريق لغة " دالة القضية". ولتوضيح ذلك يجب الإشارة إلى معنى القضية وأنواعها والفرق بينها وبين دالتها في فكره.
فهناك محاولة مهمة لوضع تمييز ثلاثي بين الجملة sentence والعبارة statement والقضية proposition، والمقصود بالجملة ـ وفقاً لهذا التمييز ـ هو أية سلسلة من التعبيرات expressions الكاملة والصحيحة نحوياً في لغة طبيعية. ومثال ذلك: "الثلج الأبيض"، أغلق الباب" و"هل الباب مغلق" ؟.. أما العبارة فهى ما يقال عندما تنطق الجملة الإخبارية أو تكتب. وفي الاستعمال غير الإصطلاحي للعبارة، نراها غامضة بين الحدث الخاص بالنطق أو الكتابة الخاصة بالجملة ومضمون ما ينطق أو يكتب. والمغزي الثاني هو الملائم في تحديد العبارة.. وأما القضية فهى ما يكون مشتركاً بالنسبة إلى مجموعة من الجمل الإخبارية المترادفة. وبهذا المغزي للقضية تعبر الجملتان عن القضية نفسها إذا كان لهما المعنى نفسه.(75)
ونجد رسل في كتابة المهم "بحث في المعنى والصدق" يميز بين الجملة والقضية بقوله: "إن القضية هى شئ ما يمكن أن يقال في أية لغة: "سقراط فإن "socrates est mortal، socrates is mortal،" قولان يعبران عن القضية نفسها. وربما يقال ذلك في أية لغة معلومة بطرق متعددة: فالاختلاف بين "قتل فيصر في الخامس عشر من مارس" و"كان الخامس عشر من مارس هو يوم مقتل فيصر" هو في الأساس اختلاف بلاغي. ومن ثم يمكن أن يكون لصورتين من الألفاظ "المعنى نفسه" the same meaning. ونستطيع أن نعرف القضية بأنها "جميع الجمل التى لها المعنى نفسه الذى يكون لجملة معلومة.. أما الجملة فهى "عدد من الألفاظ توضع معاً وفق قواعد دراسة المركبات اللغوية.(76)
ويقول رسل في عبارة أخرى:"يمكننا أن نعرف القضية بأنها "ما تدل عليه الجملة"، وإن كان بعضها ليست لها دلالة معينة.. ولكن إذا ما وجدت هذه الدلالة لأية جملة لكانت هذه هى المقصود بالقضية".(77)
كما أن القضية ـ وفقاً لرسل ـ هى الجملة الإخبارية التى تحتمل الصدق والكذب، ومن ثم فإن صيغ السؤال، والتمني، والأمر، والنهي والنداء ليست قضايا، والمقصود باحتمال الصدق والكذب أن القضية تقرر شيئاً أو تنكره، أو أنها تحوى حكماً نعتقد بصدقة أو كذبه. "سقراط فيلسوف" قضية صادقة، "سقراط مؤسس الفلسفة المادية" قضية كاذبة، لكن ما ذلك الشئ الذي تقرره القضية أو تنكره ؟، لا تقرر القضية شيئاً جزيئاً لأن هذا مما يمكن تسميته أو الإشارة إليه، لا تقريره، تقرر القضايا وقائع facts.(78)
والمقصود بدالة القضية، تعبير غير محدد ليس صادقاً ولا كاذباً، مثل قولنا "س إنسان". وهذا التمييز بين القضية ودالة القضية هو أساس نظرية التضمن theory of implication عند رسل. فهناك كما يقول، نمطين من التضمن: تضمن مادى وهو علاقة بين قضايا، وتضمن صورى وهو يربط بين دوال القضايا.(79)
ويوضح رسل ما يقصده بدالة القضية بقوله: "ليست دالة القضية إلا صيغة لفظية تحتوى متغيراً، وتصبح قضية عندما نعين قيمة للمتغير. فمثلاً "س إنسان" دالة قضية. فإذا وضعنا ـ بدلاً من "س " ـ سقراط أو أفلاطون أو أي إنسان آخر، كان لنا بذلك قضية. على أننا نستطيع أيضاً أن نستبدل بـ "س " شيئاً آخر ليس بإنسان، فيكون لدينا على الرغم من ذلك قضية وإن كانت قضية كاذبة في هذه الحالة. دالة القضية، إذن، ليست سوى صيغة لفظية، وهى بذاتها لا تصف أي شئ لكنها يمكن أن تصبح جزءا من جملة تحمل خبراً صادقاً أو كاذبا. فقولنا "كان س حوارياً " لا ينبئ بشئ. أما قولنا "هناك اثنتا عشرة قيمة لـ "س" يصدق عليها قولنا "س حواري" فهو جملة كاملة".(80)
ويقرر رسل ثلاثة أمور لدالة القضية: (1) أن نستبدل الثابت بالمتغير، فإذا كان لدينا أى دالة من دوال القضايا ـ ولتكن س ـ فإن هناك مدى ينتظم قيم س، وتكون الدالة بالنسبة له ذات دلالة، أى أنها إما أن تكون صادقة أو كاذبة. فإذا كانت " أ " هى أى قيمة من قيم هذا المدى فإن " د أ " تكون صادقة أو كاذبة. (2) أن نقرر كل قيم الدالة، أى نؤكد أنها تصدق علي الدوام مثل دالة القضية "إذا كانت س إنسان، فإن س فأن" هذه صادقة على الدوام. (3) أن نقرر بعض قيمها فحسب أو على الأقل قيمة واحدة من قيمها، أى نؤكد أنها لا تصدق إلا في بعض الأحيان مثل دالة القضية "س إنسان" فهى لا تصدق إلا في بعض الأحيان.(81)
ويتضح لنا ذلك إذا ما نظرنا في تحليل رسل للقضايا التى يرد فيها الوصف المحدد. فهو يرى أن الشي الوحيد الذى يميز "الكذا والكذا" من "كذا وكذا" هو لزوم الانفراد. فلو قلنا "الساكن في لندن" لكان وصفاً محدداً، مع أن هذه العبارة لا تصف في الواقع أى فرد محدد. ولا نستطيع أن نتحدث عن "الملك الحالى لفرنسا" لأنه لا يوجد ملك حالى، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن "الملك الحالي لانجلترا". وهكذا فإن القضايا عن "الكذا والكذا" تستلزم دائماً القضايا المناظرة عن "كذا وكذا" مع إلحاق هذه الإضافة، وهى أنه لا يوجد أكثر من "كذا وكذا" واحد. إن هذه القضية مثل "سكوت مؤلف ويفرلي" لا يمكن أن تكون صادقة لو أن ويفرلي لم تكتب البته، أو لو أن عدداً من الناس كتبها. وكذلك لا يمكن أن تكون أية قضية أخرى تنشأ عن دالة قضية "س" باستبدال مؤلف ويفرلي بدلاً من "س" صادقة. لكننا قد نقول إن " مؤلف ويفرلي " تعنى قيمة س في القضية س كتب ويفرلي، صادقة".(82)
وهكذا فإن القضية "مؤلف ويفرلي كان اسكتلندياً " يمكن تحليلها إلى القضايا الثلاث الآتية:
"س كتب ويفرلي" ليست كاذبة دائماً.
"إذا كان س وص كتبا ويفرلي، كان س وص متطابقين صادقة دائماً.
"إذا كان س كتب ويفرلي، كان س اسكتلندياً صادقة دائماً.
هذه القضايا الثلاث تقرر عند ترجمتها إلى لغة عادية ما يأتي:
شخص واحد على الأقل كتب ويفرلي.
شخص واحد على الأكثر كتب ويفرلي.
أياً ما كان الشخص الذى كتب ويفرلي فهو اسكتلندي.
فهذه القضايا الثلاث جميعها يتضمنها قولنا "مؤلف ويفرلي كان اسكتلندياً". ولا تكفي أية واحدة، ولا أية اثنتين لتفي بالمعنى كله الذى تحمله الجملة الأصلية والعكس صحيح أيضاً. وبالتالي يمكن أن نأخذ الثلاث معاً على أنها تعرف المقصود من القضية " مؤلف ويفرلي كان اسكتلندياً".(83)
ويعبر رسل عن هذه القضايا الثلاث بطريقة أكثر بساطة على النحو التالي: الأولي والثانية معا يكافئان: هناك حد جـ بحيث أن "س كتب ويفرلي" صادقة عندما تكون س هى جـ، وكاذبة عندما لا تكون س هى جـ " بعبارة أخرى: "هناك حد جـ بحيث أن: س كتب ويفرلي "تكافئ دائما " س هى جـ" (تكون القضيتان متكافئتين عندما يكون كلاهما صادقاً أو كلاهما كاذبا) فعندنا هنا بادئ ذي بدء دالتان لـ "س"، "س كتب ويفرلي" و" س هى جـ"، ونكون دالة لـ "جـ" باعتبار تكافؤ هاتين الدالتين لـ " س لجميع قيم س ". ثم نشرع بعد ذلك في تقرير أن الدالة الناتجة عن جـ " صادقة أحياناً" أى أنها صادقة على الأقل لقيمة واحدة لـ هـ (من الواضح أنها لا يمكن أن تكون صادقة لأكثر من قيمة واحد لـ جـ). وهذان الشرطان معا يعرفان بأنهما يعطيان معنى "مؤلف ويفرلي موجود".(84)
وتحليل مثل هذه القضايا التى تحتوى على أوصاف محددة يمكننا من الحديث عن الأشياء المتناقضة بذاتها ولا تقوم في الواقع الخارجي، مثل "الملك الحاضر لفرنسا" أو "المربع الدائري" لأن القضايا الخاصة بها يمكن معالجتها أيضاً على أنها دوال قضايا ذات متغيرات لا موضوعات غير موجودة في العالم الخارجي. (85) لذلك وصل رسل من هذا التحليل إلى دليل آخر على التمييز الأساسي بين اسم العلم والوصف المحدد. فحين نترجم قضية تحوى اسم علم إلى دالة قضية فإن هذا الاسم يظهر في الترجمة الجديدة، أما حين نترجم قضية بها وصف محدد إلى دالة قضية فسوف يختفي هذا الوصف.(86)
ولذلك يرى رسل أن هناك نوعين من السياقات التى توجد بها الأوصاف: الأول يقرر أو ينكر وجود "الكذا والكذا"، والثاني ينسب خاصية أو ينكرها لـ "الكذا والكذا". ومن أمثلة النوع الأول "ملكه إنجلترا موجودة"، ومن أمثلة النوع الثاني "مؤلف ويفرلي كان اسكتلندياً". والنقطة الملحوظة هنا أننا نستطيع أن نعطي كل وصف محدد داخل السياق قضية جديدة تطابق منطقياً القضية الأصلية ـ كما يقول رسل ـ ولكنها لا تشتمل على مجموعة من الرموز التى يمكن أن تسمى "وصف محدد". وبالنسبة للقضية الأولي وهي:
3- ملكة إنجلترا موجودة.
نجد رسل يحللها إلى:
4- هناك فرد واحد وواحد فقط يحكم إنجلترا وهو امرأة.
والقضية الأصلية:
5- مؤلف ويفرلي كان اسكتلندياً.
فإن رسل يحللها إلى:
6- فرد واحد وواحد فقط كتب ويفرلي وأنه كان اسكتلندياً.
ويمكن القول أن (4) صحيحة (أو خاطئة) عندما تكون (3) صحيحة (أو خاطئة). وكذلك الحال مع (6) و(5). ولكن الوصف المحدد لكل من (3)، (5) يختفي عندما يتم تحليل (3) و(5) إلى (4) و(6) وبالتالي فليس هناك أى مجال في (4) و(6) لأن نخلط بين مجموعة رموز واسم. هذا ينطبق بسهولة على لغزنا الحالي، فالجملة (1) تتحول بطريقة ملائمة إلى:
7- أراد جورج الرابع أن يعرف ما إذا كان من كتب ويفرلي وسكوت هو الشخص نفسه. فيبدو أن (7) تحتفظ بالإشارة المتفردة نفسها المميزة لـ (1)، ولكن في ضوء وجود أو عدم وجود كينونة غير محددة (شخص) له جانب من خاصية (كاتب ويفرلي) وله خاصة أخرى (كان هو سكوت)، وبالتالي لا يبدو أنه يوجد أى تضمن أو حتى اقتراح (كما في 1).
أننا نتعامل مع اثنين من الكيانات اللفظية المنفصلة ("مؤلف ويفرلي" و"سكوت") لهما المعني نفسه ويدلان على الشئ نفسه. وبالتالي لا يوجد هناك احتمال في (7) لاحلال كيان لفظي (سكوت) محل آخر (مؤلف ويفرلي)، ومن ثم فلو تحدثنا عن اللغة الموضحة في (1) فإن المشكلة التى بدأنا بها لم يكن لتظهر على السطح.(87)
6- لا يجوز الشك في "وجود" مسمى اسم العلم وجوداً حقيقياً، ويجوز الشك في حالة العبارة الوصفية المحددة. ذلك لأنه إذا لم يكن هناك فرد معين بذاته موجود وجوداً حقيقياً واقعياً لما أمكن ـ من الوجهة المنطقية ـ أن نطلق عليه اسماً. إذ إن الكائن الفرد يوجد أولاً، ثم نطلق عليه اسمه المميز ثانياً. وعليه فعبارة مثل "طه حسين موجود" عبارة لا تزيد في معناها عن قولنا "طه حسين" فقط، إذ يكفي ذكر اسم العلم وحده للدلالة على وجود المسمى وجوداً يملأ الآن ـ أو ملأ فيما مضى ـ لحظات من زمان ومسافات من مكان. وليس الأمر كذلك في حالة العبارة الوصفية المحددة، لأن هناك حالات نصوغ فيها عبارة من هذا النوع، دون أن يكون لها مسمي في الواقع كقولنا "ملك فرنسا الحالي" إذ لا يوجد ملك في فرنسا اليوم.(88)
إذن اسم العلم دال حتما على وجود مسماه أما الوصف المحدد قد لا يكون مسماه ذا وجود فعلي.. فقد نعرف كثيراً من القضايا التى تتصل بـ "الكذا والكذا" دون أن نعرف بالفعل ما "الكذا والكذا" أي دون أن نعرف أية قضية من الصورة "س هى الكذا والكذا" حيث س اسم. فمثلاً نجد في الرواية البوليسية قضايا تتجمع حول "الرجل الذى ارتكب الفعلة" على أمل أنها في النهاية ستكفي لبيان أن "أ" هو الذى ارتكب الفعلة. ومن ثم يحسن بنا أن نحصر اسم العلم في أسماء الإشارة وحدها مثل "هذا" و"ذاك"، إذ لا يعقل أن تشير قائلاً "هذا" دون أن يكون هنالك الفرد المشار إليه. فالقضية "الكذا والكذا" تفيد معنى سواء أكانت صادقة أم كاذبة. ولكن إذا كان "أ" هو "الكذا والكذا" (حيث أ اسم) فاللفظتان "أ موجود" لا معنى لهما.(89)
فالوجود لا يمكن أن يحكم به، بطريقة مفيدة، إلا على الأوصاف فقط، محددة أو غير محددة، لأنه إذا كان "أ" اسما فلابد أن يسمى شيئاً ما: وما لا يسمى شيئاً فليس اسما، وبناء على ذلك إذا قصدنا أن يكون اسما فهو رمز يخلو من المعنى، على حين أن الوصف مثل "الملك الحالي لفرنسا" لا يصبح غير قابل لأن يفيد لمجرد أنه لا يصف شيئاً، وعلة ذلك أنه رمز مركب يشتق معناه من رموزه التى يتكون منها. ومن ثم فعندما نتساءل عما إذا كان هوميروس موجوداً فإننا نستعمل لفظة "هوميروس" كوصف مختصر: ويمكننا أن نستبدله بـ مؤلف الإلياذة والأوديسا"، وتكاد تنطبق الاعتبارات نفسها على كل الاستعمالات لما يبدو شبيهاً بـ "أسماء الأعلام".(90)
وبهذا التمييز الدقيق بين اسم العلم والوصف المحدد، وترجمة القضية التى تحوى أحدهما أو كليهما إلى دالة قضية. ومعنى الوجود في الدالة، استطاع رسل تقديم تحليل صحيح لنوع من القضايا مثل "الجبل الذهبي غير موجود"، "الملك الحاضر لفرنسا أصلع"، وبذلك يكون قد استطاع أن يجد أساسا لرفض نظرية "مينونج" في الوجود الواقعي المنطقي لموضوعات الفكر مستقلا عن العقل الإنساني. يقول رسل إننا إذا أخذنا الوجود بمعنى " الصادق أحيانا وعدم الوجود بمعنى "الكاذب دائما" أمكننا التخلص من إسناد وجود موضوعي لمعنى العبارة الوصفية التى لا تشير إلى واقع محسوس، ومن ثم تصبح "الجبل الذهبى غير موجود" ـ بفضل النظرية الوصفية ـ تعنى "دالة القضية " هـ ذهبي "و" هـ جبل "كاذبة في كل قيم هـ". لقد اختفت هنا عبارة "الجبل الذهبي" ومن ثم لم تعد اسما ولا تشير إلى شئ واقعي بأي معنى من المعانى. وما دامت "الجبل الذهبي" ليست اسما فلن تكون موضوعاً منطقياً في القضية التى ترد فيها وإنما "موضوع حسب مكانه من الجملة" فقط كما لاحظ رسل أن القضية السابقة تخضع لقانون عدم التناقض ـ خلافا لما أعلن "مينونج" ـ لأننا نقرر أن "الجبل الذهبي موجود" قضية كاذبة وأن "الجبل الذهبي غير موجود" صادقة.(91)
ويرتبط هذا عند رسل بتمييزه بين الورود الابتدائي primary occurrences والورود الثانوى secondary occurrences للعبارات الوصفية في القضايا، فهو يرى أن الوصف يكون له ورود ابتدائي عندما تنشأ القضية التى يرد فيها من استبدال س بالوصف في دالة القضية س ويكون له ورود ثانوى عندما لا تعطي نتيجة استبدال س بالوصف من س إلا "جزءا" من القضية المذكورة. ويوضح ذلك المثال التالي:
لو اعتبرنا "ملك فرنسا الحاضر أصلع" نجد "ملك فرنسا الحاضر" لها ورود ابتدائي، والقضية كاذبة. وكل قضية فيها وصف لا يصف شيئاً وله ورود أولى فهى كاذبة. ولكن لو اعتبرنا "ملك فرنسا الحاضر ليس أصلعا" فهذه قضية غامضة. لأننا وحللنا أولا "س أصلع" ثم وضعنا "ملك فرنسا الحاضر" بدلا من س، ثم أنكرنا النتيجة، لكان ورود "ملك فرنسا الحاضر" ثانوياً وتكون قضيتنا صادقة. ولكن لو أخذنا "س ليس أصلعاً" واستبدلنا "ملك فرنسا الحاضر" بـ "س" عندئذ "ملك فرنسا الحاضر" له ورود ابتدائي وتكون القضية كاذبة.(92)
ويؤكد رسل أن الخلط بين الورود الابتدائي والورود الثانوى يعد مصدراً دائما للأغاليط أو المغالطات عندما نتحدث عن الأوصاف.(93)
2- الجانب الابستمولوجي (المعرفي):
لاشك في أن "لنظرية الأوصاف" وظيفة أبستمولوجية epistemological function واضحة (وترتبط هذه الوظيفة ارتباطا وثيقا بوظيفتها المنطقية، بل وتمثل امتداداً لها). فلقد ميز رسل في تحليلة الابستمولوجي بين نوعين من المعرفة: معرفة بالاتصال المباشر knowledge by acquaintance ومعرفة بالوصف knowledge by description. ومن نافلة القول إن "نظرية الأوصاف" تطبق في العلاقة بين هذين النوعين للمعرفة.(94)
وهذا ما أوضحه رسل في الفصل الأخير من كتابة "التصوف والمنطق" والفصل الخامس من كتابة "مشاكل الفلسفة". حيث تحدث عن أربع صور للمعرفة تتعلق بالمعرفة المباشرة التى تقوم على المشاهدة الخاصة بالجزئيات والمعرفة الوصفية التى تقوم على السماع أو القراءة والوصف، وأكد أن العلم بالشئ الموصوف يمكن إرجاعه في النهاية إلى علم بما نحن على معرفة مباشرة به. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أولاً: يعنى رسل "بالوصف" أى عبارة تأتي على صورة "كذا وكذا" أو "الكذا والكذا". ويسمي العبارة التى تأتي على صورة "كذا وكذا" بالوصف الغامض ambiguous description، ويسمى العبارة التى تأتي على صورة "الكذا والكذا" (في المفرد) بالوصف المحدد. ولذلك فإن كلمة "رجل" وصف غامض، و"الرجل ذو القناع الحديدى" وصف محدد.(95)
ونقول إننا نعرف شيئا ما بالوصف حينما نعرف أنه يتضمن "الكذا والكذا" أى حينما نعرف أن هناك شيئا واحداً لا أكثر له خاصية معينة، ويتضمن ذلك، بالطبع، أننا لا نكون على معرفة مباشرة بذلك الشئ نفسه. فنحن نعرف أن الرجل ذا القناع الحديدى موجود، ونعرف قضايا كثيرة عنه ولكننا لا نعرف من يكون هذا الرجل. ونعرف أن المرشح الذى يحصل على معظم الأصوات سوف يتم انتخابه، وفي هذه الحالة نكون على معرفة مباشرة بالمرشح (بالمغزى الذى يمكن أن نكون فيه على معرفة مباشرة بغيرنا من الناس) الذى سيحصل على معظم الأصوات، ولكننا لا نعرف أي هؤلاء المرشحين سوف يكون ذلك الرجل، أى أننا لا نستطيع أن نعرف أية قضية على صورة ("أ" هو المرشح الذى سينال معظم الأصوات) إذا كان "أ" هو أحد المرشحين المعروفين بالاسم. وسوف نقول إن لدينا "معرفة بالوصف فحسب" عن "الكذا والكذا" إذا كنا ـ على الرغم من معرفتنا إن "الكذا والكذا" موجودان، وعلى الرغم من أننا قد نكون على معرفة مباشرة بهذا الشخص ـ نعرف أى قضية عن ("أ" هو الكذا والكذا) حيث إن "أ" شيئا نكون على معرفة مباشرة به.(96)
وحينما نقول "الكذا والكذا" موجود نقصد أن شيئا واحداً فقط هو "الكذا والكذا". فالقضية ("أ" هو الكذا والكذا) تعنى أن "أ" له الخاصية "كذا وكذا" ولا شئ آخر يشاركه في هذه الخاصية. فإذا قيل إن "أحمد هو المرشح لاتحاد العمال في هذه الدائرة الانتخابية" فمعنى ذلك أن "أحمد" هو مرشح اتحاد العمال لهذه الدائرة ولا أحد غيره يشاركه في هذه الخاصية. ولذلك فحينما نكون على معرفة مباشرة بشئ على أنه " الكذا والكذا" موجود في حين أننا لسنا على معرفة مباشرة بأي شئ نعرف أنه "الكذا والكذا" وحتى حينما لا تكون لنا معرفة مباشرة بأي شئ يكون هو "الكذا والكذا".(97)
كما يؤكد رسل أن الألفاظ العامة هى أوصاف على وجه حقيقي. فمعرفتى بالمنضدة كموضوع فيزيقي ليست معرفة مباشرة بل مستدل عليها مما نعرفه عنها معرفة مباشرة وهو المعطيات الحسية.(98)
ثانياً: يرى رسل أن افتراض، عبارة ما قالها أحد الناس عن "بسمارك" مثلاً، وافتراض أن هناك شخصا ما يكون على معرفة بنفسه، وأن بسمارك نفسه كان يستعمل هذا الاسم بشكل مباشر ليعين شخصا جزئياً هو على معرفة مباشرة به. فلو أصدر بسمارك، في هذه الحالة، حكما على نفسه، فلابد أن يكون هو نفسه مكوناً من مكونات الحكم. فلاسم العلم هنا استعمال مباشر بوصفه يدل على شئ معين فقط ولا يدل على وصف لذلك الشئ.(99)
ثالثاً: وأما إذا أصدر أحد أصدقاء بسمارك حكما عليه لاختلف الوضع، لأن ما كان هذا الشخص على معرفة مباشرة به إنما هو معطيات حسية sens – data تتصل (بفرض أنه على صواب في ذلك) بجسم بسمارك وعقله. فجسمه بوصفه شيئاً مادياً، وكذلك عقله يعرفان فقط بوصفهما جسما وعقلاً متصلين بهذه المعطيات الحسية، أى أنهما عرفا بالوصف. أما ما يبدو من صفات عن مظهر شخص ما في عقل صديق له فأمر قائم، بالطبع، على محض المصادفة. ولذلك فإن الوصف الذى يدور في عقل هذا الصديق عندما يفكر في صديقه إنما يحصل عرضا واتفاقا. والنقطة الجوهرية هى أنه يعرف أن الأوصاف المختلفة جميعها تنطبق على الذات نفسها على الرغم من عدم وجود معرفة مباشرة بهذه الذات الحقيقية التى هى موضع البحث.(100)
وأما لو قمنا نحن الذين لا نعرف عن بسمارك شيئا بإصدار حكم عنه، فإن الوصف في عقولنا سيكون، على الأرجح، عبارة عن مجموعة غامضة من المعرفة التاريخية، وهى معرفة تزيد في أغلب الحالات عما نحتاج إليه في تحقيق هويته. فنحن نعرفه مثلاً بأنه "المستشار الأول للإمبراطورية الألمانية" ولكن لا نكون على معرفة مباشرة به فكل الكلمات هنا كلمات مجردة ما عدا كلمة "ألمانيا" فإنها بدورها ذات معان تختلف باختلاف الناس. فقد تحمل بعض الناس على تذكر رحلات قاموا بها في ألمانيا، وقد تحمل بعضهم على تذكر رؤيتها على الخريطة وهكذا. ولكن إذا كان لنا أن نحصل على وصف نعرف أنه منطبق تماماً على الأشياء التى نريد وصفها، فعلينا أن نشير إلى بعض الأجزاء التى نكون على معرفة مباشرة بها. ومثل هذه الإشارة يشملها إي ذكر للماضي، أو الحاضر، أو المستقبل (بإعتبارها مقابلة لتواريخ معينة) كما يشملها أى ذكر لهذا المكان أو ذاك أو ما يكون قد أخبرنا به الآخرون. وعلى ذلك يبدو أن أي وصف نعرف أنه منطبق علي جزئي آخر نكون على معرفة مباشرة به إذا كانت معرفتنا بذلك الشئ الموصوف ليست مجرد نتيجة تترتب منطقياً على الوصف.(101)
رابعا: يرى رسل أن عبارة من مثل "أكثر الناس تعميراً" هى وصف لابد أن ينطبق على شخص ما، ولكننا لا نستطيع أن نصدر أحكاما تتعلق بهذا الشخص تتضمن معرفة به أبعد مما نصل إليه عن طريق الوصف. فإذا قلنا إن "المستشار الأول للإمبراطورية الألمانية كان دبلوماسياً بعيد النظر" فنحن نكون متأكدين فقط من صدق حكمنا اعتماداً على شئ نكون على معرفة مباشرة به هو عادة شهادة الغير التى نصل إليها عن طريق السمع أو القراءة وبعيداً عن المعلومات التى نوصلها إلى الآخرين، أو عما يمكن أن يعرف عن بسمارك الحقيقي مما يجعل لحكمنا أهمية، فالفكر الذى يدور في عقولنا في الحقيقة يحتوى على الجزئي أو الجزيئات الخاصة التى عرضنا لها بالوصف، وفيما عدا ذلك لا يحتوى الفكر إلا على تصورات كلية. فكل أسماء الأمكنة كلندن وإنجلترا وأوربا والأرض والمجموعة الشمسية تشتمل بالمثل على الأوصاف التى تنشأ من واحد أو أكثر من الجزئيات الخاصة التى نكون على معرفة مباشرة بها.(102)
وأنه لا يبدو ـ فيما يرى رسل ـ حينما نقول عبارة حول شئ ما نعرفه ـ بالوصف فقط، أننا نقصد غالباً ألا تكون عبارتنا على صورة تتضمن الوصف، بل نقصد أن تكون العبارة حول ذات الشئ الموصوف. ومعنى ذلك أننا حينما نصدر أى حكم عن بسمارك فإننا نرغب جهد استطاعتنا أن نصدر الحكم الذى يستطيع بسمارك وحده أن يصدره أى الحكم الذى قوامه بسمارك نفسه. ولابد أن نبوء بالفشل في هذا ما دام بسمارك الحقيقي غير معروف لنا. ولكننا نعرف أن هناك شيئاًَ "ب" يسمى بسمارك وأن "ب" هذا كان دبلوماسياً ماهراً. وبهذا التصور نستطيع أن نصف القضية التى نرغب أن نثبتها وهى (لقد كان "ب" دبلوماسياً ماهراً) و"ب" هنا هو الشئ الذى هو بسمارك. والذى يمكننا من التفاهم معا على الرغم من الأوصاف المختلفة التى نستعملها هو أننا نعرف أن هناك قضية صادقة تتعلق ببسمارك الحقيقي، وأننا مهما اختلفنا في الوصف (ما دام هذا لوصف صحيحاً) فإن القضية التى عرضنا لها بالوصف تبقي هى هى. وهذه القضية الموصوفة التى نعرف صدقها هى ما نهتم به في الحقيقة، ولكننا لسنا على معرفة مباشرة بالقضية نفسها، ولا على معرفة بها، ولو أننا نعرف أنها صادقة.(103)
ويتوصل رسل من ذلك إلى أن هناك مراحل مختلفة في الانتقال من المعرفة المباشرة بالجزئيات، فهناك بسمارك للناس الذين شاهدوه وهناك بسمارك آخر للناس الذين عرفوه من التاريخ وهناك المعرفة بالرجل ذى القناع الحديدى، وهناك المعرفة بأطول الناس عمراً. وهذه الصور الأربع أنواع من المعرفة تتدرج في ابتعادها عن المعرفة المباشرة بالجزئيات، فالقضية الأولي أقرب ما يمكن إلى المعرفة المباشرة حينما تتعلق المعرفة بشخص آخر، والقضية الثانية هى أن من عرف بسمارك من التاريخ يمكن أن يقال عنه أنه يعرف (من كان بسمارك) أما في القضية الثالثة فنحن لا نعلم من كان الرجل ذو القناع الحديدي ولو كان في استطاعتنا أن نعلم كثيراً من الأحكام عنه التى يمكن أن نستنتج منطقياً من كونه كان ذا قناع حديدي، أما في القضية الرابعة فإن معرفتنا لا تتعدى الاستنتاج المنطقي من تعريف الرجل. وكما توجد مراتب تصاعدية في الجزئيات توجد أيضاً مثل هذه المراتب في دائرة الكليات، فكثير من الكليات مثلها مثل كثير من الجزئيات نعرفها عن طريق الوصف، وفي حالة الكليات كما في حالة الجزئيات نرى أن العلم بالشئ الموصوف يمكن إرجاعه في النهاية إلى علم بما نحن على معرفة مباشرة به.(104)
ويؤكد رسل أن المعرفة كلها سواء أكانت معرفة بالأشياء أم معرفة بالحقائق تقوم على المعرفة المباشرة كأساس لها. (105) وذلك لأن المبدأ الابستمولوجي epistemological principle الأساسي الذى يلجأ إليه في تحليله القضايا المشتملة على أوصاف هو: "كل قضية نستطيع أن نفهمها لابد أن تتألف برمتها من مكونات نعرفها بالاتصال المباشر".(106)
وعلى الرغم من تأكيد رسل أن ما نقول عنه إنه معرفة بالوصف يمكن تحويله في النهاية إلى معرفة بالاتصال المباشر، إلا أنه يؤمن بأهمية المعرفة بالوصف في التوصل إلى حقائق جديدة. فهو يقول: "إن الأهمية الرئيسية للمعرفة بالوصف هى أنها تساعدنا على أن نمضي إلى ما وراء حدود خبراتنا الخاصة لكى نعرف أشياء أخرى لن ندركها بالخبرة. ولكن على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعلم إلا الحقائق التى تؤلف جميعها من جزئيات وصلنا إلى معرفة مباشرة بها عن طريق خبراتنا فإنا مع ذلك نستطيع أن نصل إلى معرفة بالوصف بأشياء لم تكن قد مرت بخبراتنا".(107)
ولم يكن هذا رأي رسل وحده بل شاركه فيه كثير من الفلاسفة. بل يمكن القول بأن هناك اتفاقاً عاماً على أن "نظرية المعرفة بالوصف" تعد أهم إضافة أسهم بها رسل في ميدان الفلسفة.. فذكر "مور" في هذا الصدد: "لقد كانت نظرية المعرفة بالوصف شيئا جديداً للغاية. إنها أعظم اكتشاف فلسفي قام به رسل، أهم من أي شئ آخر قاله فيما بعد. فهو عمله المجدد الأصيل الذى لم يتأثر فيه بأي إنسان آخر على الإطلاق"(108) وقال "إير":" يبدو لي أن إحدى المزايا العظيمة لنظرية رسل في العبارات الوصفية، هى أنها تلقي ضوءاً على استعمال طائفة معينة من العبارات في حديثنا المألوف. وتلك نقطة لها أهمية فلسفية ذلك لأنه حين بين أن عبارات مثل "الملك الحالي لفرنسا" لا تؤدي وظيفة اسم العلم قد فضح المغالطة التى أدت بالفلاسفة إلى الاعتقاد بموجودات ضمنية".(109)
وإذا كانت "نظرية الأوصاف" عند رسل قد لاقت قبولاً واسعاً لدى كثير من الفلاسفة والباحثين في العصر الحديث، إلا أنها لا تزال مثار مناقشة وهجوم بين عدد آخر من الفلاسفة، ولعل من أبرز الاعتراضات عليها تلك التى قدمها الفيلسوف ستروسون.
***
ا. د. ابراهيم طلبه سلكها
................................
الهوامش
1-H. N. S: "analysis" in "The concise Encyclopedia of Western philosophy and philosophers" ed J. O. Urmsonl، p-2.
2-Ammerman، Robert. R. (editor)Classics of analytic philosophy،TaTa Mc Graw- Hill publishing company LTD. Bombay، New Delhi، 1956 pp. 1-3.
راجع أيضاً د. محمد مهران: دراسات فى فلسفة اللغة، ص ص15-16.
3- Sheldon peterfreund (and others): Contemporary philosophy and Its origins، D van Nostrand company، inc، London 1968 p- 234.
4-Guthrie. W. K. C.: Th Greek philosophers from Thales to Aristotle، Methuen، London، 1987،m pp-104-105.
5- Sheldon p. peterfreund (and others): op- cit، pp- 237- 238.
6-Ayer، A. J. language، truth and logic pp- 70- 72.
7- Ibid، p- 74.
8- Ayer، A.، J: The Central Questions of philosophy، pp- 23- 25.
قارن الترجمة العربية ص ص37- 39.
9- د/ زكى نجيب محمود: مرجع سابق ص ص146- 147.
10- د. صلاح إسماعيل: نظرية جون سيرل فى القصدية، دراسة فى فلسفة العقل، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية – الحولية السابعة والعشرون، مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت، 2007، ص34.
11- Timothy Williamson: Op – cit، pp- 11-12.
12- Anthony Kenny: Frege: An Introduction to the Founder of Modern Analytical philosophy، oxford، Blackwell، 2000، p-211
13-Michael Dummett: Origins of Analytical philosophy، Cambridge، Mass: Harvard university press، 1996، p- 25.
14- لودفيج فتجنشتين: رسالة فلسفية منطقية، ترجمة د. عزمى إسلام، مراجعة د/ زكى نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، 1968، ص ص 36، 37.
15- د/ محمد مهران رشوان: دراسات فى فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 1998 ص37.
16-Alfred Jules Ayer: Language، Truth and logic، Penguin Books، 1936،p- 76.
17- د/ زكى نجيب محمود: موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق ط3 1937 ص21.
18-Moore، E. G: principia Ethica، Cambridge university press 1962، p- vii
19-Ayer، A. J: Russell and Moore، the Analytical Heritage Macmillan، London، 1971 pp- 221- 222.
20-Sheldon p. peterfreund (and others): op. ci p- 252.
21- د/ محمد مهران رشوان: دراسات فى فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 1998 ص37.
22- Ayer، A، J (ed)، The Revolution in philosophy، paperback، London، p-1.
23- Richard Rorty: The Linguistic Turn، Essay in philosophical Method، The University of Chicago press، 1992، p- 3.
24-Richard Rorty: The Linguistic Turn، Essay in philosophical Method، The University of Chicago press، 1992، p- 3.
25-محمد جديدى: مرجع سابق، ص 256.
26- Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature، p-263.
(194) Ibid، pp- 257-258.
قارن د.محمد جديدى: مرجع سابق ص 259
27- Richard Rorty: " Introduction " In " Empiricism and the philosophy of Mind " edited by willforid Sellars، Cambridge، Mass، Harvard University press، 1997، p-1.
28- Ibid، pp- 1-2.
29- Ibid، pp- 2-3.
30- Ibid، pp- 3-4.
31-Ibid، pp- 4-5.
32- Ibid، p- 9.
33- Richard Rorty: Contingency، Irony and solidarity، Cambridge university press، 1995، pp—176 – 180.
لا يوجد، بالطبع، تمييز حاسم بين (مدرسة كمبردج "مور"، "رسل"، "فتجنشتين"، وزدم... الخ) وبين (مدرسة اكسفورد "رايل، أوستن، ستروسون"... الخ) بل لا يوجد اتفاق تام بين أعضاء كل مدرسة على حدة.
34-د. يمني طريف الخولي: "جدل المثالية والواقعية في التصور الانطولوجي عند برتراند رسل"، مقال نشر بمجلة عالم الفكر، صادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد 30- يوليو، سبتمبر ـ 2001، ص12.
35-Dorward، A، Bertrand Russell، A short Guide to his philosophy، longmans، Green and co، London 1951، P-17.
36-Ioc – cit.
37-Ibid، pp-17-18.
38-Fritz، C. A.، Bertrand Russell's construction of External world، routledge and kegan paul Itd، London، 1952، pp-53-54.
39-Russell، B، My philosophical Development، George Allen and Unwin، London، 1959، p-84.
لقد صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان: فلسفتي كيف تطورت، ترجمة عبد الرشيد الصادق، مراجعة د. زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ط1، 1960، والملاحظ أن هذه الترجمة حذفت الجزء الأخير الخاص بردود رسل على النقاد.
انظر أيضا: د. محمود فهمي زيدان: المنطق الرمزى، نشأته وتطوره، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1999، ص ص 233- 234.
40-Ioc – cit.
41-Edwards، p (ed)، the Encyclopedia of philosophy، Macmillan publishing، New York Volums، I and 2، 1967، p-96.
42-Ramsey، F. A، the foundation of Mathematics، kegan paul London، 1931، p-263.
43-Moore، G: "Russell' s Theory of Descriptions" in:
P. A. Schilpp(ed)، the philosophy of Bertrand Russell، the library of living philosopher، Vol. V. London، 1887، p-177.
44-Russell، B، "descriptions" in: Weitz، M(ed)، Twentieth- century philosophy، the Analytical tradition، A division of Macmillan publishing co. Inc New York p. 146.
Sea also:
Russell، B، Introducion to Mathematical philosophy (London: George allen and Umwin، itd، 1919)، chap. 16.
لقد صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان: مقدمة للفلسفة الرياضية ترجمة، د. محمد مرسي أحمد، راجعه، د. أحمد فؤاد الأهواني، مؤسسة سجل العرب، القاهرة.
45-Ioc-cit.
راجع أيضا: د. محمد مهران: فلسفة برتراند رسل، دار المعارف ط3، 1986، ص 283.
46-Ioc-cit.
47-Ibid، pp-146-147.
48-د. زكي نجيب محمود: موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق ط3، 1408هـ، 1987م، ص ص 165- 166.
49-Russell، B، "Descriptions"، p-147.
50-Ioc-cit.
51-Ibid، pp-147-148.
52-Ioc-cit.
53-د. زكي نجيب محمود: مرجع سابق ص ص 168- 169.
54-الموضع نفسه.
55-Russell، B، "Descriptions"، p-148.
56-Ioc-cit.
57-د. محمد مهران: فلسفة برتراند رسل، ص ص 284-285.
58-Russell، B، "Descriptions"، pp-149-150.
59-Ioc-cit.
60-Borgmann، A، the philosophy of Ianguage، Historical foundation and contemporary Issues، Martinus Nijhoff، 1974، pp-99-100.
61-Russell، B، "on Denoting" in: his Iogic and knowledge، Georage Allen and Unwin، 1950، p-93.
62-Borgmann، A،op-Cit. P-100.
63-Russell، B، "Descriptions"، p-150.
64-Borgmann، A،op-Cit. PP-100-101.
65-Ioc-cit.
66-Ioc-cit.
67-Russell، B، "Descriptions"، p-151.
68-Ioc-cit.
69-د. محمود زيدان: المنطق الرمزي، نشأته وتطوره، دار النهضة العربية، بيروت، 1973، ص 238.
70-Edward paul، (ed)، the Encyclo pedia of philosophy، vol. I، pp-98-99.
71-Russell، B، "Descriptions"، p-151.
72-Ibid، pp-151-152.
73-Ioc-cit.
74-د. محمد مهران: فلسفة برتراند رسل ص 288.
75-Haack، Susan، philosophy of logics، cambridge university press، 1978، pp-74-76.
انظر أيضا: د. صلاح إسماعيل: مرجع سابق ص 299.
76-Russell، B، Inquiry into Meaning and truth، George Allen and Unwin (publishers) Itd، 1980 p-12.
انظر أيضا: د. محمد مهران: فلسفة برتراند رسل ص ص 243-244.
77-Ioc-cit.
78-د. محمود فهمي زيدان: المنطق الرمزي، نشأته وتطوره، ص ص 176-177.
79-Passmore، J، A hundred years of philosophy، penguin books، 1968-p-218.
80-Russell، B، My philosophical Development، p-56.
قارن الترجمة العربية للكتاب، ص ص 81- 82.
81-Ibid، p-67.
قارن الترجمة العربية للكتاب ص 97.
82-Russell، B، "Describtions"، p-152.
83-Ibid، p-153.
84-Ibid، pp-153-154.
85-Borgmann، A،op-Cit. Pp-101-102.
86-د. محمود فهمي زيدان: فلسفة اللغة، دار النهضة، بيروت، 1985م. ص18.
87-Borgmann، A،op-Cit. Pp-101-102.
88-د. زكي نجيب محمود: مرجع سابق ص 173.
89-Russell، B، "Describtions"، Pp-155.
90-Ioc-cit.
91-د. محمود فهمي زيدان: المنطق الرمزي، نشأته وتطوره، ص 242.
92-Russell، B، "Describtions"، p-155.
93-Ioc-cit.
94-Fritz، C. A.، op-cit. P-62.
95-Russell، B، Mysticism and logic، Unwin books، London، 1963، p. 156.
96-Ioc-cit.
97-Ioc-cit.
98-د. محمد مهران: فلسفة برتراند رسل ص ص 298- 299.
99-Russell، B، Mysticism and logic، pp-156-157.
100-Ioc-cit.
101-Io-c-cit.
102-Ioc-cit.
103-Ibid، p-158.
104-Ioc-cit.
105-Russell، B، the problems of philosophy، oxford university press، 1959 p-80.
لقد صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان: "مشاكل الفلسفة" ترجمة د. عبد العزيز البسام ومحمود إبراهيم محمد، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ط2.
106-Ibid، p-70.
قارن الترجمة العربية ص 58.
107-Ibid، p-87.
قارن الترجمة العربية ص 69.
108-Moore، G. E، Russell's "theory of description"، p-16.
انظر أيضا الآن وود: برتراند رسل بين الشك والعاطفة ترجمة د. رمسيس عوض، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1404هـ ـ 1984م.
109-Ayer، A، J، language، truth and logic، penguin books، 1963، p-33.
انظر أيضا د. زكي نجيب محمود: موقف من الميتافيزيقا، ص ص 178-179.
ترجع هذه الشهرة أساسا إلى أن مقالة "عن الإشارة" تركز على نقد "نظرية الأوصاف" عند رسل.