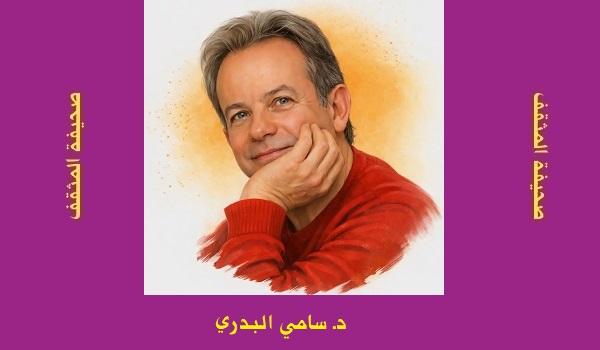حوارات عامة
استعادة اللغة.. الحوار الأخير مع نجوجي وا ثيونجو

قبل وفاته بفترة قصيرة، تحدث الكاتب الكيني لمجلة ذا نايشن عن مجموعته المقالية الأخيرة تحرير العقل من الاستعمار وأفكار ثورية أخرى.
حاورته: رودا فينج
ترجمة الحوار: د. محمد عبد الحليم غنيم
***
مثّلت حياة وأعمال الروائي والكاتب المسرحي وكاتب المقال نجوجي وا ثيونجو بعضًا من أكثر الأسئلة إلحاحًا التي تواجه إفريقيا ما بعد الاستعمار - حول اللغة والذاكرة والعدالة وإرث الإمبراطوريات الثقيل. وكان الكاتب الكيني، الذي كان مرشحًا دائمًا لجائزة نوبل للآداب، قد توفي في 28 مايو/أيار في أتلانتا عن عمر يناهز 87 عامًا، وفقًا لما أعلنته ابنته وانجيكو وا نجوجي.
وُلد نجوجي عام 1938 في كاميريثو، قرية شمال نيروبي، وترعرع تحت الحكم الاستعماري البريطاني خلال ذروة تمرد الماو ماو. انضم أحد إخوته إلى المقاومة، بينما قُتل آخر، وتعرضت أمه للاعتقال والتعذيب. في مدرسة "أليانس هاي سكول" التبشيرية، حيث كان التحدث بلغته الأم "الجيكويو" يعرّض الطالب للضرب، تشرّب نجوجي ما أسماه لاحقًا "مستعمرات العقل" — نظامًا كانت فيه اللغة الإنجليزية ليست فقط لغة التعليم، بل لغة السلطة ذاتها.
درس نجوجي الأدب الإنجليزي في جامعة ماكيريري بأوغندا ثم جامعة ليدز في إنجلترا، حيث بدأ كتابة أعمال روائية تستكشف الآثار النفسية للاستعمار. رواياته المبكرة — لا تبكِ يا طفل (1964)، النهر بيننا (1965)، حبة قمح (1967) — كُتبت بالإنجليزية تحت اسم "جيمس نجوجي"، وأسست مكانته كصوت رئيسي في الأدب الإفريقي الناشئ في منتصف القرن العشرين، إلى جانب كتاب مثل تشينوا أتشيبي ووولي سوينكا. لكن النجاح النقدي لهذه الأعمال أزعجه ومن ثم لن يرضيه. فكما كتب لاحقًا في كتابه نقل المركز (1993): "كنت أعرف عمّن أكتب، لكن لمَن كنت أكتب؟" وكانت تلك التساؤلات بداية لتحول جذري في مساره.
في السبعينيات، ساهم نجوجي في تأسيس مسرح مجتمعي في كاميريثو، وقدّم مسرحية سأتزوج عندما أريد (1977)، التي كتبها بالجيكويو بالتعاون مع نجوجي وا ميري وقام بتمثيلها عمال وقرويون. تلك المسرحية، التي انتقدت نخب ما بعد الاستعمار، مُنعت من العرض، وهدّم المسرح من قبل السلطات، وسُجن نجوجي دون محاكمة. وفي زنزانته، بدأ كتابة روايته الأولى بالجيكويو" الشيطان على الصليب" على أوراق المرحاض. كانت تلك الخطوة تحدّيًا يمثل قطيعة دائمة وحاسمة مع الإنجليزية كلغة أدبية له.
فى عام 1986، نشر كتابًا يجمع بين السيرة الذاتية والنظرية بعنوان تحرير العقل من الاستعمار، وجادل فيه بأن اللغة كانت أداة محورية للسيطرة الاستعمارية، وأن استعادة اللغات الإفريقية ضروري ليس فقط للتعبير الثقافي الذاتي، بل لمقاومة الإرث النفسي للحكم الإمبراطوري. وكما كتب في أحد مقاطع الكتاب الشهيرة: "المدفع يُخضع الجسد، والمدرسة تُسحر الروح."
فى مجموعته المقالية الأحدث، تحرير اللغة وأفكار ثورية أخرى، يطور وا ثيونجو هذا الفكرة الفكري بحيوية وإصرار. ينقسم الكتاب إلى جزأين: يركز الجزء الأول على إنتاج المعرفة في الجامعات، وتأثير العولمة على الأكاديميات الإفريقية، ودور الحكومات في تنمية منظومة للغات الإفريقية (حيث يطالب بإنشاء "مكتب مركزي للغات الإفريقية" في كل دولة إفريقية). أما الجزء الثاني فيضم إشادات وذكريات عن عدد من الكتاب والمفكرين الإفريقيين مثل سوينكا وأتشيبي وجريس أوجوت.
يُحرك الكتاب إصرارٌ على أن اللغة ليست مجرد وسيلة اتصال، بل مستودعًا للمعرفة والهوية — وأن التحرر الحقيقي يبدأ باستعادة الحق في التفكير والحلم والتخيل بألسنتنا/ لغاتنا الأم.
تحدثت ذا نايشن/ The Nation مع نجوجي عبر البريد الإلكتروني الشهر الماضي حول "الإقطاعية اللغوية"، والأمر الرئاسي الأخير الذي وقعه ترامب بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، وأمور أخرى. نُشر هذا الحوار بعد اختصاره وتحريره.
رودا فينج: هناك خيط قوي يربط بين أعمالك تحرير اللغة، وتحرير العقل: سياسات اللغة في الأدب الأفريقي، ونقل المركز: الصراع من أجل الحريات الثقافية، وهو دعوة الكتّاب والمفكرين الأفارقة لإنتاج أعمالهم بلغات شعوبهم. هل تُعتبر هذه الأعمال ثلاثية في نظرك؟
نجوجي وا ثيونجو: لم تُكتب كثلاثية عمدا فى الأصل، لكن يمكن اعتبارها ثلاثية بالمعنى الواسع للكلمة. فمسألة اللغة تحتل مكانة بارزة في الكتب الثلاثة. لكن جوهر قضية اللغة هو قضية المعرفة ذاتها. المعرفة تنتقل دائمًا من هنا إلى هناك في تقدم جدلي يُنير الطرفين، على عكس التعليم الاستعماري الذي يفترض أن المعرفة تسير في مسار أحادي من المركز الإمبراطوري إلى باقي الأماكن/ الأطراف. اللغة هي نقطة البداية لكل معرفة.
رودا فينج: نقدك لـ"الإقطاعية اللغوية" يُعدّ من أبرز إسهامات هذا الكتاب. كيف تتخيل نموذجًا أكثر مساواة للتبادل اللغوي – قائمًا على التكافؤ لا الهيمنة؟
نجوجي وا ثيونجو: كل اللغات مستودعات للمعرفة. فأفضل معرفة بالبيئة تكمن في لغتها الأصلية، لكن اللغات يمكنها أيضًا أن تتبادل المعرفة. الترجمة أعظم وسيلة لحوار اللغات. في كتابي لغة اللغات، وصفتُ الترجمة بأنها "اللغة المشتركة بين كل اللغات"، فهي تتيج الحوار وتشارك المعرفة بين لغات الأرض.
رودا فينج: في كتابك نقل المركز، أشرتَ إلى أن اللغات الأفريقية حُفظت بأكثر أشكالها سحرًا عبر "الأدب الشفوي". كيف ترى الأشكال الأدبية (المسرح، الأمثال، المقال) كمواقع للمقاومة؟ هل هناك شكل لم تجرّبه بعد؟
ن.و.ث.: كنتُ أود الغناء، لكن للأسف صوتي لا يسمح! المغّنون في كل الثقافات يحافظون على حياة اللغات. الغناء جزء من الأدب الشفوي، ولا يحتاج إلى نصوص مكتوبة.
ر.ف: في حوار مع LARB، ذكرتَ أن "المسرح أثّر في حياتي أكثر من الرواية، حتى في حرفتي الروائية. فمسرحية هي التي أوصلتني إلى سجن كاميتي، حيث أعيد التفكير في قضية اللغة وكتبت أول رواية لي بالجيكويو". هناك فصل في كتابك الجديد مخصّص لـ"ولي سوينكا" الذي تسميه "ضمير أفريقيا". هل كان هناك مسرحيون آخرون أثّروا فيك؟
ن.و.ث: يتبادر الى الذهن على الفور ويليام شكسبير وبرتولت بريخت، وكذلك الأيرلندي يوهان م. سينج، والمسرحيون الروس في القرن التاسع عشر مثل تشيخوف. لكني أعترف أنني لم أتابع كل المسرحيين المعاصرين.
ر.ف: هل هناك كتّاب آخرون تراهم "أصواتًا نبوية" لكنهم لم يُدرجوا في مجموعتك؟
ن.و.ث: أعتقد أن جميع الكتّاب هم أصوات نبوة. تأملي الأنبياء في الكتاب المقدس. كانوا بارعين في الكلمات. كانوا يعبرون عن رؤاهم شفهيًا. ولو كانو في عصر الكتابة، لكانوا وثوقوا رؤاهم كتابيا.
ر.ف: في كتابها "سقوط اللغة في عصر الإنجليزية" (2015)، أعربت الكاتبة اليابانية ميناي ميزومورا عن قلقها من أن التقاليد الأدبية واللغات غير الإنجليزية - مثل اليابانية الحديثة - يتم تهميشها تدريجياً بسبب الهيمنة العالمية للغة الإنجليزية. عملك أنت يؤكد أن اللغات الأفريقية لم تُستبدل فحسب، بل جُرّمت ودُفنت تحت أنظمة التعليم الاستعمارية. هل ترى أي تشابه بين عملك وعمل ميزومورا؟
ن.و.ث: أعتقد أن ونستون تشرشل هو من قال إن إمبراطوريات المستقبل ستكون إمبراطوريات لغوية. هيمنة الإنجليزية هي انعكاس للانتشار العالمي للإمبريالية البريطانية والأمريكية، فكلتاهما ناطقة بالإنجليزية.
ر.ف.: كيف ترى الجهود الأخيرة لـ"تحرير" المناهج في الجامعات الغربية من الهيمنة الاستعمارية؟ هل يمكن أن يكون هذا العمل ذا معنى إذا لم يُنفذ باللغات الأفريقية نفسها؟
ن.و.ث.: هذا جيد. الاستعمار يشمل المستعمِر والمستعمَر. التحرر الحقيقي يجب أن يشمل الطرفين. في أفريقيا، مسألة اللغة مركزية في عملية التحرر من الاستعمار. التسلسل الهرمي اللغوي يؤثر على العالم بأكمله.
ر.ف.: قسم كبير من كتابك يدافع عن حيوية لغة الجيكويو. كيف تقاوم تحويل اللغات الأفريقية إلى مجرد تحف في المتاحف، خاصة مع دخول أعمالك إلى مناهج الجامعات العالمية؟
ن.و.ث: أنادي بمساواة جميع اللغات، الكبيرة والصغيرة. اللغات كالكائنات الحية، يجب أن تنمو، لكن النمو يتضمن التخلص من الجلد الميت، ثم تأتي الزهرة التي تحمل مستقبل النبتة.
ر.ف: في مقالة عام 2018 لموقع "ليت هاب"، لاحظ ابنك موكوما وا نجوجي أن "اليوم، يستجيب المزيد من الكتّاب الأفارقة الشباب لنداء نجوجي فيما يُحسنون الاستفادة من عصر الإنترنت... بينما ورث جيلي قلق اللغة الذي عاناه جيل ماكيريري، فإن أعمال مجموعة جالادا تشير إلى جيل أكثر ثقة، غير مثقل بجماليات الاستعمار وما بعد الاستعمار". هل تتفق مع هذا التقييم؟
ن.و.ث: مسألة اللغة تظل محورية في كل هذا. جيل الشباب ما زال غارقا وخاضعا لعقلية المستعمر التي كانت لدى كتّاب جيلي. وعلى الكتّاب الشباب أن يكونوا في طليعة عملية استعادة لغاتنا.
ر.ف: ما الدور الذي يلعبه الإنترنت في نضال تحرير اللغة من الاستعمار؟ هل يتيح مساحة جديدة لازدهار اللغات الأفريقية أم يعزز هيمنة الإنجليزية كلغة للتواصل والحوار العالمية؟
ن.و.ث: على اللغات الأفريقية أن تواكب التكنولوجيا. ومن ثم فإن الإنترنت يمثل ساحة جديدة في معركة التحرر اللغوي.
ر.ف: في كتابك الجديد تكتب: "إذا عرفت كل لغات العالم ما عدا لغتك الأم، فأنت مستعبد/ أسير. أما إذا عرفت لغتك وأضفت إليها لغات العالم، فأنت متمكن/ حر. خيارنا بين عبودية فكرية وتمكين فكري". في ضوء الأمر الرئاسي الأخير الذي وقعه ترامب بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، كيف ترى هذا التوجه؟
ن.و.ث.: هذه سياسة رجعية. كنت أتمنى أن يطلب تعلم إحدى لغات الأمريكيين الأصليين بالإضافة للإنجليزية. سياسة اللغة الواحدة تعيدنا إلى محاولات أوروبا القديمة لفرض هوية أحادية. بينما أمريكا تعيش واقعاً تعددياً.
ر.ف.: وصفت اللغة بأنها "ساحة حرب". كيف تحافظ على التفاؤل الثوري في معركة طويلة الأمد؟
ن.و.ث.: كما قال وليام بليك: "بدون تناقضات لا يوجد تقدم". والفكرة الهيجلية نفسها:
أطروحة > نقيض الأطروحة > التركيب.
ر.ف.: في قصيدة ابنك "صيد الكلمات مع أبي"، هناك بيت مؤثر: "صيد الكلمة هو صيد الحياة". ما الذي يثيره فيك هذا البيت اليوم؟
ن.و.ث.: أتمنى - كما أتمنى لكل كتّاب أفريقيا - أن نصطاد باللغة الأفريقية، بألفاظ أفريقية.
***
.....................
المحاورة: رودا فنج /Rhoda Feng: كتبت رودا فنج عن المسرح والكتب لصحيفة نيويورك تايمز، وملحق التايمز الأدبي، وفور كولومنز، وفريز، وفوج، ونيو ريبابليك، وبافلر.
* نجوجي وا ثيونجو وُلد باسم جيمس نجوجي؛ ( 5 يناير 1938 – 28 مايو 2025) كان كاتبًا وأكاديميًا كينيًا، وُصف بأنه أبرز روائيي شرق أفريقيا وأحد الشخصيات البارزة في الأدب الأفريقي الحديث. بدأ نجوجي كتاباته باللغة الإنجليزية، ثم تحوّل إلى الكتابة بلغة الغيكويو (لغته الأم)، وأصبح من أشد المدافعين عن الأدب المكتوب باللغات الأفريقية الأصلية. تضم أعماله: روايات و مسرحيات وقصصا قصيرة ومذكرات وأدب أطفال ومقالات نقدية تتنوع بين النقد الأدبي والاجتماعي.عُرف نجوجي بمواقفه المناهضة للاستعمار ودفاعه عن الهوية الثقافية الأفريقية. رفض التكريمات الاستعمارية، وغيّر اسمه من "جيمس نجوجي" (الاسم المسيحي) إلى "نجوجي وا ثيونجو" (الاسم الأفريقي) كرمز لرفض التبعية الثقافية. تُوفي في 28 مايو 2025، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا وسياسيًا يُدرس في جامعات العالم، ويظل صوته حيًا في نقاشات التحرر اللغوي والأدب كأداة للتغيير الاجتماعي.