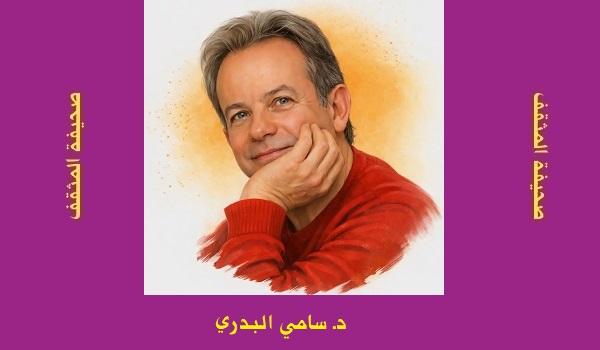آراء
صالح الرزوق: الأفكار والسياسة بين الاجتهاد والتقليد

بدأت الدعوة الوهابية في نجد بالمناداة إلى الإصلاح وتشذيب الدين من البدع والإضافات وتطورت إلى مشروع دولة. ومع الزمن فقدت الحركة زعيمها المؤسس الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذهبت معه الكثير من الثوابت ووجهات النظر. ولكن أثرت على سرديته مجموعة من العوامل التاريخية. من بينها بزوغ فجر عصر التنوير عن طريق الرحلات العلمية، ثم الاتصال بالمستعمر الغربي، وأخيرا شرارة حرب عام 1915. يضاف لذلك التوسع بحركة الاستشراق وعلى وجه الخصوص الفرع الرومنسي. وكانت من أهم أساليبه المبالغة والغموض بهدف التشويق حتى أصبح التاريخ أقرب إلى مروية – وأحيانا مسرودة أو رواية. وفي هذا السياق لم يعد ابن عبد الوهاب شخصا واحدا بل عدة أشخاص يحملون نفس الاسم ابتداء من بطل خارق (ورجل مهام صعبة) إلى نبي يبشر بدين جديد، وحتى قائد إصلاحي يكره التقليد (اتباع أهل الرأي بدون معرفة الدليل). وساعد ازدواج مشروعه على هذا التصور. لكن أعطى الاستشراق الأولوية لنشاطه السياسي. وكما فعل ماسينيون بالمتنبي وصنفه في عداد القرامطة وخلاياهم النائمة، وضع بوركهارت ووليم بلجريف ابن عبد الوهاب في صفوف حركة طليعية تسعى لإخضاع وتوحيد مختلف القبائل ولو بحد السيف1. ورأى كلاهما أن هدفه يتلخص في إسقاط الحكومات المحلية (وإلغاء الاحتفاليات الخاصة والطقوس)، وليس في تبديل أساليب الحياة والإنتاج. وببدو أن الشيخ ابن عبد الوهاب لاقى عدة خيبات أمل. أولاها قبوله بسياسة الأمر الواقع، وتقبل رابطة النسب والدم في إدارة الدولة - وهو قانون عشائري لم يكن من المقدر للعرب أن يتخلوا عنه إلا لفترة بسيطة. وهي السنوات الحاسمة التي تفصل ما بين الهجرة وفتح مكة. ثم عادت الأمور إلى نصابها (وأشير لدخول أفواج من العائلة الأموية في الدولة الوليدة، قبل انقلابهم التاريخي والدموي. وهو ما توضحه دراما تحويل العاصمة من المدينة إلى دمشق. ولا يزال هذا السلوك ساري المفعول وبالأخص في الدول التي تقودها عائلة حاكمة أو أسرة تحتكر الجيش والتجارة). وبالنتيجة قبل الشيخ الإمام بدور الرديف في القتال، إلى جانب إدارة الموارد. وكانت تتلخص بالجباية وغنائم الحرب.
ومع أنه لم يكن لدى الغرب أي سبب لدعم الشيخ الإمام وحليفه، الدولة السعودية الأولى، كان من المنطقي أن يتعاطف معه (بعد تطور الأوضاع) ولثلاثة أسباب.
أولا لأنه أقرب إلى الإصلاح والتحديث من انقلاب القصر الذي قاده الشريف حسين. وكانت بريطانيا أصلا غير مرتاحة لسردية العائلة الهاشمية. فقد تقلب ولاؤهم عدة مرات حسب الظروف.
ثانيا التزام الوهابيين بسياسة القطيعة والالغاء وليس الاستبدال. وادارة جغرافيا منطقتهم. وبدون أي برنامج توسعي2 كما هو الحال لدى الهاشميين. وعلى وجه الخصوص في فترة الدولة السعودية الثالثة. وبدعم مباشر من لورنس العرب وفريق استخباراته. وفي الحقيقة كان لدى الهاشميين مشروع انتقامي بحدين. تعريب الدولة التي خطفها الأتراك، واستعادة الخلافة التي اغتصبها الأمويون.
وثالثا الطبيعة الهجينة للتحالف، والتي يمكن تشبيهها بنشوء المجتمعات الصناعية في الميتروبول الغربي. وهذا يوفر طريقة لعقد تفاهمات بأقل ما يمكن من التكاليف. عدا أنه يقلل من فرصة التماسك وتشكيل خطر حقيقي على طريق الغرب إلى الهند والهند الصينية.
***
ومع أن تصورات الغرب لم تكن واضحة منذ البداية حيال الدولة العثمانية – في الأطراف والمركز- لكنه طور رؤية مرحلية لإشغال العرب مع الأتراك. ثم للتخلص من الأرستقراطية العربية القديمة واستبدالها بالقبائل. وغذت هذه الاستراتيجية النزاعات بين الأحساء وحائل والحجاز. وانقسم المحيط السني بين فئة من الثوار (كانوا مع التصحيح، ومن وجوهها محمد حياة السندي)، وفئات محافظة (حرصت على تقليد الأوائل. ومنهم محمد بخيت المطيعي ويوسف النبهاني وحمدي الجويجاتي الدمشقي).
وإذا كان خلاف الشيخ ابن عبدالوهاب مع من حوله على أساس فقهي، لم يكن يخلو، بنفس الوقت، من أعراض الحرب الباردة. مثل صراع الأجيال (ومن علاماته خلافه مع أبيه وأخيه الأكبر والهرب من بيت الأسرة) ثم الصراع عل النفوذ (وهو السبب الحقيقي وراء مشاحناته مع شيوخ الأحساء ورموز الدولة الخالدية وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن فهد بن عفالق).
ويمكن إجمال كل أوجه الخلاف في الجدول التالي - تمت الاستعانة في رسمه ببرنامج AI 5
ومن الواضح أن الفرق بين التكفير والتشكيك ينجم عن عدة أسباب بعضها له جذور اجتماعية (كالتربية والتنشئة) وما تبقى له جذور سياسية (مثل بنية السلطة ومراكز القرار). ولذلك يحض باحث في الفكر الديني مثل ماجد الغرباوي على فصل النص عن الأحكام. ويرى أن أساس الأحكام في الخبرة (بمعنى التفقه والعلم) ومعرفة أسباب النص أو سياقه وظرفه. وبزوال هذه الأسباب تزول الأحكام. ومثلما توجد أحاديث ضعيفة وصحيحة لدينا أيضا اجتهادات موثوقة (مدعومة بإسنادات قوية) واجتهادات مشكوك بها (منها أحاديث الرجال).
ومع أن ابن عبد الوهاب يعزو للنص في التشريع دورا قطعيا ويرى أنه حاكم وغير محكوم، ولا يمكن تفكيكه، كان ينظر إليه نظرة عاطفية. فهو لا يربطه بالعقل (التدبير)، ولكن بالقلب (النور الإلهي) - انظر كتابه كشف الشبهات والدرر السنية.
في حين يشترط الغرباوي، بالإضافة إلى الفهم، المعرفة التامة بالسياق والأسباب وأساليب التعبير. ويضرب مثالا على ذلك بالجهاد، فمعناه في القرآن أوسع من القتال والحرابة، ويفيد أيضا معنى الإصلاح والبذل – كما في جهاد النفس وجهاد الحجة وجهاد الكلمة. وبالعودة إلى مختار الصحاح للرازي نجد، تحت مادة جهد، أن الجهاد في سبيل الله يعني بذل الوسع والمجهود3. وما يحدد وظيفته المعنى المراد منه، سواء كان منع الظلم أو الدفاع عن سلامة وأمن المسلمين أو نشر الإلهية بين الجميع 4 – انظر الجدول رقم 2 - أيضا تمت الاستعانة ببرنامج AI -5
وفي أعمال الغرباوي ومن بينها موسوعته "متاهات الحقيقة" قراءة للمعنى الرمزي في النص المدون – وأفهم أن التدوين شكل آخر من الإملاء باستعمال الذاكرة وبوجود فاصل زمني عن المصدر. ولذلك يكون النص وثيقة معرفية وأداة هيمنة تتبعها السلطة لحسم الجدل في مصلحتها. وهو ما يرشح النصوص للتأثر بالقبليات – يسميها السعودي عبد الله الغذامي النسق. وهذا يسهل تعريض الدين لمخاطر الجمود، وليكون أداة تبرير وليس عدل وإنصاف. ويقدم لنا الغرباوي ترسانة من المصطلحات التي تحصر أسباب الرؤية المسبقة. وهي 1- الموروث الذي تحول إلى نائب عن الإله أو دكتاتور يمنعنا من استخراج المعنى حسب السياق.
2- التفاوت في الفهم، وهذه خاصية بشرية مفروغ منها.
3- دور السلطة وإيديولوجيتها في تربية العقل المستقيل.
4- الكسل الفكري في ظرف التخلف والضائقة الاقتصادية.
ويضيف الباحث الكويتي أحمد شهاب لما سبق بندا خامسا، وهو ما طرأ على العقيدة من نكبات وما توالى على منطقتنا من حكومات شمولية حرصت على فصل العقائد عن محتواها الإنساني، وباعدت ما بين الفكر والعمل، وجعلت الأفكار تتبع التنظيم وقيادته (أو رجاله)5.
وبالنتيجة لا يمكن تجزئة شخصية الشيخ الإمام واختزالها بجانب واحد. وتداخل الروحي مع المدني، لا يختلف عن تداخل أسباب وأطراف النزاع. ولا يغيب عن ذهني اختلاف الأيادي التي تحرك خيوط الأحداث، من معسكر غربي لديه أطماع استراتيجية، ومجتمع محلي ممزق في ولائه ونسبه. وربما بوحي من هذا التداخل وجدت حركة الاستشراق الرومنسي في صورته ما يغني تفكيرها عن الشرق النائم، والمعزول في دوائر بعيدة عن الأضواء، وما يفيدها في الترويج لسياسة الانتداب والوصاية.
***
د. صالح الرزوق
.................
هوامش:
1- مقالة ناصر التويم "دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرؤية الاستشراقية". مجلة جامعة الإمام. عدد 29. ص321-366.
2- الحياة الفكرية في المشرق العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. إعداد مروان البحيري. بيروت 1983. ص197.
3- ص114 مطبوعات دار الكتاب العربي.
4 - النص وسؤال الحقيقة. منشورات دار الطليعة الجديدة ومؤسسة المثقف العربي. دمشق / سيدني.
5 - الفكر في قبضة التنظيم. ميدل إيست أون لاين (الأربعاء 22 -10 – 2025).