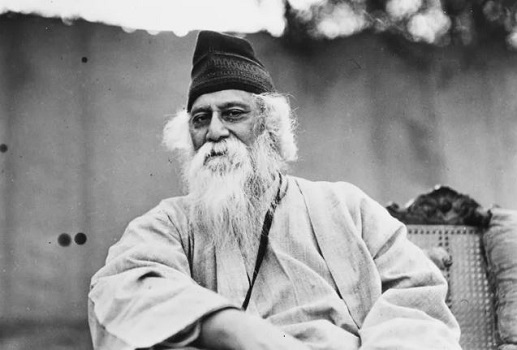قضايا
مصطفى غلمان: في معنى الإعلام وبلاغة الخطاب

سؤال الإبدال الإعلامي الجديد
الإعلام كدرس إبدالي جديد، لا يمكن إلا أن يعيد تأسيس فهومنا الثاوية لبلاغة الخطاب، وتداولياته، وآفاقه الحجاجية والإقناعية. فهو إذ يتعبأ دوما إلى مجاورة المعرفة، وإبلاغها وتبادل خطاباتها، عبر لغة بيانية واضحة متينة كاشفة، تروم إنتاج نص واع ولذيذ، وبعين راصدة منكشفة على العالم وخلفياته الثقافية والاجتماعية والبيداغوجية، فإنه يصحو اليوم على مجموعة تحولات وتفاعلات متحلحلة، بأنساق واستيهامات وأسئلة متقاطعة، تحاول الكشف عن جملةً من الأسئلة المنهجية والمعرفية التي تتمحور حول علاقة الدرس الإعلامي بمجتمع المعرفة وتحولاته السريعة، وسرِّ تغير آليات خطابه في ضوء تطور معطيات تقيس مستويات انتظاراتنا بإزاء ما ذكر، ومدى قدرتنا على مسايرة التحديات، بطفرات الانتقالات المعولمة وجهوزية استقبالنا لها، وعلاقة انخراطنا في تشكيل وعي حافزي لتلقيها واستثمارها.
يشكل هذا المنطق الثقافي لسؤال الإبدال الإعلامي الجديد، امتدادا لتشكيلة انصهار أدوات لغوية وبلاغية وسيميائية ذات صلة، تتوازى في هيكلتها العامة، مع نواظم معرفة الإعلام وإوالياته، حدوده وامتداداته، بل وحضوره الاستدعائي، في روح النص ومعانيه وتجويفاته. وهو ما يضعنا أمام تشكيلة كاملة في منحنيات النص البلاغي أو تحليله الخطابي، والذي تتداخل فيه "معرفة النص" ب" خطاب الصورة" (يمكن أن تكون صالحة للصَّوت المنطوق، والصورة الإشهارية (خاصة عند رولان بارت)، وأنواعها ودلالاتها في مجتمع الإعلام والوساطة الإعلامية، وآليات تحليل الخطاب (الإعلامي)، بفن الإقناع في مكوناته وتقنياته لاستنباط الحجج ومعالجتها وبالمقاربة الحجاجية ذات الحس الإعلامي المتاخم للتصورات التي تستحضرها علامات الكتابة المعلومة في أسئلة البرهان الإعلامي المعلوم بالضرورة:
- من.. من الذي لعب الدور في وقوع الحدث (المعنى المفهومي لتقديم الخطاب الإعلامي)
- متى.. زمن وقوع الحدث (المعنى الإشكالي لتخصيص الزمن الإعلامي)
- أين.. مكان وقوع الحدث (المعنى الرصدي لتقديم وتعبئة الخطاب الإعلامي وخلفياته)
- ماذا.. ماذا حدث (المعني التعبيري الذي يصب في الأسلوبية)
- كيف.. تفاصيل الحدث (المعني الحجاجي الإقناعي الذي يصب في التداولية الإعلامية الحديثة)
- لماذا.. أولويات أو خلفيات الحدث (المعنى التوسيعي لتنويع الخطاب واستجلائه).
يجسد هذا التجاور التحصيلي، نوعا من الارتباط بوظائف بلاغة الخطاب الإعلامي، وتشكلاته الجديدة في مضمار ما تطرحه السيميائيات النصية الحديثة التي قادها الفيلسوف البلجيكي شاييم بيرلمان ومواطنته لوسي أولبيرخت تيتيكاه والروسي غريغوري بيرلمان خصوصا فيما يتصل ببلاغة الصورة وبعدها الحجاجي الإقناعي . أو ما تتقاطع بإزائها مع مدلولات النص المنظور، على اعتبار تحديد خطابه واستدعائه وتصنيفه، وهو ما يوازي في الصميم والعمق، تحميل الخاصية الخطابية الإعلامية هذا التحول في بيانه وتبيانه. وأستحضر هنا قولة شهيرة لأوليفيي روبول، من "أن وحدة الخطاب، إنما يخلقها مُؤَلِّفُهُ: هو من يُقرِّرُ ما يتَحَدَّثُ عنه، وهو من يقرر متى يبدأ خطابه ومتى ينتهي، وهو من يقرر أن يكتب مصنفاً، أو دراما، أو رسالة أو حكمة بسيطة "1. وبمعنى أدق، فالخطاب الإعلامي ينبري لاختيار طريقة تموقعه في البراديجم المجتمعي، على خلفية النشر/ المعرفة، ثم الرصد والتحليل، وكذا التعليق والتحقيق، والتأويل والاستدراك.. بآليات خطابية إقناعية مدروسة ومستكنهة للزوميات الواقع والحدث، وبخلفيات وأساليب بيانية عديدة.
لن أدخل هنا في جدال المفاهيم الفلسفية المتعلقة بالخطابة وقول الخطاب وعلاقة ذلك بالحجاج واستعمالات اللغة، والذي يكرس تنوعا تاريخيا ومعرفيا بالحقل البلاغي الخطابي، والذي تداخلت فيه نظريات واعتبارات متداخلة، كالتفكير في الخطاب والخطابة والبلاغة والحجاج انطلاقا من منظور قيمي لدى أرسطو و بيير دو لارامي، أو علاقات صناعة الخطابة الجديدة بنظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان. وكلها أو بعضها يشكل بنيات أفقية منذورة بالضرورة للخلفية الخطابية في وضعية الإعلام، كما يجب أن يكون، لا كما أريد له. وهي حتما، تمثل بالنسبة للأكاديما الإعلامية أرضا خصبة للتلاقح البيني، ووعاء متساوقا والمعارف الأخرى، والتي تقتدر التأسيس المفهومي والاستبصار الدلالي، بنفس القيمة والاعتبار الذي تصير فيه جدارا للوقاية من آفات السقوط اللغوي والبلاغي والسيميائي.
وأعتقد أن بيرلمان يحاجج في ذات المسار، عندما يتفاعل مع هذا المعنى، إذ "ما دام الحجاج يَتَغَيَّا التأثير في مُسْتَمَعٍ ما وتعديل قناعاته أو استعداداته بواسطة خطاب ما يوجه إليه ويسعى إلى كسب تصديق العقول بدل فرض الإرادة بالإكراه أو بالترويض"2). والمستمع هنا، هو في نفس الآن، ناظر ومستدل، ومتلقي ومعاين ومستقر الرؤية. على اعتبار المحاججة المدعومة بآليات الإقناع والتوصيل المعرفي، مبتعثة، لعدم سقوط القارئ في تأويل مغلوط أو فهم مخطوء، أو حتى انزياح عن المعنى الذي يقصد منه نشر الحدث الإعلامي.
الإعلام الاجتماعي: بنية إعادة الإنتاج
مثلما هو الحال بالنسبة لمنظومة الخطاب في التعليم والتربية، يمكن تأويل طبيعة النظام الإعلامي الذي يعكس في العمق علاقات القوة والهيمنة والصراعات الثقافية والرمزية، وجود التقائية قيمية بين الحقلين، يرتكنان إلى بنية إعادة الإنتاج وتحقيقاتها المختلفة، من منطلق دراسة العلاقات المتبادلة بين التجاذبات الرقمية الجارية في المجتمع وبين النظام الإعلامي في شكله الجديد المرتبط بالطفرة الاجتماعية المتحولة.
نلمس هذا الاعتبار الجدير بالتأمل والتطوير، في نظرية بيير بورديو حول فاعلية الهابيتوس، ومركزيته في النسق السلوكي الفرداني وجهوزيته أو قابليته لاكتساب المقدرات التي تكون بواسطتها عمليات التحفيز والاقتراب من حدود التعلمات الاجتماعية (بحسب بورديو). وهو ما يفرض تمكين الهابيتوس من الموازنة بين العلاقات الموضوعية والسلوكات الفردية، مع خلق القيمة، فيما يدرج في خانة الاستعدادات المكتسبة، التي تتقاطع فيها أنساق الضوابط الموضوعية والتصرفات القابلة للملاحظة المباشرة، حيث تتداخل الأطراف كوسائط ، ليبرز مركز الالتقاء الهندسي للحيثيات و تحديد الاحتمالات والخطوط المعيشة، للمستقبل الموضوعي و المشروع الذاتي الطابع (3).
نفسها الثقافة الإعلامية، يمكن أن تنتج مجتمعا مترابطا بنطاق برامجه التعلمية وتأثيراتها على مستوى الاختيارات البيداغوجية، دون الحديث عن العنف الرمزي الممارس ضد الجماعة الأولية للفرد (الأسرة)، حيث يصعب تدبير الاختلال في غياب نظام إعلامي قيمي، محصن للأخلاقيات الاجتماعية ومناضل ضد الهيمنة والثقافة السائدة.
ويصير هذا الإعلام الاجتماعي، في حاجة ماسة إلى تربية نافعة، وتحصيل صيروري معصرن، لا يتأثر بحالات ظرفية أو بروز ظواهر مستعصية على الفهم. بل يتوق إلى جعل المناط الأخلاقي في توجهاته إلى أولوية أيديولوجية أو فاعلية فكرية ثقافية، ويمكن هنا التذكير بمرجعية بورديو في السياق عينه كون" نجاح أي تربية مدرسية وبصورة عامة، نجاح كل عمل بيداغوجي ثانوي، يتوقف أساسا على التربية الأولية التي تسبقه، وخاصة حينما ترفض المدرسة هذه الأولية في إيديولوجيتها وممارستها، وذلك بجعل التاريخ المدرسي تاريخا بدون تاريخ قبلي" (4)، كالقيمة نفسها، التي توجه مسلكيتنا لاستقبال الإعلام الاجتماعي، الذي هو رأسمال ثقافي ينزاح عن جملة اعتبارات نعاود فيها قياس نفس نتائج إنتاج التعسف وخرق قيمة الإنتاج الحقيقي.
فما العمل؟
***
د. مصطفى غَلــــمَــان
............................
هوامش:
1 ـ أوليفيي روبول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة: رضوان العصبة، أفريقيا الشرق-المغرب، 2017. ص 67
2 ـ شاييم بيرلمان، الإمبراطوريَّة الخَطابِيَّة صناعة الخطابة والحجاج، ترجمة: الحسين بنوهاشم، دار الكتاب الجديد المتحدة 2022، الطبعة 1 /2022، ص 91
3- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 49.
4- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 121.