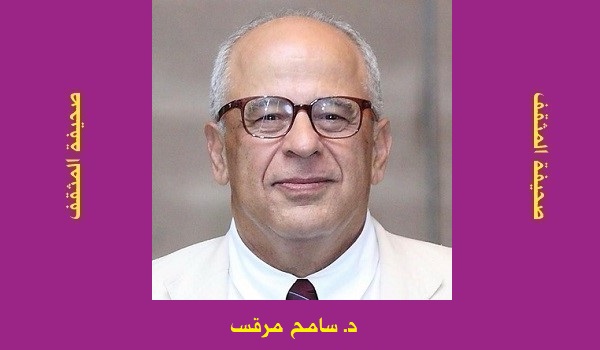قراءات نقدية
عبد الله الفيفي: في القراءة والنَّظْم والنَّصِّيَّة

لست أدري من الذي اقترح شعار «الرِّياض تَقرأ» شِعارًا لمعرض الرِّياض الدَّولي للكِتاب. غير أنَّه يظهر أنه لا يُدرِك دلالات مثل هذه العبارة، التي تبدو هزليَّة ساخرة، يمكن أن تُقال عن صَبيٍّ أضحى يقرأ، إجابة عن سائل: أهو يقرأ؟ أو عن أُمِّيٍّ تعلَّم القراءة على كِبَر، فصار يقرأ! ومن هنا فإنَّ هذا الشِّعار ينطوي على إهانةٍ للرِّياض وأهلها، وكأنَّنا نقول للعالم: «الحمد لله أيها الناس، (الرِّياض تَقرأ أخيرًا، أو تفكُّ الخط)!» يا للفخر، بشَّرك الله بالخير، هذا خبر مدهش حقًّا!
هٰكذا قفز بنا (ذو القُروح)، بلا مقدِّمات إلى هذا الموضوع. فتساءلتُ:
ـ «الرِّياض تَقرأ؟» معقول؟!
ـ بالطبع (الرِّياض) تَقرأ منذ أن أصبحت عاصمة للمملكة، وكانت قبل ذلك، كما تقرأ عواصم عَرَبيَّة أخرى منذ القِدَم؛ بمعنى القراءة الثَّقافي والحضاري. بل إنَّ القراءة والكتابة ثمرةٌ عَرَبيَّةٌ أصلًا، منذ ابتكر الكنعانيُّون أو الفينيقيُّون العَرَب رموزها في القرن العاشر قبل الميلاد تقريبًا، وما كان العالَم يعرف قبلئذٍ أبجديَّةً قط، وإنمَّا عرف الكتابة المسماريَّة المقطعيَّة في(العراق)، أو التصويريَّة الهيروغليفيَّة في (مِصْر). والكتابات الأوغاريتيَّة الكنعانيَّة- المكتشفة حديثًا بقرية (رأس شُمرة)، شمالي مدينة (اللَّاذقيَّة) في (سوريَّة)- هي بعض شواهد على تاريخٍ من تعليم العَرَب العالمَ القراءة والكتابة، وإنْ بات تاريخهم المعاصر تعتوره عُقَد النقص، حتى إنَّه ليُباهي بأنه: يَقرأ، كبقيَّة خلق الله!
ـ لعلَّ تلك العبارة «الرِّياض تَقرأ» ما هي إلَّا اجترار لعبارة، لا تقلُّ سقمًا، أُطلِقت خلال القرن الماضي: «القاهرة تَكتب، وبيروت تَطبع، وبغداد تَقرأ».
ـ وهي كذلك عبارة فكاهيَّة؛ وكأنَّ (القاهرة) لا تَقرأ، بل تَكتب فقط، أو كأنَّ (بغداد) لا تَكتب، بل تَقرأ، أمَّا (بيروت)، فلا تَقرأ ولا تَكتب، وإنَّما تطبع! وأمَّا بقية العَرَب، فلا يقرؤون ولا يكتبون ولا يطبعون، طبعًا! كلام بلا محصول، يُعْجِبُ العُربان لما فيه من ضروب البديع والتلاعب بالألفاظ، الذي يَطربون له عادةً! والواضح من هذا كله أنَّ العَرَب المتأخِّرين مغرمون عمومًا برنين الألفاظ، والترديد طربًا بما يسمعون، بلا تفكير في معناه.
ـ كيف؟
ـ ثمَّة ظاهرة ثقافيَّة عَرَبيَّة لافتة من خلال هذا السياق. وهي أنه ما أن تُطلَق عبارة، مهما كانت ركيكة، أو غير موفَّقة في مبناها ومعناها، حتى يتبارَى العَرَب، ولا سيما عبر الإعلام، في علكها دهرًا من الدُّهور، حتى ينجم غيرها. ما يذكِّرنا بالعبارة العَرَبيَّة القائلة: «فسارت مثَلًا!» مع الفارق؛ من حيث إنَّ المثَل إشارة إلى موقفٍ قصصيٍّ بعبارة مختزلة دالَّة. بخلاف ما نحن بصدده، وإنَّما الشاهد في الظاهرة الثقافيَّة العَرَبيَّة من حبِّ التكرار والترديد، بلا تفكير في المعنى. وربما جاءت هذه الظاهرة امتدادًا أيضًا للأنماط الشفويَّة الجماعيَّة التي لفتت (مليمان باري وألبرت لورد)، أو (جيمز مونرو)، في التراث الشِّعري الشَّفوي العَرَبي؛ إذ ما أن يقول شاعرٌ صيغةً شِعريَّةً معجِبة، حتى تجترُّها أفواه العشرات من الشعراء، لعقود من السنين أو لقرون.(1) وتلكم ثقافة القطيع: تثاءبت القبيلة كلُّها، لمَّا تثاءب شيخها!
-2-
ـ من حكاية «الرياض تَقرأ»، وسالفة الترديد بلا تفكير، دعنا نستأنف القراءة في قضيَّة النَّظم والنصِّية، التي قاربنا بعض جوانبها في المساق السابق. فآفة الترديد ليست بشفويَّة فحسب، بل هي مستشرية في عالم الكتابة والكتَّاب أيضًا.
ـ قد رأينا كيف انتهى الأمر بـ(أبي حيَّان التوحيدي)(2) إلى أن يثلب في كتابه «مثالب الوزيرين» نفسه هو وفهمه، بل إلى أن يثلب أدبه، حينما استدعته مناكفة بعض معاصريه، ممَّن يجمعون بين الشِّعر والكتابة، إلى الخروج من الكتابة الأدبية إلى التنظير النقدي. فإذا هو يخلط الحقَّ بالباطل، والنثر بالشِّعر، مستحسنًا قول القائل:
وإنَّ أَشعَـرَ بيتٍ أنت قائلُـهُ
بيتٌ يُقال، إذا أَنشدتَـهُ، صَدَقـا
وكان خليقًا- لو كان يعي ضُروب الكلام كما ادَّعى، وافتراق طبائعها ووظائفها- أن يكتب: «وما أبردَ ما قال القائل:...»! كما كان حقُّ البيت الذي رفع رايته أن يكون:
وإنَّ أَسخفَ بيتٍ أنت قائلُـهُ
بيتٌ يُقال، إذا أَنشدتَـهُ، صَدَقـا!
وهنا جلَّينا البون الشاسع بين (أبي حيَّان التوحيدي، -414هـ) و(عبدالقاهر الجرجاني، -471/ 474هـ) في الوعي النصوصي. ونضيف إنَّ لأبي حيان بعدئذٍ أن يردِّد علينا، معتذرًا أو هاجيًا، مع (شِمْر بن عمرو الحنفي)(3):
لَـوْ كُنْتُ في رَيْمانَ لَسْتُ بِبارِحٍ
أَبَــدًا وسُدَّ خَصاصُهُ بِـالطِّينِ
لِـي فـي ذَراهُ مَآكِـلٌ ومَشـارِبٌ
جــاءَتْ إلَـيَّ مَنِيَّتِـي تَبْغِينـي
ولَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي
فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِيني(4)
غَضْـبانَ مُمْـتَلِئًا عَلَـيَّ إِهـابُـهُ
إِنِّــي ورَبِّكَ سُخْطُهُ يُرْضِِينـي
يا رُبَّ نِكْسٍ إِنْ أَتَتْـهُ مَنِيَّتي
فَرِحٍ وخِرْقٍ إِنْ هَلَكْتُ حَزِينِ
-3-
ـ ماذا عن (النَّظم)؟ [سألتُ].
ـ أمَّا نَظْم الشِّعر، فمنه هوسٌ مَرَضيٌّ لدَى بعض الشُّعراء بنظم القوافي، يُفسِد بناء القصيد، ويضيع معه المعنى. و(هوسيَّة النَّظم، وتضييع المعانى) يتجلَّيان، مثلًا، في قصيدة (أحمد شوقي)، تحت عنوان «في الانقلاب العُثماني وسقوط السُّلطان عبد الحميد».(5)
ـ معروف أنَّ (شوقيًّا) كان يكتب شِعره كـ(جريدة يوميَّة)، لا يفوِّت حادثةً في العالَم أجمع إلَّا عرَّج عليها بقصيدة طويلة.
ـ وما كذلك الشِّعر، لا عند العرب ولا عند غيرهم، منذ أن عُرِف الشِّعر. ولذلك، كان يسرد مطوَّلاته، التي يُعِدُّ لها قوائم القوافي، كما يُعِدُّ صاحب مطعمٍ قوائم الطعام. حتى يبدو أنه لا يترك كلمة في معجم (الفيروزآبادي)، «القاموس المحيط»، أو غيره، إلَّا استقصَى النَّظْمَ عليها.
ـ ولقد كان باعث تأليف تلك المعجمات أصلًا خدمة الشُّعراء النظَّامين، من أمثال (شوقي)، ومن سلف على شاكلته من الناظمين.
ـ ولذلك لا غرابة أن تجد في قصائده كثيرًا من الحشو، والركيك إلى جوار الرَّصين، والأبيات التي لا تضيف إلى المعنى شيئًا يُذكَر. ففي تلك القصيدة، التي يستهلُّها ببيته:
سَل يَلـدِزًا ذاتَ القُصـورِ
هَـلْ جاءَهـا نَبَـأُ البُـدورِ
ستسبح مضطرًّا في بيته:
والرَّوض فـي حَجـْمِ الـدُّنا
والبَحـر فـي حَجـْمِ الغَديرِ
وهو من تلك الأبيات المحشوَّة حشوًا، لا لشيء سِوَى للإتيان بكلمة (الغدير). ثمَّ هو هنا يتحدَّث عن أميرات القصور العثمانيَّة. ليقول عنهنَّ بعد أبيات:
أَمسَــينَ فــي رِقِّ العَــبيـ
ـلِ وبِتْـنَ فـي أَسْـرِ العَشيرِ
مــا يَنتَهِيـنَ مِـنَ الصَّـلا
ةِ ضَــراعَـةً ومِــنَ النُّـذورِ
يَطلُبـــنَ نُصـــرَةَ رَبِّهِــنَّ
ورَبُّهُـــــنَّ بِـلا نَصــــيرِ
صَــبَغَ السَّــوادُ حَـبِـيرَهُنَّ
وكــانَ مِن يَـقَـقِ الحُـبـورِ
فلا تدري ماذا أراد أن يقول عنهن؟
ـ بل كيف أمست هؤلاء الأميرات في «رِقِّ العَبيل»؟
ـ كأنَّه لم يجد كلمة أخرى غير «العَبيل». ولو قال: «في رِقِّ العَبيد»، لكان قال شيئًا ذا معنى.
ـ ثمَّ ما علاقة «الصلاة» و«النذور» بالموضوع؟
ـ العلاقة أنَّ في بطن الشاعر كلمة (النذور) على حرف الراء، ولا بدَّ أن يضع عليها بيتًا. وإلَّا أنَّى له بنظم ثمانين بيتًا في الموضوع، إنْ لم يستغلَّ للتقفية كلَّ الكلمات ذات الرِّدف المنتهية بالراء؟! بل أنَّى له أن يُعَدَّ «أمير الشُّعراء» دون تلك المطوَّلات النَّظْميَّة؟!
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
..............................
(1) إشارة إلى نظريَّة (مليمان باري)، التي لخَّصها تلميذه (ألبرت لورد)، حول النَّظم في الملاحم اليوغسلافيَّة. (يُنظر مثلًا: Lord, Albert, The Singer of Tales؛ مونرو، جيمز، النَّظْم الشَّفوي في الشِّعر الجاهلي).
(2) (1992)، أخلاق الوزيرَين: «مثالب الوزيرَين الصَّاحب بن عبَّاد وابن العميد»، تحقيق محمَّد بن تاويت الطنجي، (بيروت: دار صادر)، 8- 9.
(3) الأصمعي، (1993)، الأصمعيَّات، أحمد محمَّد شاكر وعبدالسلام محمَّد هارون، (القاهرة: دار المعارف)، 141- 142.
(4) في رواية «أَمُرُّ على اللَّئيم». وهي أبلغ؛ لدلالة على أنَّ ذلك ديدنه، وليست بحالةٍ بعينها. وثُمَّت: بمعنى ثُمَّ. قال (الفراهيدي، العَين، (ثم)): «ثُمَّ: حَرْف من حروف النَّسَق، لا تُشرِّكُ ما قبلَها بما بعدَها، إِلَّا أنَّها تُبَيِّنُ الآخِرَ من الأوَّل، ومنهم مَن يُلزِمُها هاءَ التأنيث فيقول: ثُمَّتَ كانَ كذا وكذا.» وثُمَّ، وثُمَّتَ، وثُمَّتْ، كلُّها: حروف نَسَق. وقليلًا ما تجد إعلاميًّا معاصرًا يفرِّق بين (ثُمَّ) و(ثَمَّ)؛ فتسمعه يردِّد: «ومِن ثُمَّ»! وهو تعبير لا علاقة له باللُّغة العَرَبيَّة. والصواب: «ومِن ثَمَّ»، أي «ومن هناك». على الرغم من أنَّ «ثَمَّ» كلمةٌ ما زالت مستعملة في بعض لهجات الجزيرة العَرَبيَّة، بمعنى: هناك. ومن تخليطات المعجم المشار إليه، «معجم العَين»، قوله: «ثَمَّ معناه: هناكَ، للتبعيد، وهنالِكَ للتقريبِ!» فقلبَ ما كان حقُّه القول: «هناكَ للتقريب، وهنالِكَ للتبعيد.» وهو ممَّا يشكِّك في نسبة هذا المعجم إلى (الخليل). إلَّا أن يكون في النصِّ تصحيف، وهو الراجح، وأصله كلامه: «ثَمَّ معناه: هنالكَ، للتبعيد، وهناك للتقريب.» ولا تعليق لمحقِّقي هذا المعجم، ولا يحزنون، كالعادة!
(5) ديوانه الأعمال الشِّعريَّة الكاملة، (بيروت: دار العودة، 1988)، 1: 119.