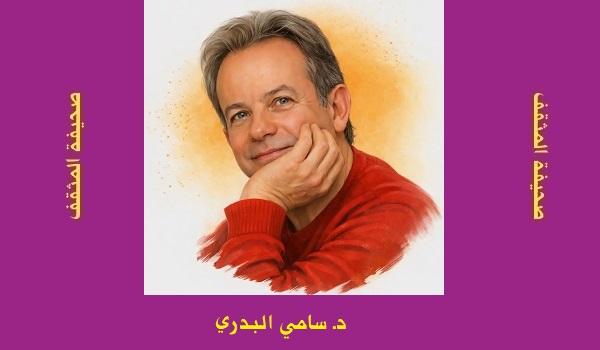قضايا
سجاد مصطفى: عقولنا ليست ملكنا.. فهل نملك الجرأة للاعتراف؟

تسبر هذه الدراسة أغوار الآليات التي تتشكل عبرها الأفكار في وعي الإنسان، مقدمة قراءة نقدية محكمة لمسار يجعل من التفكير الفردي امتدادًا لتراكمات اجتماعية وثقافية، لا نبعًا أصيلًا للذات. يعمد البحث إلى تحرّي المفاهيم بدقة متناهية، مستندًا إلى شروط التكوين العقلي في بيئات يهيمن عليها سلطة رمزية صارمة، معتمداً على إرث فكري عراقي وتأملات الباحث.
المقدّمة
لا يتراءى كل ما نعتقده صادرًا عن وعينا، ولا تعد كل قناعة نحملها دليلًا قاطعًا على حرية فكرية مستقلة. الإنسان في مجتمعاتنا ذات الطابع التقليدي لا يُبنى كمفكر حر مستقل، بل يُصاغ بوصفه كائنًا وظيفيًا يعيد إنتاج ما يُلقن إليه من قيم وأفكار مغلوبة على أمرها. ولذلك يبرز السؤال المحوري: أين تكمن حدود مسؤوليتنا تجاه الأفكار التي نؤمن بها؟ وهل التفكير ممارسة نخوضها بحرية، أم هو نتاج حتمي لبيئات اجتماعية وثقافية تربوية مُحكمة؟
تسعى هذه الورقة إلى معالجات هذه القضية من منطلق تحليلي جاد، يوازن بين قوة الطرح ووضوح الإفهام، متجنبًا الزخرفة اللغوية التي قد تشوش المعنى. فنحن أمام مسألة عميقة ذات طبقات متداخلة تتطلب تشخيصًا متينًا لطبيعة الوعي وكيفية تشكله، بعيدًا عن التبسيط والتجريد السطحي.
أولًا: سلطة التنشئة وبنية التلقين
تبدأ السلطوية المعرفية تأثيرها منذ الطفولة، حيث يُفرض على الطفل ثنائيات قطعية كالصح والخطأ، الخير والشر، الحلال والحرام، التي لا تستند إلى تجربة نقدية ذاتية بل إلى سلطة خطابية محكمة. يعبر الفيلسوف علي الوردي عن هذا الواقع بقوله إن الإنسان في مجتمعاتنا يُربى على التسليم أكثر مما يُحفز على النقد والتمحيص.
وعليه، لا ينخرط الفرد في فضاء التفكير الحر إلا بعد أن يتعرّض لمنظومة من القيم والضوابط التي تحيط به، فتُحدد له ما يجوز له التفكير فيه وما يُمنع. وهكذا تتحول الأفكار إلى ممتلكات جماعية تُتداول بين الأفراد دون مساءلة عميقة أو مراجعة واعية.
ثانيًا: المؤسسات ودورها في قولبة الوعي
المؤسسات ليست هياكل إدارية فحسب، بل هي أطر تعيد تشكيل المعنى وتوزع السلطة الرمزية، تشمل الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام. هذه المؤسسات غالبًا ما تفرز خطابات لا تشجع على التفكير المستقل بقدر ما تدعو إلى الامتثال والانصياع لما هو معتمد ومقبول.
يؤكد الباحث عبد الجبار الرفاعي أن مجتمعاتنا لا تزال محصورة داخل أنساق فكرية مغلقة، تحجب عن الإنسان فرصة امتلاك فكر شخصي مستقل، وتفرض عليه ما ينبغي أن يكون عليه. ومن هنا أقول: السؤال الحقيقي ليس لماذا تفكر بهذه الطريقة، بل من الذي منحك الإذن لتفكر بهذه الطريقة؟
ثالثًا: الرأي الشخصي كخدعة معرفية
لا يُصبح الرأي شخصيًا إلا إذا خضع للتحليل النقدي الداخلي والجدل المنهجي الصارم. أما في سياقاتنا الاجتماعية، فإن ما يُدعى آراء غالبًا ما تكون ناتجة عن انفعالات، تقليد، أو قبول اجتماعي غير مدروس. الرأي الذي لم يُمرر عبر مشفى الشك والتحليل لا يمكن اعتباره أصيلًا أو محل ثقة.
لقد كتبتُ في مناسبة أخرى أن الأفكار التي لا تكتسب صلابتها عبر الجدل والتمحيص تظل هشة مهما ألبست من قناعات.
رابعًا: التفكير من موقع الاستقلال لا الرفض
التفكير ليس فقط رفضًا للطاعة، بل هو رفض للتقليد الأعمى والقبول السطحي. لكنه لا يحض على رفض كل شيء بلا تمحيص، بل يدعو إلى الفحص والتأويل العميق. سقراط نفسه بيّن ذلك بجلاء حين قال إن الحياة التي لا تخضع للمراجعة والتحقيق لا تستحق أن تُعاش.
هنا يتجلى جوهر التفكير الحقيقي، الذي لا يقتصر على كونه فعلًا ذهنيًا صرفًا، بل هو فعل تحليلي يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمعنى والمعتقد.
خامسًا: الاستقلال المفهومي وتبعاته
لا يتحقق الاستقلال الفكري بمجرد معارضة السائد، بل حين يتحرر العقل من الخضوع اللاواعي للموروث الثقافي والاجتماعي. صاغ المفكر كارل بوبر هذا المفهوم بدقة حين بين أن الحرية الحقيقية ليست في الإيمان بما تشاء، بل في القدرة على الرفض بعد الفهم الواعي.
ومن تجربتي الشخصية أؤكد أن امتلاك الفكر الحقيقي يعني المرور بتجارب متعددة من الرفض، التأسيس، الشك، ثم الفهم العميق.
الخاتمة والناتج
لم يكن الهدف من هذه الورقة التشكيك في كل ما نحمله من أفكار، بل لفت الانتباه إلى أننا في أغلب الأحيان نعيش داخل أفكار الآخرين لا أفكارنا. فالتفكير الحقيقي لا يتجسد في إعلان الرأي فقط، بل في مساءلة الرأي ذاته عن أصله وأسبابه.
فهل تساءلت يومًا: هل فكرك حقًا لك؟ أم أنه مجرد انعكاس لمنظومة تعتقد أنك حر فيها؟.
***
سجاد مصطفى حمود