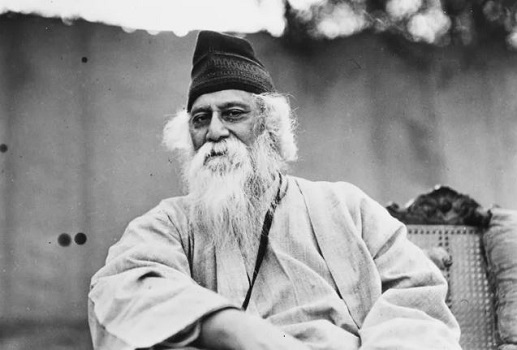قضايا
نجوى لزرق: الترجمة كجسر حضاري بين العرب واليونان

من الاستيعاب إلى الإبداع
في تاريخ الأمم، لا يُبنى المجد الحضاري إلا على تفاعل حيّ بين الفكر والعقل، بين الهوية والانفتاح، بين الذات والآخر. ولعلّ من أبرز تمظهرات هذا التفاعل في الحضارة العربية الإسلامية، ظاهرة الترجمة، التي تجاوزت كونها مجرد نقلٍ لغوي، لتغدو فعلًا ثقافيًا معرفيًا شاملًا ساهم في تشكيل ملامح الفكر العربي الإسلامي وفتح له أبواب الإبداع.
إذا كانت الترجمة، في معناها السطحي، تُعرّف على أنها تحويل النصوص من لغة إلى أخرى، فإنها، في السياق الحضاري العربي، ارتقت إلى كونها جسرًا حضاريًا حقيقيًا، مرّت عليه علوم وفلسفات وأساليب تفكير، وتمّت إعادة بنائها داخل السياق الإسلامي، ضمن رؤية عقلية متماسكة، دون أن تذوب في مرجعياتها الأصلية.
لقد نشأت الحاجة إلى الترجمة في الدولة الإسلامية منذ لحظة التوسّع والاحتكاك بحضارات غنية كالحضارة الفارسية والرومانية، لكن التفاعل الأعمق والأثر الأكبر كان مع الحضارة اليونانية، لما حملته من رصيد فلسفي ومنطقي وعلمي متراكم. فمع اتساع الدولة، بدأت تظهر أسئلة علمية وكلامية وفكرية معقّدة تتطلب أدوات تحليل عقلانية دقيقة، فكان المنطق الأرسطي، والطب الجالينوسي، والهندسة الإقليدية، كلها مداخل هامة لإشباع هذا التطلّع.
بلغت حركة الترجمة أوجها في العصر العباسي، خاصة في عهد الخليفة المأمون، الذي أسّس "دار الحكمة" في بغداد، لتكون مركز إشعاع علمي عالمي. في هذه المرحلة، لم تكن الترجمة مجرّد نشاط لغوي بل مشروعًا حضاريًا متكاملًا، حيث نُقلت أعظم الأعمال الفكرية والعلمية اليونانية إلى العربية، على يد نخبة من المترجمين المتبحّرين، أمثال حنين بن إسحاق وثابت بن قرة ويحيى بن عدي.
غير أن ما يميّز الترجمة العربية ليس فعل النقل في ذاته، بل الطبيعة النقدية التحليلية التي طبعت هذا النقل. لم يُترجم النص ليُتعبد به، بل ليُناقش ويُعلّق عليه ويُعاد بناؤه. فالفارابي مثلًا لم يكتفِ بشرح منطق أرسطو، بل أضاف إليه ووسّعه ليكوِّن نسقًا منطقيًا عربيًا إسلاميًا خاصًا. كما جمع ابن سينا بين الفلسفة الأرسطية ومفاهيم التوحيد، بينما قدّم ابن رشد شروحًا عقلانية دقيقة للفكر الأرسطي، أثّرت لاحقًا في فكر أوروبا خلال عصورها الوسطى.
بهذا المعنى، فإن الترجمة في الحضارة العربية لم تكن استنساخًا، بل كانت توليدًا للمعنى، وتحويلًا للمادة الفكرية اليونانية إلى نسيج معرفي جديد يتماشى مع خصوصية العقل الإسلامي. لقد استوعب العرب الفكر اليوناني ثم تجاوزوه، وأضافوا إليه، ونقلوه للعالم بعد أن أعادوا كتابته بلغة عربية، وفكر إسلامي، ومنطق نقدي.
كما أدّت الترجمة دورًا محوريًا في تطوير اللغة العربية نفسها، التي أثبتت قدرتها الاستثنائية على استيعاب المصطلحات الفلسفية والعلمية الجديدة، بل وتوليد مصطلحات خاصة بها، مما جعلها، لعدة قرون، لغة العلوم والفلسفة في العالم.
ولعلّ أجمل ما يُستخلص من هذه التجربة هو تعامل الحضارة العربية مع الآخر. فلم يكن الفكر اليوناني يُنظر إليه كفكر دخيل يجب رفضه، بل كرصيد إنساني مشترك، يمكن تحويله، عبر أدوات الترجمة والتحليل، إلى مادة للإبداع الذاتي. وهذا ما يجعل من الترجمة، لا مجرد وسيلة، بل علامة على النضج الحضاري والقدرة على استيعاب الآخر دون الذوبان فيه.
ومن موقعي كباحثة في الحضارة العربية، أرى أن الترجمة كانت بحقّ رئة حضارية تنفّست بها الأمة، ومفتاحًا من مفاتيح نهضتها الأولى، ومن أعظم تجليات نضجها العقلي. لقد استطاع العقل العربي في تلك المرحلة أن يجعل من الآخر الفكري مادةً للحوار، لا للرفض، ومن النص المترجَم نواةً للتجاوز، لا مجرد نهاية للفهم.
وإننا اليوم، في ظلّ تحديات الانغلاق والانبهار، مدعوّون لإحياء تلك الروح الحضارية الأصيلة، حيث تكون الترجمة مدخلًا للنقد، وبوابةً للإبداع، وأداةً لفهم الذات من خلال الآخر.
هكذا كانت الترجمة جسرًا، نعم، لكنها لم تكن جسر عبور فقط، بل جسر بناء وتشييد، نُقل عليه الفكر، وأُعيد إنتاجه، حتى أصبح جزءًا من هوية حضارية جديدة.
فهل نملك اليوم شجاعة العودة إلى الترجمة بالمعنى الذي جعل منها العرب أداة نهضتهم؟
***
بقلم: نجوى لزرق
متخصصة في اللغة والأدب والحضارة العربية