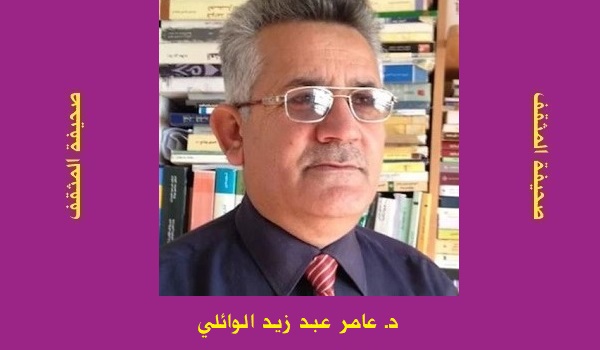قضايا
عصمت نصار: دروب الكذب وأشكاله وغرابيل الفلاسفة الناقدة

ما برح المعنيون بدراسة القيم الأخلاقية يسألونني عن معيار جدة وطرافة الموضوعات التي ينبغي عليهم تناولها بالبحث (لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه) وهل موطن ابتكارها في حداثتها أم في بنيتها المعرفية ومنهجية معالجتها؟ واعتقد أن الأصالة والجدة والطرافة والابتكار تكمن جميعها في موضوعية تناولها ونسقية وتماسك أفكارها ووضوح مقصدها وأهمية طرحها في معالجة إحدى القضايا الفلسفية التطبيقية في المجتمع في ضوء ثقافة العصر المعيش.
فما أكثر الأبحاث التي تناولت ماهية القيم الأخلاقية ومصادرها وطبيعتها ووظائفها بيد أن ما يميزها عن بعضها ليس عنوان الدراسة بل ما انتهت إليه وما أضافته على سابقتها ومبلغ أثرها في اللحظة التي ظهرت فيها.
فعلى سبيل المثال فقد كتبت عدة مقالات عن فلسفة الكذب وشاركت في الكثير من الندوات التي عقدت حول هذا الموضوع وذلك في الفترة من 2013 إلى 2019 (على صفحات مجلة روز اليوسف والبوابة نيوز وأخبار اليوم ومهرجان جامعة أسيوط وندوات مكتبة الإسكندرية) ولم يكن هدفي من ذلك هو تذكير القراء بما كتبه الفلاسفة والمتفلسفون عن تقييمهم لرذيلة الكذب وخطورة تفشي هذه الظاهرة في السلوك الإنساني بل كان الهدف الحقيقي من إحياء هذا المبحث النقدي هو التصدي للأكاذيب التي أطلقتها الجماعات الضالة المضلة بإيعاز وتحريض من دوائر المخابرات المعادية والمتآمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا أي أنهم اتخذوا من الأكاذيب بكل أشكالها أسلحة لهدم دولتنا من الداخل لتفكيك قوة تماسكها وتشكيك الرأي العام في قياداتها ونشر جراثيم الفتن الطائفية والمذهبية بين طبقات المجتمع ليسهل عليهم هدمه وتحقيق مخططهم الاستعماري الجديد.
وها نحن نكتب اليوم ثانيةً لشرح ما أجملناه وتوضيح ما خفي على الرأي العام من وسائل وآليات صناع الأكاذيب في ضوء التقنيات الإلكترونية التي لم تقف عند الشائعات الإخبارية والأحداث الملفقة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث (التزييف والإيهام والخداع البصري والسمعي والارتياب المعرفي والتجهيل العلمي) والترغيب في مشاهدة المواقع الإلكترونية المفعمة بالمكائد غير المباشرة -كما بينا في المقالات السابقة-، ودفع الأذهان لإدمان الفوضى والكفر بالثوابت واعتناق العدمية المتهكمة على الصدق والجاحدة لليقين الذي تبنى عليه المحاسن والرذائل.
***
فقد ذهب الفلاسفة إلى دراسة العادات والقيم الأخلاقية بغرابيل دقيقة لتفصل ذلك الخلط الذي يجمع بين المعيارية والنظرية في الكتابات الأخلاقية فقد ذهب الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي (لوسيان ليفي بريل) (1939:1857) في كتابه علم العادات الأخلاقية إلى أن علم الأخلاق يدرس القواعد الأخلاقية دراسة نظرية مجردة وفي الوقت نفسه يحدد القيم والغايات الأخلاقية من تلك القيم أو التصورات النظرية العقلية لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني الفاضل ويصدر أحكامًا على الأفعال الإنسانية ويرتب الواجبات ويضع الحلول للمشاكل والأزمات التي يلقاها ضمير كل إنسان عاقل حر.
وانتهى إلى أن مصطلح (العلم المعياري للأخلاق) -الذي وضعه العقليون- يشكل دربً من اللغو الذي يصعب على الأذهان استيعابه لأن التصورات العلمية المجردة لا يمكن اتخاذها معيارًا للتطبيقات السلوكية التي تتحكم فيها العديد من العوامل التربوية والنفسية والاجتماعية والمعتقدات الدينية والمبادئ السياسية وغير ذلك من الأمور المتصلة اتصالًا مباشرًا بالأخلاق التطبيقية فاللذة والمنفعة والواجب والصدق والكذب لا يمكن أن تكون مفاهيم أو قيم نظرية مجردة تصدق في كل زمان ومكان في حين أن الواقع يشهد بأن تلك المفاهيم الأخلاقية تتبدل بموجب الثقافة التي تنشأ فيها وقد غاب عن أذهان المثاليين الداعيين (لما ينبغي أن يكون) بأنهم انطلقوا إلى هذا المفهوم من انتقاداتهم لسلبيات السلوك الأخلاقي في المجتمعات أي أن الواقع هو الذي دفعهم إلى تصور المثل العليا وليس العكس.
فكيف يمكن القول بوجود علم أخلاق نظري كما يزعم الفلاسفة إذا كان تطور الأخلاق العملية التطبيقية خلال العصور هي السبب في تطور المذاهب الخلقية.
أي أن الفيلسوف يقف أمام مرآة مشاعره الوجدانية وقناعته الذهنية وحدود أفعاله السلوكية ثم يضع تلك القناعات في نسق يجعل منه الأنموذج والمثل الأعلى للإنسان الكامل على مر العصور متجاهلًا سائر الأوضاع والعادات والتغيرات التي تمر بها الواقعات المعيشة لذلك الإنسان الفرد ويحدد بمقتضاه مفهوم الصدق ومعني الكذب. ومن ثم بات لزامًا على فلاسفة الأخلاق تحديث معاييرهم للفكر الأخلاقي مهنيًا كان أو تطبيقًا عام وذلك نحو عملي استقرائي يحتكم فيه إلى منطق الذرائع والمنفعة العامة وصالح الفرد والبيئة معًا ويترتب على ذلك انتهاجهم المنهج الاستقرائي وليس الاستنباط أو المحاكاة لتصورات مجردة.
في حين ينزع علماء الدين إلى نقد المحتكمين للضمير الإنساني للفرد، أو للظواهر الاجتماعية النسبية والتحولات الثقافية المتغيرة من عصر إلى عصر ، أو للمثل العقلية المستمدة من عالم المجردات أو المدن الفاضلة التي يتخيلونها أو نموذج الإنسان الكامل الذي رفعته الاستنارة العقلية وعشقه للذات الروحيّة عن كل شهوات المادة واللذات الجسدية ويؤكد المتدينون أن كل هذه المذاهب الأخلاقية (النفسي الجواني، الأنثربولوجي الظاهراتي الاستقرائي والعقلي المثالي، والروحي الوجداني) لم تستطع الوقوف على بنية جوهر الإنسان وذلك لأن مفاهيمهم على تعددها وتباينها لم تنفذ إلى حقيقة النفس البشرية المتمثلة في الفطرة التي نشأها الله عليها ومن ثم، فإن الأوامر الإلهية والنواهي الربانية المُوحى بها في الكتب المقدسة هي أوثق المعايير والضوابط للسلوك الإنساني سواء في ميدان التطبيق المهني أو السلوك العام أو في الواجب التربوي الذي ينبغي غرسه في تنشأة النشء وتهذيبه وذلك لأنها تجمع بين إيجابيات المثل واحتياجات الواقع المعيش. ويؤكد المجددون المتفقهون أن الأخلاق الإسلامية تحتكم إلى ثابت شرعي يمتاز بالمرونة والقدرة على التطور والتعايش مع مختلف المجتمعات والبيئات.
وعلى النقيض من تلك الآراء نجد النفعيون الماديون ينظرون إلى أن الأخلاق إحدى الآليات أو الطاقات الإنسانية الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من السعادة وإشباع رغبات الفرد أو القوة المهيمنة التي تقود الحاضر إلى يوتوبيا واقعية يقودها العلم وتسيسها المنفعة العامة ويحكمها نصائح نيقولا مكيافيللى (1527:1469) ودستور تنين توماس هوبز (1679:1588) أو سوبر مان فريدريك نيتشه (1900:1844) -الذي يحتكم إلى قانون الصراع والبقاء والأصلح والمجد للأقوى.
وذلك فضلًا عن أهواء تحالف الماسونيين مع العصابات الصهيوأمريكية التي انتهت إلى أن خداع قيادات العالم وتزييف العقل الجمعي للشعوب باختراع الأكاذيب أيسر بكثير من الحروب التقليدية التي انتهجوها للتغيير في الحربين العالميتين في القرن العشرين.
***
ولما كان هدفنا هو التعرف على غرابيل الفلاسفة حيال قيمة الكذب الدنية ومكانة الصدق العليا فسوف نجد ثقوبها تتسع وتضيق وفق معايير المذاهب التي ينتمي إليها أصحابها عقلية كانت أو مستمدة من العادات والتقاليد والأعراف أو من الدين والكتب المقدسة؛ فجميع هذه الغرابيل يسعى إلى هدف واحد ألا وهو نقد الكذب وتحديد المواقف التي يجب علينا هدمه فيها وتخليص السلوك الإنساني من شروره وتعيين القدر المباح من بعض أشكاله التي تفرضه علينا الضرورة والمصلحة العامة وهو ما نطلق عليه اليوم في الفلسفة المعاصرة (عبقريّة الكذب) الذي جعله فرانسوا نودلمان الفيلسوف الفرنسي المعاصر (1958) عنوانًا لآخر مؤلفاته في هذا الموضوع. التي يستحيل الإفك فيه إلى موقف مغاير لطبيعته الآثمة القبيحة من وجهة نظر الفلاسفة الذين رفعوا لواء الصدق والحق على ما دونه في حين أن عدم التزامهم بنسقية أفكارهم أوقعتهم في العديد من المتناقضات التي كشفت عن ضعفهم الإنساني الذي لم يقاوم الأكاذيب التي اخترعوها لصناعة نظرياتهم.
وللحديث بقية عن الغرابيل الفلسفية التي أعدها قادة الفكر الإنساني لمكافحة مواطن الخداع ومزيفي العقول وهادمي الثوابت والقيم الأخلاقية والمبادئ العقديّة.
***
بقلم: د. عصمت نصار