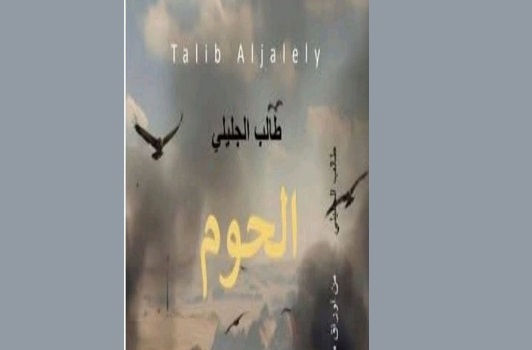قضايا
عبد السلام فاروق: "المعتزلة".. سيرة العقل المتمرد والسلطة

"ما من ثورة فكرية إلا وكانت بدايتها تمرداً على اليقينيات الجاهزة"، هذه العبارة الصادرة عن أحد فلاسفة التنوير الأوروبي، هي في الحكم جوهر التجربة المعتزلية التي نحن بصددها. في هذا التحليل، سنقترب من كتاب "مذهب المعتزلة؛ من الكلام إلى الفلسفة" للباحث العراقي رشيد الخيون، بوصفه تشريحاً لظاهرة "العقل المتمرد" في الإسلام، ذلك العقل الذي تجرأ على تحدي الثوابت، فدفع الثمن غالياً، ثم عاد ليطل برأسه بين الحين والآخر كشاهد على إمكانية أخرى للإسلام غير ذلك الذي تريده السلطات الدينية والسياسية.
اللحظة التأسيسية للمعتزلة، كما يرويها الخيّون، تحمل في طياتها كل دراما الصراع بين التقليد والتجديد. ذلك المشهد الذي اعتزل فيه واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لم يكن مجرد خلاف حول "حكم مرتكب الكبيرة"، بل كان تمرداً على منهج التفكير ذاته. لقد حول واصل السؤال من "ما هو الحكم؟" إلى "كيف نصل إلى الحكم؟"، وهي نقلة منهجية من الإجابات الجاهزة إلى آلية التفكير نفسها.
الأصول الخمسة التي وضعها المعتزلة لم تكن مجرد عقائد، بل كانت بياناً ثورياً:
1-التوحيد لم يكن مجرد إقرار بوحدانية الله، بل كان هجوماً على التصورات التجسيمية التي كانت سائدة، ونزعاً لشرعية الخطاب الديني القائم على الحكايات والأساطير.
2-العدلالإلهي كان في حقيقته إعلاء لمسئولية الإنسان، وبالتالي لنزع القداسة عن الحكام الذين كانوا يبررون استبدادهم بالقدر الإلهي.
3-المنزلة بين المنزلتين كانت ضربة للخطاب التكفيري الذي كان سائداً، وإقراراً بأن العالم ليس أبيض وأسود، وأن بين الإيمان والكفر مساحات رمادية.
4-الوعد والوعيد كان رفضاً لفكرة "الشفاعة" التي حوّلها البعض إلى غطاء للإفلات من المسئولية.
5-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان دعوة للثورة على الظلم، ولو كان الظالم خليفة المسلمين.
ولادة العقل النقدي
ما يميز تحليل الخيون هو كشفه عن التحول الجذري الذي أحدثه المعتزلة، من النقاش الكلامي التقليدي إلى بناء نسق فلسفي متكامل. لقد حول المعتزلة الأسئلة الدينية إلى إشكالات فلسفية: الله لم يعد مجرد موضوع للعبادة، لقد أصبح إشكالية معرفية (كيف نعرفه؟)، وأخلاقية (كيف نتعامل مع عدله؟)، وأنطولوجية (ما طبيعة وجوده؟).
الخيون يبرز كيف أن المعتزلة، رغم تأثرهم بالفلاسفة اليونان، لم يكونوا مجرد ناقلين، بل كانوا مبدعين. لقد أعادوا تشكيل المفاهيم الفلسفية في بوتقة التوحيد الإسلامي، فخلقوا تركيباً فريداً جمع بين العقلانية الفلسفية والروح الدينية. هذا الجمع بين "العقل" و"النقل" - وإن كان مع تقديم العقل – هو ما جعل تجربتهم أكثر ثراءً من التجارب العقلانية الغربية التي قطعت مع الدين بشكل جذري.
الجزء الأكثر إثارة في تحليل الخيّون هو كشفه للمفارقة المأساوية التي وقع فيها المعتزلة. فبعد أن بدأوا كتيار معارض، تحالفوا مع السلطة في عهد المأمون، ليصبحوا هم أنفسهم سلطة فكرية قمعية خلال "محنة خلق القرآن". لقد تحولوا من ضحايا إلى جلادين، ومن دعاة حرية التفكير إلى مطالبين بالتوحيد الفكري تحت شعار "العقل".
هنا يطرح الخيّون سؤالاً مزلزلاً: هل يمكن للعقل أن يصبح سلطة دون أن يفقد عقليته؟ هل يمكن للتنوير أن يُفرض بقوة الدولة دون أن يتحول إلى ظلامية جديدة؟ هذه الإشكالية ليست خاصة بالمعتزلة، بل تتكرر في كل التجارب التنويرية، حتى في عصرنا الحالي حيث تتحول بعض الخطابات "الليبرالية" إلى خطابات متعصبة لا تقل تعصباً عن التيار الذي تحاربه.
المعتزلة والحداثة
يبرز الخيّون كيف أن أفول المعتزلة السياسي لم يكن نهاية لتأثيرهم. لقد ظلوا كالطيف يحوم حول الفكر الإسلامي، يطلون برؤوسهم في لحظات التحول الكبرى. محمد عبده الذي حاول التوفيق بين الإسلام والعصر، طه حسين الذي دعا إلى قراءة عقلانية للتراث، نصر حامد أبو زيد الذي طبق المناهج النقدية على النص القرآني، كلهم كانوا في حقيقة الأمر يعيدون إنتاج الأسئلة المعتزلية في سياقات جديدة.
لكن الخيون يسائل هذا التأثير قائلا : لماذا ظل تأثير المعتزلة محدوداً؟ لماذا لم يتحولوا إلى تيار رئيسي في الفكر الإسلامي؟ الإجابة عنده تكمن في أن المعتزلة، رغم عقلانيتهم، ظلوا أسرى الإطار الديني. لقد أرادوا أن يكونوا "عقلانيين داخل الصندوق"، فلم يتمكنوا من كسر الصندوق ذاته. هذا التناقض بين الجرأة الفكرية والالتزام الديني هو ما حد من ثورتهم وجعلها قابلة للاحتواء من قبل النظام الفكري التقليدي.
بين النص والسلطة
لقد عاد بي كتاب رشيد الخيون "مذهب المعتزلة: من الكلام إلى الفلسفة" إلى تلك اللحظة الفارقة في تاريخنا، حين كان العقل الإسلامي يحبو خطواته الأولى نحو الاستقلال عن النص، نحو تأسيس رؤية للعالم تقوم على البرهان لا على التقليد.
ما إن يشرع المرء في قراءة تاريخ المعتزلة، حتى يجد نفسه أمام معركة كبرى، معركة لم تكن حول ألفاظ جوفاء أو مصطلحات معقدة، بل كانت معركة حول العقل ذاته. لقد وقف المعتزلة في وجه تيار جارف كان يريد أن يحول الدين إلى طقوس جامدة، وإلى نصوص لا تقبل النقاش ولا التأويل.
كان واصل بن عطاء، ذلك الشاب النابه، أول من أدرك الخطر. لقد رأى بعينيه كيف يتحول الدين إلى أداة في يد السلطة، كيف يصبح النص المقدس غطاءً للظلم والاستبداد. فما كان منه إلا أن اعتزل حلقة أستاذه الحسن البصري، ليبشر برؤية جديدة، رؤية تقوم على خمسة أعمدة:
أولها التوحيد، لكنه توحيد يرفض أن يحول الإله إلى صورة بشرية، إلى ملك جبار يجلس على عرش كما يتخيله العامة. وثانيها العدل، لكنه عدل يجعل الإنسان مسئولاً عن أفعاله، لا دمية في يد القدر. وثالثها ذلك المبدأ العميق "المنزلة بين المنزلتين" الذي أراد أن ينقذ المجتمع الإسلامي من فخ التكفير والتفجير.
لكن التاريخ، كما نعلم، مليء بالمفارقات. لقد تحول المعتزلة من ضحايا إلى جلادين، من دعاة حرية الفكر إلى مطاردي المخالفين. لقد وقفوا مع المأمون في محنته الشهيرة، محنة "خلق القرآن"، فكانوا من أشد المتحمسين لاضطهاد خصومهم، ومن أقسى المعذبين لأحمد بن حنبل وأتباعه.
أليس عجيباً أن يصبح الداعون إلى العقل أدوات للقمع باسم العقل ذاته؟ أليس غريباً أن يتحول المفكرون الأحرار إلى حراس لعقيدة رسمية؟ لقد كشفت محنة خلق القرآن عن تناقض عميق في التجربة المعتزلية، عن ذلك الشرخ الذي لا يزال يعاني منه كل مثقف يجد نفسه بين مطرقة أفكاره وسندان السلطة.
سؤال يطرح نفسه بإلحاح: لماذا فشل المشروع المعتزلي رغم كل ما كان يحمله من وعود؟ لماذا انطفأت تلك الشمعة التي أضاءت عصراً من الزمان؟
لعل الإجابة تكمن في ثلاث كبوات:
أولها أن المعتزلة ظلوا أسرى أبراجهم العاجية، يناقشون قضايا فلسفية معقدة بلغة لا يفهمها إلا الخاصة، فانقطعوا عن عامة الناس. وثانيها أنهم ارتبطوا بالسلطة ارتباط المصير بالمصير، فلما سقطت سقطوا معها. وثالثها أنهم، رغم كل ادعاءاتهم العقلانية، لم يقدموا منهجاً نقدياً متكاملاً يمكنه أن يصمد أمام تيار النقل الذي اجتاح العالم الإسلامي فيما بعد.
صحوة متأخرة
لكن هل مات المعتزلة حقاً؟ لقد ظن كثيرون أنهم انتهوا إلى غير رجعة، حتى إذا بأسئلتهم تعود من جديد على ألسنة مفكرين معاصرين. لقد حمل لواءهم محمد عبده وطه حسين ونصر حامد أبو زيد والجابري، كل بطريقته الخاصة.
لكن الفارق بين المعتزلة القدامى والمعتزلة الجدد هو أن الأولين كانوا يحاربون في إطار النظام المعرفي الإسلامي، بينما وجد الجدد أنفسهم خارج السرب، يحاربون من الهامش، بل ويحاربون أحياناً من المنفى.
ها نحن نعود بعد كل هذه القرون لنطرح الأسئلة ذاتها: هل يمكن للعقل أن يجد مكاناً له تحت مظلة الدين؟ وهل يمكن للتنوير أن ينتصر دون أن يتحول إلى دجمائية جديدة؟ وهل يمكن بناء حداثة إسلامية لا تكون مجرد تقليد أعمى للغرب، ولا تكون أيضاً مجرد ردة إلى الماضي؟
لعل الدرس الأهم الذي تقدمه لنا تجربة المعتزلة هو أن العقل لا يمكن أن يفرض نفسه بقوة السلطة، وأن التنوير الحقيقي يجب أن ينبع من القاعدة لا أن يفرض من القمة. وأن المثقف يجب أن يظل ناقداً حتى لنفسه، مراقباً لذاته، حريصاً على ألا يتحول من ثائر إلى طاغية، ومن متمرد إلى رجل دين جديد.
***
عبد السلام فاروق