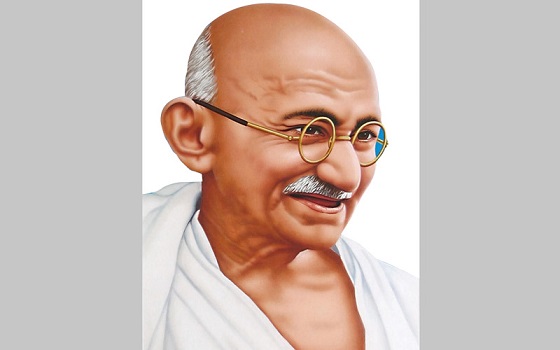قضايا
مجدي إبراهيم: محمد عبده.. من عقلانيّة الإمامة إلى حكمة العارفين (3)

(٤) منهج محمد عبده: ويجيء منهج الإمام محمد عبده في التفسير قائماً على معايشة القرآن معايشة روحيّة غير تقليدية، ولم تكن رؤيته باتجاه النظر إلى القرآن مُلزَمَة بما جاء في أقوال المفسرين السابقين؛ لأن رؤية هؤلاء المفسرين قد ارتبطت بالمستوى العقلي ودرجة العلم التي بلغوها على أزمنتهم وتحصلت لمجتمعاتهم وبيئاتهم الثقافية.
وليس شرطاً أن تتوقف العقول جامدة عند ما كانوا حصّلوه أو بلغوه، ولا أن تكون حصيلتنا الفكريّة هى فقط كامنة فيما ظهر لهم من معانيه. وواضح أن الأمام محمد عبده يعول هنا كل التعويل على استقبال القلوب في ذاتها لمعاني القرآن، فلكل إنسان قلبه الذي يختلف عن قلب الآخر، وله إشراقاته الروحية التي تتباين عن إشراقات الآخر. ومهمة القرآن هو تحويل النفوس واستقبال القلوب على الحضور للمعاني القرآنية الفاعلة فيها: فعملُ القرآن في الباطن لأجل التغيير.
ومَنْ لا يفهم القرآن، ومن لا يقرأه على حضور وطلاقة لا يستطيع أن يقوم على الحقيقة بمهمّة تجديد العقل الديني، لأن هذا التجديد يُطال نفس المُجدد أولاً ثم من أضواء العقل وأنوار الضمير وإشراقة النفس يكون التجديد؛ فلن يكون تجديد للعقل الديني ولوثة الروح باقية كامنة، والعقل نفسه معطل عن الوعي والفهم والتصحيح.
ومن لم يتخذ من القرآن هداية روح ورقيّ سريرة فلن يقتدر على القيام بمهمة الدعوة الدينية في الإسلام، ولا يمكن لهذه الأمة أن تقوم في رأى الأستاذ الإمام إلا بالروح التي كانت في القرن الأوَّل قبل ظهور الخلاف وحلول الفتن وهى "رُوح القرآن"؛ وكل ما عداه فهو حجاب بينه وبين العمل والعلم.
وعقيدته هى عقائد كبار المُحَققين؛ أنْ: "ليس وراء القرآن غاية". وفي طلاقة النّص القرآني يقول: "إن خطاب القرآن لا يختصُّ بواقعة، بل يصح أن يكون خطاباً لكل الناس". حقيقةً إنّ اللفظ القرآني ليشع حياة. حياة من نور فيها متاع للعقل، ومتاع للذوق، ومتاع للشعور. حياة تتفتّح فيها الحياة وتنمُ عن مقاماتِ وأحوالِ يصعدُ فيها الضمير مدارج ومراقِي من التّفتُّح الروحي والإدراك الذوقي. حياة تعطى صور الحياة في أصلاب الوجود.
اللفظ القرآني وحده هو الذي يصور الحقيقة، حقيقة تلك الحياة، وحقيقة ما بعد الحياة. وربما تلتمس الحقائق فلا تجد لها دلالة ظاهرة إلا فيما صورته لك تلك الألفاظ القرآنية. إنه ليعبِّر عن العمق الداخلي في أطواء هذا الوجود كله؛ عن الكون كله بما فيه ومَنْ فيه، تعبيراً لا يقف عليه إلا خالق هذا الوجود، سبحانه.
أمّا العبد المخلوق؛ فهو في التصوِّر والتعبير لا يستطيع أن يَتَقَدَّم قيد أنمُلة كيما يمسُّ مثل هذا الغور الدفين المبطون ولو مسَّاً خفيفاً إلا بمقدار ما يقترب من التعبير القرآني، وإلا بمقدار ما يستشعر في اللفظ القرآني من حقائق التصوير وحقائق التعبير.
إن هذا الكتاب لمعجزة في لفظه وفى معناه؛ وإنه لوثيقةٌ ربَّانيةٌ عظمى تدلِّل على رفعة المقاصد، وسمو الأهداف، ونُبْل القيم، وبقاء الحقائق، وشرف الغايات؛ لكل من يحفظ منه اللفظ فيعرف تباعاً معناه؛ فيتحرك ـ من ثمَّ ـ في الحياة على هداه.
هذه "الحركة" لاشك هى المطلوبة من فهم كتاب الله، وليس المطلوب كثرة التشدُّق به في غير حركة، وفى غير تغْيير من واقعات الحياة.
يُلخِّص الأستاذ الإمام هذه المعاني ليعطينا من قوله زُبْدتها حين ينص على:"إن لكلام الله أسلوباً خاصَّاً يعرفه أهله، ومن أمتزج بلحمه ودمه. وأمّا الذين لا يعرفون منه إلا مفردات الألفاظ وصور الجمل فأولئك عنه مبعدون". وفي معناه أيضاً أنه ما لم ينقلك اللفظ من حالٍ إلى حال، ومن حياة إلى حياة؛ فقلَّ أن يكون لك نصيب من فهم القرآن أو من تقريب معناه إليك إلا في اللحظة التي يمتزج فيها بروحك، ويختلط بدمك على ديدن الطهارة والصفاء والنقاء والذكر والمواصلة والتسبيح. وتلك هى حكمة العارفين التي تمثلها الأستاذ الإمام والفيلسوف الحكيم.
ولم يكن منهجه في التفسير سوى تلك النظرات الثاقبة مع المداومة على قراءة القرآن، وتفهم أوامره ونواهيه، ومواعظه وعبراته، على ديدن الحضور كما كان يتلى على المؤمنين والكافرين أيام الوحى، وإنه لينصح أحد تلاميذه قائلاً:" وحاذر النظر في وجوه التفاسير إلا لفهم مُفرد غاب عنك مُراد العرب منه، أو ارتباط مفرد بآخر خفى عليك متصله، ثم أذهب إلى ما يشخصك القرآن إليه، وأحمل نفسك على ما يحمل عليه، وضمَّ إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية، واقفاً عند الصحيح المعقول، حاجزاً عينيك عن الضعيف والمبذول".
وفى شذرة من شذراته البديعة يلحظ ملحظاً فارقاً مهماً بين من يقرؤون القرآن على الغفلة والجهالة وحظوظ الدنيا، وبين من يقرؤونه للحركة الفاعلة ترقيةً للنفوس وتهذيباً للضمائر وتوعيةً للقلوب فيقول:" معنى عبادة الله بالقرآن عند الجاهلين به: أن يقرأ الشخص ولا يخطر المعنى بباله، ولا يحرِّك نفسه لأوامره ونواهيه".
ولمّا كان القرآن وثيقة تبرهن على أسرار هذا الوجود محفوظة بالبيان الإلهي، البيان الذي لا يأتيه باطل ولا يناله عبر تطاول العصور ضعف ولا هزال طلاقة لا متناهية في نصِّه؛ وفى رُوحه، وفى لفظه ومعناه، صارت أسراره مرهونة بالمحافظة على ألفاظه على شِرعة الأدب والحضور بين يَدِ الله.
وليس المراد باللفظ هنا مُفرد اللفظ ولا بالجملة صورة الجملة، بل المرادُ فهم الكلمة الواردة على ديدن الحضور والعرفان: فهم لمعنى كبير ضخم لا يمكن تغافله ولا حذفه بجرة قلم خبيثة، هو هو المعنى الذي توارثته القلوب العاقلة عن ربها من ميراث النبوة، وتناقلته الطوايا المبدعة عملاً بما فيه من ضخامة المعنى وكبير المضمون؛ فكان أن قال الشيخ محمد عبده في شذرة أخرى مُلفتة ذكية ذات توجه علوي مقصود:"إني عندما أقرأ القرآن أو أتلوه أحسب أنى في زمن الوحي، وأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ينطق به كما أنزل عليه جبريل عليه السلام".
هذا الذي يقوله الإمام محمد عبده من حيثية التركيز المباشر على القرآن الكريم واتصاله بالقارئ التالي الذاكر على الحقيقة؛ باكتشاف الحالة الخاصّة بين القارئ والنص هو في الحقيقة الذي يعالج لنا فكرة التطبيق العملي للدين ممثلة في شرعة القرآن واستخلاص آثارها العمليّة والمعرفيّة في القلوب التي تقرأ، والعقول التي تفكر لا لمجرد القراءة وحدها أو لمجرد التفكير وكفى، ولكن أيضاً لإقامة الدليل الفعلي على اتصال القرآن بقارئه على سعة الحضور والتجرد.
وعندي أن التركيز على تلك الناحية هو جوهر الحركة المطلوبة من القرآن تأتي في إطاره وتبرهن واقعياً على خصوصيته في القلب والضمير، وأن الفكرة من خلاله قائمة على تلك السّعة المباشرة لا على الفكرة المعزولة عن وعي صاحبها بالدين كما يقرّره القرآن على شرعة القرآن.
مرة ثانية؛ هذا الذي يقوله الإمام محمد عبده يكفى وحده للرد على طعنات الغرب التي وصمت الإسلام ونبي الإسلام بالوصمة الجائرة، ولا يزالون يوجهون سهامهم الناقدة نحو الإسلام كونه لديهم يشكل مادة إرهاب وتوحش. ولا شك أن العقل الغربي ينظر نظرة ظالمة ليس فيها عدالة، إلى الدين الإسلامي من حيث هو دين؛ لأن الغربيين في الغالب في معزل عن فهم روح القرآن؛ ولأنهم خلطوا بين واقع المسلمين الحالي وهو الواقع الذي لا يمثل اقتراباً من حقيقة القرآن من جهة، وبين القرآن ونبيِّ الإسلام من جهة ثانية، فلم يفهموا على الحقيقة توجهات الوعي الديني في الإسلام كما قررها القرآن الكريم، وفاتهم معالجة الفروق الفارقة بين العقيدة الدينية الإسلامية وبين تطبيق هذه العقيدة على نحو عملي كان من المفروض تمثيله في واقع المسلمين اليوم.
(٥) الإسلام والغرب:
وإذا تسألنا من واقع هذه النقطة عن ذلك الذي يريده الغرب من الإسلام، كانت الإجابة أن الذي يكفي الغرب من الإسلام هو السلوك العملي، وشريعتا تقول: الدين المعاملة. وبهذه المثابة صارت الدعوة في الإسلام دعوة عملية تطبيقية لا تركن إلى نظر مجَرَّد عن اللواحق العمليّة.
ومن المستشرقين رجالٌ شهدوا للإسلام بتلك الأخلاق العملية، حتى أشدَّهم تعصباً وأكثرهم إيغالاً في الإجحاف على المسلمين: أعني ذلك المستشرق اليهودي الأصل "إجناس جولد تسهير"، الذي لم يستطع إنكار مبادئ الإسلام القويمة رغم مغالاته في التقييم والتقدير وإخفاقاته الناتجة عن تلك المغالاة، لكنه ظل على فكرته التي أرجع فيها أن المسلمين يكتسبون من القرآن الفضائل، وأن للقرآن أثره العظيم على سلوك المسلم في حياته الخاصّة والعامة، وفي حياته مع الآخرين، ممّن لا يعتقدون نفس اعتقاده، وفي ذلك قال في كتابه "العقيدة والشريعة في الإسلام":" ... وعلينا إنْ أردنا أن نكون عادلين بالنسبة إلى الإسلام، أن نوافق على أنه يوجد في تعاليمه "قوة فعالة" متجهة إلى الخير، وأن الحياة طبقاً لتعاليم هذه القوة يمكن أن تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهة الأخلاقية.
هذه التعاليم تتطلب رحمة جميع خلق الله، والأمانة في علاقات الناس بعضهم ببعض، والمحبّة والإخلاص، وقمع الغرائز والإثرة، كما تتطلب سائر الفضائل التي أخذها الإسلام عن الأديان السابقة. ونتيجة هذا كله؛ فإنّ المسلم الصالح يحيى حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه الأخلاق" (أ. هـ).
لكأنما الأخلاق بهذه المثابة وُجدت في الإسلام على الصورة المثلى حيث لا ترتقي إليها صورة ـ خلافاً للرأي السالف ـ لا في الأديان السماوية الأخرى ولا في الحضارات السابقة عليه. وليس هذا قط من جنس التعصُّب ولكنه الإنصاف الذي لا مبالغة فيه ولا تهويل، وإنْ يكن ها هنا تعصب، فهو التعصب الذي حَفَلَتْ به سوء النية من أقوال بعض المستشرقين، وإنْ كانوا قد أرادوا أن ينصفوا الإسلام غير أنهم بهذا الإنصاف أثاروا حفيظة بعض رجال الدين المسيحي؛ أولئك الذين لهم نصيبٌ ممّا كسبوا من تعصب لدينهم غير منصفين.
من ذلك ما قاله "جوستاف لوبون": " لو صَحَّ أن يكون للأديان ما يعزى إليها من تأثير لوجب أن نقول إنَّ القرآن أفضل من الإنجيل؛ لأن أمم الإسلام كانت أسمى أخلاقاً من أمم النصرانيَّة "(!)
(وللحديث بقيّة)
***
د. مجدي إبراهيم