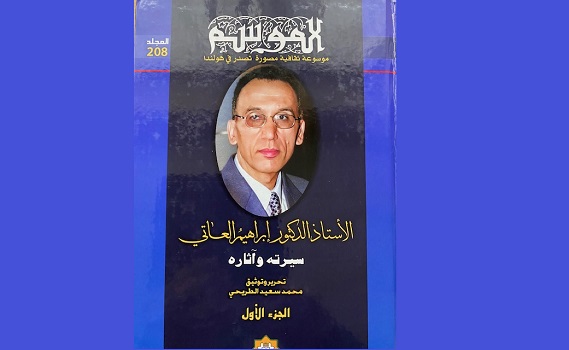قضايا
عبد الأمير كاظم زاهد: التاريخ الاقصائي ونشأة الطائفية

تعقيبا على مقال الأستاذ محمد محفوظ عنونه بالطائفة المعكوسة. اود أولا الإشادة أولا بأدبيات تقويض النزعة الطائفية المدمرة لمجتمعنا، بيد اني اسجل إضافة على البحث ان تجربة المسلمين – مباشرة بعد النبي – كانت تجربة تحمل نفسا سياسيا فيه قدر من من التعامل البشري مع المعارضين وقد تحولت الى سياسات عدائية اقصائية متعمدة ابان العصر الاموي ليس فقط ضد المخالفين لاشتراطات مذهب السلطة، انما يذكر التاريخ اقصاء بالغ الشدة ضد غير العرب – وان كانوا ممن اسلموا لله وامنو بالنبي محمد (ص) واطلق السلطات عليهم اسم (الموالي) وهو مشتق من الولاء المفروض عليهم سياسيا وقد فرض عليهم ان يلتحقوا بإحدى القبائل العربية – كأعضاء من الدرجة الثانية، ورغم انهم عوضوا هذا الشعور بالنقص انهم تمكنوا من احتلال ناصية المعرفة فكان اغلب رجال المعرفة الدينية منهم، و كان اغلب المتمردين على سلطة بني امية بثورات متعددة منهم فقد انضموا للثورات لشعورهم بالإقصاء للدعوى العباسية التي رفعت شعار مظلومية ال البيت (ع)
وتشير كلمة الموالي الى معنى الحلفاء والعبيد المحررين من الرق وهم من الخدم وقد تكونت هذه الطبقة نتيجة الفتوحات، وقد عانوا من تفضيل السلطة للعرب عليهم لان السلطة آنذاك نظرت لهم انهم اقل مرتبة فعانوا من الحجر الوظيفي في المهام العسكرية والإدارية، واقتصرت أعمالهم على المهن العادية التي كان العرب يعتبرونها أفعالا مهينة فمورست ضدهم ابشع نزعات عنصرية لان المصطلح كان مرتبطا بلفظ العبودية، ونودي عليهم احيانا ب (العلوج)
وكان الحجاج بن يوسف الثقفي قد منعهم من السكنى بالمدن وابقاهم في القرى (1) وقد التفت الى سياسة التميز الاموي ضد الموالي عدد من المستشرفين (2) والباحثين (3)
ومن الغريب ان الفكر السلفي يدافع عن سياسة الامويين ضد الموالي ويتوسل بحالات نادرة من صعود بعض الأشخاص لمراتب عالية من الموالي ويستخدمه كدليل على نقض المتفق عليه عند المؤرخين من نزعة الامويين العنصرية ضد الموالي فقد كانوا يستخدموهم في الحرب ولا يعطونهم من المغانم (4) لقد كانت استمرارا للنزعة العصبية ضمن التكوين السيكولوجي للعرب قبل الإسلام، ولم تستطيع التربية الإسلامية، تفكيك تلك النزعة تفكيكا كاملا، فقد منع الموالي من الزواج بالمرأة العربية لاسيما القرشية (5) ولان لكل فعل ردة فعل فكانت الدعوى الى الشعوبية كطائفية تاريخية معكوسة فهي تنادي بتفضيل العجم على العرب او التسوية بينهما، على صعيد اخر كان بنو هاشم من الفرع القرشي يواجهون الاضطهاد مما اضطرهم الى القيام بعدة ثورات وقد فشل اغلبها وادت الى زيادة في الاقصاء والتشريد والملاحقات ولعل من تداعيات الاضطهاد الطائفي لبني هاشم ان (حدث عاشوراء) صار (طقسا دينيا) معبرا عن رفض تلك الإقصائية فكانت اقنوما للهوية والمعنى، وقد استثمر العباسيون الاحتقان الهاشمي واحتقان الموالي فاستأصلوا مع انتصار العباسيين شافه الامويين فكانت الطائفية السياسية للأمويين فكان مشهدا اشتبكت فيها القبلية والسلطة وتحولت هذه الارادات الى عقائد اضافت عنصرا ميتافيزيقيا على التاريخ وتوسعت بسببها الصدوع واختزنت الذاكرة قصصا مؤلمة من المظلوميات والمعاني التي تثير الحزن والكراهية .
اذن المشكلة ليست معاصرة وهي وان كانت بسبب التعمد في رسم سياسات أدارة التنوع منذ العصر الاموي واضطهاد الأقلية العربية للموالي و تحكم اقلية بني امية بالناس وتسليط الضغوط الشديدة على المعارضين لهم بيد اننا حين نوافق الباحث في تسبيب القصور والعجز في إدارة التعددية، الا ان الطائفية (نزعة) تولد أيدولوجيات واعتقادات تصل أحيانا الى مغالطات وتشويهات وتزيف للحقيقة التاريخية فتجد كثيرا من المعاصرين يجهد نفسة في تبرئة بني امية من الفظائع العنصرية والأيدولوجيات الطائفية وكمثال تبرئة الحجاج الثقفي من جرائم القتل التعسفي، فخيارات إدارة التعدد ناشئة من الفكر الطائفي الأقصائي وعليه يلزمنا تشريعات قانونية حازمة في لجم الخطابات الطائفية من اين كان مصدرها
ان الخطورة في استمرار النزاعات الطائفية المدمرة تكمن في البحث غير العلمي وغير الموضوعي في التاريخ، وقلب الحقائق التي وثقتها المصادر التاريخية التي كتبت تحت عين السلطان آنذاك، لذا فان تطوير منهجنا في دراسة التاريخ الإسلامي والغاء الاسبقيات المذهبية والرواسب التاريخية المنحازة يعد علاجا مهما في تكوين العقل المعرفي
ان تشخيص الخطأ بل الخطيئة في إدارة التنوع في تجربتنا التاريخية يلزم ان يكون معه عملية انهاء قضية الأغلبية والأقلية وما يترتب عليها من اقصاءات واستبدالها بمفهوم اخوة الدين (انما المؤمنون اخوة) او اخوة الوطن (المواطنة) من دون ان تكون الخصوصيات الاثنية (صفة) للتفضيل او الاقصاء
ومن الناحية الأخلاقية ومن مبادئ الشرف ان لا نبرر تاريخ التسلط الديني والمذهبي والسياسي وندافع عنه بالإنكار القبيح للمعطيات التاريخية او تشوية تلك الحقائق سواء كانت لنا او علينا، والتعامل بحذر شديد لأجل بناء مجتمعات رفيعة بالكشف عن التخريب الاجتماعي الذي ينتج عن بعض المدونات التاريخية لاسيما كتب الفرق والمقالات
ثمة مسالة أخرى: وهي الاقصاء المعاصر لمجرد المخالفة بالراي، و ان كان هذا الاقصاء كان واقعا متأصلا في الأزمنة المتقدمة فحسبك ما جرى لائمة المذاهب الفقهية ولعشرات من العلماء والمفكرين من جانب المغلوبين طائفيا يجب ان نرشد قيمة التسامح مع من يخالفنا الراي ونعول على البرهنة العقلية
ان طبيعة الخطاب الذي يجب ان نعتمده ذلك الذي يركز على محاسن رؤيتنا دون الإساءة للغير، وبيان ظلامتهم دون تجريح عاصف لان الغالب يحتقن بالإدانة فلا بد من حكمة وجدل بالتي هيه أحسن
ومن جه ثالثة: فان المغلوبين طائفيا ستنمو لديهم مشاعر العزلة والانكفاء وعدم المشاركة في الحياة الاجتماعية لمن يختلف عنهم قوميا
نلاحظ توسيع دائرة المقدس عند المغلوبين، والمغالاة في الطقوس المذهبية تأكيدا للذات المقصاة والمضطهدة وتوظيف هذا (المقدس المغالى به) لتحشيد الناس ضد خصومهم
يلاحظ: أيضا ان الجهة المغلوبة طائفيا تقف من التجديد أيا كان موقفا متشككا فيه، لان الجهد والأولوية يجب ان تنصب حول المغلوبية
ان ذلك كله ينتج عنه مجتمعا متدينيا في وعيه وتراه ساخطا يعاني من صعوبة في خلق قيم التسامح والانسجام بين التنوعات الاجتماعية
اذن: المشكلة ليست معاصرة حتى نقول انها ناتجة عن القصور في إدارة التنوع، انما المشكلة في العقل الأيديو لوجي الذي أنتجتها المدونات التاريخية التي وثقت الممارسات الطائفية الاقصائية وبررتها سواء من الجماعات اوالسلطة والحكام او من فقهاء التفتيت المجتمعي وكتاب الفرق والمقالات والمدونات الكلامية. فالمشكلة في (مضامين التراث) التي يجب ان تعالج بدقة ومقاصدية معاصرة والاكثار من الكتابات النقدية لها وتخليص او تحرير العقل من (نزعة الطائفية والعنصرية) ونزاعات قمع الاخر المختلف
***
ا. د. عبد الأمير كاظم زاهد
.................................
(1) ظ الطبري: 8/35، المبرد: الكامل ص 286
(2) فون كريم، فان فلوتن
(3) جرجي زيدان، حسن إبراهيم حسن، الخربوطلي
(4) ظ المسعودي / مرج الذهب 2/ 254
(5) العقد الفريد 2/ 249