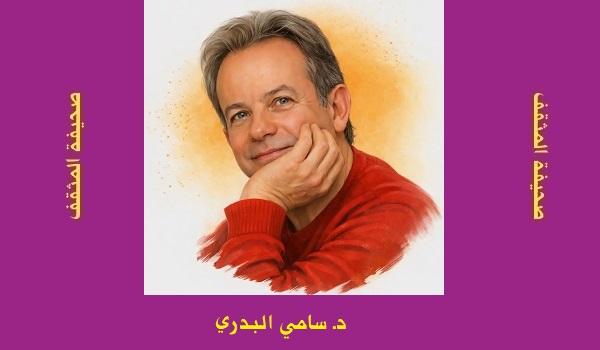قضايا
مازن جراي: قيمة الإنسان في عالم تحكمه الأرقام.. من الذات إلى الرمز
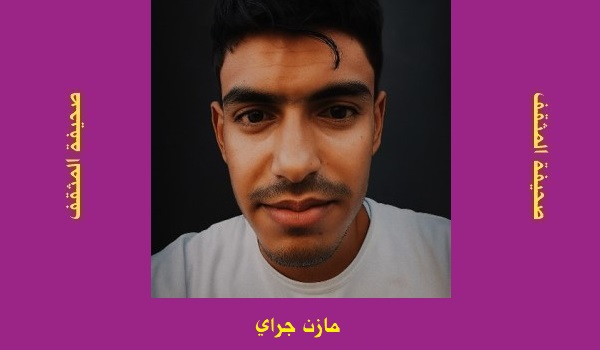
المقدمة: في عالمٍ يزداد تجريده يومًا بعد يوم، يتحول الإنسان تدريجيًا من كينونة حرة ومعقدة إلى مجرد رقم في سجل، رمز يُختزل إلى بيانات في أنظمة لا تعترف إلا بالكفاءة والإنتاجية. قيمته لا تُقاس بعدله أو إنسانيته، بل بما يضيفه إلى مؤشرات السوق، أو بما يستهلكه في معادلات الحرب والسياسة. الذات، بهذا الشكل، تذوب في بحر من الأرقام التي تُعيد تشكيله، فتغدو حياة الفرد مجرد خانة تُملأ، وتُرتّب بحسب جداول وبرامج لا تميز بين دمعة وفائدة.
هل يمكن لهذه الحسابات الباردة أن تحتضن عمق المعنى الإنساني؟
هل يتحول الإنسان إلى شيء أقل من إنسان حين تُختزل حياته إلى أرقام لا تحمل سوى بيانات؟
وهل ثمة سبيل لاستعادة تلك القيمة التي ترفضها معادلات السوق والحرب والسيطرة؟
هذه الأسئلة تشكل نسيج رحلتنا في تأمل هذه الأزمة الوجودية المعاصرة، حيث سنحاول فهم كيف تحوّل الإنسان إلى رقم، وكيف يمكن مقاومة هذا الاختزال لاستعادة كرامته وقيمته الحقيقية.
من الكينونة إلى الكمية
في بدايات الفكر الإنساني، كان الإنسان يُنظر إليه ككائن يحمل في ذاته معنى خاصًا، لا يُختزل في وظيفته، ولا يُقاس بمدى إنتاجه أو خضوعه للأنظمة. كان الإنسان هو الذات التي تفكّر، تشعر، وتختبر الوجود بكل ما فيه من تعقيد وتناقض. لكن مع صعود العقل الأداتي وهيمنة النزعة الكمية، بدأ هذا الكائن يتحوّل تدريجيًا إلى وحدة قابلة للقياس، إلى شيء يمكن تصنيفه وترقيمه وتبويبه في جداول الإحصاء وتقارير الأداء. لم تعد الذات محلّ اعتبار، بل ما تتيحه من منفعة، وما يمكن استخلاصه منها بأقل كلفة وأكبر جدوى. أصبح الإنسان رقمًا في لائحة المستفيدين، رقما في سجلّات الضرائب، رقما في إحصاءات الحرب، رقما في تقديرات المستشفيات، بل حتى في موته لم يعد يُرى إلا كإشارة على منحنى بياني. وهكذا، صارت الكينونة تُمحى على مذبح الكمية، والإنسان يُفرغ من جوهره ليُعاد إنتاجه كمعطى رقمي محايد لا ذات له ولا مصير.
الإنسان كرقم في سجلّ: البيروقراطية ونزع الوجوه
في دهاليز البيروقراطية، لا يعود الإنسان اسماً أو قصةً أو ألماً، بل يصبح رقماً يتجوّل بين المكاتب، وورقةً تنتظر توقيعاً في درجٍ بارد. تنزع الآلة الإدارية وجهه لصالح رمزه، وتختزل تعقيد وجوده في خانةٍ تُملأ وتُؤرشف. لا أحد يسأل عمّن يكون، بل عمّا يمثّل في النظام: رقم الضمان، رقم الملف، رقم الغرفة. هذه البنية الحديدية لا تتيح المجال للخصوصية، بل تفرض حياداً قاتلاً، حيث لا مكان للتفرد أو المعاناة أو التمايز. حتى اللغة تتبدّل: لا يُقال "امرأة أنهكها المرض"، بل "الحالة رقم ١٤٢"، ولا يُقال "رجلٌ ينتظر معونة"، بل "الطلب ٣٨٧/أ". الإنسان هنا لا يُرى، بل يُستخرج، يُعدّ، يُحسم، ثم يُنسى. وهكذا تتكرّس سلطة غير مرئية تُفرغ الوجود من دفئه وتحوّل حضور الفرد إلى وظيفة ضمن سيرورة لا تعترف إلا بما يمكن ضبطه وتكويمه داخل ملفات. البيروقراطية، في جوهرها، ليست فقط تنظيماً إدارياً، بل مشروع لنزع الوجوه وتفريغ المعنى من العلاقة بين البشر.
الإنسان كرقم في الحرب: الإبادة على طريقة الجداول
في زمن الحرب، يُختزل الإنسان إلى خانة إحصائية لا تُشير إلى ألمٍ أو خوف، بل إلى خسارة محتسبة أو نصر محتمل. لا يُنظر إلى الأجساد المتناثرة ككائنات كان لها بيت، وذاكرة، وأغنية مفضلة، بل كأعداد في تقارير "الخسائر البشرية" أو "الأهداف المحققة". يُقتل الإنسان مرّتين: أولى بصاروخ، وثانية بجملة باردة في بيان عسكري يعلن سقوط "خمسة عناصر"، وكأنهم لم يكونوا إلا ظلالاً بلا حياة. في هذا المشهد، لا مكان للفرد، بل للعدد، ولا قيمة للصوت، بل للنتيجة. الجداول تُدار بدمٍ بارد، تُوازن بين عدد القتلى وعدد الطائرات، بين تكلفة الذخيرة وقيمة الموقع، في محاكاة مروّعة لتحييد المأساة خلف معادلات تشغيلية. حتى صور الضحايا تُستخدم لتغذية خطاب القوة أو المظلومية، لا باعتبارهم بشراً سُلبوا حياتهم. هكذا، تتحوّل الحرب إلى مصنع أرقام، والإبادة إلى عملية إدارية لا تختلف، من حيث البنية، عن ترتيب ميزانية أو تحديث قاعدة بيانات. والإنسان، وسط هذا كله، يصبح رقماً يُمحى بمجرد أن يُحتسب.
الإنسان في ميزان السوق: الرأسمال البشري وتسليع الذات
في قلب السوق، لم يعد الإنسان يُقاس بما هو عليه، بل بما يمكن أن يُدرّه. لم يعد كائناً يبحث عن المعنى، بل مشروعًا استثماريًا يتحرك بين مؤشرات الأداء وتقييمات الكفاءة. يُعاد تشكيل الذات لتتناسب مع متطلبات العرض والطلب، وتُهذَّب الأحلام لتتماهى مع السير الذاتية، فيتحوّل الفرد إلى سلعة تسوّق نفسها بلغة المهارات القابلة للتداول، لا بلغة القيم أو العمق. وهكذا، تُختزل الهوية إلى حزمة من الكفاءات، والوجود إلى وظيفة، والكرامة إلى قابلية التوظيف. يُنظر إلى الجسد باعتباره آلة إنتاج، وإلى الذهن كموارد فكرية يُستنزف لاكتساب "قيمة سوقية". في هذه المنظومة، تتلاشى الحدود بين الداخل والخارج: المشاعر تُضبط لتناسب ثقافة المؤسسة، والانفعالات تُبرمج كي لا تعرقل سير الخطط الاستراتيجية. الذات، في هذا السياق، لا تُصاغ من الداخل، بل تُفصَّل وفق معايير السوق، فيفقد الإنسان استقلاله الداخلي ويغدو قالبًا قابلًا للتشكيل وفق رغبة المستهلكين أو أرباب العمل. تسليع الذات لا يعني بيع الجسد فحسب، بل تسويق كامل الوجود كخدمة تحت الطلب. وبين الرغبة في البقاء والخشية من التهميش، يُضحّي الإنسان بجوهره كي لا يخرج من المعادلة.
نقد فلسفي: هل يمكن للأرقام أن تحتوي المعنى؟
في جوهر السؤال يكمن التباس عميق: هل الأرقام، بطبيعتها المحايدة والكمّية، قادرة على احتواء المعنى، الذي هو بطبيعته كثيف، رمزي، ملتبس، وملون بالتجربة؟ الأرقام تختزل، تصنّف، تفرز، لكنها لا تنصت ولا تشعر. يمكنها أن تحصي عدد الضحايا، لكنها لا تستطيع أن تروي وجع أمّ فقدت طفلها. تستطيع أن تقيّم أداء موظف بدقة عشرية، لكنها تعجز عن فهم قلقه الوجودي. في عالم مهووس بالقياس، يبدو أن الإنسان قد رضي بألا يُفهم إلا بما يمكن عدّه، كأن المعنى الحقيقي صار شبهة أو ترفًا. غير أن ما يجعل الكائن البشري إنسانًا لا يُقاس: الحب، الخوف، الحنين، الذكريات، الكرامة، كلّها عصيّة على التكميم. المعنى، في جوهره، مقاومة ضد الاختزال. إنه ذلك الفائض غير القابل للتفسير، الذي يهرب دومًا من قبضة الأرقام. فكل محاولة لإخضاعه للكمّ، هي تقويض لثرائه وتعدديته. ومن ثمّ، فإن الركون إلى الأرقام بوصفها أدوات للفهم المطلق، ليس إلا ضربًا من العمى الإرادي، يُطمئن به العقل نفسه لأنه عجز عن معانقة الغموض.
مقاومة الاختزال: استعادة القيمة الإنسانية
في وجه هذا الانزلاق نحو الكمّ، تبرز الحاجة إلى مقاومة هادئة، عميقة، لا تُعلن نفسها بالشعارات بل تُمارَس كفعل وجودي. مقاومة للاختزال، لا تستند إلى العنف بل إلى إحياء السؤال: ما الذي يجعل الإنسان إنسانًا؟ ليست المسألة استبعاد الأرقام، بل رفض هيمنتها على المعنى. أن نستعيد الإنسان من سجلات الحرب، ومن تقارير الأداء، ومن نسب النمو، يعني أن نعيد إليه صوته، ووجهه، واسمه. أن ننتصر لما لا يُقاس ولا يُحدّ: للدمعة التي لا تظهر في بيانات وزارة، ولرعشة اليد التي لا تحصيها أنظمة الجودة. استعادة القيمة الإنسانية تبدأ من الاعتراف بأن الإنسان ليس أداة، ولا مورِدًا، ولا وحدة إنتاج، بل كائن يتجاوز كل ما يُقال عنه، كل ما يُحسب له، وكل ما يُبنى فوقه. أن نمنح الأولوية لما هو نوعي على ما هو كمّي، لما هو عميق على ما هو سطحي، هو الطريق لئلا نتحوّل إلى مجرد ظلال في جدول بيانات.
هكذا، في عالمٍ يتكلم لغة الأرقام، ويقيس الوجود بمسطرة الربح والخسارة، تبدو كينونة الإنسان مهددة بالتآكل الصامت. لا يعود الفرد إنسانًا بل حالة، نسبة، معدل، قيمة مضافة أو عبئًا إحصائيًا. لكن هذا الاختزال لا يخلو من ثغرات؛ ففي الهامش، حيث لا تضيء شاشات البيانات، يستمر الإنسان في التذكير بأنه أكثر من رقم. في الحزن الذي لا يُقاس، في الحب الذي لا يُترجم إلى مؤشر، في الصمت الرافض للانضواء، تتجلّى المقاومة الأعمق. لعل استعادة القيمة الإنسانية لا تكون في رفض التقنية أو الأرقام ذاتها، بل في تحريرها من أوهام الحياد وإعادة توجيهها نحو خدمة الإنسان لا ابتلاعه. وحدها الأسئلة الفلسفية التي لا تنطفئ، القلقة، المتمردة على السكون، قادرة على أن تفتح منفذًا في جدار النظام. ففي النهاية، قد لا يكون خلاص الإنسان في عدّ نفسه بدقة، بل في أن يُنصت لصوته حين يرفض أن يُعدّ.
***
بقلم الكاتب التونسي: مازن جراي