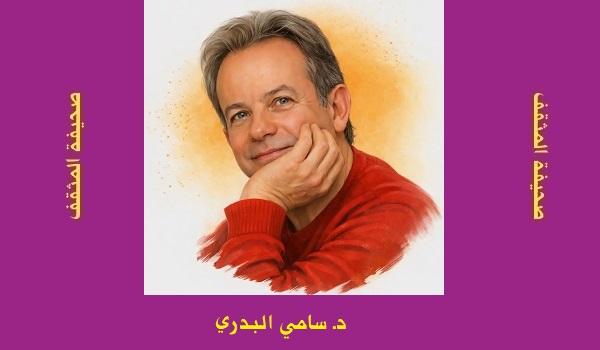قضايا
غالب المسعودي: العواقبية، النفعية، والفلسفة الاستعمارية المعاصرة

تفكيك الأيديولوجيا والتبرير
إطار المفاهيم والجدل الفلسفي: تُعدّ الفلسفة الأخلاقية مجالاً غنيًا بالنقاشات حول معايير الحكم على صواب الأفعال من خطئها. ضمن هذا المجال، تبرز العواقبية والنفعية كأطر نظرية محورية، ترتكز في جوهرها على نتائج الأفعال لتحديد قيمتها الأخلاقية. وعلى الرغم من أن هذه المذاهب تُقدَّم غالبًا في سياقات مجردة، إلا أن تحليلها في ضوء الممارسة التاريخية يكشف عن أبعاد أيديولوجية عميقة، خاصةً في سياق الفلسفة الاستعمارية المعاصرة.
تتمثل الأطروحة المركزية في أن النفعية، كشكل محدد من العواقبية، لم تكن مجرد إطار أخلاقي بريء، بل وُظِّفت بشكل منهجي كأداة أيديولوجية لتبرير الاستغلال والهيمنة. يرتكز هذا التبرير على منطق أحادي الجانب وذاتي، يقوم على حساب "المنفعة" من منظور المستعمِر وحده، متجاهلاً معاناة الشعوب المُستعمَرة وتدمير هوياتها. إن تحليل النقد الذي وجهته دراسات ما بعد الاستعمار لهذا الخطاب يُسلّط الضوء على التناقضات الجذرية بين مبادئ الغرب الأخلاقية المعلنة وممارساته الفعلية، مما يوضح أن الفلسفة الاستعمارية المعاصرة ليست مجرد انحراف عن القيم الغربية، بل هي تجلٍ طبيعي لمنطق نفعي متجذّر في الأنانية والمركزية.
تأصيل المذاهب الأخلاقية: العواقبية والنفعية
العواقبية (Consequentialism): المبدأ والمدى
تمثل العواقبية فئة واسعة من النظريات الأخلاقية التي ترى أن عواقب السلوك هي الأساس النهائي للحكم على صوابه. بعبارة أخرى، الفعل الصائب أخلاقيًا هو الذي يؤدي إلى "نتيجة جيدة". تتطلع هذه الفلسفة إلى المستقبل، حيث يعتمد ما ينبغي فعله على العواقب المستقبلية، لا على ما حدث بالفعل. هذا التوجه يميزها جوهريًا عن المذاهب الأخلاقية الأخرى.
العواقبية ليست نظرية واحدة موحدة، بل هي مظلة تجمع تحتها العديد من الأشكال التي تختلف في تحديد "ما هو جيد". على سبيل المثال، يمكن للعواقبية أن ترى أن قيمة النتائج تعتمد على أشياء أخرى غير الرفاهية أو السعادة الكلية، مثل العدالة والإنصاف والمساواة. هذا التنوع في تحديد القيمة النهائية يمنح العواقبية مرونة أكبر من النفعية. على النقيض، تركز أخلاقيات الواجب على طبيعة الفعل نفسه بغض النظر عن عواقبه، بينما تختلف العواقبية عن أخلاق الفضيلة التي تركز على تنمية التصرفات الفاضلة في الشخصية، بدلاً من التركيز على طبيعة الفعل أو عواقبه.
النفعية: أشهر أشكال العواقبية
تُعتبر النفعية أشهر وأكثر أشكال العواقبية تأثيرًا. مبدأها الأساسي هو أن الفعل يكون صحيحًا أخلاقيًا إذا كان ينتج أكبر قدر من السعادة أو المنفعة الشاملة لأكبر عدد من الأفراد. بينما يمكن للعواقبية أن تأخذ في الاعتبار قيمًا متعددة مثل العدالة، فإن النفعية تُبسّط هذا المفهوم إلى معيار واحد: "المنفعة الكلية". هذا التبسيط هو ما يجعلها، كما سيتضح لاحقًا، أداة قابلة للاستخدام في التبرير الأيديولوجي.
ضمن النفعية نفسها، توجد فروقات دقيقة. فالنفعية السلبية، على سبيل المثال، هي شكل من أشكال العواقبية السلبية التي تعطي أهمية أكبر لتقليل المعاناة بدلاً من تعظيم السعادة. يظهر هذا التمييز في فلسفة (جورج إدوارد مور وإنجمار هيدينيوس) *، حيث رأى مور أن "وعي الألم الشديد هو بحد ذاته شر عظيم" بينما "مجرد وعي اللذة، مهما كانت شدته، لا يبدو بحد ذاته خيرًا كبيرًا". كما يختلف منهج النفعية بين نفعية الفعل التي تركز على عواقب الفعل الواحد، ونفعية القاعدة التي تحدد القواعد الأخلاقية بناءً على العواقب المتوقعة من اتباع هذه القواعد بشكل عام. يمثل هذا النهج الأخير محاولة لسد الفجوة بين العواقبية وأخلاقيات الواجب، حيث يبرر القواعد الأخلاقية من خلال النتائج التي تنتجها على المدى الطويل.
رؤى متعمقة وتحليل نقدي
يكمن السبب الذي جعل النفعية تحديدًا، وليس العواقبية بشكل عام، أداة قوية في التبرير الاستعماري، في بساطة وقسوة معيارها. العواقبية مفهوم عام يمكن أن يستوعب قيمًا متعددة مثل العدالة والإنصاف، لكن النفعية تُبسّط هذا المفهوم إلى معيار واحد: "المنفعة الكلية"، وهذا التبسيط هو ما يحوّلها من إطار فلسفي إلى أداة حسابية.
التركيز على "الكلية" يفتح الباب أمام تبرير التضحية بسعادة مجموعة معينة (المُستعمَرين) من أجل تحقيق منفعة أكبر للكل (المُستعمِر). هذا المنطق يحوّل الاستغلال من فعل غير أخلاقي إلى "حساب أخلاقي" يتم فيه تبرير الأذى كجزء من عملية تحقيق منفعة أكبر. في هذا السياق، يصبح استغلال ثروات الشعوب المُستعمَرة وإخضاعها سياسيًا وقمعها "أفعالًا مبررة" طالما أن المحصلة النهائية، من وجهة نظر المستعمِر، هي منفعة تفوق التكلفة. هذا يتناقض بشكل صارخ مع أخلاقيات الواجب، التي يمثلها فكر كانط، والتي ترفض منطق النتائج وتؤكد على ضرورة احترام الإنسان كغاية في حد ذاته، لا مجرد وسيلة. إن إدراج أخلاقيات الواجب يكشف لماذا تم تبني المنطق النفعي في سياق الاستعمار: لأنه يبرر ما لا يمكن لأخلاقيات الواجب تبريره.
النفعية كقناع أيديولوجي
تتجاوز العلاقة بين النفعية والاستعمار مجرد الصدفة؛ إنها علاقة بنيوية. المنطق النفعي يمنح الاستغلال والاستيلاء على الموارد قناعًا أخلاقيًا، حيث تُبرّر أعمال العنف والقمع على أنها خطوات ضرورية لتحقيق "خير أكبر."
لم يختفِ المنطق النفعي مع نهاية الاستعمار المباشر، بل تحول إلى أشكال جديدة من الهيمنة، تُوصف بالاستعمار الجديد، التي تفرض السيطرة من خلال آليات غير تقليدية. هذه الأساليب تخدم المصالح النفعية للدول الاستعمارية مع إبقاء مظهر الشرعية الدولية. على سبيل المثال، تُستخدم شعارات الدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الدكتاتورية لتبرير الغزو والتدخل العسكري. المنفعة المعلنة هي "تحرير الشعوب"، بينما المنفعة الفعلية هي السيطرة على الثروات وزرع العملاء لضمان الولاء السياسي. وتُستخدم هيئات مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لفرض سياسات تخدم مصالح الدول الكبرى تحت غطاء "إيجاد السلام" أو "المساعدة الإنمائية".
النقد ما بعد الاستعماري
إن النقد ما بعد الاستعماري لا يقتصر على الممارسات الاستعمارية نفسها، بل يتحدى الأسس الفلسفية التي أنتجتها. يرى مفكرون مثل جاك دريدا أن الفلسفة الغربية، بما في ذلك العواقبية والنفعية، تعاني من "مركزية الذات"، ما يعني أن الغرب يضع نفسه في "المركز" باعتباره المعيار الوحيد للعقلانية والتقدم، ويحدد "المنفعة" بناءً على رؤيته الذاتية. هذا المنطق الذاتي يقود إلى تفكير ذرائعي يحدد الجانب الأخلاقي في "المنفعة الذاتية". الفلسفة النفعية، في هذا السياق، ليست مجرد نظرية أخلاقية، بل هي تجلٍ لهذا التفكير الذاتي الذي يرى أن "المنفعة" هي ما يقرره "المركز" لا ما يقرره "الآخر". هذا يفسر لماذا يظهر تناقض صارخ بين المبادئ المعلنة للغرب (الديمقراطية، العدالة) وممارساته الفعلية. يوضح النقد ما بعد الاستعماري أن هذا التناقض ليس مجرد "نقص في التطبيق"، بل هو نتاج طبيعي لأيديولوجيا متجذرة في الأنانية والمركزية.
إرث الماضي وتحديات الحاضر
يُظهر تحليل العلاقة بين العواقبية، النفعية، والفلسفة الاستعمارية المعاصرة، أن النفعية تحولت من نظرية أخلاقية محايدة إلى أداة أيديولوجية قوية لتبرير الهيمنة. قدمت العواقبية الإطار العام الذي يركز على النتائج، ولكن النفعية تحديدًا هي التي وفرت المعيار القابل للتطبيق في السياق الاستعماري، من خلال إعادة تعريف "المنفعة" لتخدم مصالح المستعمِر وحده. لا يزال هذا المنطق حاضرًا في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث تُستخدم مفاهيم مثل "التقدم" و"الحضارة" و"الديمقراطية" لتبرير التدخلات والسيطرة الاقتصادية. إن ما تصفه دراسات ما بعد الاستعمار بالاستعمار الجديد هو امتداد طبيعي للمنطق النفعي الذي يرى أن "الغاية تبرر الوسيلة"، حتى لو كانت الوسيلة هي استغلال الشعوب وامتصاص دمائها.
***
غالب المسعودي