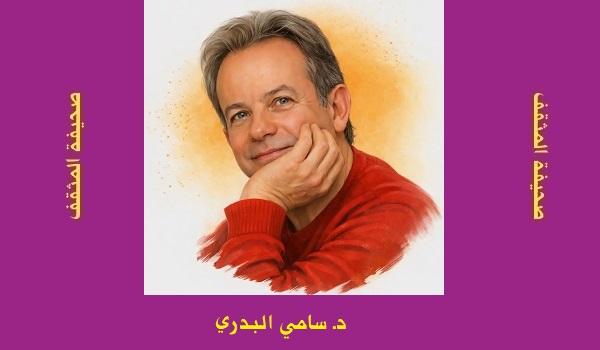قضايا
ليلى تبّاني: الوقوف على حافّة الكون.. باشلار، درويش، اينشتاين
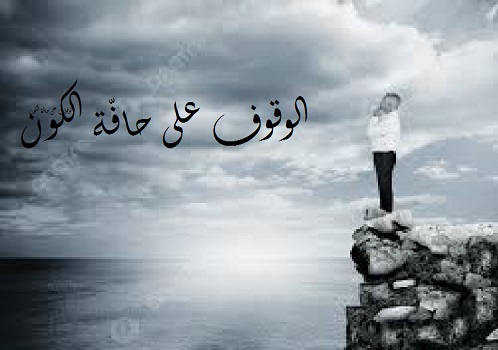
مقاربة تحليلية لكتاب "جماليات المكان" لغاستون باشلار
بين الشعر والفلسفة والعلم نقطة اهتزاز كوني، نقطة يشعر فيها الإنسان أنه لا يقف في غرفة، ولا في وطن، بل على حافة بين الوجود والعدم، ذلك الوقوف الذي يجعلنا نرى جمالية المكان وشعريته ومداه .
إنّه و في العتبة الأولى التي يلج منها الوعي باب الفهم، لم يكن المكان سوى ارتعاشة في صدر الوجود، مجرد ظلّ يبحث عن كتف يسنده. ومن تلك العتبة دخل غاستون باشلار يمشي بين جدران الذاكرة، يلمس البيت كما يلمس كاهنٌ حجرا مقدّسا، ويعرف أن المكان ليس شكلا هندسيا، بل حنينا مضغوطا في زاوية. في كتابه الارائع " جماليات المكان " كان يؤمن أنّ العليّة تصعد بنا لا لأن درجها مرتفع، بل لأن الذاكرة تخفّ حين تبتعد عن الأرض، وأن القبو لا يُظلم لأنه بلا نوافذ، بل لأنّه يحفر في الطبقات الرطبة للروح. المكان عنده حيوانٌ يتنفس، كائنٌ لا يفصح عن سرّه إلا حين نصغي إليه من الداخل، وحين ندرك أن الطفولة هي المعمار الحقيقي لكلّ الغرف، وأن الإنسان، في لحظة صدقه الأخيرة، ليس إلا بيتا يسير على قدمين في لحظة استذكار باذخة ..
يتغيّر المشهد حين يدخل محمود درويش من الباب ذاته، إذ يحمل المكان لا كجغرافيا، بل كجرح مفتوح. يدخل كمن يعود إلى بيت يعرف أنه لم يعد قائما، وكأنّ العالم كله لا يحتاج إلى خارطة بقدر ما يحتاج إلى ذاكرة. في شعره، لا يصبح البيت مأوى بل صدى، ولا تصبح النافذة ضوءا بل منفى، ولا تصبح الأرض وطنا بل سؤالا متكررا: من أين يبدأ المكان حين ينتهي الزمن؟ درويش لا يبحث عن المكان، بل يبحث عن أثره حين يُنتزع، عن تلك الفراغات التي تترك حفرة في الصدر كأنّها حفرة ضوء، عن المفتاح الذي لا يفتح بابا بل ماض مرتبك يركض في الحلم، وعن وطن يتقلّص حتّى يصبح قصيدة، ثمّ تتّسع القصيدة حتى تغدو وطنا بديلا. في عالم درويش، لا شيء يُسكن، لا شيء يُمسك، لأن كل شيء مُهدّد بالتحوّل إلى ذكرى، وكل ذكرى مهدّدة بالتحوّل إلى جرح، وكل جرح مهدّد بالتحوّل إلى لغة.
وما إن يشتد هذا الاشتباك بين المكان كحلم عند باشلار، والمكان كفقد عند درويش، حتّى يدخل أينشتاين كطرف ثالث يمجّد الثبات، يرمي نظريته فيغيّر المفاهيم البشرية كلها. فجأة لا يعود المكان مكانا ولا الزمن زمنا، بل يصبحان نسيجا واحدا، يتلوى، ينحني، يتمدد، كأن الكون رقعة مطاطية والنجوم أثقال تُشوّه سطحه. في لحظة واحدة، تتكسر الجدران الفلسفية القديمة، و يسحب المكان من تحت أقدامنا، ويضعنا في كون لا مركز له، لا أعلى، لا أسفل، لا شرق، لا غرب، بل حركةٌ دائمية تُعيد تعريف كل شيء، البيت حدث، الخطوة حدث، القصيدة حدث، كل شيء لا يقوم بذاته، بل بتوتره مع الزمن. وهنا يبدأ الاندماج والتداخل الحقيقي، الاندماج اللذيذ، التداخل الذي لا يَفرّق بين الشعر والفلسفة والعلم. باشلار يحاول أن يعيدنا إلى الركن الدافئ، إلى رائحة الدولاب القديم، إلى السرير الذي يحتفظ بأثقال أحلامنا الأولى، فيما يسحبنا درويش إلى الظلّ، إلى الحصان الهارب، إلى القرية التي لا تزال تتكوّن كلما انطفأت المصابيح، إلى المكان الذي ينزف كلما حاولنا تذكّره بينما يجرّنا أينشتاين خارج الغرفة كلها، خارج الزمن نفسه، ويجعلنا ننظر إلى المكان كما ينظر الضوء إلى جسده: بلا وزن، بلا ذاكرة، بلا توقف . ومع ذلك، فإن الثلاثة، رغم اختلاف مساراتهم، يتقاطعون عند خط واحد لا يُرى، فيصبح المكان عن ثلاثتهم ما ليس يُرى بالعين، بل ما يُمسك بالقلب . عند باشلار، هو حلم متوارٍ يتسلّل من شقوق الجدران؛ عند درويش، هو وطن مكسور يبحث عن جسده، عند أينشتاين، هو تموّج في فراغ أكبر من كل القصائد. ومع هذا، لا يستطيع أحدهم أن يلغي الآخر، لأن الإنسان يحتاج الثلاثة ليبقى، يحتاج حلم باشلار كي لا يدفىء دواخله، ويحتاج جرح درويش كي لا يحدث قطيعة ابدية مع الظلم، ويحتاج ضوء أينشتاين كي يعرف أن وجوده ليس صدفة بل ارتعاشة كونية محسوبة.
لندرك في النهاية، أن المكان ليس جدارا يُسندنا، ولا وطنا يحمي اسمنا، ولا مسافة تقيس خطواتنا. إنه الكهف الذي خرجنا منه، والجرح الذي نمشي به، والضوء الذي نذوب فيه. إنه حوار مستمر بين الحلم والذاكرة والسرعة، بين البيت الذي نحمله، والوطن الذي يحملنا، والكون الذي لا يبالي بأي منا.
***
ليلى تبّاني ــــ الجزائر