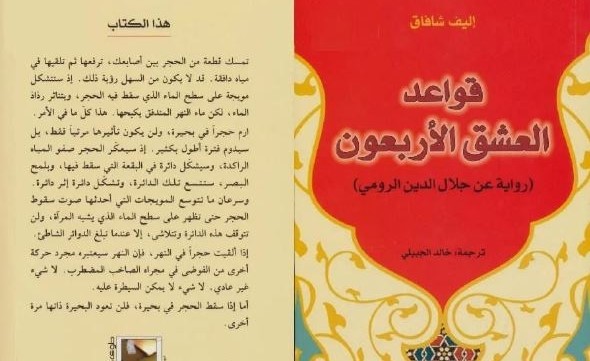قضايا
مراد غريبي: وعي التغيير في أفق المعنى

مفتتح: حين نطرح السؤال عن التغيير، فإننا لا نقف أمام مسألة نظرية باردة تنتمي إلى حقل الفلسفة المجردة أو علم الاجتماع التطبيقي، بل نواجه سؤالاً وجودياً حارقاً يخترق جوهر الكينونة الإنسانية في أعمق تجلياتها. إنه السؤال الذي يربط بين الإنسان والزمان، بين الذات والعالم، بين الإمكان والتحقق. فالإنسان، بوصفه كائناً واعياً بمصيره، ليس مجرد موجود في الزمان بل هو كائن زماني بامتياز، يحمل في داخله إمكانية التجاوز الدائم لما هو كائن نحو ما ينبغي أن يكون.
والتغيير، في هذا السياق، ليس خياراً نختاره أو نتركه، بل هو قانون كوني أنطولوجي يحكم الوجود بأسره، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، ومن أبسط فكرة إلى أعقد حضارة. لكن الإشكال الحقيقي لا يكمن في حتمية التغيير ذاته، بل في كيفية وعينا بهذا التغيير، وفي الاتجاه الذي نمنحه لحركتنا الوجودية:
هل نتغير نحو الأفضل أم نحو الأسوأ؟ هل نقود التغيير أم ننساق معه؟ هل نصنع التاريخ أم يصنعنا؟
ماذا عن فلسفة التغيير؟
عندما نتحدث عن التغيير بوصفه ظاهرة فلسفية، فإننا نتجاوز المعنى السطحي الذي يختزله في مجرد تبديل للمظاهر أو تعديل للأشكال الخارجية. التغيير الحقيقي، ذاك الذي يستحق أن نسميه تحولاً وجودياً، هو تغيير جوهري يمس البنية العميقة للكائن، يعيد صياغة علاقاته بنفسه وبالعالم، يحرك السكون الراكد في أعماق الوعي ويفتح آفاقاً جديدة للفهم والفعل. هذا التحول يستدعي، لزاماً، ثلاثة مقومات فلسفية لا غنى عنها:
1. الوعي النقدي: ذلك الوعي الجارح الذي يرفض الاستسلام للواقع كما هو، والذي يدرك، بحدس عميق، أن الوضع القائم ليس نهاية التاريخ بل هو مجرد محطة عابرة في رحلة الوجود الإنساني الطويلة. هذا الوعي النقدي يقدر مسافة، للتراجع خطوة إلى الوراء حتى نرى الصورة الكلية، لنفهم أن ما نعيشه اليوم ليس قدراً محتوماً بل هو نتيجة لخيارات وممارسات يمكن تغييرها.
2. الإرادة الحرة: تلك القوة الخفية التي تحول الإمكان النظري إلى فعل تاريخي، والتي تمنح الإنسان قدرة على قول "لا" للواقع الضاغط و"نعم" للمستقبل الموعود. الإرادة الحرة ليست مجرد رغبة عابرة أو حلم رومانسي، بل هي قرار وجودي جازم بأن الإنسان فاعل في التاريخ وليس منفعلاً فقط، بأنه صانع للمعنى وليس مجرد متلقٍ لمعانٍ جاهزة.
3. المنطق العملي: ذلك الجسر الضروري بين النظرية والممارسة، بين المثال والواقع، بين الرؤية والتحقيق. فالتغيير بدون خطة واضحة يتحول إلى فوضى، والإرادة بدون منهج تصبح عشوائية، والوعي النقدي بدون استراتيجية عملية يبقى سجين البرج العاجي للتنظير المجرد.
التغيير في الفكر الإسلامي:
يحتل التغيير في رؤى ومطارحات الفكر الاسلامي مكانة مركزية تتجاوز التصورات الفلسفية التقليدية للثبات والحركة، للجبر والاختيار. فالقرآن الكريم يقدم رؤية متوازنة ومتكاملة للتغيير حين يعلن: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". هذه الآية الكريمة، في إيجازها المعجز، تحمل فلسفة كاملة للتحول الإنساني والاجتماعي. إنها تؤسس لمبدأ الشراكة الوجودية بين الإنسان والله، بين الفعل البشري والتدخل الإلهي، بين المسؤولية الذاتية والعناية الربانية. التغيير الإلهي، وفق هذا المنظور، ليس هبة مجانية تنزل من السماء على أقوام لم يبذلوا جهداً، بل هو استجابة إلهية لتحول ذاتي عميق يبدأ من الداخل. التغيير الخارجي، بكل تجلياته الاجتماعية والسياسية والحضارية، يتبع بالضرورة التغيير الداخلي، ذلك التحول النفسي والروحي والأخلاقي الذي يجعل الإنسان أهلاً للنهضة والتقدم.
لكن الإنسان المسلم المعاصر يعيش اليوم في قلب مفارقة وجودية مؤلمة، تشبه تلك المفارقات التي تحدث عنها الفلاسفة الوجوديون حين وصفوا الاغتراب الإنساني في العصر الحديث. فمن جهة، هو يحمل في وعيه الديني إيماناً راسخاً بأن التغيير ممكن، بل واجب، وأن الإنسان قادر على صنع مصيره وبناء حضارته. ومن جهة أخرى، يجد نفسه محاصراً بواقع قاسٍ يبدو فيه الجمود سيد الموقف، حيث تتكرر الهزائم والنكسات وتتراكم الإخفاقات وتتعمق الفجوة بينه وبين العصر. هذه المفارقة ليست مجرد تناقض نظري بل هي أزمة وجودية تمس صميم الهوية الإسلامية، إذ كيف يمكن للمسلم أن يصدق بوعد التمكين الإلهي وهو يرى أمته تعاني من التبعية الثقافية والفكرية، من التخلف التقني والعلمي، من التشظي السياسي والتفكك الاجتماعي؟ هذا الصدع بين الإيمان النظري والواقع المعيش خلق حالة نفسية خطيرة من الإحباط واليأس لدى الكثيرين، حيث أصبح التغيير يبدو كحلم بعيد المنال أو كشعار أجوف يتردد في الخطابات دون أن يتجسد في الممارسات.
تحديات التغيير في راهن المسلم:
هناك عدة تحديات تواجه مشروع التغيير عند الإنسان المسلم اليوم ليست أحادية البعد بل هي متشابكة ومعقدة، تتداخل فيها العوامل الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية، النفسية والبنيوية.
1. تحدي الذات: أول هذه التحديات، وربما أخطرها، هو تحدي الذات، ذلك العدو الخفي الذي يسكن في داخلنا قبل أن يحاصرنا من الخارج. العقلية السلبية، تلك التي ترى التغيير مستحيلاً وتنتظر الحلول جاهزة من الخارج، هي أخطر معوق للتحول الحضاري، لأنها تقتل الإرادة قبل أن تولد وتخنق الإمكانية قبل أن تتحقق. هذه العقلية الانهزامية، التي تشكلت عبر قرون من الاستعمار والاستبداد والفشل، حولت الإنسان المسلم من فاعل تاريخي إلى مفعول به، من صانع للحضارة إلى مستهلك لحضارة الآخرين، من سيد لمصيره إلى رهين لقوى خارجية لا يملك أمامها إلا الاستسلام.
2. تحدي البناء: إنه تحدي تلك البنى الاجتماعية والمؤسساتية المتحجرة التي تقاوم بشراسة أي محاولة للتغيير لأنها ترى فيه تهديداً لمصالحها ونفوذها. فالتغيير الحقيقي يعني بالضرورة إعادة توزيع للسلطة والثروة والمعرفة، وهو ما لا ترضى عنه النخب المستفيدة من الوضع القائم. هذه البنى تمتلك آليات دفاعية معقدة تمكنها من امتصاص الصدمات واحتواء المحاولات الإصلاحية وتحويلها إلى مجرد شعارات لا تمس جوهر السلطة بشتى تشكلاتها.
3. تحدي العولمة الثقافية: تلك الهيمنة الثقافية والاقتصادية والتقنية التي تفرضها القوى الكبرى على العالم الإسلامي، والتي تجعل التغيير يبدو كرد فعل دفاعي وليس كفعل حضاري أصيل. كيف يمكن للإنسان المسلم أن يبني مشروعه الحضاري الخاص وهو محاط بأنظمة عالمية تفرض عليه قواعد اللعبة، من النظام الاقتصادي القائم على الربا والاحتكار، إلى النظام الإعلامي الذي يشوه صورته ويحاصر رواياته..
نحو فلسفة عملية للتغيير
على الرغم من اعترافنا بهذه التحديات، لكن لا ينبغي أن يقودنا إلى اليأس، بل على العكس، يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو فلسفة عملية للتغيير، فلسفة تنطلق من الممكن لا من المستحيل، من الواقع لا من الخيال.
يعني التغيير الناجح، ذلك الذي يحقق نتائج ملموسة ومستدامة، يجب أن يبدأ من المركز لا من الهامش، من القلب لا من الأطراف. يجب أن يبدأ من الذات، من القيم، من العقيدة، من تلك المنطقة العميقة التي تشكل هويتنا الحقيقية ورؤيتنا للعالم. التغيير الخارجي الذي لا يسبقه تغيير داخلي حقيقي يظل هشاً وسطحياً، مجرد تقليد أجوف لنماذج لا تنتمي إلى سياقنا الحضاري ولا تستجيب لحاجاتنا الروحية والاجتماعية. في الوقت نفسه، يجب على مشروع التغيير الإسلامي أن يحقق توازناً دقيقاً بين الأصالة والمعاصرة، بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على العصر. فالأصالة الحقيقية ليست تمسكاً أعمى بالماضي أو رفضاً مطلقاً للحاضر، بل هي قدرة على استلهام القيم الجوهرية من التراث وإعادة صياغتها بلغة معاصرة تستجيب لتحديات اللحظة الراهنة. والمعاصرة الحقيقية ليست تبعية عمياء للغرب أو انسلاخاً عن الهوية، بل هي امتلاك لأدوات العصر العلمية والتقنية مع الاحتفاظ بالبوصلة القيمية التي توجه استخدام هذه الأدوات. وأخيراً، يتطلب التغيير الناجح صبراً استراتيجياً، إدراكاً عميقاً بأن التحولات الكبرى لا تحدث بين عشية وضحاها، بل هي عمليات طويلة ومعقدة تمتد عبر أجيال، تحتاج إلى إرادة مستمرة ونَفَس حضاري طويل وحياة في أفق المعنى السليم...
التغيير، في نهاية المطاف، ليس خياراً ترفيهياً يمكن للإنسان المسلم أن يأخذه أو يتركه، بل هو فريضة وجودية ودينية في آن معاً. فريضة وجودية لأن الحياة تفرضها كقانون لا مفر منه، إذ لا شيء يبقى على حاله في هذا الكون المتغير. وفريضة دينية لأن الإسلام، بوصفه دين الفطرة والوسطية والشمول، يدعو الإنسان إلى أن يكون خليفة فاعلاً في الأرض، عامراً لها، مصلحاً لفسادها، ساعياً نحو الكمال الممكن. التحديات الكبرى التي نواجهها اليوم، من ضعف في التعليم إلى تخلف في البحث العلمي، من تبعية اقتصادية إلى تفكك اجتماعي وترهل إداري وتخلف عن قيمنا الحضارية، ليست قدراً محتوماً كتبه التاريخ علينا بحبر لا يُمحى، بل هي تحديات تاريخية يمكن تجاوزها بالوعي والإرادة والعمل. ليس السؤال إذن: هل يمكن التغيير؟ بل السؤال الحقيقي هو: متى نبدأ؟ والإجابة الوحيدة الممكنة والصادقة هي: الآن، من هنا، من أنفسنا، من هذه اللحظة التي نعيشها..
***
ا. مراد غريبي