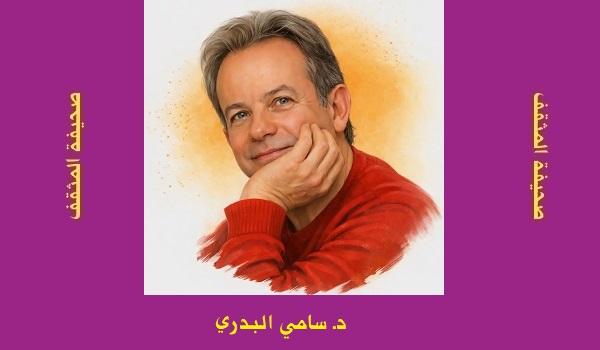قراءات نقدية
منذر الغزالي: دراسة نفسية-اجتماعية لرواية "بين حياتين"

للأديبة والناقدة السورية د. عبير خالد يحيى
الدكتورة عبير خالد يحيى، أديبة وشاعرة وناقدة، لها جهد كبير في ترويج النظرية الذرائعية في النقد، صدر لها عدة كتب نقدية تطبيقية على هذا المنهج، بالإضافة إلى مجموعاتٍ قصصية، وشعرية ورواية واحدة، هي موضوع هذه الدراسة.
تُمثّل رواية (بين حياتين) للكاتبة عبير خالد يحيى، عملاً سردياً معمّقاً يتناول التجربة الإنسانية المعقّدة، حيث تستعرض مسار حياة الشخصية المحورية، "غالية"، عبر مراحلَ متباينةٍ، وما اعترضها من تحدياتٍ وصراعاتٍ ذات أبعادٍ نفسيةٍ واجتماعية. تتميّز الرواية بأسلوبها الأدبي ّالمتفرّد وقدرتها على النفاذ إلى مكامن النفس البشرية العميقة، بالتوازي مع إضاءة قضايا اجتماعيةٍ ونفسيةٍ ذات أهميةٍ بالغة.
يتناول هذا التحليل استعراضًا لعناصر القوة الأدبية الكامنة في الرواية، من حيث البناء الأسلوبي، وعمق الأفكار المطروحة، وذلك بالاستناد إلى مفاهيمَ مستمدّةٍ من حقول النقد النفسي والاجتماعي. سيتم التركيز على كيفية تجلّي الأبعاد النفسيّة في بنية الشخصية وتطورها، وكيف تتفاعل هذه الأبعاد مع السياق الاجتماعي المحيط. كما ستتمّ الإشارة إلى الجانب الذرائعي (Pragmatic) في النص، والذي يرتبط بالقصدية والأثر المتوخى، لا سيما وأن الكاتبة تمتلك تخصصًا في النقد الذرائعي، وإن كان له مفهوم وإجراءات مختلفة عمّا نقصده في هذه الدراسة.
أولاً: عناصر القوة في الأسلوب
تتجسد قوة الأسلوب السردي في رواية (بين حياتين) عبر جوانب متعدّدة تسهم في تشكيل عالمها السردي وجذب اهتمام المتلقي:
1. تعدّد مستويات السرد: يتّسم السرد بالانتقال المتقن بين صوت السارد العليم، الذي يقدم الأحداث والشخصيات من منظورٍ خارجيٍّ شامل، وصوت الشخصية الرئيسية "غالية"، كما يتجلى في مذكراتها وتأملاتها الباطنية. يسهم هذا التعدد في إتاحة رؤيةٍ شاملةٍ للأحداث لدى القارئ، ويمكّنه من استكشاف أعماق نفسية غالية وفهم صراعاتها الداخلية بصورةٍ مباشرةٍ. يُضاف إلى ذلك وجود مقدمةٍ بقلم ناقدٍ آخر، مما يضفي بعدًا ميتا سرديًا على بنية النص.
2. البناء السردي المتماسك: يتميز هيكل الرواية بكونه غير خطيٍّ ومتشظٍّ، مما يعكس الفوضى الداخلية في نفسية غالية وشعورها المتفتت بالذات. يتنقل السرد بين أزمنة مختلفة - الطفولة، المراهقة، والبلوغ، وحتى عوالم متخيلة - مما يخلق سردًا متعدد الطبقات يعكس تدفق الذاكرة والطبيعة الدورية للصدمة.
على الرغم من التناوب الزمني والانتقال بين المراحل العمرية المختلفة، تحتفظ الرواية بتماسكها السردي من خلال خيطٍ ناظمٍ يربط بين الأحداث والشخصيات، ويكشف عن التأثير التراكمي للخبرات الماضية على الحالة النفسية والسلوكية للشخصية في الحاضر. يتم تقديم المعلومات بصورة تدرّجية تكشف عن أسرار الماضي وتأثيراتها على الحاضر، مما يسهم في الحفاظ على عنصر التشويق لدى القارئ ويسلط الضوء على ديناميكية التطور النفسي للشخصية.
من منظورٍ نفسيٍّ، يعكس هذا الهيكل نظرية فرويد حول العودالقهري compulsion) (Repetition عودة التجارب المؤلمة لتطارد الفرد حتى يتمَّ مواجهتها.
3. لغة ذات طابع تصويري وإيحائي: تتميز لغة الرواية بكونها شعرية وغنية بالصور الحسّيّة والتراكيب المجازية، ما يعزّز العمق النفسي للسرد. تستخدم عبير خالد يحيى أسلوبًا إيقاعيًا يمزج بين الواقعية والسريالية، مما يتيح للقراء الغوص في العالم الداخلي لغالية.
اللغة متأمّلةْ، ومثيرةْ للإحساس، وغالبًا ما تعتمد على الاستعارات والتشبيهات لنقل الحالات العاطفية. على سبيل المثال، في "الفصل الثاني: رسائل الماضي"، يتمّ وصف عصام بصور رومانسية وسحرية:
"عينان واسعتان سوداوان مكحلتان بأهداب تتماهى مع شعرٍ أسود فاحم، ينسدل بتموجات عريضة ليصل إلى منكبيه، عندما يتكلّم تنصت إليه غالية باستغراق شديد، يأسرها صوته، وتسحرها كلماته."
تعكس هذه اللغة الشعرية الطبيعة المثالية لعصام كرمزٍ للبراءة والهروب، وتكشف عن اعتماد غالية النفسي عليه كآليةٍ للتعامل مع الصدمة.
من منظورٍ نفسيٍّ، يمكن ربط هذا بمفهوم الأنا العليا (superego)حيث يجسّد عصام النسخة المثالية التي تطمح غالية للوصول إليها.
التباين بين الوصف الشعري للطفولة والصور القاسية للحياة البالغة، كما في "القفص الحديدي"، يبرز صراع الهوية (Identity conflict) حيث تحاول غالية التوفيق بين براءتها السابقة ومعاناتها الحالية.
4. الاستخدام الموظَّف للرموز:
تُعدّ الرمزية عنصرًا أساسيًا في الأسلوبية، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستكشاف النفسي للذاكرة والهوية والصدمة.
تزخر الرواية برموزٍ متعدّدةٍ تثري دلالاتها وتضيف أبعادًا فلسفيةً ونفسيةً إلى النسيج النصي.
- الصديق الخيالي (عصام/سوسو): باعتباره رمزاً للعالم الداخلي لطفولة الشخصية، وآلية نفسية للتكيف (Coping Mechanism) وملاذًا لها من قسوة الواقع الخارجي. يعكس الاقتباس التالي لجوء الشخصية إلى عالم داخلي خيالي كوسيلة للهروب من الواقع والتعامل مع المخاوف: "أما صديق غالية الخيالي، فطفل عمره تسع سنوات، مليح الوجه... يروي لها الكثير من الحكايات، يأخذها إلى عوالم مليئة بالغرابة والمغامرات المثيرة، لطالما أحبّت طريقة سرده لقصص كان فيها البطل الذي ينتصر على كل الأشرار، تستمتع بحكاياته تلك أكثر من استمتاعها بحكايات الجدّة التي كانت تشعرها بالخوف من الغول والذئب..."
- عصام كرمز للذاكرة والصدمة: من ناحيةٍ ثانية، يمثّل عصام ملاذًا ومصدرًا للصدمة، كصديقٍ خياليٍّ في طفولة غالية، يجسّد براءتها المفقودة وأمان سنواتها الأولى؛ لكنّ رحيله وإعادة ظهوره يرمزان إلى قبضة الذاكرة المستمرة. في "الفصل الثاني: رسائل الماضي"، يقول عصام:
‘سوف أراقبك من بعيد، وسأقترب أحيانا ًمتسللاً، لكن بسحنة وبهيئة لن تعرفيني بها، قد تحزرين، وتشكّين بأنها أنا. يشير هذا إلى الذاكرة كقوة غامضة ومؤرقة، تساهم في أزمة الهوية عند غالية. من منظورٍ نفسي، يمكن اعتبار عصام تجسيداً للاشعور (unconscious) حيث يحمل ذكريات مكبوتة تؤثر على قراراتها.
- البحر والشمس كرموز للهوية والأمل: يرمز البحر والشمس إلى الخسارة والأمل. يعكس البحر عمق صراعات غالية العاطفية، بينما تشير الشمس إلى التجدد. في "تداعيات الوداع. تعكس الصورة التاليةصراع غالية مع الصدمة ورحلتها نحو هويةٍ مستقرة، حيث تبحث عن الراحة في الدورات الطبيعية. "كانت غالية تبكي عصام!... ودّعها ووعدها ذات مغيبٍ وقال: ‘سأحضر إليك كلّ غروب، عندما ترتمي الشمس في حضن البحر، تغيبُ عنكِ لتشرقَ في مكان آخر ...". من منظور يونغ، يمكن اعتبار البحر رمزًا للاوعي الجماعي (Collective unconscious)، بينما تمثل الشمس "الأنا" (ego)التي تسعى للتوازن؛ وتُشكل عناصر البحر والشمس والقمر ثلاثية رمزية تتغير إيحاءاتها تبعًا لتطور الأحداث وتحول رؤية غالية للحياة، مما قد يعكس مراحل مختلفة من تطورها النفسي
- الحبس والتحرر: ترمز مفردات مثل "القفص الحديدي"، و"الزريبة"، و"القبر" إلى حالة القمع النفسي والاجتماعي والشعور بالسجن الذي عاشتها غالية في إطار تجربتها الزوجية..
في "زينة الحياة الدنيا"، يُصور إرهاق غالية "تسقط يدا غالية على ذراعَي الأريكة متهالكة، تحول دون سقوط كتلتها التعبة المتضخمة أرضا." يعكس هذا الانحدار حالتها النفسية، حيث تحاصرها التوقعات الاجتماعية، لكن رفضها للأدوية يشير إلى التحرر. من منظور نفسي، يمثل هذا انتقالًا من الإذعان إلى الإرادة الذاتية.
ثانياً: عناصر القوة في الأفكار والموضوعات
تطرح الرواية جملةً من الأفكار والموضوعات العميقة التي تعكس فهماً دقيقًا للحياة الإنسانية وصراعاتها المتجذرة، مع تركيز خاص على الأبعاد النفسية والاجتماعية:
1. أهمية مرحلة الطفولة وتأثيراتها النفسية: تُبرز الرواية الدور المحوري لمرحلة الطفولة وتأثيرها المستمر على مسار حياة الفرد وبنيته النفسية. لا تُعدّ شخصية الصديق الخيالي مجرّد تفصيلٍ هامشي، بل هي مكوِّنٌ أساسيٌّ في البنية النفسية لغالية، تعكس حاجتها الفطرية إلى الرفقة والدعم في مواجهة عالمٍ يبدو غامضًا وغير مفهوم بالنسبة لها. يستمر هذا التأثير حتى بعد تجاوزها مرحلة الطفولة، مما يؤكّد على أنّ بعض الاحتياجات الأساسية وأنماط التكيّف النفسي تتشكّل في مراحلَ مبكرةٍ من العمر وتستمرّ في التأثير على السلوكيات والعلاقات المستقبلية.
2. الصدمة والمرونة النفسية (Resilience): تتعرض غالية لسلسلةٍ من الصدمات المتوالية خلال حياتها، بدءًا من حادث والدها الذي قد يمثّل صدمةَ طفوليةً مبكرة (Childhood Trauma)، مرورًا بمرارة تجربتها الزوجية التي تتضمن عنفًا نفسيًا وجسديًا، وصولًا إلى فقدان والدتها وجنينها. لا تكتفي الرواية بسرد هذه الصدمات، بل تركّز بشكلٍ أساسيٍّ على آليات تعامل غالية معها، وقدرتها على الصمود والمقاومة في وجهها. إنّ التحوّل الذي تشهده شخصيتها من موقع الضحية إلى موقع الساعي نحو النجاة واستعادة الذات يُمثِّل جوهرَ مفهوم المرونة النفسية، وقدرة الفرد على التعافي والنمو بعد التعرض للشدائد.
3. تعقيدات العلاقات الأسرية وتأثيرها على الصحة النفسية: تصور الرواية العلاقات الأسرية بتعقيداتها المتشعبة، حيث تتجلى مظاهر الحب والدعم في علاقة غالية بوالدتها وجدتها وأختها سما، مما يوفر لها شبكة دعم نفسي أساسية. بينما تبرز في المقابل صور القسوة والظلم ضمن محيط عائلة زوجها، مما يشكل بيئة سامة تؤثر سلبًا على صحتها النفسية وشعورها بالذات. كما تتطرق الرواية إلى تأثير التقاليد والأعراف الاجتماعية على القرارات المصيرية، ومن ذلك الإصرار على بقاء غالية في زواجها رغم معاناتها الشديدة، مما يعكس الضغط الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات النفسية. "بات زواجي قبراً تحكمه كلمات، عقد قرانه الشرع على وحشٍ بشريٍّ لا يعرف كيف يمارس الحياة، تسرسبت حياتي من أوراق تقويم أيامي، مبللةً بدموع قهر ساد كلَّ لياليّا وجزءاً من نهاراتي، أخلصت حدّ التفاني لكلّ من حولي، حتى لجلادي الذي بنى أساطير انتصاراته الشبقية على تخوم الخيانة...". في هذا المقطع، تشبّه الكاتبة الزواج بالقبر، ما يعكس الشعور بالاختناق النفسيّ وفقدان الحياة، كما يشير إلى "دموع القهر" التي تعبّر عن المعاناة النفسية الشديدة.
4. قضايا المرأة في السياق الاجتماعي وتأثيرها النفسي: تتناول الرواية، بصورةٍ ضمنية وصريحة، قضايا تتعلّق بوضع المرأة في المجتمعات الشرقية، ومنها الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالزواج والإنجاب (خاصةً إنجاب الذكور)، والتعرّض للعنف الأسري، وتقييد حريتها والتصرّف في ممتلكاتها. هذه الضغوط والانتهاكات لا تؤثّر فقط على الجانب الاجتماعي للمرأة، بل تترك آثارًا نفسيةً عميقةً تتمثّل في الشعور بالعجز، فقدان الثقة بالنفس، الاكتئاب، والقلق.
تُعدّ قصّة عمة مصطفى المسجونة في الزريبة رمزًا صارخًا لقمع المرأة وإسكات صوتها، وتجسيدًا للآثار النفسية المدمّرة. يسلّط الحوار التالي الضوء على الآثار النفسية المدمرة، من الإهمال والحرمان، وفقدان الكرامة، مما يؤدي إلى "بكاء حتى ابيضّت العينان" كدليل على المعاناة النفسية الشديدة.…"من أنت يا خالة؟ أجاب بصوت مخنوق: «عمّة مصطفى - «ولماذا أنت هنا؟! ما قصتك؟"، تجيب العجوز بحسرة: «أظن أنّ عمري قد تجاوز الستين، أقيم هنا منذ أكثر من عشر سنوات، كنت قبلها أعيش مع أختي وأولادها، توفيت وضاق أولادها ذرعاً بي، لم أتزوّاج بعد موت زوجي، قدمت إلى أخي والد مصطفى، أعطيته قطعة الأرض خاصّتي... مقابل أن أقيم عنده ويكون لي سترًاا.» تتنهّد وتزفر زفرةً حارّة، ثم تستأنف: - «لكنّ زوجته لم يرق لها ذلك، أجبرته على إلقائي هنا، وأشاعت بين الناس أنني توفّيت بعد أن توفّيَت أختي، لم يعلم أحدٌ بوجودي هنا، أذاقتني كل ألوان المهانة، بكيت حتى ابيضّت عيناي، تتعاقب عليّ الفصول، فأغرق شتاءً بالمطر المتسلّل من هذا السقف الهش، وأكتوي صيفاً بلهيب الشمس الحارقة....»"
5. مسار البحث عن الذات والتحرر النفسي: تُمثّل رحلة غالية مساراً للبحث عن ذاتها التي تعرّضت للفقدان تحت وطأة الظروف القاسية والضغوط النفسية والاجتماعية. تجد غالية في فعل الكتابة ملاذاً ووسيلةً للتعبير عن كيانها واستعادة صوتها المقموع، ما يمثّل عملية تطهيرٍ نفسي (Catharsis) وإعادة بناء للذات. إن تطوّرها ككاتبة وناقدة يُمثّل تجسيداً لعملية التحرر، ليس فقط من القيود الخارجية، بل أيضاً من القيود النفسية الداخلية التي فرضتها عليها مسارات حياتها؛ ويعكس مقالها عن "الرجولة" في الخاتمة درجة الوعي والنضج التي بلغتها في تحليل العلاقات الإنسانية وديناميكيات القوة، مما يشير إلى اكتمالٍ نسبيٍّ لمسار تطوّرها النفسي.
يُظهر المقطع التالي كيف أصبحت الكتابة وسيلةً لغالية ليس فقط للتعبير، بل لإعادة تنظيم أفكارها ومشاعرها، والنظر إلى الحياة من منظورٍ جديد، مما يشير إلى عملية نموٍّ نفسي وفكري: "وتناسخت الأيام والسنين في جنات أروادية، وغالية قد تخرّجت من كلية الطب، واختصّت في طبّ الأطفال؛ لكنّي لمحتُها كاتبةً، وتعرّفت عليها من بين سطورها في مدوّنتها، وهي تكتب روائع من قصص وشعرٍ عن ذلك العالم البحريّ العجيب. ".
والاقتباس التالي يُصوّر لحظة التحوّل النفسي والنهوض من حالة "الموت" النفسي، باستخدام استعارة "الحمامة التي نبت الريش في أجنحتها" للتعبير عن استعادة القوة والقدرة على التحليق بعد فترةٍ من القمع والألم: "نبت الريش في أجنحة الحمامة التي تعرّضت للقصّ والبتر، وبدأتْ ترفرف برفرفاتٍ بسيطة، كلَّ يوم أطير قليلاً ثمّ أعود إلى قبري، إلى أن كان ذلك اليوم الذي حلّقت فيه في السّماء ولم أرجع إلّا في الليل..."
6. الجانب الذرائعي والأثر النفسي: يمكن قراءة الرواية من منظورٍ ذرائعيٍّ، عبر النظر إلى القصدية والأثر المتوخّى منها. قد يتمثّل قصد المؤلفة من خلال تقديم هذه القصة في تسليط الضوء على حجم المعاناة النفسية والاجتماعية التي قد يتعرّض لها الأفراد نتيجةً للظلم، والتأكيد على الدور الحيوي للدعم النفسيّ والاجتماعيّ في تجاوز هذه المحن. أمّا الأثر المتوقَّع على المتلقّي، فيتمثّل في إثارة مشاعر التعاطف، وربما تحفيزه على إعادة النظر في هذه القضايا ضمن سياقه الواقعي، وقد تسهم الرواية في زيادة الوعي بضرورة الصحة النفسية وأهمية مواجهة الظلم. يُلاحظ أيضًا أن استخدام الكاتبة لخبرتها في مجال النقد ينعكس في بناء السرد وعمق تحليل الشخصيات، حيث يتجلى التحليل النفسي والاجتماعي بصورةٍ متكاملةٍ ضمن النسيج السردي للرواية، مما يعزّز من مصداقيتها وتأثيرها.
خاتمة
رواية "بين حياتين" إسهامٌ أدبيٌّ بارزٌ، يجمع بين البراعة السردية وعمق الطرح الفكري، مع تحليلٍ نفسيٍّ واجتماعيٍّ للشخصيات والأحداث. من خلال أسلوبها التصويري ولغتها الإيحائية، تنقلنا الرواية في رحلة سرديّةٍ مؤثرة عبر حياة شخصيةٍ تواجه ظروفًا بالغة القسوة، لتؤكد في المحصلة على قدرة الروح البشرية على الصمود والتكيف، والسعي نحو إيجاد بصيص الأمل حتى في أحلك الظروف. إن عناصر القوة المتجلية في الرواية، سواء على مستوى البناء الأسلوبي المتقن أو ثراء الأفكار المطروحة التي تتناول الأبعاد النفسية والاجتماعية بعمق، تجعل منها نصًا يستحق القراءة والتدبر، وتُعدّ شهادةً على أنّ الأدب بمقدوره أن يكون مرآةً عاكسة للواقع الإنساني وأداةً فاعلةً للفهم والتغيير على المستويين الفردي والمجتمعي..
***
بقلم: منذر فالح الغزالي
كاتب وناقد من سوريا، يعيش في ألمانيا الاتحادية
بون في 10/5/2025