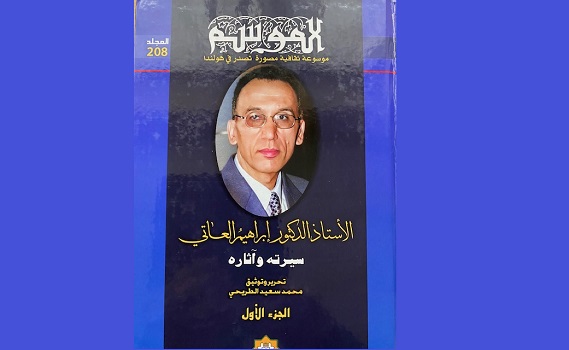قراءات نقدية
رياض عبد الواحد: قراءة وتأويل لقصيدة (النهر الظامئ)

للشاعر يحيى السماوي.. من الظمأ إلى الفاجعة
مقدمة: تُعدّ القصيدة الشعرية اليوم وسيطًا تداوليًّا مكثّفًا، تتفاعل فيه اللغة والسياق والحسّ الجمعي في لحظة جمالية متوترة. وقصيدة "نهري بلا ماءٍ..." تندرج في هذا السياق بوصفها نصًّا شعريًّا ينفتح على أفق الحسين بوصفه حدثًا رمزيًّا مؤسّسًا للوعي العربي والإسلامي، متكئًا على لغة موحية، وبلاغة سردية مكثفة، تحوّل المشهد إلى لحظة صدمة دائمة.
في ضوء النظرية التداولية، سنسعى لتفكيك هذا النص على مستوى المقاصد، والافتراضات المسبقة، وأفعال القول، لنكشف عن المشهد التداولي الذي تبنيه القصيدة عبر مشاهدها الثلاثة المتلاحقة.
تأطير تداولي أولي للنص:
تعتمد القصيدة في بنيتها على التكثيف الرمزي وتفعيل أفعال القول غير المباشرة، فتبدأ بجملة خبرية:
"نهري بلا ماءٍ"
وهي عبارة تؤسس لفعل تداولي قَصديّ يتجاوز ظاهر القول (إخبار عن نهر جاف) إلى فعل تعجّبي أو احتجاجي، يراد منه التنبيه إلى مفارقة أو خلل في نظام الوجود. من هنا تبدأ القصيدة في تفعيل الوظيفة التداولية المعروفة بـ"الإنذارية" أو "التحذيرية"، وهو ما يشيع في النص بأكمله.
التداولية والمجاز الرمزي:
"وأما غابي
فيتيمةُ الأفياءِ والأعنابِ"
يتموضع هذا السطر في الحقل التداولي المتعلق بـفقدان البركة/الحياة/الكرامة. فالنهر الذي كان يفيض أصبح يابسًا، والغابة التي كانت تستظل وتمتلئ بالثمار أصبحت يتيمة، والتعبير عن الغابة بـ"يتيمة الأفياء والأعناب" يحيل إلى انقطاع النعمة وغياب المدد.
من منظور تداولي، ينتمي هذا القول إلى ما يعرف بـ"أفعال التقييم" وهو فعل يقوم به المتكلم في الحكم على الواقع، ومنح المتلقي مفتاحًا معرفيًا للتأويل، عبر صيغة انفعالية تحمل في طيّها حزنًا وخيبة.
لحظة الصدمة التداولية
"قُتِلَ الحسينُ؟
فكيف لا يغدو الضحى
ليلاً..
وشمسُ الصبحِ دون شهابِ؟"
تتموضع هذه المقاطع ضمن نموذج "الاستفهام التقريري الصادم"، والذي يُعد في التداولية من أبرز أساليب أفعال الإقناع، فيعرض الشاعر حقيقة تاريخية (مقتل الحسين) على أنها حدث كونيّ غير قابل للتصديق.
فالسؤال التداولي هنا لا ينتظر جوابًا، بل هو "سؤال تأكيدي" يُراد منه نقل وقع المأساة إلى مستوى كوني يتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ.
وتفعيل الزمن النهاري (الضحى) على أنه يغدو ليلاً، وتحويل شمس الصباح إلى نجم مطفأ، كلّها أفعال لغوية تنقل التوتر من المجال النصي إلى القارئ ذاته، ليشعر بالدهشة والخذلان.
تفعيل أفعال القول الانفعالية – مشهد السماء الباكية:
"لَطمَتْ ملائكةُ السماءِ خدودَها
وبكتْ عليهِ حجارةُ المحرابِ"
هذه الذروة في القصيدة تقود إلى المشهد الأعلى في البنية التداولية: مشهد الحداد الكوني. حين تتجاوز ردة الفعل عالم البشر إلى عالم المفارق (الملائكة) وعالم الجمادات (الحجارة).
الملائكة تلطِم، والحجارة تبكي. إنهما فعلان فائقان لطبيعة الأشياء، يُفعلان لغويًا كنوع من أفعال القول الانفعالية المكثفة:
"لطمتْ" فعل انفعالي بدائي يعبر عن ذروة الحزن.
"بكتْ" فعل إنساني يتجسد في الحجر ليصبح علامة رمزية على اختلال نظام الكون بعد مقتل الحسين.
هذا المشهد يعتمد على ما يسميه التداوليون "فعل التضمين الثقافي" (Presupposition)، إذ يفترض الشاعر معرفة مسبقة لدى المتلقي بثقل حدث كربلاء، ما يجعل المعنى يتشكل بعمق داخل العقل الجمعي.
المقصدية التداولية للنص:
تقوم النظرية التداولية على تحليل نية المتكلم وموقفه من العالم. وهنا، نستطيع أن نرصد المقاصد التالية:
1. الاحتجاج الرمزي: القصيدة لا تحكي مقتل الحسين كحدث، بل كـ"نكبة كونية"، فكل شيء انقلب رأسًا على عقب.
2. التفجير القيمي: يعلن النص عبر التداولية انهيار قيم "العدالة، والنبل، والقداسة"، حين يُقتل الحسين، فينهار العالم معه.
3. إعادة تأويل الزمن: الضحى يغدو ليلًا، أي أن الزمن لا يعود وسيلة انتظام، بل هو في حالة انكسار دائم.
4. نقل الحزن من الواقعة إلى الوجود: لا يُصوّر النص حزن الإنسان، بل حزن الكون كله، وهذه قمة البلاغة التداولية.
البعد النفسي الرمزي في تشكيل الذاكرة الشعرية:
إذا أضفنا إلى التحليل التداولي بُعدًا نفسيًا رمزيًا، اتّضح أن الشاعر لا يُوجّه خطابه فقط إلى العقل الجمعي، بل إلى اللاوعي الجمعي أيضًا، حيث تتشكّل الذاكرة الجُرحية بوصفها هوية مكسورة تعيد إنتاج الحزن بوصفه آلية إدراك ووجود.
فـ"النهر بلا ماء" ليس مجرد صورة عن الظمأ، بل هو تمثيل لأنا متصدعة تبحث عن رموز الحياة في مشهد موت. و"الغابة اليتيمة" هي اللاوعي المُجتث من الأمان الأولي، من ظلّ الأم وخصب الأرض، وكل ذلك يُصاغ بصمت الصدمة.
أما سؤال: "قُتِلَ الحسين؟"، فهو تجلٍّ واضح لما يسميه علماء النفس بـ"إنكار الفاجعة"، حيث لا تصدّق النفس ما حدث، فيأتي السؤال محمّلاً بذهول الإنسان أمام الجريمة، ورفضه النفسي العميق لها، وإن أدركها عقليًا.
وحين "تلطِم الملائكة" و"تبكي الحجارة"، فإن النص يُمارس نوعًا من الإسقاط النفسي، حيث تنفجر الذات الشاعرة من الداخل، لكنها تُحوّل ذلك الانفجار إلى رموز خارجية، لتجعل من الفقد صدمة شاملة.
بهذا المعنى، فإن الشاعر يُعيد تشكيل الحدث الكربلائي لا بوصفه قصة ماضٍ، بل بوصفه كربلة الوعي والوجود واللاوعي. فالقصيدة لا تتذكّر فقط، بل "تُكابد" عبر ذاكرتها، وتُقاسم المتلقي فجيعة مستمرة تتناسل رمزيًا في ذاته وتاريخ أمته.
الخاتمة:
إن قصيدة "نهري بلا ماءٍ..." ليست مجرد خطاب رثائي حسيني، بل هي "فعل لغوي مركّب"، يُستعمل فيه الشعر كوسيط تداولي ونفسي لإعادة سرد مأساة كربلاء بوصفها لحظة انكسار كوني وأخلاقي ووجودي.
النص يفعّل استراتيجيات متعددة: الاستفهام، الاستعارة، قلب الزمن، تأنيث الأشياء، إضافة إلى تفجير الرموز اللاواعية في جسد اللغة، ليعيد بناء المشهد من جديد في ذهن المتلقي.
وحين نقرأ في ضوء التداولية والتحليل النفسي الرمزي، ندرك أن القصيدة لا تبحث عن البكاء فقط، بل تسعى إلى زلزلة البنية الذهنية التي سمحت بقتل الحسين، فتصبح مقامًا لـ"بلاغة الغضب المقدس"، وإدانة للوجود الناقص، وتذكيرًا دائمًا بأن الحقيقة الدامية لا تزال تنزف فينا.
***
رياض عبد الواحد
...........................
نهري بلا ماءٍ ..
وأمّا غابي
فيتيمةُ الأفياءِ والأعنابِ
//
قُتِلَ الحسينُ ؟
فكيف لا يغدو الضحى
ليلاً ..
وشمسُ الصبحِ دون شهابِ؟
//
لَطمَتْ ملائكةُ السماءِ خدودَها
وبكتْ عليهِ حجارةُ
المحرابِ
//
لَعَنَ الإلهُ القاتلينَ ومَنْ لهم
أمرٌ بِسَلِّ مهنّدٍ
وحرابِ