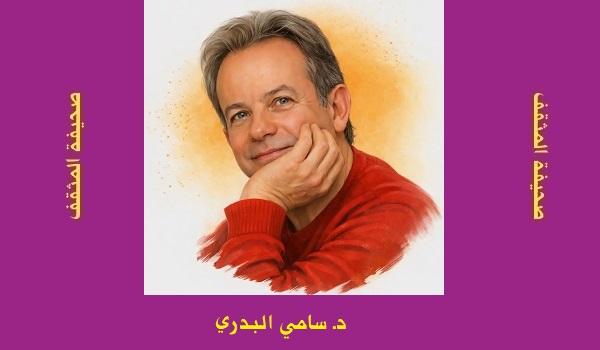قراءات نقدية
سهيل الزهاوي: رمزية المرأة وقضية التحرر في قصيدة "العنقاء"

للشاعر عبد الستار نورعلي
الشعر ليس مجرد أداة تعبيرية، بل هو مرآة تعكس الفكر والوجدان الإنساني، ويُعيد تشكيل الواقع من خلال الرموز والصور الشعرية. في قصيدة "العنقاء" للشاعر عبد الستار نورعلي، يتجاوز الشاعر الطرح التقليدي للمرأة، ليقدمها كقوة ديناميكية تمثل جوهر الحياة ومحركها الأساسي. لا تكتفي القصيدة بالاحتفاء بالمرأة، بل تطرح إشكالية علاقتها بالمجتمع، بين الحاجة إليها كمكوّن أساسي للحياة، وبين الممارسات القمعية التي تحدُّ من دورها.
القصيدة تتبنى بُعدًا نضاليًا، حيث تصبح المرأة رمزًا للمقاومة والتجدد، وهو ما يعكسه استدعاء رموز قوية، مثل العنقاء والمطر والخيول، التي تشير إلى صراع حضاري بين الجمود والتغيير. لا يقف الشاعر عند حدود الوصف، بل يدفع القارئ إلى مساءلة القيم الثقافية والاجتماعية المحيطة بالمرأة، مما يجعل النص أكثر من مجرد قصيدة؛ إنه دعوة للتحرر الفكري والإصلاح الاجتماعي.
من خلال هذه القراءة النقدية، سيتم تحليل البنية الرمزية للقصيدة، وتفكيك رؤيتها للمرأة كمفهوم ثقافي واجتماعي، إضافةً إلى استكشاف العلاقة بين الأسطورة والتاريخ والواقع، في تشكيل الخطاب الشعري لمضمون النصّ.
العنوان ودلالته:
عنوان القصيدة "العنقاء" ليس مجرد اختيار عشوائي، بل هو مفتاح تأويلي للنص، حيث يستحضر الطائرَ الأسطوريَّ الذي ينبعث من رماده، ليجسد المرأة ككيان قادر على تجاوز المحن والقيود المجتمعية. هذا الاختيار يعكس رؤية الشاعر للمرأة كرمز للتحوّل والتجدد المستمر، مما يضع القارئ منذ البداية أمام ثنائية الصراع والانبعاث التي تحكم بنية القصيدة.
الثيمة الرئيسة والمضمون:
تتجاوز القصيدة الطرح التقليدي للمرأة كمصدر للحب والعطاء، لتضعها في قلب معركة فكرية واجتماعية ضد التهميش والقمع الثقافي. من خلال استدعاء صور رمزية كالمطر، الحرير، والعصافير الفينيقية، ينسج الشاعر شبكة دلالية معقدة تربط المرأة بالحياة والحرية، مقابل قيود المجتمع التي تحاول كبح هذا الحضور الديناميكي.
المرأة بين الأسطورة والتاريخ:
يعتمد الشاعر على استعادة الرموز التاريخية والأسطورية المرتبطة بالمرأة، لكنه يعيد تأويلها وفق منظور معاصر يتحدى القراءة التقليدية. فحواء لم تعد مجرد رمز للخطيئة، وامرأة العزيز لم تعد مجرد امرأة خاضعة لرغباتها، بل تصبحان تجسيدًا لإرادة المرأة واستقلاليتها، وهو ما يعكس انحياز النص إلى رؤية متحررة من القيود النمطية.
النقد الاجتماعي والتاريخي:
تنحاز القصيدة إلى تفكيك الصورة المزدوجة التي يقدمها المجتمع للمرأة؛ فهي تُحاط بألقاب التقديس مثل "القارورة الرقيقة"، لكنها في الوقت ذاته تُحاصر بقيود تحد من دورها الاجتماعي. هذا التناقض يتم كشفه في مشاهد رمزية مثل الفتاة التي تربي أخاها ليحقق النجاح، بينما تظل هي في الظل، وكأنها مجرد "حائط مصدوع" في نسيج المجتمع، تعبيرًا عن التهميش النسوي.
اللغة والأسلوب:
تتميز القصيدة بالتكثيف الرمزي الذي يمنحها أبعادًا متعددة تتجاوز القراءة المباشرة إلى تأويلات أكثر عمقًا. فـ"العنقاء" ليست مجرد طائر أسطوري، بل تتخذ بعدًا دلاليًا يعكس قدرة المرأة على التجدد والنهوض من رماد القهر. أما "التفاحة"، فهي استدعاء ضمني لحواء، حيث تعيد الشاعرة تأويل هذا الرمز ليصبح دلالة على الإرادة النسوية بدلًا من الخطيئة.
الإيقاع والموسيقى الداخلية:
تعتمد القصيدة على الإيقاع الداخلي الناتج عن التكرار الصوتي والدلالي لبعض المفردات مثل "المثل"، "العنقاء"، "البقاء"، مما يخلق تموجًا موسيقيًا يعزّز الانفعال الشعري. كما أن التوازن بين الجمل الطويلة ذات الطابع السردي والجمل القصيرة الحادة التي تحمل صدمة شعورية، يساهم في دفع القارئ إلى التأمل وإعادة النظر في المعاني المطروحة. هذه التقنية لا تعزز فقط الإيقاع، بل تُحدث تفاعلًا ديناميكيًا بين المتلقي والنص، مما يجعل التجربة القرائية أكثر تأثيرًا وحيوية.
تحليل الأبيات الآتية التي تناولتها من قصيدة "العنقاء" يكشف عن مستوى عميق من الرمزية والتأمل، وهو يضع المرأة في قلب محوري يمثل التغيير والنهوض، مع التركيز على الصعوبات التي تواجهها نتيجة التقاليد أو الفكر السائد. لنلقِ نظرة أكثر تركيزًا على الرسائل المبطنة والاستنتاجات النهائية:
1. بداية القصيدة "المرأة كحلم غامض":
بداية القصيدة تكشف عن رمزية عميقة للمرأة كحلم يتجسد في الخيال، حيث يُصور الشاعر المرأة على أنها حلم بعيد أو غامض لا يمكن إدراكه بالكامل، كما يظهر في قوله:
حين تكون المرأةُ الأحلامْ
تنسدلُ السَّتائرُ الحريرْ،
فلا نرى أبعدَ منْ أنوفِنا.
هنا، تُقدّم المرأة كحلم بعيد، متمنّع عن التحقق، ما يعكس النظرة الاجتماعية التقليدية التي تقتصر فيها رؤية المرأة على جوانب جمالية فقط، دون أن تُدرك أدوارها الحيوية والعملية في المجتمع. تتداخل الستائر الحريرية كرمز يعكس الترف، الرقة، والمثالية، مما يعني أن المجتمع في بعض الأحيان يُحجم عن رؤية الحقيقة كاملة عن المرأة، وتظل مكانتها محجوبة تحت غطاء من الانطباعات السطحية. ويظهر الشاعر أيضًا حالة من الانغلاق الفكري في قوله "فلا نرى أبعدَ منْ أنوفِنا"، مما يرمز إلى النظرة الضيقة التي تعيق فهم دور المرأة الحقيقي في المجتمع.
2. تقدير المرأة كقوة حية ومؤثرة:
في المقطع الثاني، يتحول التصور عن المرأة من مجرد كائن جميل إلى قوة حيّة تُحرّك الوجدان والمجتمع، كما في قوله:
وخافقٌ يضربُ في صدورنا،
فكلّ نبض امرأةٍ هديرْ
والمطر الغزيرْ.
المرأة هنا تظهر كقوة فاعلة، حيث يُرمز إليها بـ "الخافق الذي يضرب في صدورنا"، ما يعكس تأثيرها العميق في نفوس الأفراد. كما يرمز الشاعر إلى طاقتها الحيوية بأنها "هدير" قوي يشبه حركة البحر التي تتجدد باستمرار، بينما يرمز "المطر الغزير" إلى خصوبة وقوة المرأة في بعث الحياة، سواء على مستوى الوجود الفردي أو المجتمعي. هذه الصورة تُظهر المرأة كمصدر للتجديد والإلهام في الواقع.
3. التساؤل حول ردود الفعل تجاه دور المرأة:
أما المقطع الثالث، فيُثير تساؤلاً هامًا حول كيف سيتعامل المجتمع مع تغير دور المرأة: هل سيختار الانفتاح الذهني على قوتها وتقديرها، أم سيقاوم هذا التغيير بالصراع والعنف؟ يتساءل الشاعر:
نفتحُ حينها عقولَنا
أم نسرجُ الخيولْ
والسَّيفَ والرُّمحَ
وصوتَ الحلمِ الغريرْ؟
الرموز في هذا المقطع، مثل "الخيول والسيف والرمح"، تمثل الصراع والتحدي، مما يشير إلى مقاومة البعض للتغيرات التي قد تأتي مع تحرير المرأة. بالمقابل، "صوت الحلم الغرير" يعكس الرغبات والطموحات غير المحققة بعد، مما يعبر عن حالة من التردد الاجتماعي في كيفية التعامل مع هذه التحولات. فبينما يرى البعض في هذا التغيير تهديدًا لقيمهم التقليدية، يراه آخرون فرصة لبلورة واقع جديد.
4. تحولات البدايات، ولادة الأمل والحلم:
في حلمٍ
يُبرعمُ الرَّبيعُ فوقَ صدرِها،
ينتظر اللحظةَ كي يدخلَ في الفؤادْ،
يُعطّرُ الروحَ بدفء روحها،
يقتطفُ العشقَ ويبدأ الحصادْ،
في هذه الأبيات، يظهر الشاعر في إطار إبداعي غني بالصور الرمزية التي تعكس فلسفته الحياتية ونظرته العميقة لدور المرأة في الوجود. يُصوّر الشاعر المرأة كحاضنة للحياة، حيث يُبرعم الربيع فوق صدرها، مما يعكس بداية النماء والتفتح. هذا التصوير لا يقتصر فقط على المعنى البيولوجي للأمومة، بل يتعداه إلى كونها رمزًا للعطاء المتجدد. كما أن "ينتظر اللحظة كي يدخل في الفؤاد" يشير إلى لحظة تحول حاسمة تتداخل فيها الأحاسيس السطحية مع الجوانب الأعمق للروح، مما يعكس التأثير العاطفي العميق للمرأة في الوجود.
في "يُعطّرُ الروحَ بدفء روحها"، يُقدم الشاعر تصورًا للمرأة ككيان روحي يمنح الحياة دِفئًا وإشراقًا، تمامًا كما يترك العطر أثرًا دائمًا. أما "يقتطفُ العشقَ ويبدأ الحصاد"، فيعكس اكتمال الدورة الإنسانية وتحوّل المشاعر إلى تجربة ملموسة، تتوج بالإنجازات التي تفيض بالعطاء. هذه الأبيات تتسم بغنى لغوي ومهارة تصويرية، مما يتيح للقارئ التفاعل مع المعاني المبطنة والتأمل في مسار النمو والازدهار الذي يوصل إلى النضج.
5. الأسطورة وتعدد دلالاتها، تفاحة الخطيئة:
في كتبِ الرِّوايةِ الأولى:
غزالةٌ تسلَّقتْ تفاحةَ البقاءْ،
وانتزعتْ تفاحةً لتقضمَ الغرامَ
واللعنةَ، والدهاءْ،
الاستدعاء للأسطورة التقليدية في قصة "آدم وحواء" عبر التفاحة يضيف بعدًا رمزيًا عميقًا. التفاحة، التي كانت رمزًا للخطيئة والمعرفة المحرمة، تُعيد إنتاج المعاني المتداخلة التي تجمع بين اللذة والعذاب، العشق واللعنة. في هذه القراءة، تظهر "الغزالة" كمخلوق برئ، لكنها تتجاوز البراءة لتصبح رمزًا للتمرد والتحدي على القيود الاجتماعية والأخلاقية. من خلال سعيها وراء التفاحة، تُظهر الغزالة رغبتها في اختبار المحرمات، مما يجعلها تتجسد كرمز للمخاطرة والتجربة التي تحمل في طياتها قدرًا من الهاء
6. جمال يوسف وصراع الرغبات:
امرأةُ العزيزِ راودَتْ فتاها عنْ نفسهِ
في حضرةِ العشقِ، وفي أمّارةِ الرَّغبةِ
في مملكةِ الأهواءْ،
استحضار قصة يوسف وزليخة في هذا المقطع يظهر الصراع بين الرغبة المكبوتة والعشق المُعذِّب. في "مملكة الأهواء"، يتجسد الصراع الداخلي للمرأة التي تتجاوز محظورات المجتمع وتتمرد على القيم التقليدية. "هيتَ لك" تصبح صرخة تحرر ورغبة خارجة عن المألوف. وفي المقابل، يظهر يوسف في هذا السياق أسيرًا لجماله، ما يعكس مأساة مزدوجة: من جهة هو في صراع داخلي مع رغباته، ومن جهة أخرى هو ضحية الجمال الذي يُستخدم كأداة للصراع بين القيم المجتمعية والتوقعات الشخصية.
7. الجمال وجدلية المأساة والمجتمع:
فانفجرتْ دماءُ صالةِ النِّساءْ،
صرخْنَ: هيتَ لكْ!
يا أيُّها الأبدعُ خلقِ اللهِ في البقاءْ
يُصور الشاعر الجمال كعنصر يثير التوتر والصراع في المجتمعات التي تحكمها تقاليد صارمة. جمال يوسف، رغم كونه هدية إلهية، يصبح مصدرًا للمعاناة والصراع بسبب التوقعات الاجتماعية والقيود المفروضة. هذه "التراجيديا" تجعل الجمال، بدلاً من أن يكون سببًا للسعادة، يصبح نقطة اشتباك بين الرغبات الفردية والأعراف المجتمعية، فيُظهر يوسف في هذا السياق كرمز للألم الناتج عن قيود المجتمع.
8. "استدعاء الأسطورة" تفاحة الخطيئة والمصير:
في كتبِ الرِّوايةِ الأولى:
غزالةٌ تسلَّقتْ تفاحةَ البقاءْ،
وانتزعتْ تفاحةً لتقضمَ الغرامَ واللعنةَ، والدهاءْ،
هنا، نجد إشارة ضمنية إلى النصوص المقدسة أو الروايات الأسطورية الأولى التي وضعت الأسس لمفاهيم الحب والخطيئة. "غزالةٌ تسلَّقتْ تفاحةَ البقاء" يرمز إلى البراءة والجمال الذي يتحدى الممنوع، كما في قصة "آدم وحواء". التفاحة في هذا السياق تتجاوز معناها التقليدي لتصبح رمزا لتجربة الإنسان المليئة بالتناقضات، من الحب إلى الخطيئة، من اللذة إلى العقاب.
9. استدعاء قصة يوسف ونساء المدينة:
امرأةُ العزيزِ راودَتْ فتاها عنْ نفسهِ
في حضرةِ العشقِ، وفي أمّارةِ الرَّغبةِ
في مملكةِ الأهواءْ
تُسلّط هذه الأبيات الضوء على قصة يوسف وزليخة من زاوية جديدة. هنا، الجمال يُعَذِّب يوسف، وتحول نساء المدينة إلى رموز للتمرد على التقاليد. في "مملكة الأهواء"، تُستعرض الرغبات المتناقضة، التي تثير الصراع الداخلي والخارجي على حد سواء، فتبرز المرأة في هذا السياق كمحرك للتغيير الذي لا يخلو من المخاطر.
10. انفجرت دماء صالة النساء، صرخن:
هيت لك!
يا أيها الأبدع خلق الله
في البقاء
"انفجرت دماء صالة النساء": يعكس هذا المشهد انبهار نساء المدينة بجمال يوسف الذي يبدو غير قابل للتحقيق، وتظهر الدماء هنا كرمز للقهر والدهشة المتزايدة.
"هيت لك": الصيحة تعبر عن رغبة مكبوتة، لكنها تحمل أيضًا تهديدًا بالخضوع للجمال كقوة خارقة للطبيعة ومصدر لتحديات اجتماعية ودينية.
11. جدلية الجمال والخضوع للمجتمع:
خُلِقتَ في أحسن تقويم
كنتَ لعبة المقدود من دُبُرٍ
وتجريح النساء
"خُلِقتَ في أحسن تقويم": استعارة من آية قرآنية تصف الجمال الذي خلقه الله بشكل مثالي، لكن هذا الجمال يوضع تحت ضغوط المجتمع الحادة التي تقيد حرية صاحبه.
"كنتَ لعبة المقدود من دُبُرٍ": استعارة تعكس غياب السيطرة الذاتية، حيث يُستغل الجمال وتصبح صاحبه مجرد أداة ضمن مؤامرات تُحاك حوله.
"وتجريح النساء": الجمال يصبح مصدرًا آخر للمعاناة، سواء لصاحبه أو لمن يتأثرون به، ما يُبرز التداخل بين النعمة والمعاناة.
12- إنّ ضلعي يتوارى اليوم خلفَ الظَّهرِ
يسقيني بساتينَ الهواء
وأناشيدَ خريرِ الماءِ صوبَ جنةِ البَّهاءْ
"إنّ ضلعي يتوارى اليوم خلفَ الظَّهرِ"هذه العبارة تعكس الشعور بالضعف أو التهميش، فالعلاقة بين الضلع والإنسان تحمل دلالات ثقافية ودينية، وقد يُفهم الضلع هنا كرمز للأنا المتوارية أو الهامشية.
"يسقيني بساتينَ الهواء": تصف هذه الصورة بساتين الهواء التي توحي بالوهم، مما يعكس حالة من التلاشي أو الآمال غير المحققة التي تظل بعيدة عن الواقع.
"وأناشيدَ خريرِ الماءِ صوبَ جنةِ البَّهاءْ": يربط الشاعر الماء كرمز للحياة والطهر بمكان بعيد عن الواقع، ما يوحي بالبعد بين الحال المثالي والواقع القاسي.
13. السَّلسبيلُ هُنَّ،
قيلَ: رفقاً بالقواريرِ، انكسرنا نحنُ،
والقارورةُ الزُّجاجُ في مكانِها
في حانةِ الصَّدرِ،
"السَّلسبيل": يرمز إلى الماء العذب من الجنة، ويُستخدم هنا ليعكس رمز الحياة والنقاء، كما يعبر عن صفات الروح الطاهرة للمرأة.
"قيلَ: رفقًا بالقواريرِ، انكسرنا نحنُ": إعادة توظيف للحديث النبوي عن النساء كالزجاج، مع نقد لحالة الانكسار التي تعانيها المرأة في الواقع، حيث يتحول الجمال إلى مصدر قسوة بدلاً من الحماية.
"والقارورةُ الزُّجاجُ في مكانِها": يظهر التناقض بين المظهر الخارجي المستقر للمرأة وبين الواقع الداخلي المهشم الذي تعيشه.
"في حانةِ الصَّدرِ": ترمز هذه العبارة إلى المكانة العاطفية للمرأة، ولكنها تحمل أيضًا إشارة إلى استهلاك المجتمع لها على الصعيد العاطفي.
"وفي أحسنِ تقويمٍ، وفي أجملِ تنظيمٍ": يعكس هذا الاستدعاء النقدي لتناقض صورة الكمال المثالية مع الواقع الذي يعاني فيه النساء من الانكسار والتهميش.
"وأشهى منْ دمِ الغزالْ": رغم جمالها، المرأة تُعامل كفريسة في مجتمع لا يقدر جوهرها، بل يراها مجرد غاية يتم استغلالها.
من خلال النصّ الآتي أدناه من القصيدة، يقدم الشاعر نقدًا اجتماعيًا يعكس التناقضات العميقة بين الصورة المثالية التي يتم تقديمها للمرأة وبين الواقع المعيش الذي يظل مليئًا بالقهر والانكسار، يقول الشاعر:
أبي وأمي أرضعاني مَثَلاً،
أختي التي ربّتني أحيا مثلاً،
أكملتُ منْ تحت يديها؛
كي تراني مثلاً،
مُدرِّساً صرْتُ،
وصارَ السِّينُ والصَّادُ مثالاً ساطعاً:
مهندساً، محامياً، مُطبِّباً،
أو عاملاً مكافحاً، أو قائداً مثقفاً
أو ناشرَ الهواءِ في الأرجاءْ،
أختي التي ربّتني أحيا مَثَلاً
ظلّتْ جوارَ الحائطِ المصدوعِ تحيا مَثَلاً،
كانتْ تصوغٌ الثوبَ بالخضرةِ، بالماءِ،
بتغريدِ الحمامْ
وحبِّ مَنْ يغزلُ مِنْ غنائهِ حلاوةَ الأحلامْ
ورايةَ السلامْ،
في مرضي
كانتْ هي الضِّمادَ والدَّواءَ والحنانْ.
في الامتحانْ
تجلسُ في فُوّهةِ البابِ وفي لسانِها
زغرودةُ النجاحْ،
في السِّجنِ زارتني
وفي العينين كبرياءْ،
لا تعبٌ مرٌّ ، ولا إعياءْ،
وقلبُها صُلْبٌ منَ الصُّمودْ
والأملِ الموعودْ،
وحينَ لفّوا الحبلَ حولَ الرَّقبةْ
أو فجّروني ارتفعتْ برأسِها، صاحتْ:
سيبقى مَثَلاً ، وخالداً،
مادمْتُ في الأحياءْ،
ما دامتِ العنقاءُ والرَّمادْ والبقاءْ.... هذه الابيات تعكس صورة عميقة عن تأثير العائلة، خاصة الأخت، في تشكيل شخصية الانسان وتحليل النص بشكل مختصر: "أبي وأمي أرضعاني مَثَلاً": يُظهر الشاعر دور والديه في غرس القيم والمبادئ منذ الصغر، بحيث تكون هذه القيم مثل الغذاء الروحي الذي يغذي الشخصية. واستخدام مفردة "مثلاً" يعبر عن أن هذه القيم لم تكن مجرد تعليمات، بل جزءًا أساسيًا من تكوينه الشخصي.
"أختي التي ربّتني أحيا مثلاً": يتناول الشاعر دور الأخت باعتبارها نموذجًا يحتذى به، ويُظهر كيف أن الأخت لعبت دورًا محوريًا في تربيته وتشكيل شخصيته، خاصة في الأوقات التي قد يفتقد فيها الشاعر أحد والديه.
"ظلّتْ جوارَ الحائطِ المصدوعِ تحيا مثلاً": يبرز هنا تماسك الأخت في وجه الصعاب، ويُرمز إلى "الحائط المصدوع" بالصعوبات الاجتماعية، ويُظهر أن الأخت رغم هذه الظروف، كانت رمزًا للصمود والمثابرة.
"كانتْ تصوغٌ الثوبَ بالخضرةِ، بالماءِ، بتغريدِ الحمامْ": يقدم الشاعر صورة فنية للأخت كرمز للعطاء والجمال، حيث كانت تزين الحياة بكل ما هو جميل ومعطاء، مما يعكس تأثيرها الإيجابي على البيئة المحيطة.
"وحبِّ مَنْ يغزلُ مِنْ غنائهِ حلاوةَ الأحلامْ": تعبر هذه العبارة عن القدرة على تحويل الألم والتحديات إلى حلم جميل، فالأخت هنا تمثل الأمل والمثابرة.
"كانت هي الضمادَ والدَّواءَ والحنانْ": في لحظات الأزمة والمرض، تظهر الأخت بمثابة الحماية والرعاية الشاملة، بما في ذلك الجوانب الجسدية والعاطفية.
"في السِّجنِ زارتني وفي العينين كبرياء": يمثل السجن في النص رمزًا للظلم والقهر، بينما زيارة الأخت تمثل الدعم العاطفي والإنساني في أوقات المحن، وتجسد الكبرياء والمثابرة في ظل الصعاب.
"وحينَ لفّوا الحبلَ حولَ الرَّقبةْ": يقدم الشاعر صورة رمزية للإعدام أو القتل في سبيل قضية سامية، ويُظهر كيف أن التضحية لا تمحو الرسالة، بل تجعل منها رمزًا خالدًا.
"سيبقى مَثَلاً وخالداً": تُجسد هذه الجملة فكرة أن النضال والتضحية لا يزولان مع الفناء الجسدي، بل يتحولان إلى إشعاع دائم، بفضل من يحيي ذكرى الشهيد ويروي قصته.
"ما دامتِ العنقاءُ والرَّمادْ والبقاءْ": العنقاء هنا ترمز إلى التجدد والأمل بعد الموت، حيث يتم الربط بين الموت والحياة، مُعبّرًا عن فكرة البقاء والنمو بعد الانكسار.
في المجمل، يعكس الشاعر من خلال هذه الأبيات قيمة العائلة، وخاصة الأخت، في تعزيز القيم الإنسانية والصمود أمام التحديات، مشيرًا إلى أن التضحية والمثابرة تظل خالدة في ذاكرة الأحياء
الاستنتاج النهائي لتحليل القصيدة:
تُقدم قصيدة "العنقاء" للشاعر عبد الستار نورعلي رؤية شعرية شاملة تركز على قيم البطولة والتضحية، حيث يتم إعادة تفسير الألم ليصبح رسالة أمل متجددة. في هذه القصيدة، يُرفض التفكير في الموت كخاتمة نهائية، بل يُعاد تعريفه كبداية جديدة، حيث تذوب الأجساد بينما تظل الأفكار حيّة وخالدة في الوعي الجماعي.
في هذا السياق، تتجاوز المرأة في القصيدة دور المشاهدة السلبية للأحداث لتصبح قوة فاعلة في التاريخ، تحول الأحزان إلى منبع للإلهام وتعكس صلابة الإرادة في مواجهة التحديات. من خلال الرموز الفلسفية العميقة مثل الحبل، الانفجار، العنقاء، والرماد، تتجسد جدلية الفناء والبعث بشكل واضح، ليصبح الموت مدخلًا لعملية الخلود التي تُغذي النضال الجماعي.
لا تقتصر القصيدة على التعبير عن تجربة فردية للفقد، بل تعلو بها لتصبح قضية جماعية تنطلق من الألم الشخصي لتؤكد إرادة الحياة واستمراريتها. من خلال هذا الأسلوب، يتمكن الشاعر من تشكيل نص شعري يعكس المزيج بين الأسطورة، الرمزية الفلسفية، والالتزام بالقضايا الكبرى. وهكذا، تبرز القصيدة في النهاية أن الموت ليس نهاية مسدودة بل بداية جديدة، تتجسد في التضحية التي تُعيد الإنسان إلى حالة من الخلود، حيث يتحول من كائن زائل إلى رمز حي يُلهم الآخرين ويقودهم نحو أفق مشرق.
من خلال هذا السياق، تعيد القصيدة تعريف دور المرأة في إطار غير تقليدي، حيث تبرز كعنصر حيوي في المقاومة والتحمل، مُظهرة أن التضحية ليست مجرد فعل إنساني عابر، بل هي مسار طويل نحو الخلود، حيث يصبح الإنسان رمزًا يُلهِم الآخرين في رحلة النضال المستمرة.
***
سهيل الزهاوي