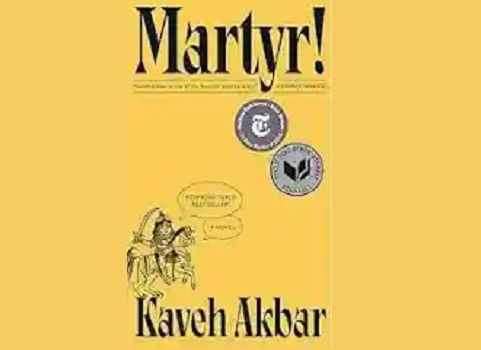قراءات نقدية
صالح الرزوق: بورتريه بولص آدم

يعود اطلاعي على تجربة الأخ والأستاذ بولص آدم إلى بدايات الألفية الثالثة حينما كان يكتفي بقرض الشعر. وأستعير كلمة قرض من ذاكرتنا الكلاسيكية. فالشعر هو ديوان العرب. ولكن انتباهتي لتجربة بولص بالأساس كان لها مدخل غير عروبي.
أولا أنني وجدت في رؤيته للشعر نوعا من التطابق اللاهوتي والباطني مع تجربة الشاعر البولوني المستنير والمتمرد جيسلاف ميوش. فكلاهما يرهن تراكيبه لواقع غامض ونثري ويتطور على الحد الفاصل بين الظلام والنور. وقد بلغ ميوش أقصى إمكاناته في هذا السياق بمجموعته المتأخرة "الفضاء الثاني"، والتي صدرت ترجمتها الإنكليزية عام 2005. وهي إعادة تفسير وتركيب لخبراته مع الدولة والذات والكتاب المقدس. بمعنى أنها رؤية تدمج في مستوى واحد المادة والميتافيزيقا والواقع. ولبولص ما يشبه ذلك في كل مجموعاته وقصائده الأولى، فهو يتكلم عن نفسه من حيث أراد أن ينعي إلينا الواقع الشمولي والمتهافت لعالم أشرف على السقوط.
المدخل الثاني تشابه اسمه مع كاتب اسكوتلاندي مشهور وقليل الحظ وهو ألكسندر تراكي. فقد بدأ حياته برواية "آدم الصغير" (وكنية بولص هي آدم). وقد تناول تراكي في كتابه الجريء حكاية تنافس أخوين على قلب امرأة واحدة. وربما تجد فيها أصداء لرواية "صحراء الحب"، وهي للفرنسي ذائع الصيت فرانسوا مورياك. وتدور حكايتها حول تنافس أب وابن على قلب غانية.
يبقى بولص أقرب لميوش من ناحية الحياة الخاصة. لأن الاثنين مرا بتجربة مع النظام انتهت بالهرب والقطيعة والهجاء. في حين أنه احتفظ بمسافة عن تراكي الذي وجد نفسه مطلوبا للعدالة بتهمة البغاء والترويج للهروين. وتجد كل هذه التفاصيل في كتاب لويس عوض عن "الاشتراكية والأدب".
ولم يتوقف بولص عند الشعر. فقد فاجأنا بعدة أعمال روائية وقصصية عن السجون والهجرة ومشاكل الحداثة وما بعدها. وربما تجاوز نفسه وأبناء جيله بعملين صغيرين وهامين هما "باصات أبو غريب". و"روائي بلا نسخ". وبالرغم من الفارق بينهما من ناحية الأسلوب تستطيع أن تجد نفسك وسط زنازين أبو غريب وضمن مجتمع السجناء (وقد ترك هذا الكتاب في ذهني أكثر من لمحة تشابه وجدتها في "قافلة الإعدام" للإيراني بهروز قمري). كما أنه تجد نفسك داخل متاهة الروائي المجهول الذي ينشر أعماله قبل أن يكتبها. وهذه الفكرة تداهم حالة السبات العربي وتفضح الحفرة الوجودية التي نهبط فيها بالإكراه والإجبار.
ثم رفد بولص أعماله الصغيرة والمتألقة بكتابين ضخمين. الأول "نينا تغني بياف"، وهي كما أسميها روايته الأوروبية، فكل أحداثها أو معظم أحداثها تجري في بلدان الشمال. وتخيم عليها أجواء أرستقراطية ومخملية. وإن كان لا بد من المقارنة أضعها من ناحية السياق بجانب رواية "نهم" للدكتور شكيب الجابري. وقد أصدرها في الثلاثينات، واختار لها شخصيات ألمانية مائة بالمائة وأسندر دور البطولة لكوزاريف الإنسان المادي والعدمي والذي ينتهي نهاية مأساوية. وكانت غاية الجابري إدانة أخلاقه ومنهجه. وربما كان بولص يريد أيضا في رواية "نينا" أن يكتب بيانا ضد المعوقات التي تؤخر وتخنق تفتح المواهب. وهو أيضا ديدنه في روايته التالية "تسجيلات يوناذم". ويركب فيها المركب الصعب، ويتابع سيرة عراقي آشوري تدفعه الظروف للهرب إلى أمريكا، ثم العودة إلى العراق، وبنفس المخطط الذي تحكم برواية "أمريكا" لربيع جابر. غير أن جو بولص هو الجبال والبوادي، وشخصياته من الذكور الذين اعتادوا على المخاطر. ولا تخلو هذه النزعة من روح استشراقية واستشراق مضاد. وبالأخص أنه يلمس رسالة الحضارات النائمة في بلاد ما بين النهرين. بقصد الإحياء والنهوض أو العودة لمسرح الأحداث (ولكن بأجندا غير دموية تتبنى أدوات نصفها اقتصادي والآخر معرفي - بمعنى الثقافة الاجتماعية). بينما اختار جابر جو البيت والدكان - ووضع على رأس روايته امرأة أمسكت بيدها زمام الأمور. ولهذا السبب أجد أن رواية بولص برية ورواية جابر مائية. وتذكير الحضارة وتأنيثها يأتي بعد تذكير الهوية وتأنيثها. فقد بدأت الرواية العربية من طلب العلم في أوروبا، وتأنيث المعرفة والدخول بصراع سيميائي مع المرأة الأوروبية قبل قطع العلاقة بحجة الأخلاق - كما فعل العجيلي وسهيل إدريس والطيب صالح، لتنتهي بالهجرة أو اللجوء وتأنيث الحرية واقتصاد السوق.
***
د. صالح الرزوق