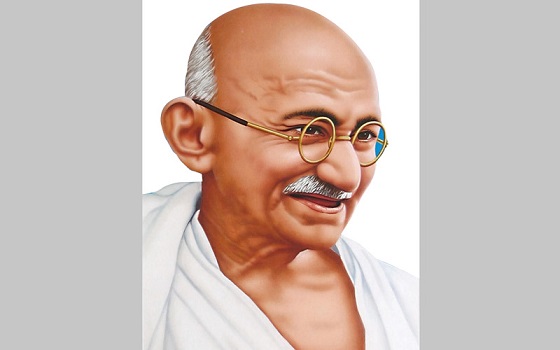قراءات نقدية
وسام العبيدي: جدل الثنائيات في رواية "قافز الموانع"..

ما لا يختلف عليه المتابعون للمشهد الثقافي بصورة عامة، هو كثرة النتاج الأدبي - شعرا كان أم نثرا - في موضوعات كثيرة، قد لا يتاح للمتلقّي أن يطالع تلكم الأعمال جميعها متابعة الراصد المتأمِّل في مبناها تارةً وفي معناها تارةً أخرى، وفي الوقت نفسه لا يمكن الزعم أن تلك الكثرة تعد من علامات التعافي والازدهار في المشهد الثقافي، ففي ظلِّ استسهال النشر، واندلاق لعاب نسبة عالية من الذين يَحبُون حبْوًا في طريق الأدب قراءةً له، وقفزهم - بقدرة قادر - إلى مرحلة الكتابة والنشر، فضلا عن غياب النقد الموضوعي الرصين عن متابعة تلك الأعمال متابعةً تكشِفُ الزَّبَدَ منها عمَّا ينفع الناس؛ لأسبابٍ معروفةٍ أو مجهولةٍ بقَصدٍ أم مِنْ دُونِه، تَفَشَّتْ تِلكُمُ الأَعمالُ الأدبيَّةُ في ظاهرها، ولكنّها بعد التمحيصِ النَقديِّ الجاد، قد لا تجدُ لها نصيبًا من هذا الوصف.. !
والكلامُ أعلاهُ إنَّما يصفُ ظاهرةً لا يُمكِنُ بحالٍ من الأحوال جعلها قاعدةً تنطبق على جميع الأعمال الأدبية، فكما قيل: "لكلِّ قاعدةٍ استثناء" ومن هذه الاستثناءات التي أقفُ عندها في مجال الرواية، ما صدرَ للروائيِّ العراقيِّ القدير سلام حربة، من عملٍ روائي رصين حمل عنوان: "قافز الموانع" عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق لهذا العام، يستحق أن نُنوِّهَ عنه؛ لما أثارته من إشكالات في الواقع الاجتماعي بعد تغيير النظام السياسي في العراق، ونقول إشكالات وليس إشكالية واحدة، على الرغم من أنَّ الناظر في الرواية سيجد أنَّ حدثًا بارزًا يستولي عليها دون غيره، وهو المتعلق بادّعاء السيادة – أي الانتساب إلى آل الرسول – لشخصيّة ثانويّة في الرواية – وهو ناصر الذي ادّعى فيما بعد أنه (المبارك) – لكن الشخصية الرئيسية – وهو علاء ويكون ابن أخٍ لناصر – إلا أنَّ هذا الادّعاء سيتولّد عنه إشكالياتٍ أخرى، إذ بعد ظهور العمِّ (المبارك) على الساحة بعد أنْ كان مختفيًا لمدةٍ طويلة كان لأهلِ المحلّة أن تنسى معالم وجهه، ولا تعرف أنه (ناصر) الذي لم تفارق اسمه الموبقات والمنكرات، مستغلاًّ اضطراب الوضع الأمني، مدّعيًا باللقب المبارك ليموِّه على الناس، ويجعلهم تابعين له، باعتبار أنَّ الذي ينحدر من هذه السلالة المباركة في عُرف ذلك المُجتمع شخصٌ منزّهٌ عن فعل الموبقات، وهنا تبدأ المواجهة بين علاء الذي لم يقتنع بهذه السرديّة التي انطلَت على أهلِ المحلّة وعلى أخيه المعروف بسلوكه الجنسيّ المنحرف، وكان يقف إزاء كلِّ ما يصدر عن عمِّه من مواقف وسلوكيّات بالمرصاد، مذكِّرًا أنّ النسب الذي يدّعيه باطلٌ وأنّه ينحدر من نسبٍ قيل من أصول غير عربية، وهنا لم ينظر علاء إلى نسبه نظرة ازدراء، ويتشبّث بالنسب المبارك الذي ألصقه بهم العم المبارك، بل رأى – وهو أستاذ التاريخ – أنَّ الإنسان هو الذي يُشرِّف نسبه، وليس العكس، هذه الرؤية العقلانية التي آمن بها علاء، كانت الدافع لأنْ يبقى صلدَ الموقف إزاء ترغيب وترهيب عمِّه الذي ازدادت شعبيّتُه في المحلّة التي عاد إليها يومًا بعد آخر، فضلاً عن ضغوط زوجته وابنته اللّتين اعترضتا عليه أكثر من مرّة خوفًا مما سيجرّه موقفه عليه من مخاطر بدت تُحيق به وتزداد، وهنا يُجسِّد لنا الكاتب أزمة المثقّف حين يجد أقربَ الناس منه يتخلّون عنه ولا يجد عونًا له أو تشجيعًا منهم فيما يتّخذه من موقفٍ مسؤول في زمنٍ تلتبس فيه الحقائق وتضيع فيه القيم الأخلاقية..!
وإذ يتمسّك البطل "علاء" بالجذور، عبر البيت القديم الذي ورثه من أبيه، يجسِّد لنا الكاتب عبر شخصية العمِّ المنتحل صفة (المبارك) انسلاخه من تلك الجذور وقفزه على القيم الأخلاقية في عدم احترامه بيت العائلة، إذ استولى عليه حين ظهر بعد سقوط النظام السياسي، مدّعيًا أنَّ والده قبل أنْ يتوفاه الله كان مدينًا له وفي حال عدم تسديده الدين، كان قد كتب له البيت في قصّةٍ ساقها على (علاء) مستغلاّ سطوته المادّية على من يستطيع التأثير عليهم. وكان له بعد هذه الخطوة أنْ يعمل على تغيير كثيرٍ من معالمه بدءًا من إزالة الباب العتيقة التي توقّف عندها الكاتب واصفًا تفاصيلها الدقيقة معبِّرًا من خلال ذلك الوصف عن عمق الذكريات الجميلة التي مرّت على ذاكرة (علاء) وهو يرى الباب مرميّة على الأرض كجثّةٍ هامدة، وهي خطوة تكشف عن لا مبالاة ذلك العمِّ بإرث العائلة، بقدر ما تعمل على مسح كل ما يتعلق بها من ذاكرة ترتبط بالمكان وتفاصيله، وعبر ذلك التجريف المتعمّد من قبل العمِّ المدّعي لصفةٍ دينية، يوصل الكاتب لنا رسالةً واضحة تتمثّل بزيف ادّعاء تلك الصفة من قبل ذلك العم، وذلك من خلال وضع يده على مُلك أبيه من دون أنْ يتقسّم على بقية أولاده بحسب الأحكام المرعيّة في مسألة الإرث، ولم يكتفِ بهذا الدور، بل عمل من البيت مقرًّا لمجالسه الدينية التي يعقدها، موظِّفًا قدرته المالية على جذب البسطاء من الناس الذين يحتشدون على مجلسه الذي تُرافقه الولائم الدسمة، وبهذا أظهر الراوي لنا سلطة الكهنوت الديني على وسط اجتماعي مهيّأ لتقبّل هكذا ادّعاءات وتصديقها لسطحية الوعي الجمعي الذي يقيد عقول هؤلاء الأتباع، ويمنعهم من مناقشة هكذا ادّعاءات بموضوعية. وهنا تبرز شخصية علاء الذي لم يُهادن إزاء سلطة ذات وجهين: سلطة القرابة ممثّلةً بالعم (ناصر) وسلطة رجل الدين الذي تمثّل بعنوانه الجديد: (المبارك) الذي بسط نفوذه على المحلّة وصار الناس البسطاء يلتفّون حوله ويتكاثرون يوما بعد آخر، ويُمكن أنْ نضيف لها سلطة أخرى انضمّت إلى السلطتين السابقتين، وهي سلطة الأعراف التي تقضي على الشخص أنْ لا يغيّر السائد أو يعترض عليه، إذ كانت الأعراف تقضي على بطل الرواية مجاراة الناس في تقاليدهم وسلوكياتهم، ولا يقف منتقدًا ما يقومون به من أفعال أو أقوال، وهو الأعزل لا يملك غير الثقافة الي تزوده بالموقف الشجاع، ويبقى في صراعٍ مع زوجته (بتول) التي تحاول جهدها في ثنيه عن الوقوف بوجه عمِّه ومن اصطفَّ معه من أشخاص، وفي قبال رفضه فكرة الرحيل عن المحلّة، يرتفع صوته بالقول: (لن أترك هذا المكان وسأواجههم، عمّي وباسم وجودي، بكلِّ ما أستطيع حتى ولو بصوتي فقط، أنا بحقيقتي وهم بزيفهم وكذبهم، إنْ تنازلتُ لهم سيجعلون من حياتي جحيما..) والمكان الذي أشار إليه يمثِّل الجذور التي ينتمي إليها الإنسان، وكلُّ ما يمُتُّ بها من آثار للأسلاف، وما يطمح الإنسان تحقيقه فيها من أحلام ومنجزات، فهو إذن يُدرك أنَّ الهويّة لا تتجسّد إلا من خلال ارتباط الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه، ويمكن لنا أنْ نستجلي ذلك بوضوح في قوله: ((أنا لا أحبُّ الأحياء الحديثة والقصور الكبيرة، لأنّها مُسيّجة ومعزولة عن بعض ولا أحد يعرف ما يجري داخلها ولا يتسرّب منها حرف كلام، بيوتٌ تنغلق على أسرارها، أنْ تكون أحد أبنائها أو ساكنيها يُشعرك بالترفّع والتكبّر وأرقّ كرامةً من الآخرين. وُلِدتُ في محلّة الوردية وامتلأت زغابات روحي برائحة أزقّتها الطينية وعفونة أبواب بيوتها الخشبية المتآكلة بمطارقها النحاسية ذوات الأشكال الهندسية الجميلة، تخدّرت خياشيمي بروائح أنواع الأكلات التي تخرج من مطابخ بيوتها القديمة وتعوّدنا رؤية الأيدي وهي تحمل الصواني الممتلئة بمواعين الأكل التي فيها ما لذّ وطاب تتصاعد منها خيوط الأبخرة الحارّة المتموّجة الراقصة التي يجب أنْ يأكلها الجار قبل صاحب الدار. لا حاجة لسكنة هذه المحلات الشعبية إلى اقتناء السيارات لأنهم في وسط المدينة يحيطهم النهر والأسواق والمقاهي والدكاكين من الجهات الأربع) ص135 . فالمكان لديه يُشكّل جزءًا لا يتجزأ من ذاته، بوصفه مستودعًا للذاكرة التي يتلخّص منها موقفه الفكري والثقافي من الماضي والحاضر والمستقبل. وبهذا التفصيل ينطلق البطل علاء في تقييم ما حوله من مظاهر وأحداث وشخصيات، ساعيًا إلى ترسيخ مبادئ لم تكن غريبة عن هذه البيئة التي عاش فيها.
ولكن المفارقة تكمن حين يعيش المُنتمي لهويته الوطنية في زمنٍ تتبدّلُ فيه الولاءات والانتماءات والآراء والمواقف لمصالح فئوية أو شخصية، وهنا يعيش البطل (علاء) زمنًا يصفه بالقول: (الزمن في معظم البلدان يتقدّم إلى أمام إلا في العراق فإنه يمضي إلى الخلف، الزمن بطبيعته هو ما يرسم المستقبل الذي تبصره الشعوب وتتحرك بثبات وإصرار وبأرواح منفتحة نحوه. حين يكون الماضي أجمل من الحاضر فاقرأ على هذا البلد السلام) 176.. وفيما يؤكّد أنَّ (علاء) يعيش انتماءه الوطني أنّه لم يلق أذنًا صاغية لمن راح يخوِّفه من رحلته إلى الرمادي مرورًا بالفلوجة، هذه المدينة التي احتدمت بالأحداث بعد سقوط النظام، إذ يصف لقارئه ما رآه من أهوال، بالقول: (كان الوصول إلى هذه المدينة يعني أنْ تكتب وصيّتك لأنّ فرصة الرجوع منها ضئيلة أو تكون معدومة، الطريق إلى المحافظة مُخططٌ بالمفارز الأمريكية المُطعّمة بأعداد قليلة من قوات الأمن العراقية، أما الوصول إلى مدينة الفلوجة، مدينة الجوامع، يعني أنْ تنطق بالشهادة. هذه المدينة لم تهدأ أبدًا وأصبحت مركزًا لتنظيم القاعدة ودخلت في كرٍّ وفر في قتالها مع القوات الأمريكية والعراقية وقصّت ذيل المحتل حين دخلها عددٌ من المتعاقدين من قوات البلاك ووتر إلى المدينة في آذار 2004 حيث جرى قتلهم وتعليقهم على جسر المدينة وأعمدتها) 176 – 177. وبعد ذلك يتفاجأ البطل علاء بأنْ يجد زميله القديم في الدراسة المعروف بتوجهه اليساري، قد صار بقدرة قادر ملتحيًا متأثّرًا بموجة التدين الشكلي الذي تفشّى بين ساكني هذه المحافظة، مستغربًا عن سرّ ذلك الانقلاب، والروائي إنما يستعرض هذا الموقف وغيره من مواقف إنما يسعى إلى تأكيد وحدة البطل في عالمٍ غير منسجمٍ ورؤاه الاجتماعية أو الفكرية، الأمر الذي دعاه إلى توظيف المنظور الشخصي للكاتب، لأجل إقناع القارئ بما يراه جديرًا بالأهمية والتقدير، وبحسب قول الدكتور شكري الماضي: (وإذا كانت الرواية الحديثة تكابد من أجل اختفاء الكاتب لتقديم المادة الروائية بموضوعية، فإنّ الروائي الجديد يتدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة، بل يتعمد مخاطبة القارئ ومحاورته كما يتقصد التعليق والشرح، وكل هذا من أجل تحطيم مبدأ "الإيهام بالواقعية") [أنماط الرواية العربية الجديدة: ص 15] وإذا كانت بعض مشاهد الرواية قد أخذت المبالغات في صياغة بعض أحداثها ما جعلها مفارقةً للمطابقة الحقيقية للواقع المعيش في الوسط الاجتماعي الذي شيّد الروائي أحداثها فيه، فإنَّ ذلك ما تستدعيه الوظيفة التخييلية للرواية بوصفها نقلاً لا يستدعي المطابقة الواقعية بحذافيرها عن الواقع، بقدر ما تكون (بنية فنية دالّة على الاحتجاج العنيف، والرفض لكل ما هو متداول ومألوف، وهي تجسيد لرؤية لا يقينية للعالم، مع تأكيد تنوع نماذجها وتعدد ألوانها وتباين أطيافها واختلاف مناهجها في التصوير) وهذا ما يمكن أنْ يُدركه قارئ رواية (قافز الموانع) التي يقف القارئ بعد انتهاء سيرورة الأحداث التي سردها لنا الراوي العليم بتلك التفاصيل، بين تأويلين لتعيين من هو المقصود بقافز الموانع، هل هو البطل الذي تحدّى عمّه ومن يقف في صفه..؟ أو عمه (ناصر) الذي لم يكن ليرعوي عن نيل ما يطمح إليه من مكاسب بأيّ طريقةٍ كانت..
***
د. وسام حسين العبيدي