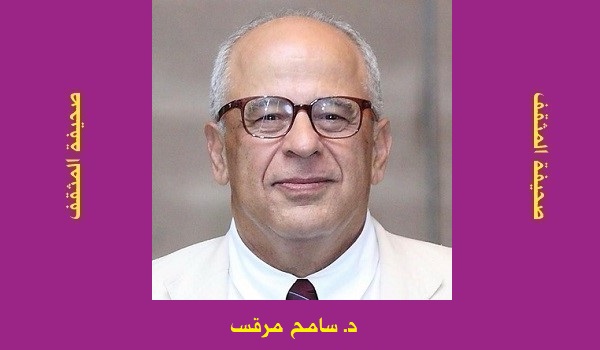قراءات نقدية
فاطمة الثابت: قصر التاجر.. أنثروبولوجيا المكان في الذاكرة السردية لمدينة المسيب

تبدو رواية قصر التاجر للكاتبة منى الثابت وكأنها ليست عن المسيب فحسب بل عن الإنسان في علاقته بالمكان حين يصبح المكان ذاكرة وهوية وكياناً فاعلاً فالكاتبة لا تقدم المدينة بوصفها فضاءً جغرافياً ثابتاً بل ككائن يخلق أبناءه، ويمتص تاريخهم ويعيد إنتاجهم في سرديته الخاصة.
"قد يصعب تحديد ميلاد وعينا بالوجود في هذا العالم بدقة، هل يولد لحظة إبصارنا النور؟ أم لحظة نطقنا الكلمة الأولى؟ أم إنه لاهذا ولاذاك؟ يقيناً، إنه حين تبدأ الذاكرة تسجيل أول المشاهد، أول خطوة على طريق الحياة الدبق المعبد بصمغ الذكريات والمشاعر"
"فأبعد ذكرى تُشكل البداية، وماقبلها اللاشيء..."
منذ المشهد الافتتاحي للرواية، حيث يُعاد بعث البطلين من نجمين في السماء إلى جسدين على الأرض، تضعنا الرواية أمام رؤية كونية أنثروبولوجية للمكان، المكان ليس مجرد خلفية للأحداث، بل أصل الوجود ذاته.
أنثروبولوجيا القصر.. الطبقة والسلطة والذاكرة
القصر في الرواية ليس بناءً معمارياً، بل بنية اجتماعية، إنه يمثل البيت الكبير كما يسميه علماء الأنثروبولوجيا أي النظام الرمزي الذي يُعيد إنتاج الهرمية والسلطة والتمييز بين السيد والتابع، الرجل والمرأة، النخبة والعامة.
" لم تخلع الخاتون السواد مذ توفى زوجها، ولزمت الإمساك بعصاه لا لحاجة بها، إنما كجزء من هندامها ..كما داومت على التختم بخاتمها الذهبي المزين بحجر فيروز دائري الشكل، مكملاً لشكل يدها المعروقة التي وشمتها بنقاط خضراء اللون .."
الخاتون الكبيرة، بما تحمله من سلطة مهيمنة، والباشا، رمز النظام الأبوي ـ الإقطاعي، يشكلان وجهين لسلطة المكان، في حين تأتي شخصية شمسة بوصفها محاولة لكسر هذه البنية عبر وعيها المختلف وجسدها الرافض للتوريث الرمزي للعبودية الأنثوية.
شمسة والبحث عن ضوء المكان
تمثل شمسة في الرواية الوجه الإنساني للمكان، تسكنها المسيب كما تسكن النخلة الفراتية عذوبة الماء ومرارة الملح، شمسة ليست بطلة في سياق رومانسي فقط، بل هي امتداد لأنثى الأرض العراقية، التي تُعيد تشكيل الذاكرة الجمعية في مواجهة التسلط العثماني والثورة المتأخرة.
" شمسة ذات الستة عشر ربيعاً، كان لها من أسمها نصيب شكلاً ومضموناً . أفصحت ملامحها بصدق عما وراءها فلم تكُ بكماء الملامح وجهها البيضوي وضّاء القسمات بسحنته الحنطية وشى بحيويتها …."
من منظور أنثروبولوجيا الأدب، يمكن القول إن شمسة تجسد ما تسميه مارغريت ميد "الذات الثقافية" أي المرأة التي تعي موقعها في نسق اجتماعي - رمزي وتعيد إنتاجه من داخل التجربة لا من خارجها.
" أبطنت شمسة سيلاً من الاستفهامات نحو مسلمات كثيرة يُحظر عليها الخوض فيها، وهذا ماجعلها تجاهد تمردها المستتر بتصرفات مثالية بعض الشيء تكفيراً عمّا اعتقدت أنه سوء في سريرتها.."
الفرات بوصفه أرشيفًا ثقافياً
نهر الفرات في الرواية ليس مجرى مائياً بل حامل للزمن الاجتماعي؛ هو شاهد على التحولات من زمن العبودية إلى زمن الثورة، من التقاليد إلى الأسئلة الوجودية،فكل مشهد على ضفافه يعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والمقدس، بين الذاكرة والأسطورة، وكأن الكاتبة يستخدم الفرات كـ"أرشيف أنثروبولوجي" يحفظ روح الجماعة، وأحلامها، وخيباتها.
الرواية كبحث أنثروبولوجي
ينتمي قصر التاجر إلى ما يمكن تسميته بـ الأدب الأنثروبولوجي؛ أي الأدب الذي يتعامل مع الإنسان بوصفه نص ثقافي مفتوح، ويُعيد قراءة العادات، المعتقدات، اللغة، والسلطة من داخل السرد.
" تزين مضيف النساء بباقات الورد الدمشقي بمختلف ألوانه، وتخلل أغصان الياس . وضعت الباقات في مزهريات كريستال على طاولات الخشب الجانبية بين الأرائك، حيث وضع على كل طاولة مزهرية وشمعدان فضي وكمكُم أو كلبدان (عبارة عن إبريق نحاسي صغير له شكل الكرة من الوسط بقاعدة مخروطية وعنق طويل ورفيع ينتهي بما يشبه الزهرة المثقبة، يستعمل لرش ماء الورد وأحياناً تثبت في ثقوبه أعواد البخور الرفيعة) أما الطاولة الكبيرة في الوسط فقد وضعت عليها مزهريتان …"
خاتمة: من سرد المكان إلى وعي المكان
في نهاية الرواية يتضح أن المسيب ليست مجرد إطار زمني أو مسرح للأحداث، بل ذاكرة جمعية تتجسد عبر اللغة فكل حجر وبستان وضفة نهر في النص هو كائن يروي حكايته الخاصة.
بهذا المعنى يحول الكاتب المكان من فضاء مادي إلى فضاء رمزي ـ أنثروبولوجي، ومن الجغرافيا إلى الوجود.
" وقفت شمسة مع نجيب في الشرفة المطلة على الفرات يتأملان غروب الشمس، فقالت شمسة بيقين وبراءة:
- صدقت أمي عندما أخبرتني أن الشمس حين تغيب تغفو في النهر
- أبتسم نجيب لكلامها ثم وجه إليها سؤالاً ماكراً:
وكيف يكون الماء بارداً ليلاً وقد نزلت الشمس فيه ياشمسة؟
اتسعت عيناها وردت بثقة كبيرة :
لأن الشمس نائمة …."
رواية قصر التاجر هي نص عن المكان في جوهره، عن كيف يصنع الإنسان المكان، وكيف يُعيد المكان صناعة الإنسان إنها شهادة أدبية على أن المكان في الأدب العراقي ليس ديكوراً بل ذاكرة حية تقاوم النسيان.
***
د. فاطمة الثابت