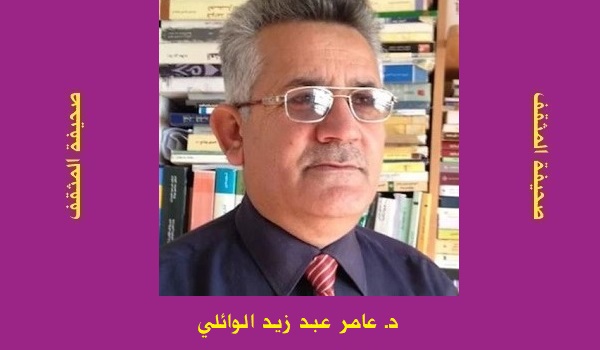تجديد وتنوير
حيدر شوكان: المفارقة الوجدانية في التشيّع الاجتماعي.. بين الحزن الطقسي والفرح الرمزي

صباح هذا اليوم، وبينما كنت أجلس في سيارتي متجهًا في مشوار اعتيادي، كان الراديو يصاحب الطريق بصوته الخافت، حتى استوقفتني إحدى الإذاعات المحلية التي استضافت خطيبًا دينيًا عرفته منذ طفولتي، وكنت أراه يتنقّل بين المنابر والمناسبات التي لا تنقطع في فضائنا الشيعي. كان صوته كما عهدته، يحمل نبرة الوعظ ذاتها، غير أني هذه المرة لم أستمع إليه بذاكرة السامع، وانما بعين المتأمل. إذ تسربت إلى ذهني فكرة ظلت تتشكل ببطء: أي تجربة وجدانية يعيشها المجتمع الشيعي وهو ينتقل، على مدار العام، بين مآتم تتداخل مع أفراح، وبين طقوس تتعاقب حتى تكاد تلغي المسافة بين الحزن والبهجة؟
هناك، في ساعة صامتة بين الجملة والخطبة، أدركت أنّ هذا التعاقب هو بنية وجدانية وثقافية تستحق أنّ تُقرأ بوصفها مرآةً لعمق النفس الجماعية، ولمفارقتها الغريبة بين الألم والأمل، بين الذاكرة والاحتفال، بين ما يُبكي وما يُبهج في آن واحد.
من يتأمل في المشهد الشعائري للتشيّع الاجتماعي، يلحظ ظاهرة لافتة تثير تساؤلًا أنثروبولوجيًا ونفسيًا في آن واحد: كيف لجماعة دينية أنّ تعيش في إيقاع زمني تتعاقب فيه المناسبات بين الحزن والفرح بصورة متقاربة إلى حد التداخل؟ فالأسبوع الواحد لا يكاد يمرّ إلَّا وفيه مأتم لإمام أو مولد لآخر؛ يوم للدموع واللطم والجزع، ويوم تالٍ للبهجة والإنشاد والفرح. هذه الظاهرة، التي تبدو لأول وهلة تناقضًا وجدانيًا، تستبطن في عمقها رؤية مغايرة للزمن وللمعنى، إذ لا يخضع الشعور الديني لقوانين الانفعال المادي، بل يتغذى من تجربة رمزية تعيد إنتاج التاريخ في الوجدان المعاصر.
فالحزن في التشيّع هو بنية رمزية متجذرة في سردية الظلم والتضحية. إنه استحضار مستمر لجرح تأسيسي تمثله كربلاء بوصفها لحظة انكسار للعدالة وولادة للوعي. لذلك، لا يُفهم الحزن الشيعي كحالة اكتئاب جماعي، بقدر ما هو آلية لإبقاء الذاكرة مفتوحة على سؤال الحق والباطل. في المقابل، يأتي الفرح الطقسي ليعيد إلى هذا التاريخ صبغته المشرقة، وكأن كل مولد هو وعد متجدد بأن النور لا ينطفئ، وأنّ الأمل ما زال ممكنًا رغم استبداد المأساة. بهذا المعنى يصبح الفرح امتدادًا للحزن، لا نقيضًا له، فكلاهما جزء من دورة رمزية واحدة تحفظ توازن الوعي بين الألم والرجاء.
الطقس الديني/ الاجتماعي، في بنيته العميقة، هو نظام لغوي يعبّر به الإنسان عن علاقته بالمقدس وليس مجرد مظهر خارجي للانفعال. في الحالة الشيعية، تتخذ هذه اللغة بعدًا دراميًا: البكاء واللطم والزيارة والإنشاد مفردات في خطاب رمزي واحد، وليست ممارسات متفرقة. إلا أن الإفراط في هذا الخطاب- حين يتحول إلى عادة يومية خالية من التأمل- يولّد نوعًا من الازدواج الوجداني، إذ يجد الفرد نفسه متنقلًا بين حزن عميق وفرح مفاجئ دون أن تتاح له فرصة إعادة توازن المشاعر. هنا يظهر ما يمكن تسميته بـ "التوتر الطقسي"، أي الحالة التي يتحول فيها التعاقب الطقسي إلى ضغط نفسي وجماعي في آن واحد، فالمجتمع الذي يودع مأتمًا في المساء ويستقبل مولدًا في الصباح التالي يعيش تجربة انفعالية مضغوطة لا تتيح للوجدان أن يستقر على حالة شعورية واحدة.
ومع ذلك، لا ينبغي قراءة هذا التوتر بوصفه خللًا، وانما يمكن فهمه بوصفه آلية دفاع ثقافية ضد النسيان وضد الموت الرمزي للمعنى ومنابعه. فالحزن المكثف يمنع الذاكرة من التكلّس، بينما يضمن الفرح استمرارية الحياة في وجه هذا الثقل التاريخي ووطأته. الشيعي لا يفرح لينسى، بل ليواصل الحياة رغم الألم، ولا يحزن ليستسلم، بل ليحتجّ على التاريخ. إن التوتر بين النقيضين يصبح، في هذا السياق، توازنًا من نوع آخر: توازنًا ديناميكيًا يحافظ على حرارة الوعي ويمنع الجماعة من السقوط في اللامبالاة.
الزمن في الوعي الشيعي دائريًا، وليس خطيا؛ فالماضي يعود في كل موسم وشعيرة ليُعاد تمثيله من جديد. هذا الزمن المقدس يتخطى التقويم التاريخي ليخلق نوعًا من "الذاكرة الحية" التي لا تفصل بين الموت والبعث، بين الكارثة والوعد. ومن ثَّم، تنبع المفارقة: فحين يفرح الشيعي بولادة الإمام، فهو لا يحتفل بلحظة زمنية بقدر ما يحتفل بمعنى مستمر، وحين يحزن على استشهاده، فهو لا ينعى غيابًا بقدر ما يستحضر حضورًا يتجدد في كل آن. إنه يعيش في زمن تتجاور فيه النهايات والبدايات، فلا يكون الحزن سوى وجه آخر للفرح، ولا تكون المأساة سوى بوابة للرجاء.
ومع أن هذه البنية الرمزية العميقة تمنح التشيّع طاقته الروحية، إلا أن خطر الانفصال بين الطقس ومعناه يظل قائمًا. فحين تُمارس الشعائر بلا وعي تأملي، يتحول الدين إلى عادة، والرمز إلى قيد. هنا يصبح التوازن مهددًا، ويظهر الاضطراب النفسي بوصفه نتيجة لتراكم الأفعال الخالية من المعنى. لذلك، تبرز الحاجة إلى التفكير الطقسي، أي تحويل الممارسة الدينية إلى فعل تأملي متعقل يعيد وصل الانفعال بالعقل، والرمز بالمعنى.
إن ما يبدو اضطرابًا وجدانيًا في التشيّع الاجتماعي هو في جوهره توتر خلاق بين الحزن والفرح، بين التاريخ والرمز، بين الذاكرة والحلم. فالجماعة التي تبكي كي لا تنسى وتفرح كي لا تموت، تمارس شكلًا فريدًا من مقاومة الزمن وصون المعنى في عالم يميل إلى التفاهة والنسيان.
الا أن استمرارية هذا المعنى مرهونة بقدرة الفرد والمجتمع على الوعي بالطقس، كتمرين روحي وفكري على إدراك التناقض وتجاوزه. فالحزن حين يُعقلن يصبح وعيًا، والفرح حين يُؤوَّل يصير حكمة، وبينهما يولد توازن جديد، ليس في الانفعال، وانما في الرؤية.
***
د. حيدر شوكان سعيد
قسم الفقه وأصوله- جامعة بابل.