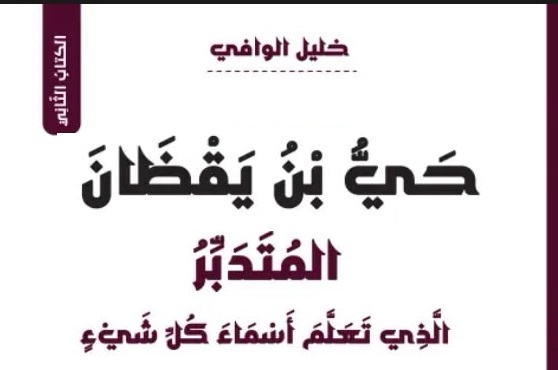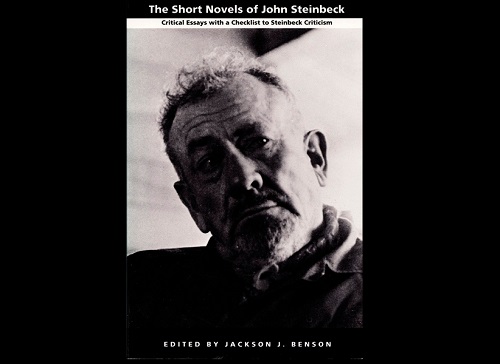لم تكن أم كلثوم مجرد صوت جميل يصدح، أو نجمة تلمع في سماء الفن، بل كانت - وما تزال – رسالة إنسانية تتخطى الحدود، وتختصر المسافات بين الشرق والغرب. وها هي اليوم، بعد رحيلها، تواصل مهمّتها، لكن هذه المرة من خلال متحفها الذي استقبل وزيرا الثقافة في مصر وفرنسا، ليكون شاهدًا على أن الفن لغة لا تحتاج إلى ترجمة، وأن الثقافة هي الجسر الأقوى بين الشعوب.
في حضرة كوكب الشرق
في قصر المانسترلي، حيث يمتزج النيل بصوت أم كلثوم، التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو بالسيدة رشيدة داتي، ليس فقط ليتفقدا مقتنيات السيدة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، بل ليبحثا كيف يمكن لهذا الصوت العابر للقارات أن يكون مدخلًا لتعاونٍ ثقافي أعمق. فالفرنسيون، رغم بعدهم الجغرافي، يعرفون قيمة "كوكب الشرق"، لأن الفنّ العظيم لا يُقيم وزنًا للحدود.
السياسة تلتقي عند المطالب المشتركة، لكن الثقافة تلتقي عند المشاعر المشتركة. اختيار متحف أم كلثوم لاستقبال الوزيرة الفرنسية رسالة ذكية تقول: "هذه مصر التي نحب، وهذه مصر التي تفتح أبوابها للعالم". ففي زمن يحاول البعض أن يصور الشرق على أنه متحف للإرهاب أو الفوضى، تأتي أم كلثوم لتذكر الجميع بأن هذه الأرض أنجبت أعظم الفنانين، وأسست لأرقى الحضارات.
عندما أعلن البلدان عام 2019 عامًا للثقافة المصرية الفرنسية، لم يكن ذلك حدثًا عابرًا، بل كان تتويجًا لعلاقةٍ ثقافية عمرها قرون. فالفرنسيون هم من ساعدوا في فك رموز حجر رشيد، وهم من أقاموا أواصر ثقافية مع مصر منذ حملة نابليون، رغم ما فيها من تناقضات. اليوم، نحن أمام فصل جديد من هذه العلاقة، حيث تطرح فرنسا أن تكون ضيف شرف في معرض القاهرة للكتاب، وتتحدث عن تعاون في الترجمة وترميم المخطوطات. وهذا يعني أن الثقافة، رغم كل محاولات العولمة لطمس الهويات، ما زالت تحتفظ بقدرتها على الجمع بين المختلفين.
التراث ذاكرة لا تموت
أهم ما ناقشه الجانبان هو ملف "التراث غير المادي"، وهو مصطلح يبدو أكاديميًا، لكنه في الحقيقة يمثل روح الشعوب. فالأغاني، العادات، الحكايات الشعبية، وحتى الطبخ التقليدي، كلها عناصر تشكل هوية الأمم. ومصر وفرنسا، بتراثهما الغني، يمكنهما أن يقدّما للعالم نموذجًا لكيفية الحفاظ على هذه الذاكرة الإنسانية. أم كلثوم نفسها لم تكن مجرد مغنية، بل كانت جزءًا من تراث غير مادي صار عالميًا.
دبلوماسية الثقافة..
في كتابه "قوة المكان"، يقول الكاتب الأمريكي توماس فريدمان: "عندما يتحدث السياسيون، يصغي الناس بأذن واحدة، وعندما يغني الفنانون، يصغون بقلوبهم كلها". وهذا بالضبط ما حدث في متحف أم كلثوم. فبينما قد تختلف الحكومات حول ملفات شائكة، فإن الجميع يتفق على عظمة "أغنية الأمل" أو "سيرة الحب". لقد حولت أم كلثوم – من دون أن تدري – متحفها إلى "منطقة محايدة" تذكر الضيوف بأن هناك مساحات مشتركة لا يختلف عليها. والسؤال هنا: كم من المواقف السياسية المتوترة يمكن أن تذوب لو جعلنا الثقافة وسيلتنا الأولى للحوار؟
وفي العصور الوسطى، كانت القبائل تهاجم بعضها فتحرق المدن وتقضي على السكان، لكنها كانت تترك الشعراء! لأنهم كانوا يعتبرون "ذاكرة الأمة". اليوم، أم كلثوم هي شاعرة الصوت، ومتحفها هو الذاكرة التي تحفظ هويتنا. وزيارة الوزيرة الفرنسية لهذا المتحف تذكير بأن الأمم لا تموت حين تحافظ على تراثها، بل تصبح جزءًا من ذاكرة الإنسانية جمعاء.
الثقافة هي البوصلة
في زمن الحروب والصراعات الاقتصادية، تبقى الثقافة هي البوصلة التي تذكرنا بإنسانيتنا. زيارة الوزيرة الفرنسية لمتحف أم كلثوم تثبت أن مصر، رغم كل التحديات، ما زالت قادرة على أن تكون منارة للفن والثقافة. وها هو صوت أم كلثوم، بعد نصف قرن من رحيلها، لا يزال يجمع بين ضفتي المتوسط، ليذكرنا بأن الفنّ الحقيقي لا يعترف بالحدود، وأن الثقافة هي أقوى وسيلة للحوار.
فليستمر الحوار، وليكن الفن دليلنا.
***
د. عبد السلام فاروق