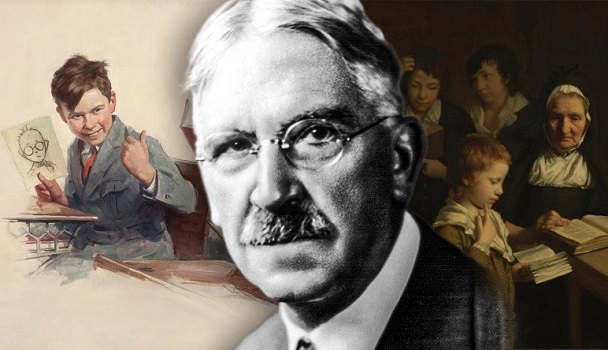اخترنا لكم
خالد الغنامي: الرواية.. الفن والدور السياسي

منذ بداياتها الحديثة في القرن الثامن عشر، ظلّت الرواية تُقرأ وتُكتب تحت لافتة الفن، بوصفها الجنس الأدبي الأكثر قدرةً على استيعاب الشخصيات والأحداث والأزمنة والفضاءات. وقد منحت القارئ متعة التخييل وفرصة التأمل في الحياة من خلال منظار خيالي، وجعلته يشارك في تجربة فنية تستدعي الحواس والخيال معاً. غير أن التاريخ الأدبي يكشف أنّ الرواية، في كثير من محطاتها، لم تكن تكتفي بمهمتها الجمالية، بل أدّت أدواراً تجاوزت الفن البحت، لتدخل في قلب النقاشات السياسية والاجتماعية، سواء كان ذلك تصريحاً أو إيحاءً ضمنياً. ومن هنا برزت الفكرة التي ألمح إليها عددٌ من الروائيين في تجاربهم، الرواية يمكن أن تكون أداة من أدوات الحوار الفكري، وأنها قد تسهم في تشكيل الوعي الجمعي بقدر ما تقدم متعة جمالية.
الرواية، في هذا المنظور، تتحوّل إلى منبر طويل المدى، يختلف عن الخطبة السريعة أو المنشور قصير العمر. فهي نص يمتلك أدوات الإقناع، حبكة متماسكة تمسك بالانتباه، وشخصيات تنمو وتثير التعاطف أو النفور، ولغة تجمع بين الإيحاء الفني والحِجاج الفكري. وحين يُوظَّف هذا البناء لخدمة قضية عامة أو للتعبير عن رؤية تجاه مجتمع أو سلطة، فإن أثره يكون أعمق من أي خطاب مباشر، لأن الرواية لا تخاطب العقل وحده، بل تنفذ إلى الوجدان، وتستثير الخيال، وتخلق تجربة شعورية تجعل القارئ يعيش الفكرة قبل أن يقتنع بها.
أمثلة ذلك عديدة؛ فهناك الرواية السياسية الصريحة التي تحوّل أحداثها وشخصياتها إلى مرآة مباشرة لواقع قائم، مثل روايات جورج أورويل: «1984» و«مزرعة الحيوان»، أو رواية آرثر كوسلر: «ظلمة عند الظهيرة» التي قدّمت نقداً داخلياً للنظام السوفياتي من خلال تصوير المحاكمات السياسية. هذه الأعمال لم تُكتب لمجرد إبراز براعة أسلوبية أو ابتكار شكلي، بل جاءت من شعور عميق بضرورة التدخل في النقاش العام وتحذير القراء من مسارات قد تقود إلى الاستبداد.
غير أن الدور السياسي للرواية لا يقتصر على الأعمال المباشرة، بل قد يظهر بصورة ضمنية أكثر عمقاً. فديستويفسكي، مثلاً، لم يكتب رواياته ليصدر بيانات سياسية، لكنه من خلال شخصياته الممزقة وأسئلته الوجودية الكبرى عن الحرية والسلطة والعدالة، فتح للقارئ مجالاً رحباً لتأمل هذه القضايا. وكذلك فعل نجيب محفوظ، الذي وثّق تحولات مصر السياسية والاجتماعية على مدى عقود، وجعل القارئ يعيش تفاصيلها من الداخل عبر شخصياته التي تمثل طبقات وشرائح المجتمع. في مثل هذه الأعمال، السياسة لا تظهر شعاراً، بل خلفية خفية توجه الأحداث وتشكل المصائر.
في المقابل، هناك اتجاه أدبي عُرف بـ«الفن للفن»، يرى أن القيمة الجمالية للرواية تكمن في استقلالها عن أي غرض خارجي، وأن إخضاع الفن لغايات سياسية يهبط به إلى مستوى الدعاية. لكن هذا الموقف يتجاهل أن كل عمل أدبي مرتبط، بشكل أو بآخر، بسياقه الزمني والمكاني. فالكاتب حين يختار موضوعاً أو شخصية أو أسلوباً لغوياً، فإنه يكشف عن رؤية للعالم، وهذه الرؤية قد تحمل أثراً سياسياً حتى لو لم يُصرَّح به. الرواية إذن ليست خطاباً محايداً بالكامل، لأنها تعكس قيماً وأفكاراً ووجهات نظر تسهم في تشكيل وعي القارئ.
حتى الروائي الذي لا ينتمي إلى حزب أو تيار سياسي، لا يعزل نصه عادة عن قضايا عصره، بل يتعامل مع الرواية باعتبارها وسيلةً لاستكشاف القيم والأفكار. فهي ساحة لاختبار المواقف والرؤى، قادرة على خوض معارك فكرية بأسلوب فني بعيد عن الخطابة المباشرة. القارئ حين يدخل عالَم رواية جيّدة لا يشعر أنه يتلقى تعليمات، بل يتعاطف مع شخصيات ويعيش أحداثاً، لكنه بعد أن يطوي الصفحة الأخيرة قد يكتشف أن نظرته لقضية اجتماعية أو تاريخية تغيّرت بعمق.
التاريخ الأدبي يقدّم شواهد كثيرة على هذا التأثير. من كوخ العم توم لهارييت ستو، الذي ساهم في إذكاء الجدل حول العبودية في أميركا، إلى روايات أميركا اللاتينية التي وثّقت أجواء الديكتاتوريات وكشفت آليات القمع. وفي السياق العربي، نجد أن بعض الروايات عالجت تحولات المجتمع وظروف الاستعمار وما تلاها من تحديات بناء الدولة، مقدّمةً بذلك شهادةً فنيةً على مرحلة تاريخية فارقة. في كل هذه النماذج، لم يُلغَ الفن لصالح السياسة، بل منحت السياسة نفسها عمقاً وقوة عبر الفن.
إن القول إن الرواية ليست للفن وحده لا يعني اختزالها في السياسة، بل الاعتراف بأنها تحمل طاقة مزدوجة، جمالية تغذّي الخيال والحس الإنساني، وفكرية قادرة على المساهمة في تشكيل الوعي العام. والكاتب الذي يدرك هذه الازدواجية قادر على أن يقدم عملاً يعيش طويلاً في ذاكرة القراء، يجمع بين البهاء الفني والرسالة الفكرية.
وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتغير فيه وسائل الاتصال، تبقى الرواية، رغم بطء قراءتها، مساحة نادرة للتأمل العميق، ولرؤية السياسة من منظور البشر العاديين الذين يعيشون آثارها. هي فن أولاً، لكنها أيضاً أفق للتفكير، يسهم في ترسيخ الفهم والتوازن داخل المجتمع. ومن هنا تأتي أهميتها؛ فهي لا تهدف إلى إشعال الصراع أو الدعوة إلى التغيير الجذري، بل إلى تعزيز الوعي، وتوفير لغة مشتركة لفهم القضايا الكبرى، بما يجعلها رافداً من روافد الاستقرار والنضج الثقافي.
***
خالد الغنامي - كاتب سعودي
عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 22 سبتمبر 2025 م ـ 30 ربيع الأول 1447 هـ