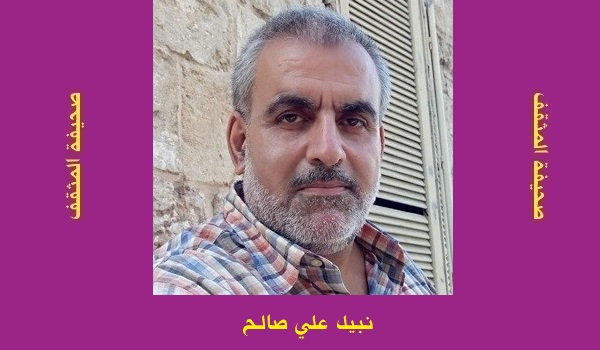شهادات ومذكرات
عبد السلام فاروق: وداعًا حسن عبد الحميد.. فيلسوف العقل وحارس المنطق

ماذا يبقى من الفيلسوف حين يرحل؟ أتبقى كتبه حروفًا جامدة على ورق أصفر، أم تتحول أفكاره إلى كائنات حية تسكن عقول تلاميذه؟ وهل الموت نهاية للمفكر حقًا، أم أنه تحول من الوجود المادي إلى الوجود الفكري الخالص؟ هذه الأسئلة الوجودية تفرض نفسها بقوة مع رحيل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، ذلك العقل المصري الذي جسد بمسيرته معنى "الفيلسوف المعلم" الذي لم يكتف ببناء نظريات مجردة، بل أسس مدرسة فكرية حية تنبض في تلاميذه من أمثال الدكتور أحمد فاروق. يشكل رحيله تغيبًا لرؤية فريدة في فهم العلاقة بين المنطق والواقع، بين التراث الفلسفي العربي والحداثة الأوروبية.
من الصعيد إلى السوربون
ولد الدكتور حسن عبد الحميد عام 1940 في قرية الحريزات بمحافظة سوهاج، في بيئة زراعية بسيطة لم تكن تبدو مهيأة لاستقبال فيلسوف مستقبلي. لكن القدر كان يخبئ له مسارًا مختلفًا. بعد حصوله على درجة الليسانس من جامعة عين شمس، سافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة المنطق وفلسفة العلوم في جامعة السوربون العريقة، حيث قضى هناك أكثر من عقد كامل (1964-1975)،
في فرنسا، عمل حسن عبد الحميد باحثًا في المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) من 1968 إلى 1973، وهي فترة غنية شكلت وعيه الفلسفي. هناك تعرف على تيارات الفكر الفرنسي الحديث، وتأثر بشكل خاص بفلاسفة مثل جاستون باشلار وجان بياجيه وروبير بلانشيه، الذين قدموا رؤية نقدية للأبستمولوجيا تختلف عن المدرسة الوضعية المنطقية السائدة آنذاك، هذه التجربة العميقة مع الفلسفة الغربية لم تقطع صلته بجذوره العربية، بل على العكس، زودته بأدوات جديدة لإعادة قراءة التراث الفلسفي الإسلامي.
العودة والبناء
عندما عاد الدكتور حسن عبد الحميد إلى مصر، حمل معه رؤية جديدة للمنطق وفلسفة العلوم. رسالته الدكتوراه التي حملت عنوان "منطق الاستدلالات القانونية" كانت إشارة مبكرة إلى اهتمامه بالجوانب التطبيقية للمنطق، بعيدًا عن التجريد النظري المحض،
في جامعة عين شمس، بدأ عبد الحميد مسيرته الأكاديمية التي استمرت عقودًا، تدرج خلالها من مدرس إلى أستاذ مساعد ثم أستاذ كرسي. لكن دوره لم يقتصر على التدريس الرسمي، فقد كان -كما يصفه تلميذه الدكتور محمود محمد علي- يتمتع بـ"أسلوب مفيد وشيق، يتعامل مع تلاميذه كأنداد له، وليسوا مجرد طلبة يتلقون العلم على يديه". هذا التواضع الفكري المصحوب بعمق معرفي جعل منه معلمًا استثنائيًا، ترك تأثيرًا كبيرًا على أجيال من دارسي الفلسفة في مصر والعالم العربي.
بين التراث والحداثة
مسيرة الدكتور حسن عبد الحميد لم تكن سهلة أو خالية من التحديات. واجه كغيره من المفكرين العرب إشكالية العلاقة بين التراث الفلسفي الإسلامي والمنطق الحديث. في وقت كان فيه الكثيرون إما منغلقين على التراث رافضين كل جديد، أو منبهرين بالغرب رافضين كل قديم، حاول عبد الحميد تأسيس رؤية نقدية توافقية.
من أهم معاركه الفكرية دفاعه عن "المنطق الإشراقي" للسهروردي المقتول، حيث رأى أن هناك تقاطعات بين هذا المنطق وبين بعض تيارات المنطق الحديث، كما خاض معركة أخرى في الدفاع عن دور المنطق في الفقه الإسلامي، خاصة عند الأشاعرة، معتبرًا أن هناك علاقة عضوية بين المنهجين لم تُدرس بشكل كافٍ في التراث العربي الإسلامي،
بين التأليف والترجمة
ترك الدكتور حسن عبد الحميد إرثًا فكريًا غنيًا، وإن كان -للأسف- غير معروف بالقدر الكافي خارج الأوساط الأكاديمية المتخصصة. من بين أعماله البارزة:
1. دراسات في المنطق متعدد القيم: حيث حاول فيها الربط بين المنطق الحديث والتراث المنطقي العربي،
2. المنطق الصوري القديم بين الأصالة والمعاصرة: دراسة نقدية للمنطق الأرسطي في ضوء التطورات الحديثة،
3. العلاقة بين المنطق والتصوف: حيث تناول فيها تجربة السهروردي المقتول كنموذج للتفاعل الخلاق بين المنطق والتصوف،
كما ترجم كتاب "البصيرة والفهم: دراسة في أهداف العلم" لستيفن تولمن، مقدمًا للقارئ العربي أحد أهم أعمال فلسفة العلوم المعاصرة،
الأسلوب والرؤية
تميز أسلوب الدكتور حسن عبد الحميد -كما يصفه تلاميذه- بـ"الهيبة والوقار التي كانت تكسو ملامحه الشخصية الظاهرة، وتكشف عن باطن ثري، يعمر بإيمان قوي، وثقة بالنفس، وعاطفة جياشة، وسريرة نقية، وقلب صاف عن الأحقاد "، هذه الصفات انعكست على منهجه الفلسفي الذي جمع بين الدقة المنطقية والعمق الإنساني.
في محاضراته، كان عبد الحميد يرفض التلقين، ويشجع تلاميذه على إبداء آرائهم بحرية، حتى لو اختلفت مع آرائه. يقول الدكتور أحمد فاروق في وصفه: "من فرط أدبه العظيم أنه كان يدلي برأيه من غير ما إصرار على صحته، وكنت أراه يفصح عن وجهة نظره السديدة في الوقت الذي يطالبك فيه إبداء وجهة نظرك بكل صراحة ووضوح"،
التأثير والتلاميذ
ربما يكون أعظم إنجازات الفيلسوف الحقيقي هو تلاميذه الذين يحملون فكره ويطورونه. في حالة الدكتور حسن عبد الحميد، كان من بين تلاميذه البارزين الدكتور أحمد فاروق، والدكتور عصام بيومي والدكتور هاني مبارز،
هؤلاء التلاميذ لم يكونوا مجرد ناقلين لأفكار أستاذهم، بل طوروا رؤى جديدة مستلهمة من الأساس الذي وضعه. ففي الوقت الذي ركز فيه عبد الحميد على المنطق وفلسفة العلوم، توسع تلاميذه في مجالات أخرى مثل فلسفة السياسة وحروب الجيل الرابع والخامس، لكنهم حافظوا على الروح النقدية والمنهجية الدقيقة التي غرسها فيهم،
الرحيل والبقاء
اليوم، وقد رحل الجسد، تبقى الأسئلة التي أثارها الدكتور حسن عبد الحميد حية في كتبه ومحاضراته وتلاميذه. رحيله يذكرنا بأن الفيلسوف الحقيقي لا يموت تمامًا، لأن أفكاره تظل تحاور الأجيال اللاحقة. لقد كان عبد الحميد نموذجًا نادرًا للفيلسوف المعلم الذي لم يكتف بالتنظير، بل ساهم في بناء عقول قادرة على التفكير النقدي الخلاق.
في زمن تطغو فيه الصورة على الجوهر، والسرعة على العمق، يصبح فقدان مثل هذه العقول خسارة مضاعفة. لكنّ التعويض الوحيد عن هذه الخسارة هو مواصلة القراءة لأعماله، وإعادة اكتشافها، ونقلها إلى أجيال جديدة ربما تكون أكثر حاجة إليها اليوم مما كانت عليه الأجيال السابقة.
رحل الفيلسوف، لكن فلسفته باقية. غاب الرجل، لكن أسئلته مازالت حاضرة. وهذا ربما هو أصدق تعريف للخلود.
***
د. عبد السلام فاروق